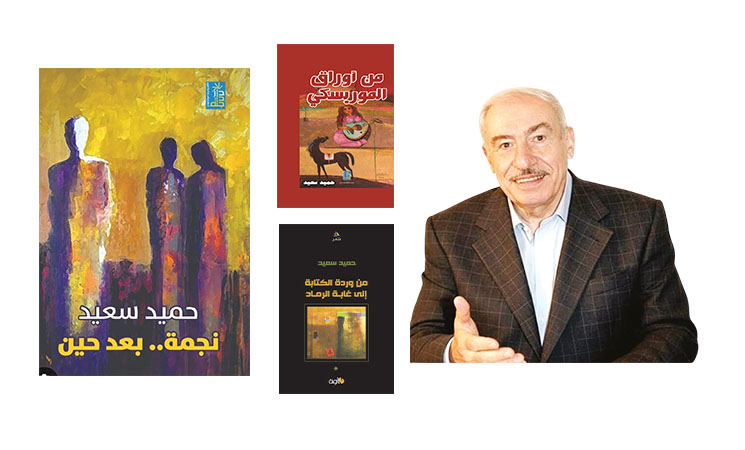1ـ توطئة:
رواية الكاتب والمفكر المصري يوسف زيدان المعنونة بـ «الورّاق ـ أمالي العلا»(*1)، تتحدث عن شخصيتين من التاريخ، الأول «نصري بن قاسم بن عبد المجيد الجعفري الشريف» (ص 69)، وهو السارد لأحداث الرواية، كان ينسخ الكتب. والثاني هو علاء الدين المعروف بـ «ابن النفيس» أحد أهم أطباء عصره، من أصل سوري، انتقل إلى مصر وحقق بها مبتغاه.. إلى أن أصبح رئيس أطباء مصر والشام..
جمع الكاتبُ الرجلين في عنوان مشترك للرواية! رغم أن الطبيب «ابن النفيس» يكبر الناسخ بأربعين عاما، وهذا الأخير عاش أربعين عاما بعد وفاة الأول. بعملية حسابية نجد أن وقائع الرواية تغطي مائة وعشرين عاما جلها استغرقه القرن السابع الهجري.. وقد عرف العالم الإسلامي حينذاك أحداثا جساما، وخاصة في المنطقة التي تجمع مصر والشام..
يحكي السارد عن حياته؛ مولدُه كان بصعيد مصر، وبسبب أحداث سياسية مات والده وتركه صغيرا في حضن خاله.. فتعلم منه نسخ الكتب وبرع فيها.. ثم انتقل إلى القاهرة بهوية واسم مختلفين مخافة الانتقام منه وقتله بسبب تاريخ والده والصراع على السلطة والانتقامات التي تأتي من طرف المنتصرين بعد كل جولة تطاحن..
احترف النّسخ وعمل مع صاحب وكالة، ولما انهارت الوكالة بموت صاحبها، أصبح «الوراق» يعمل مستقلا، ثم مشتركا مع صديق له اسمه يحيى بن خلف. وقد عانى الكثير من الفقر ومن أشكال الخداع التي تعرض لها، من ذلك ما لقيه من معاملة زوجته وأمها.. لكن براعته في نسخ الكتب وتسفيرها جعلته معروفا، ويتلقى الكثير من الطلبيات.. إلى أن تعرف عليه «ابن النفيس» وهو أحد أشهر أطباء مصر، فاستقدمه إليه لنسخ الكتب عامة وخاصة المتعلقة بالطب، وخصص له إقامة وأجرة، وتوطدت علاقتهما، إلى أن أملى الطبيبُ سيرته على الناسخ..
من هنا تبدأ الحكاية الثانية في الرواية، وقد انطلقت من منشأ الطبيب ببادية دمشق، إلى انتقاله إلى مصر، مرورا بما عاناه هو وأسرته وبلده الأصلي سوريا عموما من تقلبات أوضاع الحُكم وصراع الحكام والغزو الخارجي التتري والمغولي والصليبي.. وانتشار الأوبئة (ص 82).
يبدو أن الكاتب يوسف زيدان لم يقصد من روايته هاته، تقديم نبذة من التاريخ، ولكن غرضه الأساسي حسب ما يبدو هو تضمينُ المتنِ رسائلَ واضحةً وأخرى مُشفرة تَعني الحاضر.. وإن كان الكِتاب موسوما بجنس الرواية، لكنه لا يخلو من تلميحات تاريخية سيْرا على نهج الكاتب كما وقع مع رواية «عزازيل»(*2)، واعتماده بحثا دقيقا في ثنايا كل حقبة مَعنية بالكتابة عنها..
2ـ الصراعات والفتن:
ما أن تهدأ الأوضاع بانتصار طرف على آخرين، حتى يحمى الوطيس من جديد، فتعمّ الفوضى والقتل والانتقام والسبي والتخريب.. «وحسب ما دلت عليه تجاربُ الأمم ومآلات الويلات، فلا عبرة هنا بأن الغالبين مسلمون أو غير مسلمين، فالمحاربون والساعون إلى السلطة لا يعرفون أي دين، ودَيْدنهم الدائم هو الفتكُ والسفك والغدرُ.». (ص62). فالغلبة لمن انتصر، ولكن إلى حين! لهذا تكثر في الرواية أخبار القتل الشنيع في ما بين الحكام، من ذلك ما يوجد بالصفحتين 58 و59. وكذلك بالصفحة 255 نموذجا عن مسلسل الاغتيالات الذي ابتدأ بين «شجر الدر» وزوجها الأمير «أيبك»..
لهذا ظل يعيش الإنسان مرتعبا حتى ولو لم تكن له أية علاقة بالسياسة والتطلع للسلطة. أما في حالة الرفض وشق عصا الطاعة، فالسارد يذكر ما يشبه القانون، حيث «كل الثورات تنتهي بالأبرياء إلى هاوية الخراب والويلات، ثورة الزَّنج، ثورة الحسين، ثورة المختار الثقفي، ثورة البشموريين. وفي كل مرة يغلب الظالمون الثوار، لأن الأعتى أقوى من الأنقى، ولأنه لا شيء له معنى حتى يستحق الثورة من أجله» (ص 87). خلاصة السارد وهو يتحدث عن مأساته الشخصية، مطاردا، هاربا، فقط لأن أباه كان مع «ثوار» ضد المماليك! لكنه لم ينبته إلى أن كل «حركة سياسية»، تبشر بالأمل، سرعان ما ينقلب ذلك إلى ألَـم كما تطرقت لذلك الرواية في عدة مواقع..
3ـ النقد الذاتي الصريح:
تتجلى في الرواية الكثير من مظاهر النقد الذاتي القوي والصريح، ليس من طرف السارديْن فقط نحو نفسيهما ومسارهما الشخصي، ولكن كذلك ما له علاقة بالتاريخ والأمة والتدين والدول والحكام والسلوك العام للناس..
إذا كان «ابن النفيس» نفسه قد حقق نجاحات مبهرة في مجال الطب والتدوين وتكوين الأطباء.. فبدوره لم يسلم من توجيه النقد إليه، لعل أهم ذلك هروبه من الشام إلى مصر، دعمه لبعض الحكام والسهر على صحتهم رغم ما يقومون به من جور. غيْرَ أن اقتراحه أسلوبا جديدا في ميدان الطب الحربي، يُعدّ من صميم الواجب والدفاع عن النفس والبلد..
أما «الوراق»، فقد ظل يعتقد أن هويّته السابقة وتَخفّيه المبالغ فيه، يحميه من أي انتقام ويجعله خارج عيون السلطة، بينما العكس هو الصحيح، فحتى وهو كشخص هامشي، يُقدِّمُ عنه المخبرون تقريرهم اليومي! (ص 269).
يظهر أن أهم مبتغى من وراء كتابَة رواية «الورّاق ـ أمالي العلا» ونشرها، هو انتقاد السياقات الحضارية والثقافية والسياسية لمرحلة زمنية معينة غطّت قرنا ونيف من الزمن، يعني منطقة جد حساسة في العالم الإسلامي وهي مصر والشام.. ولعل أبرز مَلمح من ذلك بعض أشكال التديّن التي تحمل في طياتها تناقضات صارخة بين الفعل والقول، بين الاتكال والتوّكل.. نجد السارد مثلا يقول: «.. دعوت الله كثيرا في صلواتي.. وبكيت مرارا وأنا أدعوه ساجدا. لكنه لم يستجب». (ص116). بل أكثر من ذلك يطرح تساؤلات وجودية ويشكك في كل شيء، بما في ذلك ما يذكره «خطباء المنابر الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء، والوعَّاظ المدَّعون الذين مكَّنهم الدين من آذان السامعين، يؤكدون للناس أن كل إنسان يقدَّر عليه في اللوح المحفوظ لحظة مولده، رزقه وأجله وكونه في حياته شقيًّا أم سعيدا. دون بيان للحكمة في ذلك، وعلى أي قاعدةٍ وأساسٍ يكون شقاؤه أو سعادته؟ هم لا يعرفون، ولا أحد يعرف المعنى المراد من تلك الأقدار التي لا ضابط لها ولا معيار». (ص 117).
لهذا أعاد السارد النظر في ما قبِل به سابقا، وأدرك «أن أمور الحياة تسير على غير هدى ولا ضابط ولا سبيل مستقيم، وطرحتُ عني (حسب قوله) المعتقدات الإيمانية بالكلية، بل وتوقفت عن التفكير فيها..». (ص72). لهذا سيُعلن لاحقا توقفه عن الصلاة (ص 123)، وممارسته بعض الأفعال غير المقبولة دينيا كمعاشرة المتزوجات(ص 282)..
4 ـ مميزات خاصة:
تضع الرواية القارئَ في خضم السياق التاريخي الذي وقعت فيه الأحداث خلال القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي.. ولعله زمن اتسم بالتراجع عن المراحل السابقة التي اتسمت بتحقيق انتصارات عسكرية، وإنجاز بعض المساهمات الثقافية والحضارية في المعمار والتأليف والاستقرار.. بل لقد انطلقت مرحلة أخرى من علاماتها الانغلاق على الذات، والاكتفاء بمحاولة صد العدوان الخارجي، الذي كان قد التهم الأطراف، وأحدث الخراب والدمار، ولم يتم توقيفه سوى بعد تكتل المصريين في زمن الظاهر بيبرس وقلاوون وغيرهما، من ذلك وصف الوقائع الحربية لرد العدوان (ص 238)، وهنا تحضر إحدى رسائل الكاتب المُضمَرة.. وقد حصَر الحديث عن المشرق ولم يثر الغرب الإسلامي، حتى أن جل أولئك «الزعماء» حينذاك من خارج مصر..
في ذلك القرن العصيب (13م.) كثرت الفتن ذات الطابع السياسي، وقُتل آخِـرُ «الخليفة العباسي المحدودة حركته بقلعة الجبل». (ص42). وانتشرت المذاهب الدينية التي تفرق الناس أكثر مما تجمعهم، وقد وُصف أحد أئمتها بالمرتشي والفاسد (ص 122). كما حوصرت التوجهات المخالِفة لما هو رسمي ورائج، إلى درجة ارتعاب «الوراق» من نسخ «كتاب «الزمردة» لأبي الحسن أحمد «ابن الراوندي» الملقب بالملحد» ( ص7)، إذ قد يحدث له مثل ما وقع لناسخ آخر مع «كتاب محـمد الكُليي «الكافي في فقه الشيعة الإمامية» فأهين الرجل، وحكم القاضي بجلده وتجريسه وسجنه. وبعدما انقطع خبره، وخرَّب العامةُ والدهماء دكانه ومنزله». (ص 9).
بل أكثر من ذلك، فقد حكم قاض «بالإعدام علانية في ميدان عام» على أحدهم بضرب عنقه (ص285)، فقط لأنه بحث عمّن ينسخ له كتابين، أحدهما هو «المصحف المصوَّب» (ص283)، وآخر ديوان شعر «في مدح الراح والقَدْح في الحشيش»، مُرفقا بقول شعراء آخرين «ذمّوا شرب الحشيش وأكله» (ص 274).. وذلك «بتهم انتقاص المصحف وازدراء الدين والاستهانة بالعقائد»(ص 285).
لم تأت الرواية كلها ممتلئة بأخبار الشؤم، بل إنها تتضمن كذلك ما يشي بالرغبة في الحياة، وقد استعرضت الكثير من سيَـر أشخاص آخرين غير الشخصيتين الرئيسيتين في قصص موازية وعارضة، وقد ظهرت على أبعاد إنسانية، تحلم، تشتاق، تحب، تغامر..
خاتمة:
إذا كان هناك مشكل عويص يهم السياسة مُتمثلا في دسائس الحكام وصراعاتهم، فقد مثّل ذلك مصدر إعاقة حقيقية لتحسين الأوضاع، لكن من جهة أخرى، هناك حضور لشخصيات تتعاطى العلم والمعرفة والكتابة والتدريس كحالة «ابن النفيس»، وقد كرس حياته للطب، وفي آخر حياته وهب داره وكتبه لمارستان.. وقع تفصيلٌ في حياته ووضعياته المختلفة، حتى أنه يبدو للقارئ في تجلياته البشرية الواضحة كأنه مِن المعارف أو الشخصيات العامة من زمننا. يقول «ابن النفيس» عن نفسه: «وفي زمن العتمة جعلت عزائي محصورًا بين القلم والأوراق، ومداواة الناس، فاستغنيتُ بالعلم عن العالم الذي انتابه الجنون واجتاحه الصراع على الرياسة» (ص 262).
وبذلك لم يكتف الكاتب يوسف زيدان بنقل لمحة تاريخية من الماضي، بل جعلها تحمل رسالة إلى الحاضر والمستقبل بمضمون التنبيه والعِبرة..
ـ (*1) زيدان، يوسف. الوراق/ القاهرة، دار الشروق 2023. الطبعة الثانية.
ـ (*2) زيدان، يوسف. عزازيل/ مصر، دار الشروق، 2014، الطبعة 28.
وهي نقد للمسيحية ومواكبة تحولاتها الأولى، وقد أظهرت الرواية أحد قساوستها في إنسانيته كباقي البشر، وتعرضت لبعض تصرفات المتدينين التطرفين كسحل الفيلسوفة هيباتيا بالإسكندرية حتى الموت..