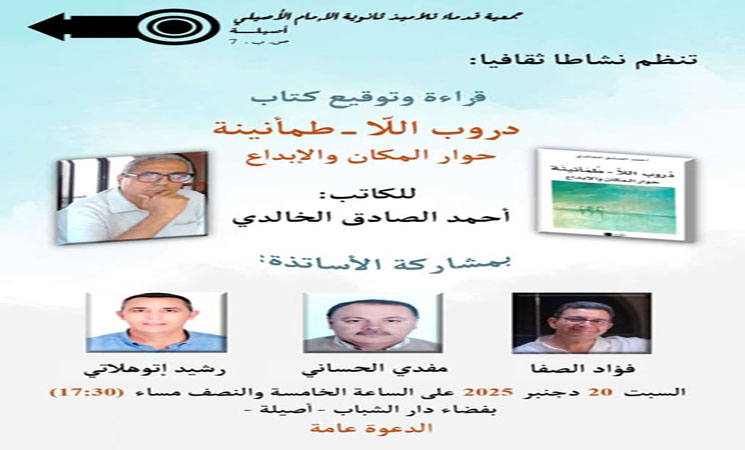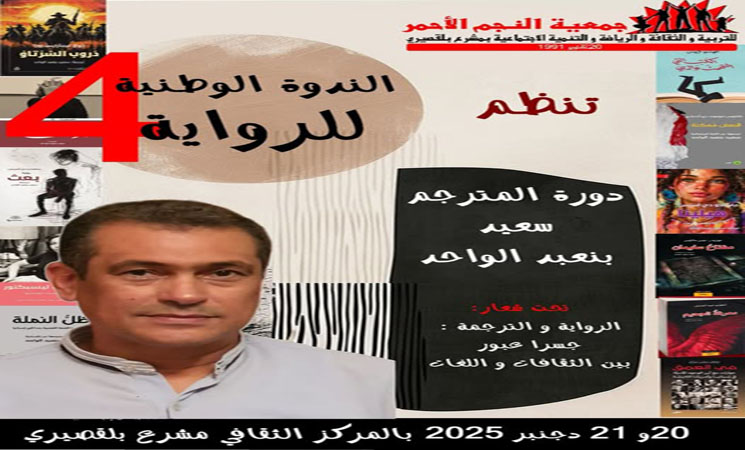مقدمة: رحلة بين أروقة
المعاناة ودهاليز الأمل
تقتحم الأديبة سلمى بعدِّي، المولودة في 3 مايو 2005 بمدينة طانطان، في روايتها «ديستوبيا» التي تتألف من 140 صفحة مقسمة على 14 فصلا، تقتحم عوالم الأدب بجرأة نادرة، مقدمة نصا يزخر بالشاعرية والعمق النفسي.تسطر سلمى نصا ينفذ عبره القارئ إلى جوهر التجربة الإنسانية، ويتحسس جراحاته الغائرة،وتبني سردا يضع المتلقي أمام مرآة تعكس هشاشة الإنسان وسط قسوة الحياة وتقلباتها المقلقة،سردا بقدر ما تتناثر فيه الشذرات الشاعرية المرهفة، بقدر ما تتهادى فيه النفس البشرية بين الألم والأمل، إنه سرد يكشف في المحصلة، تعقيدات الحياة الإنسانية، وتلاطم أمواجها الهادرة، وما يرشح عنها من مشاعر مربكة لوجود الإنسان ومستثيرة لقلقه، لوجوده المنفلت من حدود الزمان والمكانفي آن. ولا جرم فالرواية الإبداعية قادرة على منح الذات حيزا متفاوتا داخل العمل الأدبي، أو إثقالها بجدية مطلقة، وقد تجعل منها النص بأكمله.
الغلاف: الأبعاد والرؤى
بين التيه والتشظي
غلاف الرواية يجسد أجواء الديستوبيا عبر تناسق بصري رمزي؛ فاللون الأبيض الذي يهيمن على الوسط يعكس غموضا وفراغا وجوديا، بينما يرمز الأسود في الأسفل إلى الظلام والقهر. الشكل الدائري الذي يتصدر الغلاف يمثل رأس إنسان غير واضح الملامح، دلالة على التيه والتشظي وفقدان الهوية. الأشباح السفلية، مع الطيف الذي يقف بلا رأس، توحي بالإنسان المستلب، الممزق بين مشاعر متناقضة وعاجز عن مواجهة عالم الظلم والانهيار القيمي. كلمة «رواية» تشير بوضوح إلى جنس العمل الأدبي، مما يمنح القارئ إطارا لفهم طبيعة النص والإحاطة بموضوعه. أما العنوان «ديستوبيا»، بخطه الكبير، فيختزل مضمون الرواية ويبرز فكرتها المركزية. التباين بين الأبيض والأسود يعمق الإحساس بالصراع بين النقاء المفقود والظلام المسيطر.
قراءة في العنوان: الديستوبيا عالم المتناقضات
الرواية تنطلق من عتبة عنوانها «ديستوبيا»، التي تستوحي عالمها الذي يعج بالمتناقضات، وهو مصطلح مشتق من الإغريقية، حيث السابق فيه «ديس»، يشير إلى السوء، واللاحق «توبيا»، تعني المكان/ العالم الذي تصفه الرواية، عالم مظلم يعكس فسادا عميقا يتداخل مع المعاناة الفردية والجماعية، عالم فوضوي يغيب فيه التوازن والانسجام، وتغمره الأجواء الكئيبة. فالديستوبيا من هذا المنظور، أدب المدينة الفاسدة، أو عالم الواقع المرير وهو مجتمع خيالي، فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما. فتصحب القارئ في رحلة عبر الألم والبحث عن الذات وسط عالم قاس لا مكان فيه للرحمة والمودة. فلا مكان لشيء غير حكم الشر المطلق والخراب والقمع والفقر والمرض؛ إذ يتجرد فيه الإنسان من إنسانيته.
والعنوان بات يحظى باحتفاء أغلب النقاد المحدثين على مستوى التنظير والتطبيق؛ إذ يضطلع بدور مهم لا يقل عن أهمية المتن النصي كمتوالية من الملفوظات تؤخذ كمواضيع للتحليل وتعتبر خصائص للنموذج اللغوي القابل للدراسة وكقاعدة لوصف وتحضير نموذج تأويلي لهذه اللغة. فعتبة العنوان تعتبر نظاما سيميائيا وإشاريا دالا، ومكونا جوهريا من مكونات أي نص أدبي بحيث من الخطأ تجاوزها أو تخطيها،عند السيميائيين يشكل سؤالا إشكاليا، بينما النص هو بمثابة إجابة عن السؤال، وهو أول المؤشرات التي تدفع بالقارئ إلى رحلة من الفضول المعرفي حول النص.
الإهداء: من الحب الأبوي إلى البناء الروحي
تدشن الروائية رحلتها السردية بإهداء يحمل رمزية بالغة: «إلى من أمسك بيدي نحو صراط الأدب، وشيع لي مستقبلا يضج بالأمجاد، إلى سيد الدنى، والرجل الذي لا ينسى، إلى والدي محمد بعدي». هنا، يصبح الأب مرآة للصراط المستقيم، ذلك الدرب الذي تتخذه الرواية كرمز لإيجاد التوازن في عوالم مضطربة. إن هذا الإهداء لا يقتصر على كونه رسالة حب أو عبارات ثناء؛ بل هو بيان يلخص ما ستسعى الروائية إلى تقصيه: الحماية، التضحية، والبوصلة الأخلاقية التي تضيء للمؤلفة درب البحث عن الذات. وما يلفت انتباه القارئ أيضا، أن الإهداء يحمل دلالات رمزية تعزز من الطابع التأملي والجمالي للنص، والجمال أعم من الفن. وقد يرمز إلى العلاقة البسيطة والخالدة بين الابنة ووالدها، وهي علاقة تتجاوز الأشكال السطحية لتصل إلى جوهر الروح والمعنى، فكتابة الإهداء بهذه الطريقة تظهر وعي الكاتبة بالجانب الفني للغة، وتضيف لعملها بعدا بصريا يعبر عن تمرد إبداعي ينفلت من القواعد التقليدية إلى آفاق أرحب، مما يثري نصها الأدبي ويمنحه زخما فنيا متعدد الأبعاد.
اللغة الشاعرية: جمال يزاحم الألم
إن الحركة الأدبية حركة إنسانية بالدرجة الأولى، ينتجها الإنسان للإنسان، فيعالج قضاياه، ويعبر عن همومه. وفي هذا السياق، تأتي رواية سلمى بعدي، المتخمة بلغتها الشاعرية المكثفة، التي تكشف عن نضج فني لافت رغم حداثة سن الكاتبة. تقول سلمى: «الحياة شعبة مدرسية صعبة، تشيع لنا آفاقا مغرية لنصعد صهوتها في رحلة البحث عن السمو. ومهما ظننا أننا نسمو مكانة كلما جبنا أصقاع أيامها، إلا وعصف بنا زمهرير نزواتها»(ص92). هنا، تتحول الحياة إلى معلم صارم، يمنحنا دروسه عبر الألم والسقوط. مع وجود عبارات استعارية تؤثث فضاء النص، وتخلع عليه بهاءها الرشيق مثل «زمهرير نزواتها» و»شعبة مدرسية صعبة» تخلق حالة من التوتر الفني بين القسوة والجمال. فالألفاظ المشكلة للنص الأدبي لسلمى بعدي مشحونة بشحنات دلالية مركبة شديدة التعقيد، تفضي إلى سيل من القراءات غير المحدودة، بالنظر إلى الإمكانات التعبيرية الهائلة، مما يولد إشعاعا تعبيريا وتنويعا أسلوبيا، يضيء جوانبه المظلمة وتضاريسه الخفية.
العناوين: فصول تحاكي تناقضات الحياة
تعكس عناوين فصول الرواية مثل «بين دقتين» و»صدع» و»من نسل إبليس»تركيبة النص السردية كفسيفساء معقدة. هذه العناوين لا تخدم فقط البناء السردي؛ بل تضيف طبقات رمزية تشير إلى الصراع الداخلي والخارجي، كما يظهر في عنوان «رجل موقوت» الذي يحمل دلالة زمنية ونفسية، نابضة بالإيحاء المشحون بالدلالات، وهو يمثل ما يحف بالكلمة من معان ثانية أو ثانوية لا توجد في المعنى الأول المبدئي للكلمة.كل عنوان يمثل مفتاحا لموضوع الفصل، ليجعل من الرواية رحلة تأملية تقود القارئ بين متاهات الإنسان والوجود.
تحليل التيمات: الإنسان في مواجهة عالم فاسد
الفساد الأخلاقي والاجتماعي:
من الجملة الأولى، تصرخ الرواية بحقيقتها: «هناك في مستنقعات الفساد بعيدا عن السمو أمسى العالم مكفهرا، وذبلت جميع البتلات الجميلة»(ص 7). الصورة هنا تجمع بين الرمزية والتجسيد، حيث يتحول العالم إلى مستنقع، وتعني أدب المدينة الفاسدة أو عالم الواقع المرير وهو مجتمع خيالي، فاسد أو مخيف أو غير مرغوب فيه بطريقة ما وتصبح «البتلات الجميلة» استعارة للفضائل التي تلاشت وسقطت في طي النسيان.
الاغتراب والبحث عن الذات:
تبرز حالة الاغتراب النفسي والاجتماعي في قول البطلة: «عانيت الصدمات، غير أنني بين الخيبة والخيبة عزمت على خوض شوط يحسم معاناتي» (ص10). هذا القرار بين المعاناة والمواجهة يعكس جدلية مستمرة بين الانهيار والصمود، حيث تسعى الشخصية إلى الخروج من شرنقة الألم نحو هوية جديدة، فالاغتراب وعي الفرد بالصراع القائم بين ذاته وبين البيئة المحيطة به بصورة تتجسد في الشعور بعدم الانتماء والسخط والقلق وما يصاحب ذلك من سلوك، أو الشعور بفقدان المعنى أو اللامبالاة، وهو عدم الاندماج النفسي والفكري في المجتمع، ونوع من الانفصال عن المجتمع وثقافته.
التوتر الأسري:
يتضح الصراع مع الأب في المشهد الذي تقول فيه البطلة: «ترى أي أمر بالغ الأهمية هذا الذي جعلك تتذكر ابنتك أيها السيد؟» (ص12). هذه الجملة تختزل مرارة العلاقة بين الأب وابنته، حيث ينظر إليه كسلطة متعالية لا كحاضن محب. هنا، يصبح الأب رمزا للصراع النفسي بين الحب والرفض، ويضرب في العمق الأسرة كجماعة اجتماعية أساسية ونظام اجتماعي رئيسي، وهي ليست أساس وجود المجتمع فحسب؛ بل الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، والإطار الذي يتلقى منه الإنسان أول دروس الحياة الاجتماعية، غير أن الرواية تفكك هذا النظام وتصور الحياة الاجتماعية بركانا هادرا لا تتوقف معاوله عن الهدم والخنق والقهر.
التراجيديا الإنسانية:
في أحد أقوى المقاطع، تقول البطلة: «حياتي أشبه بمشهد تراجيدي أراهن أنه أشد بأسا من أي تراجيديا شكسبيرية» (ص11). هذا التشبيه يضع معاناة البطلة في مصاف التراجيديات الكبرى، ليبرز قسوة الظروف التي تواجهها مقارنة بمآسي الأدب الكلاسيكي. ونستحضر في هذا السياق، قصة روميو وجولييت التي استقاها شكسبير من قصة شائعة لها سند تاريخي، ويقال إنها وقعت بالفعل في مدينة فيرونا الإيطالية في مطلع القرن الرابع عشر، وهي قصة بسيطة عميقة المغزى. فهي تصور الصراع الأبدي بين قوى الحب والسلام متمثلة في الحبيبين وقوى البغضاء والشقاق التي تتجسد في العداء القديم بين أسرتيهما. فالكاتبة تستلهم هذه الصور القاتمة من التراث الأدبي الشكسبيري على نحو ينغمس معه الإنسان في الإحساس بالأسى والانكسار.
اللغة وتفاصيل الوجدان: استعارات تحاكي الروح
استعارات تصف الوجدان:
في قولها: «ما اغترفت من الحياة سوى قسوة تلظت بين دروبي، وطبعت أرصفة فؤادي نسخة حديدية» (ص86)، تحوّل الكاتبة الألم إلى مادة صلبة محفورة في الذاكرة. الكلمات تشكل لوحة تجريدية، حيث تصبح المشاعر أشياء ملموسة يمكن للقارئ أن يلمسها، وهو ما ينم عن امتلاك الكاتبة على حداثة سنها لكفاءة لغوية تتمثل في القدرة على إنتاج الجمل وتفهمها، إنها المعرفة الضمنية للغة يتملكها الكاتب أو المتكلم أو السامع، وهي نظام داخلي من القواعد التي تمكن الجهاز المحدود من إنتاج وفهم عدد لا محدود من الملفوظات.
جماليات الأمل:
رغم القسوة، تتسلل لحظات من الأمل في حلة مدثرة بعنفوان الجمال على غفلة من عيون الزمن وتحرشات الحياة والجمال دائما غريب كما قال شارل بودلير، تقول الكاتبة: «أشرقت البسمة في سماء ثغرها كشفق جديد» (ص120). هنا، البسمة تتحول إلى شفق، والجمال يعيد تشكيل المشهد النفسي، ليخلق حالة من التوازن المؤقت بين الألم والتعافي، فالأدب – بمفهومه الجوهري الأصيل – هو التعبير الفني الإبداعي عن موقف الإنسان ورؤيته لمشكلات الحياة وقضاياها وتصويرها، وتلمس أساليب مواجهتها، والكشف عن الإمكانيات التيتنطوي عليها الطبيعة الإنسانية.
قراءة في البناء السردي: مشاهد متداخلة وأزمنة متقاطعة
تعتمد الرواية على تقنية السرد المتداخل، حيث تتشابك الأزمنة والذكريات في نسيج واحد، مما يعكس تعقيد تجربة البطلة النفسية. تقول البطلة: «كنت معتكفة أمام تابوت الذكريات» (ص11)، لتصور الذاكرة كصندوق مغلق يحمل الألم والحنين في آن. هذا البناء يعكس قدرة الكاتبة على مزج الذاتي بالموضوعي، وتقديم حكاية شخصية تمتد لتلامس القضايا الإنسانية الكبرى.تتميز الرواية بتركيب سردي يعتمد على الشعرية المكثفة والرمزية العميقة. الكاتبة تلجأ إلى استخدام المجاز، الاستعارة، والانزياح اللغوي لإغناء النص وإضفاء بعد فلسفي عليه، ولعل لمسة الوالد وتكوينه وتوجيهه تبدو حاضرة في هذا النسج الأدبي الجميل.
الخاتمة: بين الألم والسمو
تأتي رواية ديستوبيا كسردية عميقة تصف هشاشة الإنسان أمام قسوة الواقع وألم الإقصاء، دون أن تغفل لحظات الأمل التي تسطع بين ركام الألم. سلمى بعدِّي قدمت نصا يحمل روحا فلسفية ولغة مشبعة بالجماليات، مما يجعلها إضافة مميزة للأدب المغربي المعاصر. الرواية ليست مجرد حكاية، بل مرآة تعكس معاناة الإنسان في بحثه عن ذاته وسط عالم فاسد، مسكون بالتناقضات، تجمع بين السرد الشعري والتأمل الفلسفي لتقدم نصا أدبيا متعدد الطبقات. من خلال رموزها وصورها الفنية، تنجح الكاتبة سلمى بعدي في معالجة قضايا إنسانية شائكة مثل الوحدة، الألم، والصراع الداخلي، مما يجعل الرواية عملا يستحق التأمل والدراسة.