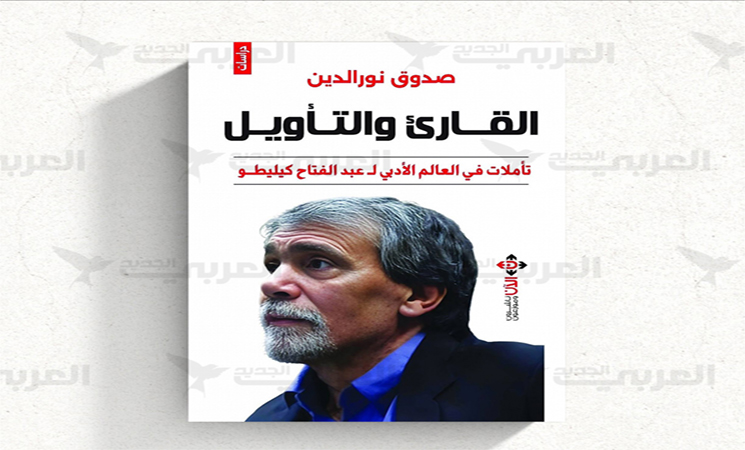ماذا أقول؟
فقط أنني كاتب سعيد. فالقليل منا يحظى بمثل هذا الحضور الثري الشاهد لكتاب أدباء من عيار كبير، لهم مشوار يعرفه كل من يرتاد دروب الحرف في بلدنا، هنا في المنصة، حيث أتواجد، وضمن الحاضرين، أمام ناظري. هي خمس قراءات أُلقيت تخُصُّ شخصي وما دبجت من إبداع أدبي، تجعلني سعيدا، لأن من كتبوها وتلوها على مسامعي ومسامع الحاضرين، ليسوا أيا كان في كوكبة من امتشقوا القلم، فهم مبدعون ورواد.. لذا قلت ونفسي أن لا بد أن أخجل من نفسي بعض الشيء، أن أتحلى بكل التواضع اللازم، أن أنحني إجلالا لقاماتهم ..
فأن أُمنَحَ هذه اللحظة السعيدة مِنّة نادرة أقدرها حق قدرها، بما هي عربون على تقدير وقَبول وفتح لباب مُشرع لارتياد هذا الكون العسير المتمنع الذي اسمه الكتابة.
في ذات السياق، أتساءل : هي الكتابة تمنحني اعترافا بعد المسار الطويل، بعد الكتابة ليلا، نهارا، وفي كل الفصول، وفي كل الأزمنة الممكنة، وفي كل الأمكنة المتاحة، حيث تعِنُّ، وحيث تقول لك هيت لك.. ليس بدون عناء أو جهد، لكن هذا من صلب الكتابة. فالخلق الأدبي هو ملء للبياض، للفراغ، بالحياة التي تُرى/تُقرأ.
أتبوأ حالاً، الآن، مكانةً بوِّأني إياها أصدقائي الكتاب الكبار، شعراء وكتاب رواية وكتاب قصة ونقاد، كل لامعٌ في مجاله، وطنيا وعربيا. تحت أنظار أدباء وكتاب وفنانين وأصدقاء مثقفين كبار لأن ما أبدعوه كبير، والجميع يعرف ذلك.
هل أقول لنفسي، مُسِرّا علنا وفي قرارة نفسي في ذات الآن : ها أنت اللحظة كاتب، كاتب بلا أدنى شك.
نعم، بكل تأكيد.. وهذا السؤال، ولأبوح بذلك وأنا مرتاح البال والقريحة، سألته نفسي بصيغة الاستفهام البريء قبل أكثر من ثلاثة عقود، في مكان قريب من هنا، من مقر مديرية الثقافة بالدار البيضاء، أي من على أحد مقاعد حديقة لارميطاج الشهيرة .. حين كنت أرتادها يوميا، بنحافة جسدي واتساع أفق حلمي، وأنا مراهق ثم وأنا أتعثر في ريعان الشباب، لأقتعد مكانا، وأشرع غالبا في قراءة رواية ما أكون ابتعتها للتو بثمن بخس من أسواق الكتب المستعملة عند كتبيِّ درب السلطان في القريعة أو شارع الفداء أو بوشنتوف أو كراج علال، أو عند كتبيِّ سوق درب غلف النائي نسبيا، بعد أن أكون خضت مشيا في هدوء في حي الفيلات الراقية آنذاك بالدروب التي تحاذي شارع 2 مارس الشهير. أو في الكثير من الأحيان، بعد أن أكون شاهدت فيلما في سينما الملكية أو الأطلس، أو بعد أن أكون شاهدت مباراة في كرة القدم بين الفرق العمالية بملعب لاجونيس (ملعب محمد شكري، بيتشو حاليا).
هل هي عودة إلى حيث كان ضبابّ أول في سبيل غير بائن، وها قد تم استحضاره حنينيا بعد إن انقشع ؟ بلا أدنى ريب، أقول نعم.
كنت حينها أحلم أن أكون كاتبا، أن أستطيع الكتابة بالشكل المتعارف عليه آنذاك، كما كنت أتمثل الأمر من خلال ما كنت أقرأ لا غير، أي النجاح في تدبيج نص قصصي !! لا غير. كنت في ذلك الزمن أقرأ كثيرا، وظللت على ذات المنوال حتى الساعة، وكتبت كثيرا. وما كتبت إلا ما أستشعره دون وفاء سوى لما تمليه ضرورات الكتابة بما هي معادل للوجود من خلال الحكي، كي يوجد ما ينقص هذا الوجود، ومن خلال الشعر في ما بعد،، كي يُرى من زاوية اللامرئي، ومن خلال مراودة الفنون. وذلك كي لا يثقل غياب معنى الكينونة على كاهل القلم فينكسر، وتنكسر معه.
اكتساب الصفة جاء بعد سنوات طويلة في ما بعد. وأن يكتسي الأمر هذا الاحتفاء الرائع مع كتاب رائعين، في مقر مديرية الثقافة بمدينة الدار البيضاء، مدينتي التي ولدت فيها وحيث ترعرت وحيث تعلمت الأبجديات الأولى لمعنى الكتابة، أعتبره مصادفة لا تتاح إلا للمتخيرين، وقدرا جميلا. من تلك الصدف التي تتبع منطقا خاصا لا تعرف اتباعه سوى الكتابة. وهذا في حد ذاته مبعث سعادة فريدة، لا لتميز ما، ولكن لأنها سليلة المنطق إياه. الأمر كذلك فعلا. والشاهد ما غمرتني به كلمات بعمق المحبة وعمق المعرفة لكتاب مشهود لهم بالتمكن والتمكين في قارة الأدب.
ليست كلمة السعادة هنا سوى ما يحدده القاموس، أي «حسن الحظ، الحظ السعيد، مناسبة ميمونة،حدث من المرجح أن يجلب بعض الرضا» وهي تلخص ما أشعر به وما منحتني إياه الجلسة الأدبية هاته التي شرحت ما أبدعته، بأقلام الشاعر محمد عنيبة الحمري، الروائي محمد صوف، الشاعر محمد عرش، الناقد محمد علوط، الشاعر عبد العزيز أمزيان.
كيف لا أكون كاتبا سعيدا.. وشكورا..
(*) نص التعقيب الذي قرأه الكاتب مبارك حسني في أمسية التكريم التي نظمت له بمديرية الثقافة بالدار البيضاء من طرف جمعية محترف التلقي المسرحي