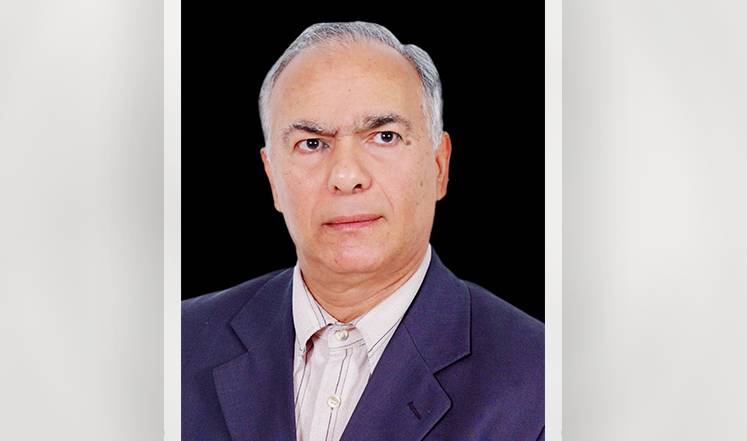أصبح المعنى الوحيد القابل للتأويل والفهم، هو المادة المُعدَّة شكلا ومضمونا لقوة استهلاك و استنفاد شاملين، لا يستدعيان حضور أية مبادرة فكرية ومعرفية، بفعل هيمنة الرؤية التبسيطية لأشياء العالم، والتي لم تعد تسلم منها أغلب الفضاءات التي كانت من قبلُ متعودة على استقبال أصوات، تنتشي بتأجيج نقاشات وسجالات، حول ما دأبت على اعتباره إشكالياتٍ متميزة بدورها المركزي في إضاءة المشهد المعرفي.
بعيدا عن الرؤية الكونية، وضمن حدود جغرافيتنا التاريخية والثقافية المحصنة بضواري تخلفها المتعالي، سيتمكن سؤال المعنى ومعه سؤال التأويل، تدريجيا، من اجتراح مسارات جديدة ذات بعد إشكالي ، يكمن في قوتها التبسيطية، انسجاما مع التوجه العام الناظم لحركية الحياة اليومية، وأيضا مع نسبة لا يستهان بها من الحياة الثقافية، حيث تهيمن الظاهرة الاستنفادية، التي لم تعد معها ثمة أية حاجة لتوريط السؤال في دوامات فكرية، قد تكرهه على التواجد داخل مجاهل، لم تعد تسمن أو تغني من جوع، و»لا طائل يرجى من ورائها»!! ففي ظل هذا المعطى، أصبح المعنى الوحيد القابل للتأويل والفهم، هو المادة المُعدَّة شكلا ومضمونا لقوة استهلاك و استنفاد شاملين، لا يستدعيان حضور أية مبادرة فكرية ومعرفية، بفعل هيمنة الرؤية التبسيطية لأشياء العالم، والتي لم تعد تسلم منها أغلب الفضاءات التي كانت من قبلُ متعودة على استقبال أصوات، تنتشي بتأجيج نقاشات وسجالات، حول ما دأبت على اعتباره إشكالياتٍ متميزة بدورها المركزي في إضاءة المشهد المعرفي، وفي «إغناء مسار الصيرورة التاريخية»!!.إذ بموازاة هذا العنف التبسيطي، لم يعد ممكنا التشويش على سكونية الخطابات المتداولة «بعنف وخشونة» الخطابات التأملية،التي لا تلبث أن تفقد صلاحيتها حالَ مغادرتها لتخومها، كي تتجه إلى أراضي الجوار، المعبر عنها بالفضاءات العامة المستقطبة للشرائح الكبيرة والغالبة من ساكنة المحيط الاجتماعي، والغارقة كالعادة في إكراهات اليومي، باعتبار أن مصدر زادها الأساسي من المعرفة ،مُستقىً رأسا،مما تفرزه هذه الإكراهات من قضايا لا تعود مرونة التفاعل معها إلى بنيتها الفعلية،بقدر ما تعود إلى مرونة المنهجية الموظفة في معالجتها، وهي منهجية استنفادية مستقلة أو تكاد، عن تلك الموظفة من قِبلِ الخطابات التأملية. فبالرغم من اهتمام الخطابين بنفس الأسئلة، إلا أن الفارق الأساسي بينهما، يكمن في طريقة طرح كل منهما للسؤال ذاته، كما يكمن أيضا في صيغة بحثهما عن أجوبة منسجمة مع خصوصيتهما، فالخطاب التأملي مثلا، يروم من وراء طرح أسئلته، استخلاص أجوبة توضع على ضوئها أنساق معرفية، قابلة للتدوين والنقاش والبحث والمقارنة والمساءلة،والتي غالبا ما يكون لها تأثير في تطوير المعارف بمختلف مجالاتها،وكلها عوامل من شأنها انتزاع هذه الأسئلة من سياق اليومي والمعيش،وترحيلها إلى سياق مغاير،ذي طبيعة فكرية،تتجاوز القدرات الإدراكية والمعرفية للمزاج العام،الذي لا يكون معنيا بمغادرة فضاءاته الاستهلاكية،إلى فضاءات المعرفة،حيث يختزل همه في استنفاد ما يتتالى على إدراكه،بمنأى عن أية مسافة تأملية،قد يؤدي حضورها إلى إرباك آليات هذا الاستنفاد،وإلى تعطيل تفاعله مع ما هو بصدد استكشافه،بما يستحثه على صرف اهتمامه عن تعقيداته،كي يتفرغ لمعالجة إكراهات اليومي، بعيدا عن تدخل أية منهجية تتنافى مع إمكانياته المعرفية.والمسافة المشار إليها في هذا السياق،هي المنهجية البنائية الموظفة من قبل الخطاب التأملي في تأويله للمكونات التي تصطخب بها إكراهات اليومي،لأن من شأن المسافة التأملية،أن تسمح بتوسيع إطار التعرف،كي تتيسر بذلك إمكانية ملاحظة العناصر التي تبدو منفصلة من وجهة النظر الاستنفادية،وقد أمست مندمجة بصيغة تفاعلية فيما بينها،بمعنى أن الشيء الذي يبدو لهذه الرؤية مستقلا بذاته،يصبح من منظور الرؤية التأملية،مجرد حلقة ضمن أخرى،في سلسلة متنامية ومتتالية الحلقات،حيث يكتشف الملاحظ حضور علاقات متعددة ومتشابكة بين عناصر كانت تبدو خارج الرؤية عن بعد،قائمة بذاتها ومنفصلة عن باقي العناصر المحايثة أو الموازية،لأننا وحالما ندرجها ضمن علاقاتها التفاعلية،نحصل على نوع من التسلسل،الذي يغير منهجية الاستنفاد،فينقلها من إيقاع السرعة إلى إيقاع البطء/التروي،باعتباره ضرورة حتمية،أفضت إليها الوضعية الجديدة،التي أمست عليها العناصر،بفعل حضور عامل المسافة المولدة للعمق التأملي والتركيبي.
فالبطء/التروي،المنتمي بالضرورة إلى مجال التأمل والفكر،بما هو مجال التدقيق والتمحيص المضاعف للرؤية،والمواكَب بتحصيل الخلاصات والنتائج،يتعارض بشكل تام مع منطق الخفة المنسجم مع آلية استنفادٍ غيرِ مُلزَمٍ بواجب بناء أي نسق،لا يستدعى حضوره إلا لضرورة نظرية ما. بمعنى أن الاستنفاد بما هو سلوك آلي، يفيد الإجهاز التام على الشيء، بعد امتصاص رحيقه المتمركز في قلب اللحظة المنفلته، وهي اللحظة التي لا تحتمل حلاًّ ثانيا عدا حلِّ تملكها ظرفيا، والتملك الظرفي يعني الفوز العاجل بما له نكهةُ روحٍ مقيمة في الشيء، زُرِعَتْ فيه مبدئيا من أجل غاية واحدة ،تتمثل في انتزاعنا لها على وجه السرعة، بامتصاصها، والإلقاء بما تبقى من قشرتها في سلة العدم،كي يصبح واقعا خارج دائرة النص، بوصفه لا نصا، ﻷن مفهوم النص يتعارض كما يتناقض ضمنيا مع منطق الاستنفاد المدعم بسلطة الحاض، الشبيه بوحش زمني، مصاب بنوبة شره مزمنة وطاحنة، لا تسمح له بتاتا بالتساؤل عما التهمه منذ قليل،أو عما سيلتهمه، لأنه معْنِيّ فقط بما سيحشو به حنجرته الآن،بصرف النظر عن نوعيته أو دلالته. وهو ما يمكن تسميته بالاعتراض الأعمى لسبيل العابر، أو بمعنى آخر، الإيقاع بالعابر في مطحنة الاستنفاد التام والأهوج، وهي العملية التي تترجم بها المطحنة فعاليتها،و شرعية حضورها،و قدرتها على الإحاطة بكل ما يتفاعل به الفضاء الاجتماعي من إشارات، ومن حيوات.أي إثبات القدرة على التواجد الحاد في الهنا والآن، حيث ما من مجال للعابر كي ينجو بجلده من مطحنة استنفاده. ثم إن العابر، وبدعم من الشبكات الاجتماعية التي أمست حاليا العمود الفقري للشبكة العنكبوتية، لا علاقة له إطلاقا بذلك الطيف الرومانسي الذي طالما استبد بعشق الشعر والشعراء، إنه في هذا السياق تحديدا، يأخذ شكل طوفان، هو خليط من كل شيء ولا شيء، بدءا من العوالم الكبيرة المسحوقة تحت حذائك، وانتهاء بأحلام الدببة النائمة على سجادة جليدية عائمة بإحدى أرخبيلات القطبين، مرورا بأدق الذبذبات الاجتماعية والسياسية والكارثية على الصعيد الإقليمي والكوني، التي غالبا ما تتخذ منحى غرائبيا، حيث أنت مطالب بأن تكون على علم تام بما يحدث هنا والآن، كي تنساه للتو، أو بالكاد، كي تستعيده لسبب مُلِحٍّ، لا يخرج هو أيضا عن منطق إعادة استنفاد ما لم يتم طحنه بالكامل. وإذا كان من الضروري أن نقدم تشبيها لهذا المشهد، فإننا لن نعثر على أدق وأبلغ من يد آلية، تطارد بمطرقتها رؤوس حشرات اجتماعية وسياسية وبيئية، لا تكف عن التناسل من الجهات الخمس. إنها العاصفة الدائمة واللامرئية التي لا تكف عن مراكمة كل شيء أمامك، أي الكل شيء، الذي لا خيار لك في ردِّه، وتصفية صحيحهِ من باطله، مادام مُعدّاً سلفا ضدا عليك، للعبور تحت مطرقة الاستنفاد الذي نتحفظ مؤقتا من إسقاط أية صفة محددة عليه. ذلك أننا لسنا هنا بصدد تقييمٍ من شأنه القيام بمفاضلة معينة، لأن المفاضلة سوف تميل حتما بميزانها جهة قرار، سيظل معلقا بين المابين، والقرار هنا سيكون معززا بعنفه وباستماتته على ممارسة سلطة ما، بعيدا عن أية رؤية موضوعية واضحة و مؤطرة بإوالياتها المنطقية،إذ من سيدَّعي الحق في محو ساكنة هذا الكون،و إقصائها من دائرة الفكر والتأمل،بدعوى شغفها الجنوني بأندية رياضة ما،واستماتتها الجسدية والعصبية على فِرق بعينها،بدل أن تهتم بأسئلة «فكرية وجمالية»سيجعل منها كائنات دونية و منحطة؟! إننا وفي حالة استمرارنا طرح مثل هذه التساؤلات،سوف ننزلق تدريجيا إلى دوامة الهرطقة،التي لن نتمكن خلالها من فك طلاسم العبور البشري لهذا العالم/الوجود،بمعجم لا يخلو من نزوعه الخرافي أو الأسطوري المُطَعَّم بنكهته الحداثية، والذي ليس له سوى أن يرى الكائنات وقد تمت برمجتها آليا، كي تتحرك بمعزل عن أي تدخل عقلي، أو منهجي داخل مدارٍ مفرغ من الدلالة، تنتهي أطرافه ومسالكه عند هاوية العدم،وهي صورة تمتلك في الواقع غير قليل من المصداقية، إذا ما حاولنا إخضاعها بشكل مضاد لتصور يشفق على الكائنات البشرية،من وقوعها في قبضة مصائر استنفادية، تنزع عنها أي أمل محتمل في الوجود،بما تعنيه كلمة الوجود من تواجد الحد الأدنى من ظلال مثل، من شأنها إضفاء ما يمكن تسميته تجاوزا بالمعنى، فالقول بالمعنى في هذا السياق المناوئ للعنف الاستنفادي،هو بمثابة الحجْرِ القاسي والمؤرق،الذي يحرك الإلقاءُ به مياهَ البِركة الآسنة،كي تتقلب قليلا أو كثيرا،مُفْصحة عما يعتمل بدواخلها. والإلقاء بالحجر في قلب هذه البركة أو تلك، قدَرٌ من الصعب إغفاله، حيث لا مناص من طرح السؤال، ولا مناص من إعادة النظر في ما اعتقدنا منذ قليل أننا استنفدناه، ولو بالنظر إلى ما يتشكل به من بنيات. ولعل إلقاء الحجر على رأس البركة التي تتأمل ببلادة مشهد الغروب، هو ما يمكن أن يغري المفاضلة باسترداد أنفاسها، كي تُلَمِّحَ بصوتها الخفيض أو المسموع، إلى حتمية اشتغال مطحنة الاستنفاد المنزوعة من مصفاة التفكير، باعتبار أن اشتغال الفكر، محكوم سلفا بحدوده الثابتة، كما أن مبالغته في الاشتغال قد تؤدي-ربما!- إلى توليد طاقة فائضة عن حاجة الوجود، وأيضا عن حاجة الكائن!!بما قد يوقعه في شرك بطء/تروٍّ، يتعارض تماما مع حركية الأكوان، التي يستمد منها الاستنفاد الخاطف لأشياء العالم مصداقيته. إن استهلاك الشيء باستنفاد ما فيه من حياة على الطريقة التبسيطية، يعني بتْر ألسنته كي يتوقف عن البوح بكل ما فيه،كما هو الشيء بالنسبة للعقل الفردي الذي تَحُولُ قوانينُ الفناء دون تجاوزه لمساحة زمنية محددة، تفاديا لتوريط أسئلة الكون في ما لا قِبل لها به،حيث يُفترض في أي إنشاء من إنشاءات الكون، حضور نسبة معقولة من التوازن،ما دام السير الطبيعي للوجود، يقتضي حضور توازن في الخفة كما في الحركة، واللتين يجسد بهما التأمل بعضا من إوالياته، جنبا إلى جنب مع عنف الاستنفاد وسطوته، بمعنى أننا نظل بحاجة كبيرة إلى العمى كي نتمكن نسبيا من الرؤية .
ولكن من أين الحديث عن الأنساق التي بها تتأسس البنيات الحضارية، في حالة ما إذا كانت سلطة الاستنفاد هي السائدة؟ وفي حالة ازدرائنا للمشتغلين بما سبق أن سميناه بالمسافة، أي في حالة اعتبارنا لهم مجرد مدعين، ومهرطقين، وهي وجهة نظر مردودة تماما، ذلك أن حاجتنا للأنساق، تفيد حاجتنا الحيوية والماسة إلى مبدعيها، وإلى الساهرين على إعدادها، إذ بفضل الأنساق ذاتها، يمكن أن تنصرف عامة الكون إلى متعة وسلطة الاستنفاد الجارف ،في قلب شبكة الأنساق التي تشتغل بها آليا، دون أن يحدث ثمة أي جنوح في سير قطارات العالم .