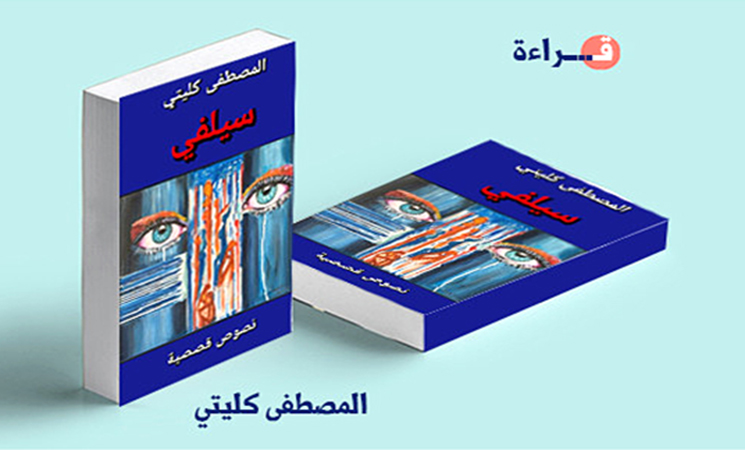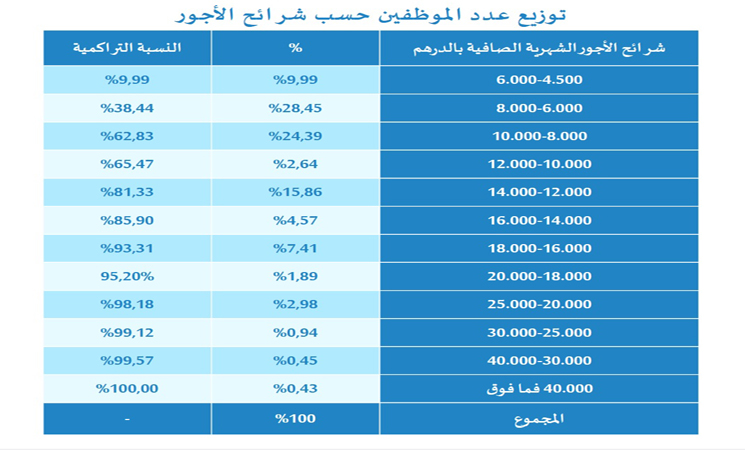نمو الكتابة وتطورها وسؤال التصنيف الجيلي
تمهيد
لا شك أننا أمام عنوان مثير ألا وهو القصة المغربية ومفهوم الجيل”، وذلك نظرا لما يطرحه من قضايا وإشكالات، أولاها ماذا نعني بالجيل؟ وما المعايير المعتمدة من أجل التصنيف في جيل دون آخر؟ هل الأمر يتعلق بالسن؟ أم بطبيعة الكتابة والأسلوب؟ أم الإيديولوجيا المشتركة؟ وإذا كان الأمر كذلك، في أي جيل نصنف كتابا كتبوا في الستينات والسبعينات والثمانينات ولا يزالون إلى الآن يمارسون فعل الكتابة، حيث تنمو الكتابة عندهم وتتطور؟ ثم ماذا نقول عن كتاب بدأوا الكتابة في فترة معينة، لكنهم أثناءها كتبوا القصة الكلاسيكة والقصة والواقعية ومالوا أيضا إلى التجريب/ الكتابة الجديدة؟
1 – القصة المغربية وإشكال التصنيف الجيلي
انطلاقا من الأسئلة التي طرحناها، يمكن القول إننا نرفض مفهوم الجيل -على الأقل في بداية هذه الورقة-، ونعوضها بعشرية (عشر سنوات) أو ربما أكثر من عشرية تميزت بوجود أسماء إبداعية بغض النظر عن تصنيف العمر، فالمبدع نفسه قد يتكرر في عشريات أخرى، وهذا حقه ما دام يحافظ على تواجده كميا ونوعيا، وهذا ما يدحض النظرة التنقيصية أو قل للدقة الدونية التي يحملها البعض عن كتاب القصة الرواد من ناحية جودة الكتابة، إذ غالبا ما يصنفهم البعض بكونهم يمثلون البدايات وفقط، ويحكمون على العديد منهم ظلما وبهتانا أنهم لم يغادروها وظلوا فيها، وعلى العكس من ذلك يمجدون كل صوت جديد، خاصة إذا ولج مباشرة مرحلة التجديد في الكتابة. غير أنه لا ضير من الاعتراف بأن هناك مجموعة من الأسماء التي حافظت على زخمها في الكتابة القصصية المغربية من حيث المواضيع والثيمات والأسلوب، والخصائص بل تلفي أن أعمالها القصصية قد تضم بين ضفتيها قصصا كلاسيكية وواقعية وحديثة، أي أنها كذلك توظف تقنيات الكتابة الجديدة، نذكر منها أحمد بوزفور، إدريس الخوري، ومحمد زفزاف، والمصطفى الكليتي، ومحمد الشايب، وأنيس الرافعي، ومحمد منتسب وغيرهم. ذلك أن المبدع الحق هو الذي يحمل مشروعا إبداعيا ذاتيا قابلا للتطوير والتجويد، رافدا من كل جديد بعيدا عن الركون والسكونية.
وقد آثرنا أن نتبين ذلك من خلال البحث في تجربة أحد الأسماء القصصية المغربية التي ظلت تبدع في القصة لعشرات السنين ولا زالت مستمرة إلى الآن. والأمر يتعلق هنا بالقاص المصطفى كليتي وليد مدينة سوق الأربعاء الغرب الذي خلّفت قريحته الإبداعية العديدة من المجاميع القصصية التي نذكر منها “موال على البال”، “القفة” و”66 كشيفة” و”فقط” و ” سيلفي”.
وانطلاقا من نصوصه القصصية “سيلفي”، سنتلمس مفهوم الجيل في القصة المغربية، لنؤكد أو ندحض هذا التصور، وذلك من منطلق أننا أمام مبدع ينصت بشكل كبير إلى الشارع من موقعه، بوصفه مثقفا عضويا بعيدا عن النخبوية، شغوف بالإبداع ومواكب لما هو نقدي، ما يعني أن كتاباته تتضمن بياضات لا بد من ملئها، فهي تضمر ما لا تظهر.
2 – البعد التيماتي في النصوص القصصية سيلفي
يبدو مستفزا العنوان “سيلفي” الذي، وذلك بما يحمله من عمق حداثي يرتبط بالتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم في السنوات الأخيرة، حيث أصبح له أثر بيّن على حياة الناس. ذلك أنه كلمة مقترضة غير عربية تعني نفسه وذاته، ترتبط بالتقاط صورة شخصية في وضعية معينة، وهذا الالتقاط لهذا النوع من الصور ينتشر أكثر في صفوف الشباب، لكن في النسق المدروس من خلال قصة “سيلفي” ارتبط بكبار السن، ورغب عن طريقه المبدع التأريخ للذات والهوية، فحضرتِ الذاكرة بكل ثقلها لتربط بين الماضي بما يخلفه من ذكريات عن الزمن الجميل، والحاضر الذي يُمثِّل الحنين والشوق. يقول السارد في قصة “سيلفي” ويؤرخ للحظة ” ونعيشُ عمرنا الثالث في طرق أبواب الأطباء واسترجاع الذكريات، أخرجت هاتفي وضممتها لصدري ورفعنا أيدنا لكاميرا الهاتف من أجل التقاط صورة. ندت منها صيحةٌ مرحةٌ:
-ربما نلتقي أو لا نلتقي نحن الآن في السيلفي ندخل التاريخ”.
وقد استمر هذا التعبير عن الشوق والحنين المليء بالفيض العاطفي من خلال قصص أخرى مؤرخة للزمن الماضي الجميل العابق بالعاطفة، حيث التذكر والاسترجاع لأحداث ارتبطت بالتقاليد والعادات الموروث الشعبي، وهو ما تجسد في قصة “حمام الجمعة”.
وكذلك تحضر المرأة بشكل كبير في هذه النصوص القصصية ففي قصة “ويكاند” استسلمت سيدة فيها لرجل كهل استغلها، وفي قصة “المطمورة” تعرضت شخصية الزاهية لمحاولة الاغتصاب، بل إن في قصة “قصة على مبسم سيجارة شقراء أحمر” اغتصبت سيدة من قبل زوج أمها وشبان متسكعين، فانتقمت بنقل مرض السيدا إلى الرجال من خلال علاقاتها. حضرت كذلك المرأة المناضلة التي تدافع عن حقها من خلال “قصة نقطة حليب”، حيث تصدين لقرار نزع ملكية الدوار التي أمرتها السلطات وأفتى فيها خطيب الجمعة بغرض هدم ضريح سيدي والو وإنشاء سد. يقول السارد: “الاحتجاجات والأصوات تتعالى، النساء يولولن ويغرسن أظافرهن في وجوههن، فتطفر بالدم وقد نزعن الغطاء عن رؤوسهن ودوَّحْنَ بسوالف شعورهن المتدلية، وتمرَّغْن في التراب نادبات، وقد امتزج التراب الترسي بدمائهن القانية”.
كما تحضر تيمة الموت من خلال موت الأم في قصة “منديل أمي الأبيض” المليئة بالألم والأسى والحسرة والفجيعة. وتحضر المرأة بأدوار أخرى في قصة “تقشير الأحلام”، حيث النساء يستعن بقابلة الدوار ومفسرة الأحلام يزة التي سُرعان ما سيكشف كذبها وعدم صدقيتها فيما تقول بعد أن أنجبَتْ إحداهُن ولدا عوض بنتٍ التي تنبأت بها يزة في تخمينها وتفسيرها.
لا شك إذن، أن هذه الثيمات وغيرها، تحضر عند العديد من كتاب القصة بغض النظر عن السن أو سنوات الكتابة، فهي لا تميز جيلا دون غيره، ولا تميز اسما دون آخر، وإن اختلفت درجات التعاطي مع بعضها..
3 – تجليات لإيحاء والرمزية والسخرية اللاذعة
لقد استعان المبدع في قصصه بالإيحاء والرمزية والسخرية اللاذعة. فمن منطلق أن القصة القصيرة “جنس أدبي ‘إشكالي’ بطبيعته، لا يمكن أن ترتع أو تترعرع إلا حيث يكون إشكال ما” فإن الكاتب يوظف شخوصا مثيرة يلبسها ثوبا، يُعبر من خلاله عن مواقف، وذلك بطريقة مضللة. وهذا ما بَيَّنتْهُ أولى القصص الموسومة ب “نزوة” التي خرق فيها الكاتب أفق انتظار المتلقي بأن منح صفات إنسانية للنمل تعبيرا عن رؤى وأفكار وتصورات بخصوص ما يسود من صراع بين أفراد المجتمع/ المجتمعات غالبا ما تكون ناتجة عن سوء الظن وسوء الفهم، فيودي ذلك بحياة الجميع. يقول السارد: ” ظهرت النملة المغامرةُ تحمل عشيقها وهي تجتهد لكي يصل إلى بر الأمان، فظن حرسُ النمل الأحمرِ بأن النملة السوداء قد قتلت أحد أبنائها ونكلت به، وظن أهل النملة السوداء بأن النمل الأحمر قد غرر بها واعتدى عليها، فقامت معركة شرسة بينهما، فوجدها الدب فرصة لكي يلتهم بقساوة وبشاعة كل ما يعرض أمامه”.
والرمزية والإيحاء يظهران كذلك في قصة “كبرياء” التي منح فيها البطولة للحصان، ومنحه صفات إنسانية مثل الحب والصدق، والأنس، والتعب، والحزن، والألم وغيره. يقول السارد مخاطبا الحصان “كم من يد امتلكتك، وكم مرة وقفت في أسواق المزايدة، وكلما تقدم بك العمر، وكثرت أعطابك وكبواتك ينقص ثمنك، وعيبك أنك تحبُّ وترتبطُ بصدق بمن تُحبُّه وتأْنسُ به، لكن سرعان ما يتخلى عنك في أقرب نهزة، وأنت مجرد بضاعة في السوق، بسومة ورقم”.
كما أن السخرية اللاذعة تجلت في قصة “هاو هاو مع سبق الإسرار”، التي تكرس للمفارقة الصارخة بين أفراد المجتمع الذي يعاني أبناؤه من الفوارق الطبقية، والتي تدفع البعض إلى استلطاف الكلاب التي يمتلكها الأغنياء رغبة في الحصول على الأكل وإشباع البطن، وَسَدُّ الرّمَقِ. وفي ذلك يقول السارد “كلما عض الرجل الجوع، تسلق السور وتلمس غذاءه عند الكلاب”.، وكذلك برزت السخرية اللاذعة في قصة “الأطلس الكبير في الكيس الصغير”، التي تَحوَّلَ فيها الخبير إلى ساحر وأخرج من كيسه حيوانات لا تخطر على بال.
وصفوة القول، نستنتج أن الإيحاء والرمزية والسخرية اللاذعة التي وظفها لكليتي، ليست مرتبطة به وفقط، بل وظفها كتاب آخرون من مختلف الأعمار وبأناقة، مثل أحمد بوزفور، وأحمد زفزاف، وسعيد منتسب، ولطيفة البصير، ومحمد الشايب وغيرهم. وهذا ليس بغريب، مادام أن على المبدع أن يبتعد عن المباشرة، ويمنح المتلقي الفرصة للتأويل وملء البياضات.
4 – البعد الفني وبعض تقنيات الكتابة السردية
لا غرو أن النصوص القصصية المدروسة توظف لغة تنفذ إلى أعماق النفس البشرية، وأعماق الذات، أراد من عبرها خلق عالم خيالي إبداعي معبر عن كينونته، ذلك أن الذات وهي ” تغترب في العالم الخيالي تحمل معها الإبداع والكينونة”. وتعتمد نصوص سيلفي كذلك أسلوبا سلسا يخلو من التعقيد، ويميل إلى الإيحاء والرمزية والغموض، وخرق أفق انتظار المتلقي، وإلا كيف نفسر طلب الأمير الرقص مع ساندريلا على إيقاع مقطوعات موسيقية ورقصات متنوعة وصولا إلى أغنية شعبية مغربية” وريني وحشك يا الغابة.؟. يقول السارد “المقطوعات الموسيقية والرقصات تتواصل، من إيقاع ‘السالسا’ إلى ‘ الطانغو’ إلى ‘ الفلامينكو’ إلى ‘ الرقص’. وصولا إلى حمأة رقصة شعبية. ألهبت المكان بهرجة ومرحا. ‘كلا يغني على كيتو..وريني وحشك يا الغابة (..) الأمير يدعو ‘ساندريلا’ لتراقصه الرقصة الصاخبة، تلبي النداء بسروور..). غير أنه “من الحب ما قتل” مثل ما جرى لعيروض الذي قتله عنترة الذي سرق منه عبلة بنت الحداد.؟
كما أن الكاتب وظف الميتا سرد الذي يركز فيه على “ذاته المهووسة بشهوة الإبداع وحرقته، برصد شهاداتهم الإبداعية، كتابة وإبداعا، وتنظيرا، ونقدا؛ بسعيهم إلى استحضار طقوس الكتابة الممكنة، والافتراضية، والاحتمالية، والتخييلية” وهو ما تجلى في قصة “تسلل” التي أتى فيها السارد على ذكر مجموعة من الأسماء الإبداعية، بل وأومأ إلى خصوصيته في الكتابة. يقول السارد:
“قال المؤلفُ محاولا الكلامَ بصوتٍ مسموعٍ:
في كتاباتي لدي الحرية بأن أبقي وأميت من أشاء أنا أتحكم في قدَرِ أبطالِي. ولا يتدخل في عوالم روايتي إلا النقاد والقراء، وأعتقد أن الحديث عن الرواية يجب أن يكون خارج هذا المكان، لأن الحديث عن الرواية لا يليق بمحكمتكم الموقرة”.
ملمح الميتا سرد هذا، نلفيه عند بعض الكتاب، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر محمد الشايب من خلال مجموعته القصصية “كماء قليل” التي يستحضر في بعض قصصها زفزاف، وخصائص الكتابة.
والملاحظ أن المصطفى كليتي وظف العديد من خصائص الكتابة السردية ما جعل من نصوصه مصنعا/مختبرا جرب فيه العديد من تقنيات الكتابة السردية، فقد وظف الأغاني التي اختلفت مشاربها وأنواعها بين الشعبي والكلاسيكي والديني وغيره، منها، وريني وحشك، على هدي على ديني، أجيال ورى أجيال، فات الميعاد.. ووظف مقطوعات موسيقية وذكر أسماء مبدعيها.
واعتمد الاقتراض بما هو استعمال كلمات ومصطلحات غير عربية وتوظيفها على الصيغة العربية لتأدية معنى يصعب تأديته باللغة الأمر، ومن أمثلة ذلك: سيلفي، ويكاند، الفايسبوك، كافيتيريا، لوطوروت.. طويوطا، بورتريه، كوفيد، كورونا.
واستخدم كذلك التناص بتوظيف التناص القرآني ياسين والملك (القرآن الكريم)، و قصة ساندريلا، واستعارة اسمي عبلة وعنتر،. والشعر. واستعان بالازدواجية اللغوية باعتماد اللغة العربية واللسان الدارج المغربي في العديد من المواقف “اطلق السخون.. اشوية ديال البارد عافاك”.. واعتمد تعددا للسراد في قصة “سيلفي”. وهو الأمر الذي يؤكد تشربه، لآليات الكتابة القصصية الحديثة.
خلاصة:
يمكن القول إننا أمام مبدع له ذاكرة خصبة، قادرة على استحضار تفاصيل التفاصيل والكتابة عنها، حيث تنفرج سريرة المبدع لتترك له المجال من التعبير عما يجول في الخاطر، بنفس مختزل ومكثف المعنى، وبنفس طويل وأسلوب سردي مميز وظف من خلاله الوصف والميتا سرد والسخرية والازدواجية اللغوية والإيحاء والرمزية. فهل من المنصف أن نضعه في جيل دون آخر؟
هوامش:
كليتي المصطفى، سيلفي، سيليكي أخوين، طنجة، ط.1، 2024.
2 سيلفي، ص. 63.
3 سيلفي، ص. 64.
4 سيلفي، ص. 76.
5 سيلفي، ص. 93.
6 العوفي نجيب، مقاربة الواقع في القصة المغربية: من التأصيل إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط.1، الدار البيضاء، 1987، ص. 217.
7 سيلفي، ص. 13-14.
8 سيلفي، ص. 17
9 سيلفي، ص. 103.
10 التليلي عبد الرحمان، الخيال والإبداع، الكراسات التونسية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية، تونس، ع.178، 1997، 100.
11 سيلفي، ص. 22-23.
12 جميل الحمداوي، الميتا سرد في القصة القصيرة بالمغرب، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني، تطوان، ط. 1، 2018، ص. 55.
13 سيلفي، ص. 122.
14 الشايب محمد، كماء قليل، الراصد الوطني للنشر والقراءة، ط.1، 2023.
15 سيلفي، ص. .65.
المصادر والمراجع
– كليتي المصطفى، سيلفي، سيليكي أخوين، طنجة، ط.1، 2024.
– العوفي نجيب، مقاربة الواقع في القصة المغربية: من التأصيل إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط.1، الدار البيضاء، 1987، ص. 217.
– التليلي عبد الرحمان، الخيال والإبداع، الكراسات التونسية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية، تونس، ع.178، 1997، 100.
– جميل الحمداوي، الميتا سرد في القصة القصيرة بالمغرب، دار الريف للطبع والنشر الإلكتروني، تطوان، ط. 1، 2018، ص. 55.
– الشايب محمد، كماء قليل، الراصد الوطني للنشر والقراءة، ط.1، 2023.