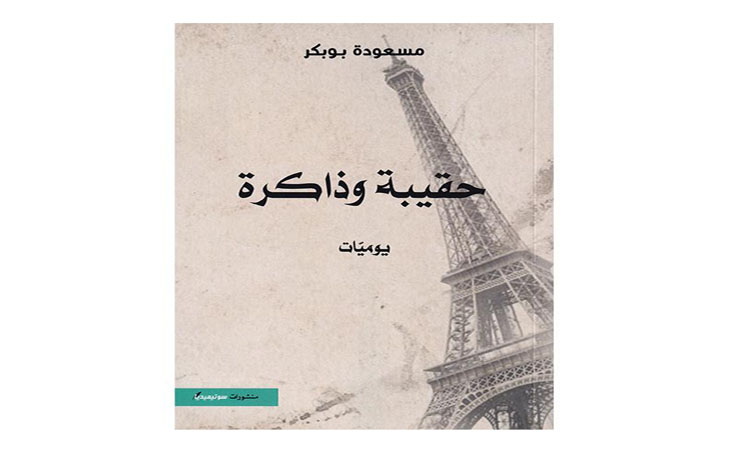الدمى الروسية المنفلتة من الكاتب والقارئ معا
تدعونا النصوص القصصية لسعيد منتسب إلى إعادة تشكيلها على القماش بالألوان الطبيعية الفارقة. أي أنها نصوص لا تتقصد المعنى إلا حين تفجيره إلى ذرات تفيد النقيض/اللامعنى، وكأن هذا الأخير هو الفرشاة التي يرسم بها نصوصه، ليكتشف القارئ أنه أمام لوحة مؤطرة تتداخل فيها الصور وتتعانق، وتتشابك، وتتفارق. حيث لا يستطيع المشاهد ضبط اللوحة إلى حين تركيز نظره على ذراتها. كل ذرة ترميك إلى مرجع خاص بها. إننا أمام لوحة غرنيكا لبيكاسو، وهي لوحة تزيل البرواز من مكانه، أو بمعنى آخر إن القارئ يحرر اللوحة من إطارها كي يستطيع النظر إليها بتأمل كبير.
هكذا تبدو وقصص الكاتب شبيهة بلوحة بيكاسو، حيث يكون العنوان المؤطر لها بروازا يعتقل الحكايا المشتتة بعناوين فرعية مختلفة. كل حكاية تبدأ من ألفها ولا تنتهي في السطر الأخير وكأنها تبحث عن جارتها المقنعة بعناوين أخرى كما الدمى الروسية. بهذا المعنى يكون النص الأول مربوطا بما يليه، بينما السابق عليه يظل محشوا في البياض. البياض تيمة رئيسة في هذه النصوص، وهي دالة على الولادة والموت، وبينهما تكون التسمية سلطة ثقافية تقيم القانون والكتابة. والأنكى من ذلك هو المسخ/التحول الذي يسقي به الكاتب مرق نصوص، إنه العلامة الفارقة في نصوص سعيد منتسب ، وهي دالة على تحويل المستحيل الى الممكن، وتحويل الميت الى الحي، والمقبرة الى مسرح كوميدي، وتراجيدي، حيث تنكشف العناصر الأربعة في دائرية مروعة. الرائع والجميل الذي يرفع التناقض الى حدوده القصوى، جاعلا من الأقنعة الإفريقية حدوده دون اكتراث لما يقوله المتلقى، هذا الأخير الذي تزوبعه الحكاية، وتخلخل مسارها المتحول من وإلى. تحول كفكاوي عجيب يخلط فيه الكاتب الطبيعة بعجيبها المتدفق في الماء، وهو العنصر الحامل لبلاغة البياض في ثنائية الولادة والموت، بينما العناصر الأخرى والديكور الذي يؤثث به الكاتب نصوصه من أشجار، ودور، وشخوص، وتراب، وكلام، وكتابة، وموسيقى وأشياء أخرى، تغطي الخلفية الجميلة لهذا النص. ولأن المقاطع مستقلة بعضها عن بعض بعناوين تمحو العنوان الأول “صرخات لا تنتهي لامرأة تلد”. وكأن النظر إلى كل عنوان من هذا النص هو تغير صورة المرأة المراد ضبطها. نعني بذلك أن النص القصصي يشبه المرأة تماما يفترض النظر إليه من زوايا متعددة حتى ولو كانت عصية على النظر والضبط، فهي تنزلق من المعنى كما النص القصصي تماما. إنها لا تنتهي حيث الصرخة وما يتولد عنها من شهوة ورغبة.
الآن نريد فضح شهوتنا، ورغبتنا في قراءة نص واحد، حتى وإن كنا نعرف أن المسألة صعبة، وصعوبتها تتأتى من رؤية الكاتب إلى العالم، والاستعارات التي يتعكز عليها لترويع القارئ وتضييعه في نفس الوقت. صحيح أن القصص المغربية في بعدها المدرسي تفيد الضبط التحليلي من خلال مرجع نقدي معين. إلا أن نص سعيد منتسب ينفلت من أي سلطة نقدية كيفما كانت نوعيتها. إنه نص زئبقي، ومروع، وهذه الكلمة الأخيرة تحمل دلالتين: دلالة الخوف، والمخيف. بينما تروم الثانية إلى الرائع والجميل وبينهما يكون القارئ مندهشا ومشغولا يعد أصابعه حتى لا تطير. لقد قلنا سابقا إن نصوص سعيد منتسب شبيهة بالدمى الروسية، لا يستطيع متلقيها عزل الواحدة عن الأخرى، وكأن كل قطعة نصية نافذة لقطعة أخرى، وهي بالأحرى مرآة جامعة للقطع النصية كلها، أي أن كل قطعة لا تستقيم دلالتها و صورتها إلا بشبيهتها.
بهذه الطريقة تكون الصراخات دليلا على ولادة المرأة. وهذه الولادة التي يرغب الكاتب تظهير مخاضها، لأن المخاض وجع يتلف العقل والتوازن، وهو بذلك يكون مروعا. يظهر هذا في الطرائق السردية التي تحيل على التحول/المسخ الكفكاوي.
من هذه الصيغة نستطيع مقاربة القصة “صرخات لا تنتهي لامرأة تلد”.
إن كتابة القصة هي الناظم الرئيس في هذا النص، أي أن الكاتب يبني نصه من سؤال النص ذاته. بهذا المعنى تكون الحكاية هي الموضوعة المركزية فيه. ماذا يعني هذا القول؟ صحيح أن هناك شخصيتين مترابطتين في ما بينهما كما الورقة تماما، المرأة والطفل، وبينهما الحكاية التي يود كل واحد منهما إمتاع الآخر بها. ولأن أية حكاية لا تكون كذلك إلا في توالدها. وكأن الحكاية العقيمة لا يعول عليها، وبالمقابل خصوبتها تحيل على الحياة والتجدد. إنها كالماء والنهر الذي لا نسبح فيه مرتين كما قال الحكيم الاثيني هيراقليطس. كأن الحكاية تتجدد بتعدد الحكائين والسراد. «ولم تكن سوى مياه تدندن بخفوت على ضفاف غير مرئية..» إذا كان الأمر كذلك فالنص يستلزم ضبطه في الموضوعات التي انبنى عليها. سنحاول مقاربة بعضها.
1- الحكاية:
هي التي تعطي للحياة المعنى، وهي التي تقاوم الموت. فلا سبيل للمرأة وابنها إلا تبادل الحكايا. إنها الرباط الذي يعطي للوجود الحياة وفق الطبيعة. إنها رديفة الموسيقى حيث لا تستقيم الأولى إلا بالثانية في جدلية تندفع فيها الطائرات الورقية الى الطيران كما خيال الطفل، وأمه. وكأن حبل السرة هو الخيط الشفاف الذي يقوم بتظهير الحكاية قبالة المقبرة: “وهي تنتظر أن أعود من المدرسة، جائعا ومسلوخا، تنتظرني لتلدني من جديد” (ص6) يكون الانتظار ولادة جديدة لحكاية أخرى. لكن كيف يكون الانتظار مخاضا للقول، والبوح، وحبل السرة يخفي الوجع، والصرخة والولادة.
لا غرو إذن أن يكون الانتظار إيقاظا للأوهام والحكايا. وهذا لا يتم إلا في بعديها. البعد الاول يكون فيه الطفل مرآة لأمه. بينما يكون الأم يمّا لتجديد صورة الطفل، وعملية توليد الحكايا، وجهان متلاصقان ومختلفان. يظهر ذلك في الجملة السردية التالية: هي تخرج من باب، وأنا أدخل من باب. هي تطفئ السراج، وأنا أمسك السراج الثاني بيد ترتعش (ص 3). إن عملية الدخول والخروج تفيد ضمنيا أن لكل واحد منهما عالمه الخاص، حتى وإن كانت المرأة هي منبع الضوء، وبوصلة الطريق، فهل هذا يعني أن كل حكاية يسردها الطفل والام لها مفعولها الخاص والذي يكون شرطا رمزيا في التبادل تأخذ من يدي التي تتجمد في يدها. هي تقص حكايات بطعم الكراميل، وأنا أحكي لها عن البغلة التي حرنت وكادت ترميني من أعلى الجرف. ص 5 ثمة صورة سيكولوجية ترسم اللاشعور، وتقوم بإعلانه. فمن جهة هناك رباط شبه مقدس بين الأم والطفل، وهذا ما يمثله ترابط اليدين. بينما في الجهة الاخرى استعارة بليغة تعطي للحكاية طعم الكراميل. في حين تكون حكاية الطفل محمولة على القفز والطيران والزوغان كما البغل الحرون. لكن من أين يستمد الطفل حكاياه، هل هو نابع من طبيعة المكان الذي يعيش فيه أم أن حليب الام خزان للحكايا. كيفما يكون الأمر فالمرأة هي مصدر الحكي في التاريخ الكوني. إنها سلطة تقوم بتدبير عالمها. ضمن العتمة، والظلمة والحجب والهامش.. بينما يستمد الطفل بعضا منها، والبعض الاخر يكون موازيا للقهر المسلط عليه في المسيد، المدرسة. إذا نظرنا الى الخصيصة التي تلحم طريقة الحكي لكل واحد منهما، سنتحصل على مجالين مختلفين، وهما لغة الام، ولغة الطفل / الأب .فالأولى مركونة في الهامش، والشفهي.. بينما الثانية تندفع نحو القانون والكتابة والمؤسسة (المسيد نموذجا) ومع ذلك فإن اليدين المشدودتين تعلنان حدود الترابط بين لغة الأم ولغة الأب، بين المؤنث والذكوري، لتبقى سلطة الحكي بيد الأم / المرأة. إنها تهدي لطفلها الضوء كي يضيئ الحكاية. ناولتني مصباحا يدويا وطلبت مني أن أقرأ لها تحت شجرة اللوز (ص 6) هذه الحكاية تبني مشاهدها قبالة المقبرة. وكأن ما تبقى من المكان يكتبه السراد.
2 – المقبرة
ثمانية عناوين تسكن عنوان القصة. أربعة منها تحمل اسم المقبرة: (مقبرة امبرطو، مقبرة سباتة، مقبرة الشهداء، مقبرة سيدي مسعود) هي أسماء تفيد شخوصا ممكنين وموجودين. في حين يكون اسم واحد دالا على المكان. كل اسم يفتح باب حكايته، أو هو بالاحرى دمية من الدمى الروسية حيث الاسم الاول يحيل على الكاتب والناقد الايطالي، بينما اسم الشهداء دال على المدفونين في سبيل قضية وطنية أو ما يشبهها. بينما سيدي مسعود الذي لا نعرفه، هل هو ولي من أولياء لله المتعددين، في الارض؟ أم هو صاحب الارض التي وهبها مسكنا للموتى؟ ان القادم الى مقبرته سعيد بمآله. كيفما يكون الحال فمبتغانا من التسمية هو سفر وترحال من مقطع نصي وموسيقي الى آخر. المقبرة تتميز بهذه الخصيصة الوجودية الفارقة. ليس لأن السارد قبالة الموت أي في مواجهة حميمة مع القبور المصطفة بعشوائية واضحة. وإنما في الموسيقى المصاحبة للموت. وكأن هذه الأخيرة لا تستقيم إلا في محراب الأولى.
الموسيقى هي الرافعة الرئيسية في ترميم الاعضاء المتناثرة والمنخورة بالديدان. كما أنها تخلخل التقابل المربك بين الحياة والموت. هكذا يستعيد السارد / الطفل حدود المقبرة بالموسيقى، أو بمعنى آخر فالمقبرة تعلن نهاية الزمن هي العدم عينه «الساعات توقفت عن النبض حين رآهم يهيلون عليها الحصى ويثقلونها بألواح حجرية صلدة. هل يعزف الآن، أم حتى يتأكد من انصرافهم. ص 1 العزف رديف الحكي، وهذا ينبني على كون الحكاية تبتدئ من الموت. وكأن ما يكون صالحا للحكاية هو ما ودعناه، أو ما ينتظره. ان الكاتب يقف في خطوط انفلات مروعة بين المحجوب والعري، بين الخفي والظاهر، بين الميت والحي. وفي صيغة بين بين يقف السارد شاهدا على إتمام الدفن حتى يستطيع العزف / الموسيقى، والقراءة، والكتابة. هذه العناصر الموضوعة في خطوط انفلاتها تضعنا أمام إشكالية الكتابة القصصية عند سعيد منتسب، فهو من جهة لا يعطي للحدث حدوده، ولا يهندسه بالمسطرة والبركار بل يقوم بمسخ العوالم كلها دون حساب مآل قرائه السذج. فالقصة تصبح كوخا، والاغنيات تصبح طائرات ورقية. المقرؤون كلاب وما الى ذلك كثير.
إن موضوعة التحول / المسخ هي التي أعطت لهذا النص، ونصوص أخرى فرادة الكاتب. وهذا لا يتأتى إلا بمجهود قرائي فارق أو بمعنى آخر فالاستعارات التي يركبها السارد يوجهها حينا وتوجهه حينا آخر. ليست موضوعة بطريقة اعتباطية وعشوائية بقدر ماهي مركبة بمهل ومطرزة بحكمة، لكن ما الذي يجعل المقبرة خلفية.
موسيقية وقرائية وكتابية؟ هل ماننصت إليه نقرأه ونكتبه هو أشبه بالمقبرة البورخيسية؟ أم أن المكتبة والحكايا مقابر، منها ما يتوالد ويتجدد ومنها ما ينتظر التنقيب والتوليد، ومنها ما ابتلعه التراب ولم يعد صالحا. يقول السارد في صفحة 5: »نريد شراء كلمات« تضحك المرأة بسخاء وتشير إلى المقبر التي تخترق الحقول مثل طفح جلدي«.
لقد برع الكاتب في موسقة نصه القصصي “صرخات لا تنتهي لامرأة تلد”« وأثثه بإيقاعات متعددة ومتجددة تأويليا، ذلك أن إيقاع المقبرة يستقيم بالموسيقى والتحول/ المسخ والنظرة والماء هذا الأخير الذي يتجدد كلما وصلنا إليه ويعطي للأرض الخصوبة والجمال مثلما يكون قوتا يقتات منه الجنين في الرحم. إنه الحياة أو أصل الوجود كما يقول طاليس بل أكثر من ذلك هو الذي ينعش المقبرة ويحيي موتاها “وأراني طفلا يسقي قبرا وسط نهر يتدفق منذ الأزل في حفيف أشجار اللوز” صفحة 64 .وفي سياق آخر “ولم تكن الكلمات سوى مياه تدندن بخفوت على ضفاف غير مرئية” ص 6 ..هكذا يحيي الموتى وتحيا الكلمات وتتجدد المعاني، إذا حاولنا النظر من زاوية معاكسة ووضعنا هذه القصة قبالة الماء وصورناها فيه، فإن غياب الأثر سيكون مهمازا قويا للبحث عنه في تجدده. من هذا الوصف الاستعاري يكون الحلم نافذة الكاتب في كتابة الماء وتجديد رؤيته إلى الكتابة القصصية والسخرية من الذين يبحثون عن الأثر في الماء أو المنشغلين بوضع القصة والكاتب في خانة من خاناتهم الموجودة على رفوف المكتبة الرسمية. بهذا المعنى تكون هذه القصة منفلتة من كاتبها وقارئها معا، ومطروحة في لعبة الامكان الذي يربك العلاقة بين الكاتب والقصة والقارئ كما العناوين المقطعية التي يمحي الواحد منها الآخر لتستسلم لصرخات لاتنتهي أو لولادة متجددة.