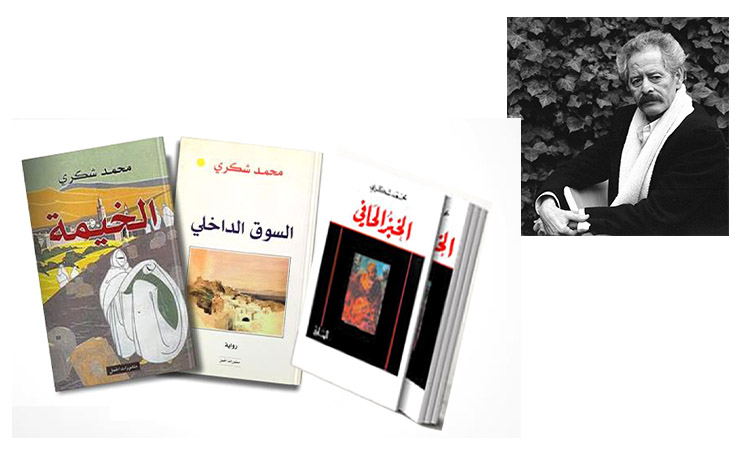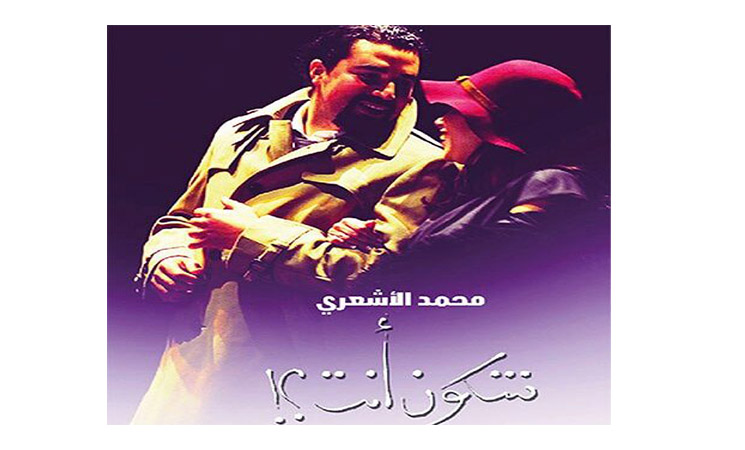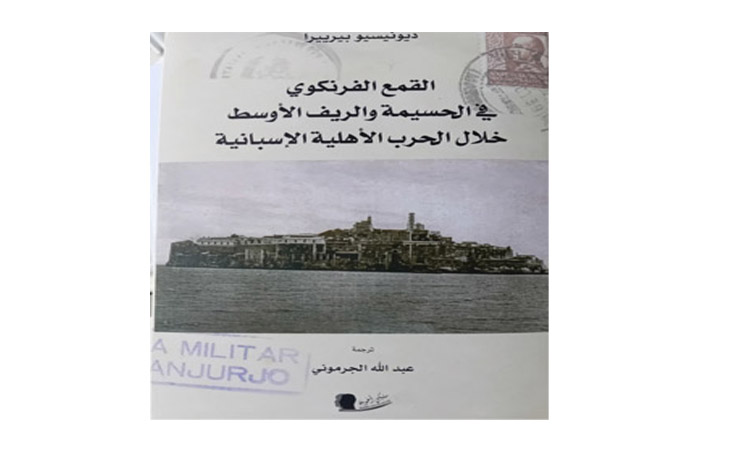عادة ما يتم اعتماد منطق الدحض لتحقيق التطور في المعرفة العلمية، فتقوم النظرية الجديدة بإلغاء سابقتها، أما في العلوم الإنسانية والاجتماعية، بما فيها التاريخ، فتختلف المقاربات عن بعضها البعض، ولكنها تتعايش على الرغم من ذلك. ويرى كارل بوبر (Karl Popper) أن على العلوم الإنسانية أن تنتظر عالما من عيار غاليلي (Galilée) لترقى إلى مرتبة العلوم الدقيقة(1). أمر يبدو بعيد المنال إذا ما نحن نظرنا إلى مسار تاريخ العلوم، ذلك أن العلوم الدقيقة نفسها تتأثر بالسياق التاريخي والسياسي والثقافي الذي أنشأها. وليس هناك اختلاف بين السلطة المكتسبة في الحياة الاجتماعية وما يتم اكتسابه في النقاش العلمي. فقد تكون النتائج التي توصل إليها العلماء المغاربة في حقل العلوم الدقيقة أكثر مدعاة للتمحيص من طرف النخبة العلمية الدولية مما تفضي إليه دراسات باحثين أمريكيين. ويرى المؤرخ الأمريكي ستيفان شابين (Steven Shapin) أن القبول الجماعي لأبحاث العالم في أوروبا، خلال العصر الحديث، كان يرتكز على عقدة الثقة بالباحث ونزاهة الدارس المتمرس، والثقة ليست بالأس العلمي الموثوق به. وكان يمثل هؤلاء العلماء في القارة العجوز الشرفاء الذين كانوا يحظون باحترام الجميع، نظرا لصدقهم ونبل أخلاقهم وتواضعهم وحبهم المطلق للحقيقة، كما يرونها ويتصورونها (2). نفهم مما سبق، أن المؤرخين لا يسعون إلى الوصول إلى حقيقة مطلقة، بل يهدفون، في إطار مقارباتهم الهرمنوطيقية، إلى إعطاء تأويلات غير كاملة، ولكنها ما فتئت تزداد غنى وتكاملا مع مرور الزمن (3).
يلعب التاريخ دورا حاسما في إعادة بناء الماضي، وتشكيل الهوية الوطنية لمختلف البلدان، وتحس كل أمة بالحاجة إلى تأكيد خصوصيتها، لذلك يشكل التاريخ، بالنسبة لها، أحد الروافد المهمة الداعمة لهذه الخصوصية، فيفخر المواطن بانتمائه لهذه الحضارة أو لتلك. وعلى غرار بقية المواطنين في العالم، يشعر المغربي بانتمائه لحضارة تليدة وموغلة في القدم. ويرجع الفضل في التعريف بتاريخ المغرب إلى جمهور المؤرخين الذين لم يألوا جهدا في العودة إلى الشواهد والوثائق الدفينة والغميسة، من أجل إطلاع القراء على الأحداث والقضايا المنسية وغير المعروفة لهذا التاريخ. ونستحضر في السياق المغربي الأعمال والدراسات المهمة للباحثين الأوائل الذين خبروا صنعة التاريخ، ووضعوا كثيرا من التآليف والمصنفات.
إن المتأمل في الكتابة التاريخية المغربية منذ الاستقلال، يرى أنها تأثرت بالكتابة التاريخية التقليدية بالمغرب، كما أنها في ذات الوقت استلهمت كثيرا من قضايا البحث والمقاربات من المدارس الغربية، ومنها على وجه الخصوص المدرسة الفرنسية. إن إلقاء نظرة سريعة على مسار مختلف هذه المدارس الفرنسية، يوضح تركيزها في البداية – وبتأثير من المدرسة الألمانية- على الجانب السياسي والعسكري والدبلوماسي، وعلى علية القوم من أباطرة وملوك ووزراء، وعلى تاريخ الأمم. لقد نشأت المدرسة الوضعية بفرنسا خلال القرن التاسع عشر على عهد الجمهورية الثالثة، وقد رامت وضع اللبنات الأولى لبناء صرح بحث علمي رصين، مستبعدة المساجلات الفلسفية، وصولا إلى الموضوعية المطلقة في التاريخ. ورأت أن بإمكانها بلوغ ما سطرته من أهداف، إن هي اعتمدت منهجا صارما في ترتيب الوثائق ونقدها، غير أن كثيرا من هذه الغايات لم يتحقق (4). وكان صدور مجلة الأنـال سنة 1929 إيذانا ببروز مدرسة تاريخية جديدة في فرنسا ستحمل نفس الاسم. وقد سعى روادها إلى تهميش التاريخ الحدثي والتاريخ السياسي لصالح التاريخ ذي الإيقاع البطيء، والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي، والتاريخ الديمغرافي، والجغرافيا التاريخية، وتاريخ الذهنيات (5). وقد أدى هذا التغيير في القضايا إلى توسيع مفهوم الشواهد المعتمدة لكتابة التاريخ. وهكذا تم إغناء البحث التاريخي مع الجيل الأول والثاني والثالث لمدرسة الأنـال بالخوض في قضايا جديدة عن طريق الانفتاح على بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية (6).
هكذا وجد المؤرخون المغاربة أنفسهم، عقب الاستقلال، أمام أصناف متعددة من الكتابة التاريخية في الغرب، وتأثروا بها في دراساتهم وأبحاثهم، واختار كل منهم قضاياه وشواهده حسب تكوينه واجتهاده. لم يشكل هؤلاء المؤرخون والمؤرخات إلا “كمشة”، حسب العبارة التي كان يستعملها الأستاذ ابراهيم بوطالب رحمه الله، ولم يكن بمقدورهم تغطية كل القضايا، واستعمال كل الشواهد، فالتراكم الذي حصل في فرنسا على وجه الخصوص، عبر مقاربة قضايا مختلفة تباعا، لم يعرفه المغرب. لذلك وجدنا من الدارسين من يهتم تبعا لميولاته وتكوينه واجتهاده الشخصي بالتاريخ السياسي، أو من يركز على البعد الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو يخوض في الجوانب الثقافية. ومن هنا قد لا يفهم البعض دواعي توجيه مؤلفات إلى القارئ المغربي تتحدث مثلا عن عودة الحدث، بينما كان الحدث حاضرا ولا يزل ماثلا في الكتابة التاريخية الحالية. ولقلة عدد المؤرخين، لم تتم حتى الآن تغطية كل الأحداث والقضايا السياسية حتى عبر المقاربات الكلاسيكية، وذلك قبل الانتقال إلى دراساتها عبر مقاربات جديدة منفتحة على بقية العلوم الإنسانية والاجتماعية. فجمهور المؤرخين في المغرب يظل محدودا نسبيا إن نحن قارناه على سبيل المثال بعدد أعضاء الرابطة التاريخية الأمريكية الذين يربو جمعهم عن عشرة ألاف فرد.
اهتمت عدة دراسات بمسار الكتابة التاريخية المغربية، عقب الاستقلال، وتم التمييز بين مرحلتين، مرحلة امتدت من 1976 إلى 1986، غلب عليها البعد الوطني والسياسي، وسعى من خلالها المؤرخون المغاربة إلى الوقوف في وجه الكتابة التاريخية الاستعمارية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتوضيح أن المغاربة مثلوا دائما أمة واحدة، وذلك منذ أوائل القرن الخامس عشر، وأن الهجمات الاستعمارية هي التي أضعفتهم في القرن التاسع عشر. وكانت الوثائق المغربية عمادهم في هذه المرحلة، وخاصة المخزنية منها، وخير من مثل هذا الاتجاه جرمان عياش ومحمد المنوني. وقد تميزت أعمال هذا الأخير بالجدة في اختيار القضايا المدروسة. وأعقبت هذه المرحلة مرحلة ثانية، تم الانتقال فيها إلى التاريخ الاجتماعي في إطار مقاربة علمية وشمولية، من خلال التركيز على الدراسات المونوغرافية، عبر دراسات أحمد التوفيق والعربي مزين وعبد الرحمن المودن وغيرهم.وما ميز هذه الكتابات هو انفتاحها على علم الاجتماع والأنثروبولوجيا واللسانيات والاقتصاد. كما تم الاهتمام بنشر المخطوطات كالتراجم والرحلات، وتم التركيز على القضايا الثقافية والتاريخ الديني. وفي نفس السياق، تم البحث في تاريخ الأقليات، وتاريخ بلدان ومجالات ثقافية أخرى، كالإمبراطورية العثمانية، وبقية العالم العربي، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأوروبا، وآسيا، والأمريكيتين، في إطار التاريخ العلائقى على وجه الخصوص (7).
وفي مقابل هذا التأليف حول الكتابة التاريخية المغربية، تكاد تنعدم السير الفكرية التي يتحدث فيها المؤرخون المغاربة عن مساراتهم الفردية. لذلك ارتأينا أن نخصص سلسلة محاضرات تحت عنوان: تجارب أكاديمية في البحث التاريخي، يتحدث فيها هؤلاء عن سيرهم الفكرية. إننا نسعى من خلال هذا المؤلف إلى التعريف بعطاءات هؤلاء الباحثات والباحثين الحاليين، الملتزمين بقواعد البحث الأكاديمي المتين والصرامة العلمية، وهم، دون غيرهم، أفضل من يعرف بمسارهم الفكري، والتذكير بالعقبات التي تواجههم وهم يمارسون صنعتهم. وقد استجابت ثلة من المؤرخات والمؤرخين المغاربة للدعوة التي وُجهت إليهم، على الرغم من الصعوبة التي قد تعتور الحديث عن الذات بصيغة “الأنا”.
وقد آلينا على أنفسنا ألا نحدد محاور للمداخلات، تاركين كامل الحرية للمتدخلين. فقد يعتبر بعض الباحثين أن مسارهم تحدد منذ ارتيادهم “المسيد”، بينما يرى البعض الآخر أن تكوينهم كمؤرخين يبدأ في مرحلة النضج عقب الانتقال إلى الدراسة الجامعية. والحق أنه عندما نعود إلى مسار بعض المؤرخين، نرى أن بعضهم يبدأ الحديث عن سيرته بمرحلة الصبا، وعن المكان الذين ترعرع فيه. ففي المغرب، تعرض عبد الله العروي في سيرته الذهنية للحديث عن عائلته وصباه، وعن دراسته بمراكش والرباط (8). وهذا فرنان بروديل (Fernand Braudel)، المزداد سنة 1902، يحكي عن طفولته بقرية صغيرة بين شمبانيا وباروا، والتي لم تكن تضم زمن ولادته إلا مائتي نسمة. كما يتحدث عن والده الذي كان معلما، وعن دراسته بالمدرسة وبالثانوي وبجامعة بالسوربون (9). أما جورج ديبي (Georges Duby)، المزداد سنة 1919، فيبدأ الحديث عن مساره عقب حصوله على شهادة التبريز سنة 1942، وقراره بتهييء أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط (10). إن هذه السير المتنوعة والمرتبطة بالأوساط العائلية والمجالية والمشارب الفكرية المختلفة للمتدخلين يمكن أن تصبح مدخلا لدراسة سوسيولوجية لجمهور المؤرخات والمؤرخين المغاربة.
وقد تم توزيع المؤلف إلى ثلاثة أقسام: تم تخصيص القسم الأول للتاريخ الاقتصادي والسياسي والعلائقي، وتضمن مداخلات عثمان المنصوري، وعلال الخديمي، وعبد الحق المريني، وعبد الرحيم بنحادة. أما القسم الثاني، فتم تخصيصه للتاريخ الاجتماعي، وضم مداخلات عبد الأحد السبتي، وامحمد بن عبود، ومحمد المنصور، وفاطمة الزهراء طموح، والمصطفى بوعزيز. فيما تم تخصيص القسم الثالث للتاريخ الثقافي والديني وعلم الآثار، وتضمن محاضرات البيضاوية بلكامل، ومينة المغاري، وعبد الله نجمي، ونفيسة الذهبي، وجامع بيضا. قد يلاحظ القارئ حضورا متميزا لجامعة محمد الخامس بالرباط، وذلك لأنها تظل الجامعة الأم، كما أنها كانت ولا تزال مؤسسة جذب لأن هناك مؤرخات ومؤرخين بدأوا مشوارهم في جامعات أخرى، والتحقوا في وقت لاحق بهذه الجامعة الأم. وستتم دعوة مؤرخات ومؤرخين بشكل أكبر من بقية الجامعات المغربية في المحاضرات القادمة. وتنبغي الإشارة إلى أن باحثات وباحثين آخرين اعتذروا عن المشاركة، لأنهم وجدوا حرجا في الحديث عن أنفسهم، أو نظرا لوضعهم الصحي. وقد بدأت سلسلة المحاضرات مع مداخلة عبد الأحد السبتي بتاريخ 22 فبراير 2018، وانتهت بعرض مينة المغاري في 10 مارس 2020. وكان من المقرر أن يشارك في هذه السلسة الأولى كل من محمد مزين وعبد الرحمن المودن، لكن انتشار وباء كوفيد 19، أوقف سلسلة المحاضرات في مارس 2020، ورحلا قبل أن يقدما مداخلتهما. فرحمهما الله تعالى وأسكنهما فسيح جناته.
* “صنعة التاريخ في المغرب: مسارات وتوجهات” تنسيق خليل السعداني. الجزء الأول، الرباط: منشورات المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيروأمريكية، 2024.
إحالات:
Cf. Karl Popper, Conjectures et réfutations. La croissance du savoir scientifique, (Paris: Payot, 1985); Misère de l’historicisme, (Paris: Plon, 1988).
2-PapNdiaye, «Autorité et preuve en histoire des sciences», in Revue de la Faculté des Lettres Beni Mellal, n° 4, (2001), pp. 189-200; Steven Shapin et Simon Shaffer, Léviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle entre sciences et politique, (Paris: La Découverte, 1993).
3-Jean Heffer et François Weil, sous la direction de, Chantiers d’histoire américaine, (Paris: Belin, 1994), pp. 15-6
4 Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, (Paris: Editions du Seuil), 1983, pp. 181-8; Christian Delacroix, François Dosse, Patricia Garcia, Les courants historiques en France, XIXe-XXe siècle, (Paris: Gallimard, 2009), pp. 96-168; Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, Historiographies. Concepts et débats, I, (Paris: Gallimard, 2010), pp. 443-452.
5-Bourdé et Martin, Les écoles historiques, pp. 215-243; Jean-Claude Ruano-Borbalan, coordonné par, L’histoire aujourd’hui. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien, (Auxerre: Sciences Humaines Editions, 1999), pp. 279-286; Delacroix, Dosse, Garcia, Les courants historiques en France, XIXe-XXe siècle, pp. 200-294.
6-Jacques Le Goff, La Nouvelle Histoire, (Paris: Editions Complexe, 1988); J. Le Goff et Pierre Nora, sous la direction de, Faire de l’histoire, Nouveaux problèmes, nouvelles approches, Nouveaux objets, (Paris: Gallimard, 2011); Bourdé et Martin, Les écoles historiques, pp. 245-70.
7-اُنظر بخصوص الكتابة التاريخية المغربية: محمد المنصور، محمد كنبيب، عبد الأحد السبتي، تنسيق، البحث في تاريخ المغرب. حصيلة وتقويم، (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1989)؛ عبد الرحمن المودن، عبد الحميد هنية، عبد الرحيم بنحادة، تنسيق، الكتابات التاريخية في المغارب. الهوية، الذاكرة، والإسطوغرافيا، (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2007)؛ خمسون سنة من البحث التاريخي في المغرب، في مجلة الجمعية المغربية للبحث التاريخي، عدد 7-8، (2009-2010)؛ عبد الأحد السبتي، التاريخ والذاكرة. أوراش في تاريخ المغرب، (الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2012)؛ عبد الأحد السبتي، “في كتابة التاريخ المحلي”، في من إيناون إلى استانبول. أعمال مهداة إلى عبد الرحمن المودن، تنسيق عبد الأحد السبتي، عبد الرحيم بنحادة، (الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2012)؛ محمد حبيدة، بؤس التاريخ. مراجعات ومقاربات، (الرباط: دار الأمان، 2016)؛ مجلة المناهل، ملف العدد، إطلالة على حصيلة الدراسات التاريخية المغربية، العدد 99، (أبريل، ماي، يونيو 2020).
8-عبد الله العــروي، أوراق. سيـرة إدريس الذهنيــة، (الدار البيضـاء، بـيـروت: المركـز الثـقـافي العــربي)، 1989، ص.15-46.
9-محمد حبيدة، من أجل تاريخ إشكالي. ترجمات مختارة، (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة)، 2004، ص.59-61.
10-Georges Duby, L’histoire continue, (Paris: Editions Odile Jacob, 1991), pp. 7-8.