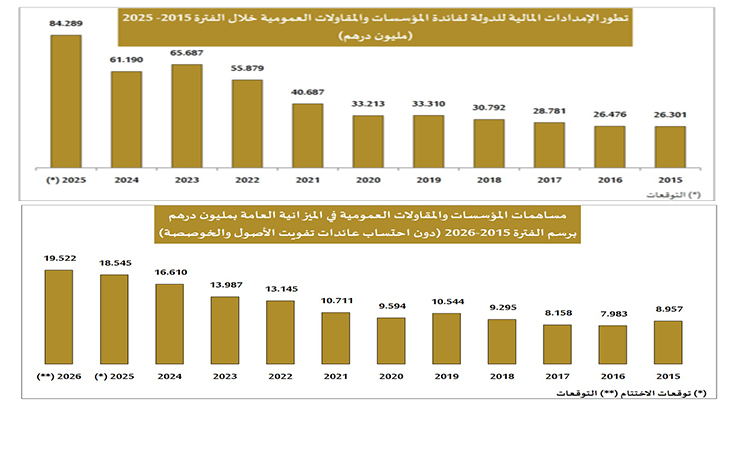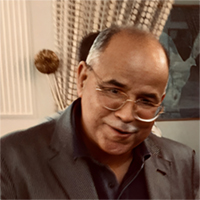
ينتمي الشاعر عبد السلام الزيتوني شعريا إلى الموجة الثانية من شعراء الحداثة المغاربة، بعد جيل الرواد. فقد بدأت قصائده تظهر على المنابر الأدبية منذ أواخر خمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي. ومع هذا فإن قراءة في قصائده المبثوثة في المجلات والجرائد السيارة تجعله ينتسب عربيا إلى الشعراء الذين أنضجت شعريتهم هزيمة 1967 التي تركت ندوبا غائرة في جيل بكامله.
لذلك فإن عبد السلام الزيتوني الذي تشبع كباقي شعراء جيله بنفس رومانسي حاد في بداياته الأولى، سيكون شاهدا على صدمة الهزيمة بطريقته الخاصة، وسيكتب القصيدة بروح طافحة بالشعور القومي والوطني، دون أن يتخلى عن ذلك النفس الرومانسي الذي قال عنه الشاعر المغربي الكبير محمد السرغيني ذات يوم إنه ملح القصيدة.
من هنا سيزاوج الشاعر عبد السلام الزيتوني في شعره بين لواعج الذات وهموم الوطن في بعديه القطري والقومي، بشكل لا يترك المجال للفصل بين الذات والموضوع.
ومن ثم فإن كتاباته الشعرية لا تشبه القصيدة الملتزمة رغم أن فيها من الالتزام ما لا تخطئه العين، كما أن تلك الكتابات تند عن القصيدة الرومانسية رغم ما فيها من غنائية تخاطب الأذن والعاطفة قبل أن تخاطب العين والعقل.
لم يخلف الشاعر عبد السلام الزيتوني الذي غادرنا في مثل هده الأيام من سنة 1013 بعد أن أدى ما عليه كمثقف مغربي، من أدوار طالت جميع مناحي الحياة العامة، من الأعمال المنشورة سوى ديوان شعري واحد وكم هائل من القصائد الموزعة على المجلات والملاحق الثقافية، جمع منتخبات منها قبل وفاته في ثلاثة دواوين مخطوطة ما زالت تنتظر النشر، وهي «الإفرانيات» و»قصائد منسية» وبغداديات أيام المحنة».
وفي كل هذه الأعمال ظل الشاعر مخلصا للشعرية العربية الأصيلة التي تعتبر القصيدة الحديثة امتدادا للتراث الشعري وانخراطا في الحداثة في نفس الوقت.
من أجل ذلك ظل هذا الشاعر مؤمنا بأن الوزن هو أحد أعمدة النص الشعري، ولكنه الوزن المرن الذي لا يتحقق على حساب مكونات النص الأخرى. وراح ينوع في الأوزان الخليلية مستغلا ما يمكن أن تتيحه من إمكانات إيقاعية غير محدودة. فكانت قصائده بحق متعة للعين والأذن، وللعقل والعاطفة معا.
ولأن تجربة الشاعر عبد السلام الزيتوني الشعرية تمتد زمنيا على مساحة تتجاوز خمسين عاما. ولأن تلك التجربة عرفت تحولات شعرية أفضت إلى تنويع في أنماط الكتابة الشعرية لديه، فإن من الإجحاف حشرها في خانة واحدة.
وعليه فإن هذه الدراسة التي تطمح إلى رسم الملامح الكبرى للقصيدة عند الزيتوني ستقتصر على ديوانه المتاح للقراء، الذي يحمل عنوان «نسيت دمي عندهم» الصادر عن منشورات الاتحاد العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب سنة 1994.
تفترض هذه المحاولة للاقتراب من ديوان «نسيت دمي عندهم» أن النصوص الشعرية التي يضمها بين دفتيه تشكل وحدة متجانسة. ذلك أن الديوان عبارة عن مختارات شعرية انتقاها الشاعر نفسه، من بين مئات القصائد التي دبجها خلال سنوات طوال، لتمثل عملا شعريا متكاملا ومتلاحما.
من هنا فإن القصائد المنشورة في الكتاب يجمعها مكان الكتابة الذي هو مدينة مكناس، ولكنها تنتمي زمنيا إلى فترات متباعدة، يؤلف بينها رابط ما، اعتمادا عليه ارتأى الشاعر أن تكون دون سواها ديوانا شعريا.
وهكذا، فإن النظر إلى قصائد الديوان في شموليتها وتكاملها هو الذي يؤدي إلى القبض على الخصائص العامة للنص الشعري عند عبد السلام الزيتوني، الذي يشكل تجربة إبداعية خاصة.
ويبدو أن مفهوم التجربة يمكن أن يشكل نقطة ارتكاز تتجمع حولها كل نصوص الديوان. فمن المعروف أن هذا المفهوم يتحدد في علاقته بالشعر حين يصبح بعدا وجوديا يتخذ الذات منطلقا ومآلا في علاقتها بالوجود في مضمونه الفلسفي العام.
وبهذا المعنى يغدو الشعر متمردا على كل ما هو جمعي ومشترك، جانحا نحو التفرد والفردانية.
ولعل أقوى ملمح في ديوان «نسيت دمي عندهم» يفصح عن تجليات «التجربة» بالمعنى المشار إليه هو سيادة ضمير المتكلم على باقي الضمائر الأخرى. بدءا بالعنوان، مرورا بكل القصائد التي يضمها بين دفتيه.
يتخذ ضمير المتكلم في ديوان «نسيت دمي عندهم» ثلاث علاقات مترابطة:
1ـ علاقة مع الكتابة الشعرية التي تتحول إلى شكل من أشكال الصراع بين الأنا وبين القصيدة. وهي علاقة لا نعدم مثيلات لها عند شعراء آخرين، حين تستعصي عليهم القصيدة فلا يجدون إلى كتابتها سبيلا، فيصورون هذه الحالة الفارقة بين الرغبة والتمنع. ألم يكتب الشاعر أحمد المجاطي ذات يوم: « تسعفني الكأس ولا تسعفني العبارة».
ولكنها عند الزيتوني تكتسي طابعا آخر: القصيدة عنده مخاض عسير، يفضي إلى درب طويل قد يقود إلى مخرج وقد يقود إلى فراغ. يكتب تحت عنوان: «القصيدة» (ص 16).
عجنت المساء مساء
وشكلت دربا من دربه
أسافر ما شئت في بهوه
وأرحل في الكلمات
أراهن مقبرة من جليد
واستل من مئزر الريح ما سال من عنكبوت
قلوع ممزقة والمدى راعف الأفق
يزهو في عمق الريح منكسر النغمات
وعدت أراود دابرة الطرف
أستنطق الكلمات
الشاعر هنا ينازع الكتابة من أجل أن تستجيب إلى استيعاب عالمه، وهو عالم غير العالم الذي نراه بأعيننا ونحسه بأيدينا. إن الشعر في المقطع السابق إعادة تشكيل لما تدركه الحواس وهو ما تعبر عنه كلمة «عجنت»، وهذا ما ولد إحساسا بالتعاسة لدى الشاعر في الوصول إلى مبتغاه، فظل يتحايل على القصيدة من أجل القبض على ناصيتها فيفشل، ولكنه لا ييأس، فيكرر المحاولة بعد أن يمزق ما خطته يمينه:
ألملم ما انفك من شعث الحرف في بحرها
وأقفو صغار النوارس تلعق أفقا
وتأكل من بعضها
لعلي أضرم نار الضغينة
بصدر التي شحت في صدرها
فما طاوعتني اللعينة
وكانت عنيدة
كذلك ماتت على شفتي القصيدة
2ـ علاقة مع الواقع، وهي علاقة متوترة تكاد تصل بالشاعر إلى حافة اليأس. هذه العلاقة الموسومة بالصراع تكمن في أن الواقع يصر على معاكسة رؤية الشاعر الذي ينشد عالما آخر تسوده المحبة والوئام وقيم الحرية والعدل والمساواة: («في بلاد العنكبوت» ص 40)
في بلاد العنكبوت
يكبر الظل مسافات ويخبو في تجاويف الظلم
تبلغ القامة أعشارا لدى باعتها عند المساء
ويصير الجسد الدافئ في طاحونة العرف بخورا وعدم
في بلاد العنكبوت يفرخ الجن جيوشا لا ترى
ويسوي دولة في رحم الأنس بأحضان البيوت
إن علاقة التوتر التي تربط الشعر بالواقع في هذه القصيدة/النموذج تكمن في الفجوة بين الواقع والحلم، بين الكائن والممكن. ولا شك أن الشاعر في المقطع السابق يرسم صورة لما كان يعرف في الستينيات والسبعينيات بسنوات الرصاص التي كان فيها الصراع على أشده من أجل الحرية والعدالة والاجتماعية.
وقد توسل الشاعر من أجل توضيح ملامح تلك الصورة بلغة إشارية تحتمل قراءات متعددة بغية الإفلات من عين الرقيب التي لا تنام، ولكن قليلا من التأمل يفيد بأنه يشير إلى جيش من البوليس السري الذي كان يجتاح فضاءات تلك المرحلة.
3ـ علاقة مع الوطن يمكن اعتبارها امتدادا للعلاقة بالواقع. ويطغى على هذا النوع من العلاقة الإحساس القومي الذي يعلي من الارتباط بالأرض إلى حد السمو. إن هذه العلاقة تقوم على التوتر كما هو الشأن في العلاقتين السابقتين، ولكنه توتر العاشق وليس توتر المستنكر الغاضب.
إن هذه العلاقة تطغى على العلاقات الأخرى في الديوان، ولذلك فإن القصائد التي تعبر عنها كثيرة مثلما نجده في «رسالة إلى فدوى طوقان» (ص 22) و»لست أول من يعبر الدرب أو آخره» (ص 26)، و»نسيت دمي عندهم» (ص 31) التي كرسها لمحنة العراق والتي نجتزئ منها هذا المقطع:
جاء من هضبات الصهيل
قواربه من شفق
والمجادف من انبعاث
هيئي الطقس واستنطقي الدار يا رعشة الأغنيات
وعانقي هذا المهاجر في النبض ملء الذراعين
عانقي أرض العراق
نسيت دمي عندهم حين مروا كراما
وحين تسابقوا. لا فرق بين احتراق واحتراق
ينبغي لإضاءة هذه العلاقات أن نربطها بالتجربة الشعرية التي تخرج بها عن نطاق ما هو «طبيعي» إلى ما هو شعري. ولا يمكن وضع اليد على دور «التجربة» في تحديد تلك العلاقات إلا عن طريق استدعاء الثنائيات التي تشكل نقط تجاذب تحكم طبيعة الكتابة الشعرية عند عبد السلام الزيتوني. ومن أبرز تلك الثنائيات:
أ ـ ثنائية الرؤية والرؤيا: الرؤية تحيل على الواقع، ويمكن أن نمثل لتموضعها في الديوان بذكر شخصيات وأمكنة معروفة، ولكن لها رمزية كبيرة في الذاكرة العربية، مثل «فدوى طوقان» و»أبو جهاد» و»أطفال الحجارة» و»بغداد».
أما الرؤيا فتشير إلى كل ما يرتفع عن الواقع، كالحلم والأسطورة والدين والسحر وغيرها. وفي الديوان إشارات صريحة أو ضمنية إلى هذه الحقول المعجمية كلها.
إن بين الرؤية والرؤيا كما وظفهما ديوان «نسيت دمي عندهم» علاقة إضاءة متبادلة، إذ لا تستعمل الواحدة منهما في انفصال عن الثانية. وهذا ما يجعل الواقع وقد تحول غلى قصيدة في برزخ بين الحلم والواقع، بين الوعي واللاوعي.
إن هذه الثنائية الجوهرية التي تبرز في شعر عبد السلام الزيتوني بشكل لافت للنظر، تفصح عن نفسها من خلال ثنائيات أخرى يمكن أن تساعد على بلورة مفهوم الكتابة الشعرية لديه:
ـ الشعر والنثر: على الرغم من أن الشاعر لم يكتب قصيدة النثر، وعلى الرغم من أنه يحرص على التدقيق في وزن القصيدة وفق البحور الخليلية المعروفة، إلى الحد الذي جعله يخصص هامشا لإشارة عروضية حين سجل في أحد الهوامش أن قصيدة «نسيت دمي عندهم» تجمع بين الخبب والمتقارب (ص 33)، إلا أنه يحرص في نفس الوقت على استغلال الإمكانات التي يسمح بها عروض القصيدة العربية الحديثة الموزونة لجعل عناصر الشعر متكاملة ومنسجمة.
وقد تجلى هذا في إعادة النظر في مفهوم البيت الشعري وفي استعمال علامات الترقيم التي حلت محل الوقفة العروضية في القصيدة العمودية. وأدى هذا إلى أن الوزن في الديوان لم يعد عنصرا معزولا أو مكملا، وإنما أصبح مكونا بنيويا يؤثر في المكونات الأخرى ويتأثر بها.
وإذا كان من السهل تحديد معالم البيت الشعري في الديوان بوصفه وحدة أساسية في بعض القصائد التي يغلب عليها الطابع الغنائي خاصة، فإنه من الصعب تحديد ملامحه دون ربطه بما سبقه وبما لحقه في أغلب قصائد الديوان.
البيت الشعري في قصائد الديوان ليس وحدة أساسية مستقلة بنفسها وإنما هو جزء من وحدة أكبر هي ما سماه كمال خير بك «الكتلة الشعرية» التي تعتبر بديلا من حيث الدور والفاعلية عن البيت في القصيدة القديمة.
ب ـ اليومي والشعري: يتخذ اليومي في ديوان «نسيت دمي عندهم» خاصيتين بارزتين، تتمثل الأولى في القاموس السهل الذي يطغى على غيره، وتتجلى الثانية في التركيز على الصورة/المشهد التي تلتقطها عين الشاعر فتعيد بناءها بشكل يجعل المألوف عجيبا واليومي خارقا.
وسرعان ما ينسج هذا اليومي شعريته انطلاقا من الجملة ثم المقطع، ليمتد إلى القصيدة كلها. إذ أن علاقة التجاور والتنافر التي تحكم مكونات اللغة الشعرية في شعر الزيتوني ترقى باليومي ليصبح شعريا عبر علاقات معقدة نسميها صورا. ولهذا السبب يطغى الغموض الدلالي على قصائد الديوان بطريقة لا تجعل القارئ مجرد متلق فحسب، بل عليه أن يقيم علاقة تفاعل حقيقية بينه وبين النص، كي يخرج في نهاية الأمر بقراءة تتسم بنسبية كبيرة وتفتح المجال واسعا أمام قراءات أخرى.
وإذا كان تكثيف اللغة خاصية عامة في الشعر الحديث، فإنه في الديوان يقوم بدور بناء الرؤيا في القصيدة التي تتخذ شكل معمار استعاري، كما هو الشأن في قصيدة «متاهة» (ص 21):
للمتاهة أسلمت رحلي في لحظة واهمة
كانت العين قاصرة
والمسافة مغرية
والتكايا دعاء
والكواعب خط الوصول
ليس بيني وبين الأصول
سوى همهمات وترتيلة وانحناء
بعدها استبيح انحنائي حتى عقفت
وحين صدئت
وداهمني البرص في الردهات
يا شموس السماوات
ويا نفحة الملكوت
وما لمعقوف ظهر سوى أن يموت
لكي تقوم الصورة بهذا المنجز، فإنها تتوسل بمجموعة من الإحالات المرجعية عبر استحضار نصوص موازية. نقرأ من قصيدة «قوافل عينين» (ص 19)
ورأينا الذي لا يرى
كيف باع الخليل عمامته
كيف فاضت أصابعها كربلاء
كيف هشمت الريح كل المجرات، أقفرت السبع
إلا هشيما تعملق في أعين الأغبياء
إن هذه الطريقة في الاعتماد على تكثيف اللغة هي التي تتحكم في طول القصيدة أو قصرها. ولذلك نجد في الديوان تفاوتا بين القصائد من حيث الطول والقصر.
وإذا كان الشاعر يميل إلى القصائد القصار ليحكم البناء العضوي للنصوص، فإنه في القصائد الطوال يلجأ إلى تمييز مقاطعها الكبرى بوضع علامات فارقة بين مقطع وآخر، أو بترقيمها، أو منحها عناوين، أو ترك فراغات بينها. وتلك طريقة أصبحت شائعة في الشعر الحديث، ترمي إلى ترسيم نوع من الميثاق بين الشاعر والقارئ. وقد يفهم من هذا أن الشاعر يرمي إلى تسهيل مأمورية القارئ، ولكنها في «نسيت دمي عندهم» تشير إلى تعدد الفضاءات داخل القصيدة الواحدة، كما في قصيدة «رسالة إلى فدوى طوقان» وفي غيرها من القصائد.
* كاتب مغربي·