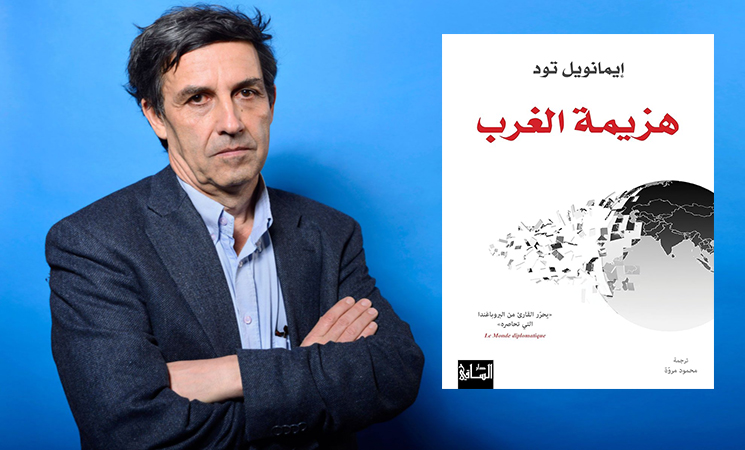تعززت المكتبة الوطنية أواخر السنة الماضية بكتاب مهم يحمل عنوان « على عتبة التسعين، حوار مع الذات « للشيخ عبد الرحمن الملحوني.و فيه يغوص الكاتب الذي عُرف بغزارة عطائه خدمة لتوثيق الذاكرة الشعبية بمراكش و لأدب الملحون، في ما أثمرته ستون سنة من البحث و التنقيب فيما تختزنه الصدور من رصيد شفهي، و في ما توارى من مكنونات المخطوطات و الكنانش والتقييدات، التي لولا انتباهه السابق لزمانه، لكان مصيرها إلى الإتلاف. ليضع أمام الوعي الجمعي المغربي رأسمالا استثنائيا من الدرس و التدقيق في مكونات الثقافة الشعبية المغربية عامة، و الثقافة المراكشية خاصة. في هذه السلسلة نستعيد مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني جوانب مما تضمنه هذا العمل، في جولة ساحرة تجمع بين ذاكرة الطفولة و تراكم العادات، و تقاطع الخطاب و فنون العيش في الحومات، إضافة إلى تطور سيرته العلمية في الزمان و المكان في احتكاك مع هواجسه المعرفية التي حركت أعماله.
سؤال: في الحلقة السابقة، تحدثنا عن تأثير روح مراكش ونضارة خضرتها في إذكاء القريحة الشعرية لوالدكم، و كذا تأثير السياق التاريخي المطبوع بأطماع الحماية الفرنسية..
الشيخ عبد الرحمن الملحوني: ينبغي أن أشير إلى أنه في سياق الحديث عن ميلاد الحاج محمد بن عمر الملحوني قدم الأستاذ محمد بوعابد كشفا لأهمية مدينة مراكش، مسقط رأس الشاعر، كما قدَّم – أيضا – نبذة موجزة عن أهمية هذه المدينة التاريخية، والاستراتيجية، ومرجعيات ممن افتتنوا بجمالها، وطقسها، وتعشقوا حضارتها، وأصالتها. وعن طريق ذلك، مكَّن القارئ من الوقوف على مكونات الهوية الحضارية، والثقافية، والتاريخية لمدينة يوسف بن تاشفين.
ففي هاته الفترة بالذات، أبرز الأستاذ محمد بوعابد عِشق الأدباء، والشعراء، والفنانين، والمؤرخين – ولو في عجالة سريعة، وجولة عابرة – وفي هذا السياق – أيضا – أثبت ما قاله – عن مراكش – الأديب أحمد زياد:
«.. وإن مراكش لمن كبريات مدن المغرب، التي لها من فخامة المجد، ما يجعلها في مقدمته، وأنها حقا لمدينة بالمعنى الذي يُطلقه علماء العمران على المُدن التي تتكامل فيها جميع أنواع الرَّفاهية وملذات العيش، وأسبابه. ولمناخها محاسن، ومزايا لا تـُوجد في مناخ غيرها، كما أن وُجودها بين شمال المغرب، وأقصى جنوبه، يجعلها ذات أهمية من حيث الاقتصاد والحرب» انتهى قوله .
ينبغي هنا أن نلفت الانتباه إلى أنه إلى غاية وقت قريب، اكتفى الناس بالحديث عن مرَّاكش، بما ورد في كتب التاريخ، قديمها وحديثها، وكان الوقوف على ما ترويه «الذاكرة الشعبية» وما يزخر به «ديوان الملحون» غير وارد في كتب المؤرخين. وهذا اللون يعد اليوم كشفا آخر في مجال الحديث عن مراكش، وعن أدوارها التاريخية، والحضارية، والثقافية، يؤهل مؤرخ العصر ليكتب تاريخا من نوع آخر، يستمد أصوله ومنابعه من القاعدة، لا من مرويات التاريخ الرسمي. فلهاته الشَّهادات قيمتها، ومكانتها، مادام القصد، هو التـَّعرف على كل مرحلة من مراحل تاريخ هذه المدينة في رَغْوِه وصريحه، وفي هزله وجده. ومع تقدم البحث التاريخي، اصطلح على تسميته بالوثائق، وأصبحت قيمة البحث لا بمقدار ما يحققه المؤرخ بواسطة المعارف الرَّسمية فحسب، بل بمقدار ما اعتمد عليه من وثائق من هنا، وهناك، وعلى مدى الجهد العلمي المبذول في جمعها، أو الإطلاع عليها وتحقيقها، وكيفية استنطاقها وتوظيفها. وفي هذا تدخل أهمية قصيدة الملحون، وخصوصا تلك القصائد التي توثق جانبا هامًا من الجوانب الاجتماعية والوطنية، شهادات تُعتبر اليوم ركنا من أركان التاريخ للوصول إلى معرفة الحقيقة التي هي هدف أسمى، وشعار من شعارات المؤرخ الملتزم برسالة التاريخ .
ولهذا أقبل المؤرخ على هذا اللون، وأخذ يستنطقه لعله يجعل من مضامين الثقافة الشعبية الأصيلة وثيقة تعتني بما ينشده المؤرخ من التقدم العلمي في البحوث التاريخية في المغرب المعاصر.
سؤال: تقصد أنه يمكن أن نقرأ التاريخ بالأدب الشفهي، بمعنى ما أن قصائد الملحون قد تكون في حد ذاتها كاشفة لمناطق ظل أغفلها التاريخ الرسمي؟
الشيخ عبد الرحمن الملحوني: إن المتأمل في الشعر الفصيح، قد يجد تطابقا ملحوظا في موضوعاته الأدبية من جهة، وبين الشعر الملحون من جهة أخرى، لأن الزجال المغربي، كان يستفيد من ثقافة رجل العِلم والأدب، وكان يجمع مادته الأدبية، والدينية، والثقافية، والتاريخية مما كان يروج في الأوساط الرَّسمية، ومما كانت تجود به مجالس أهل التصوف – أيام زمان- على تعدد مشارب أصحابها، واختلاف آرائهم، وثقافتهم. نعم، فهناك مؤهلات ثقافية، واجتماعية تجعل من الزَّجال المغربي شاعرا وأديبا موفقا، ينتج من الأدب، ما لا يحيد عن منهاج الأدب الرَّسمي في توجهاته وتطلعاته، وفي مراميه وأبعاده !. وبقدر ما يكون الباحث في تاريخ المغرب، مُلمًّا بالأدب المدرسي الفصيح، وبفن الملحون في جل أغراضه الأدبية، وما يقابل هذه الأغراض في الأدب الأمازيغي – أيضا – بقدر ما يتأتَّى له الوصول إلى دقائق الأحداث، وما يجعله – أيضا – يفصح – وفي طلاقة – عن بيان جذورها، ومكامنها الخفية والظاهرة إلى حين !.
وحين يصبح الباحث في الأدب المغربي، على علم من مضامين هذا الثالوث، يكون له السَّبق في كثير من الأمور الهامَّة، والأساسية التي يُعالجها معالجة خبير بما يلفها، وما يحيط بها من غموض.
سؤال: قد تكون هذه الازدواجية بين العامي و الفصيح في الأدب، غير ذات نجاعة من ناحية التدبر العلمي لاشتغال الآليات الثقافية لصنع الوجدان الإنساني.. ربما هذا ما تقصده .
الشيخ عبد الرحمن الملحوني: يعد شاعر الملحون، من الشخصيات الأدبية التي أثارت بين المهتمين بالثقافة الشعبية جدلا واسعا مما تثيره أدبيات شاعر الفصحى بيننا اليوم. وهذا الجدل لم يمنع دارسي الأدب الشعبي من أن يجمعوا على أن شاعر الملحون – بوجه خاص – هو أحد الذين صنعوا الكلمة الشاعرة في أدَب العامَّة، وجعلوا منها ريادات موفقة في كثير من الإنتاجات الشعرية التي حواها ديوان الملحون بين دفَّتيه بكل اعتزاز وفخر وإلى اليوم، بداية من عصر كل من المصمودي والمغراوي.
فالوقوف عند إنتاج هذا الشاعر، أو ذاك، وعند هاته الفترة أو تلك، هو وقوف في أناة عند محطة من أهم محطات النـَّقد، واستقراء ما تركه شعراء الملحون من أشعار، ونفائس، ظلت وستظل إرثا حضاريا، وفكريا، ومعالم بارزة من روائع ما جادت به العامَّة بانخراطها في هوية الأحداث التي عرفها المغرب على محور معيَّن، من محاور الزمن الحضاري، توضح مدى مساهمة ثلة من رجالات الملحون في الحفاظ على مخزون الذاكرة الوطنية في كل ما كانت تجود به الأجيال المغربية على تعاقبها واستمرارها .
فقراءة القصيدة الزجلية – في إمعان وتدبر – تعلّم الباحث والدَّارس أن الذين أنجزوا ما أنجزوا، من روائع الشعر الفصيح، لم يتجاوزوا عتبة الإبداع الذي ساهم به شاعر الملحون، مساهمة تشهد له – وفي كل محطة من محطات ازدهار الزَّجل ببلادنا – بالذوق الرَّفيع، السليم، كما تشهد له – وبحق – على معانقة شاعر الملحون للجماعة الشعبية العريضة في الأفراح، والأتراح، وفي السراء والضراء ! وأيضا بالاعتماد على المثال الذي يُقدمه ديوان الملحون، حيث يتبين للباحث ، أن بعض قصائده في الجانب الاجتماعي، والوطني يهتم بما عرفته أحداث ووقائع القرنين : 19م و 20 ! وما قبلهما بكثير.