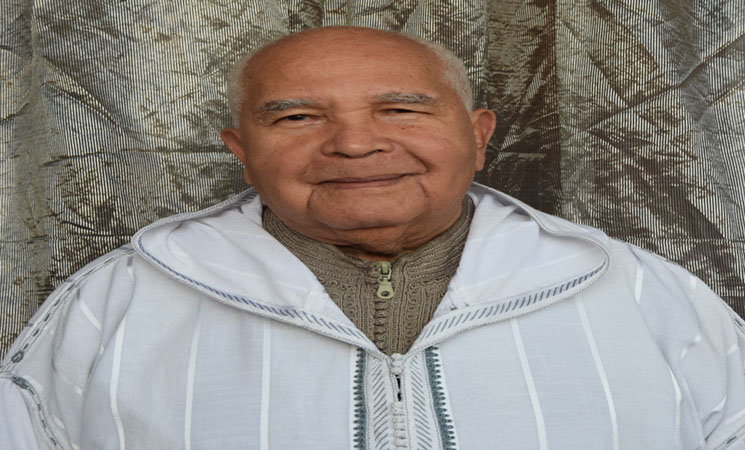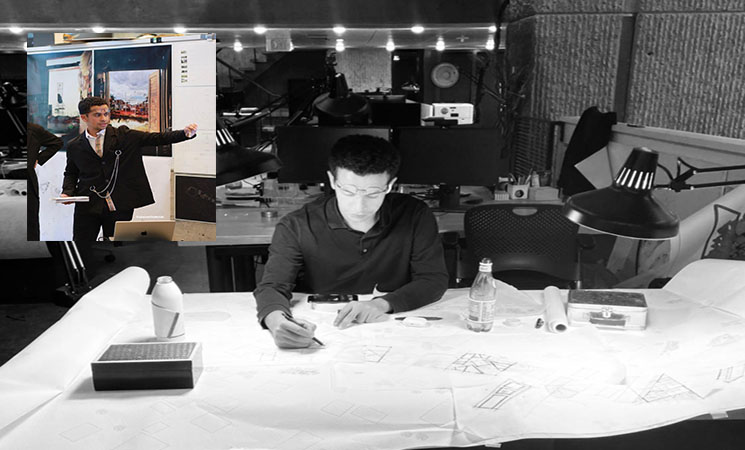الملحون مقاوما سردية المستعمر
تعززت المكتبة الوطنية أواخر السنة الماضية بكتاب مهم يحمل عنوان « على عتبة التسعين، حوار مع الذات « للشيخ عبد الرحمن الملحوني.و فيه يغوص الكاتب الذي عُرف بغزارة عطائه خدمة لتوثيق الذاكرة الشعبية بمراكش و لأدب الملحون، في ما أثمرته ستون سنة من البحث و التنقيب فيما تختزنه الصدور من رصيد شفهي، و في ما توارى من مكنونات المخطوطات و الكنانش والتقييدات، التي لولا انتباهه السابق لزمانه، لكان مصيرها إلى الإتلاف. ليضع أمام الوعي الجمعي المغربي رأسمالا استثنائيا من الدرس و التدقيق في مكونات الثقافة الشعبية المغربية عامة، و الثقافة المراكشية خاصة. في هذه السلسلة نستعيد مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني جوانب مما تضمنه هذا العمل، في جولة ساحرة تجمع بين ذاكرة الطفولة و تراكم العادات، و تقاطع الخطاب و فنون العيش في الحومات، إضافة إلى تطور سيرته العلمية في الزمان و المكان في احتكاك مع هواجسه المعرفية التي حركت أعماله.
n كيف استلهم والدكم الشاعر محمد بن عمر الملحوني رحمه الله، روح مراكش ووقائع الحياة فيها في سياق تاريخي معلوم، تحدده تصرفات سلطات الحماية الفرنسية؟
p لعل المتأمل في ديوان الحاج محمد بن عمر الملحوني – رحمه الله – وبخاصة في القصائد ذات الجانب الاجتماعي، والوطني، سيلاحظ- لا محالة – أن هناك إيماءات – ولو عابرة – إلى أهمية مدينة مراكش في ذهن الشاعر ووجدانه .
إنها إشارات إلى ما قام به المستعمر الغاشم من تحريف، وبتر لأصول وثوابت المدينة، ولعوائدها وأعرافها الأصيلة التي استمرت، باستمرار الأجيال المغربية على تعاقبها إلى حين . فالباحث في تاريخ مراكش – على عهد الشاعر – يرى – من خلال ما قدمه من أشعار – أن المستعمر في هاته الفترة العصيبة، قد أخذ يقتطع – دون استحياء – من تاريخ المدينة أحداثا معينة ويعزلها – كبطلة ورائدة – بتعاون مع أحد العملاء مثل الكلاوي وأعوانه .
وهنا ينبغي أن نورد ملاحظة ذات طابع منهجي، فإذا كان التركيز على قصائد الملحون ذات الجانب الاجتماعي والوطني يُفسر بما قد سبقت الإشارة إليه، فإن ذلك – من جهة أخرى – يطرح للمؤرخ مشكلتين منهجيتين :
– أولاهما : إلى أي حد تكون المعرفة قطعية بالنسبة لما يقدمه شاعر الملحون، وما يحكيه ويستمده من محيطه الاجتماعي، والثقافي. إنها إشكاليات ترتبط جذورها بشكل يقيني لكل المعلومات والمعارف، ما يُقابل منها بالتاريخ الرَّسمي، وما يقدم بشكل عرضي !.
وثانيتهما : إلى أي حد يمكن المجازفة بالبحث في تاريخ الفترات التاريخية عن طريق ما تحتفظ به من وثائق شفهية ، يحولها شاعر الملحون إلى مكتوب مُتداول ، وما دام هذا المكتوب مصدره شفاهيا، الأحداث، والوقائع يجب أن تقابل بالمكتوب المؤرخ .الدراسة المنوغرافية المحدودة زمانا، ومكانا، تحقق – دون شك – سبيلا من سبل معرفة الواقع، غير أن فهم هذا الواقع واكتشاف محركاته – كما يقول المؤرخون – لا يتأتى إلا بتتبع أصول وجذور قواعدها، للتعرف على كيفيات تطور أصولها إلى ما صارت إليه، وما دامت هذه الظاهرة تعيش بين الشَّك واليقين، فعلى المؤرخ أن يسلك منهاج الاستقراء في استنطاق الوثائق المعتمد عليها، سواء كانت شعرا عاميا، أو من الفصيح، أو ما يدخل في المرددات الشفاهية، أو فيما جاء مكتوبا غير سليم في مصادره ومراجعه، ليعطي تداوله دليلا قاطعا على حاجة المؤرخ إليه.
ولعل إنجاز سيرة ذاتية للشاعر محمد بن عمر الملحوني، – رحمه الله – من خلال ما كان يُروَى من مرويات أصدقائه ومُريديه، استنتاجا لما قد تجود به بعض قصائده وسراربه وعروبياته في هذا المجال أو ذاك، وبهاته المناسبة أو تلك، لشيء مهم في غاية الأهمية من أجل تقريب شخصية الشاعر من القارئ بل في سبيل تسهيل مأمورية الباحث والدارس، وهو يتجوَّل في رحاب ديوانه، دون أن ننسى – أيضا – أهمية التحقيقات التاريخية والميدانية التي تقدمها هاته المحطة التاريخية، من محطات عمر شاعرنا، في مختلف مراحل حياته : مرحلة، مرحلة، بل إن أحداث المقاومة، ليست أحداثا تاريخية، بل هي ظواهر اجتماعية فاعلة، ومعالم أدبية صادقة، تتقاطعها اختصاصات هذا الشاعر، أو ذاك ، لاختبارات مدى جدوى هذه الأدبيات في تنشيط وجدان العامة، وتحميس كافة الملتفين بالشاعر، وأيضا لإظهار نتائج التفاعل الأدبي، والوقوف على أبعاده ومراميه . وهذا يحتم على الباحث في «ديوان الملحون» ربط أدبيات المقاومة بالتحقيقات التاريخية، وبالدوريات الشفاهية الميدانية، التي تؤخذ عن هذه الجماعة أو تلك، وعن هذا الحقل الأدبي، أو ذاك ! نعم ، فظاهرة تحقيق النص الشعبي، لا تدرك تمام الإدراك، إلا بجهد جهيد من قبل الخزَّانة.
وإذا كانت فئة الخزَّانة في حظيرة أهل الملحون : تُدرك تمام الإدراك، تعقيد ظاهرة تحقيق سلامة النص الشعبي المتداول ، وتعدد نسخه عند هذه الجماعة أو تلك، وعند هذا الفريق من حفاظ الملحون، أو ذاك، فإن ما يخالجنا من إحساس بالتقصير في هذا المجال يجعلنا لم نهتم – مضطرين – إلا بالنسخ التي قوبلت بما في حوزة «شيخ الأشياخ»، مثلا أو ممَّا راج في مجالس تلاميذه وخاصة خاصته . وهذا قد يكون اقتناعا من بعض حفاظ الشعر الملحون ورواته، أو من الأسباب التي دعتنا إلى اقتناء كنانيش، وكراسات ، ودفاتر الملحون، دون تحفظ مما يوجد بين دفتيها، وحيث نقابله بما هو محفوظ بين جانحتي صدور الهُواة والمولعين بفن الملحون. وقد يكون التأكيد على هذه المراجع سمة من سمات الاعتراف بصحة محتوياتها، وسلامة مضامينها، ولا سيما حين يقابل النص المسجل، والمسموع في حظيرة أهل الملحون، بما هو موجود – طبق الأصل – بهذه المراجع !