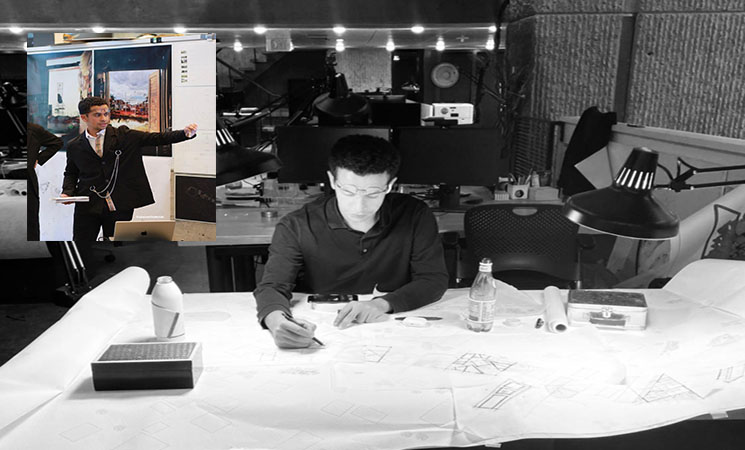تعززت المكتبة الوطنية أواخر السنة الماضية بكتاب مهم يحمل عنوان « على عتبة التسعين، حوار مع الذات « للشيخ عبد الرحمن الملحوني.و فيه يغوص الكاتب الذي عُرف بغزارة عطائه خدمة لتوثيق الذاكرة الشعبية بمراكش و لأدب الملحون، في ما أثمرته ستون سنة من البحث و التنقيب فيما تختزنه الصدور من رصيد شفهي، و في ما توارى من مكنونات المخطوطات و الكنانش والتقييدات، التي لولا انتباهه السابق لزمانه، لكان مصيرها إلى الإتلاف. ليضع أمام الوعي الجمعي المغربي رأسمالا استثنائيا من الدرس و التدقيق في مكونات الثقافة الشعبية المغربية عامة، و الثقافة المراكشية خاصة. في هذه السلسلة نستعيد مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني جوانب مما تضمنه هذا العمل، في جولة ساحرة تجمع بين ذاكرة الطفولة و تراكم العادات، و تقاطع الخطاب و فنون العيش في الحومات، إضافة إلى تطور سيرته العلمية في الزمان و المكان في احتكاك مع هواجسه المعرفية التي حركت أعماله.
p عندما نفكر فيما تفضلتم به عن تأثير روح مراكش في شعر والدكم الحاج محمد بن عمر الملحوني، تنتصب أمامنا بشكل مباشر ساحة جامع الفنا بمكوناتها الثقافية. كيف يمكن أن نرصد هذا التأثير؟
p الشيخ عبد الرحمن الملحوني: سنعود مرة أخرى إلى حفيده الأستاذ محمد بوعابد فهو يقول ما نصه :
مكان النشأة : مدينة مراكش، وبنفس الحي الذي كان به مسقط رأسه. ومراكش – منذاك – كانت عاصمة المغرب، مع فاس، وإذا كانت لفاس جامعتها الشهيرة (القرويون)، وجوامعها الكبرى، وعلماؤها الأفذاذ، فإن لمراكش – كذلك – جامعتها اليوسفية، وعلماءها الكبار الذين كانوا ينشرون العلم، والمعرفة تحت أروقتها، وعلى منابر المساجد، والجوامع المراكشية التي تعددت بتعدد الحومات، والأحياء الآهلة بساكنتها . ولقد توفر حي شاعرنا على مسجد كبير مع كتاب، وعلى أضرحة ومزارات. مما يوجد به، ومما يحيط بجنباته. وهو قد تلقى بذلكم الكتـَّاب التعليم الأولي كما ارتبط – أيضا – بتلك المزارات، والأضرحة من حيث تقديره لها، واعتباره إياها، بسبب انخراطه في إحداها !.
المعروف عن الشيخ محمد بن عمر الملحوني، أنه كان مُريدا للطائفة العيساوية، ممَّا جعله يكثر من مديح الهادي بن عيسى ، وله في ذلك “ذَكْراتْ”، كما أن اهتمامه بمزارات المدينة، وأضرحتها، خلق فيه نزوعا إلى التعلق بالأولياء، ومدحهم في كثير من قصائده وتوسُّلاته، وعلى رأسهم الرجال السبعة، ومن خلال اهتمامي – كباحث – بالطائفة العيساوية، فقد رصدت الكثير من إنتاجات الشاعر المترجم له، واعتمدت عليه اعتمادا في كل ما كان يرويه عن الطائفة العيساوية، وما احتفظت به ذاكرته من أخبار الشيخ، ومرويات الأتباع والمُريدين. هذا إلى جانب ما قد جمعته بنفسي من مصادر أخرى في كل من فاس، ومكناس، وسلا، والرباط، وتارودانت، والصويرة، وآسفي، وغيرها من المدن التقليدية التي كانت بالأمس القريب تهتم بتراث العيساويين، وبعوائدهم، وتقاليدهم وما سلسلة “ذاكرتنا، حضارتنا” إلا مرآة تعكس هذه الدراسات، وتُعرف بهذا الجانب من ثقافتنا الصُّوفية.
p لكن هناك، أيضا جذبة المكان، إذ لا يمكن أن ننسى أن ساحة جامع الفنا، كانت قريبة من الحي الذي نشأ فيه، و هي ليست فقط مكان خام، بل تشكيلة خطابية، من الصعب الإفلات من عدوى تأثيرها..
p الشيخ عبد الرحمن الملحوني: فضاء ساحة جامع الفناء، ذلكم الفناء الشاسع، الذي يشكل نقطة التقاء، وافتراق في نفس الوقت. فهي نقطة تواصل، لجملة علاقات اقتصادية، ذكر منها الأستاذ بوعابد بعض الأمكنة التي كانت تمثل الدَّور الرئيسي والأساسي في إثبات هذه الساحة الاقتصادية، والترفيهية والتثقيفية.
ويرى محمد بوعابد، في هذا السياق أن شاعرنا قد استفاد الكثير من هذه الساحة التي كانت – أيضا- نقطة تلاق بين ثقافتي البادية، والمدينة، وبين الثقافة العالمة، وثقافة الشرائح الاجتماعية الوسطى، والدُّنا، فالمتأمل في وضع هذه الساحة وفي تطورها التاريخي والاجتماعي، والفني، يتبين له – وفي يسر – أنها قد مثلت ميدان التقاء كل هذه الثقافات، وتصارعها، وتجاذبها الحوار الدائم، في سبيل تحقيق الوَحدة الثقافية الأصيلة لمدينة مراكش، ولباقي المُدن المغربية الأخرى.
ففي هذه المعلمة الكبرى من معالم مراكش، كان يتم الصهر بين نمطين من الثقافة، واللغة والسلوك، بل أنماط تتعدد وتختلف باختلاف شرائح القائمين بشؤونها وقضاياها إلى حين. بل إن الساحة كانت تؤدي وظيفة تلاقي أخطار التطور اللامتكافئ – كما يقول محمد بوعابد – بين منطقة تعيش من محاصيل البادية، وبين مناطق، هي مصدر معيشة المدينة، هذا بالإضافة إلى ما كان يُدره قِطاع الصناعة التقليدية من نشاط اقتصادي حين يصحُو ، ويزدهر .
p الساحة بمعنى ما، كانت تقوم بدور توحيد الثقافة الوطنية من خلال هذا التجاور الذي كانت تتيحه لأنماط مختلفة من الخطابات ذات المنشأ المديني أو البدوي..
p الشيخ عبد الرحمن الملحوني: يرى الأستاذ محمَّد بوعابد، أنَّ السَّاحة قد جاءت للتخفيف من حدَّة أوضاع المدينة بداخل السُّور، أو لمحاولة رصد الواقع المفروض، الذي لم يسمح – أبدا – بتوحيد الثقافة الوطنية، هذه الوحدة التي تُحقق وحدة الكيان المجتمعي، الوطني.
ويرى في موقع آخر من أطروحته: أنَّ جامع الفناء، ليست لحظة واحدة في التـَّاريخ، فهي لحظات… ولذلك وظائفها قد تتغير بتغير المجتمع الذي تعبر عنه وتعبر له.