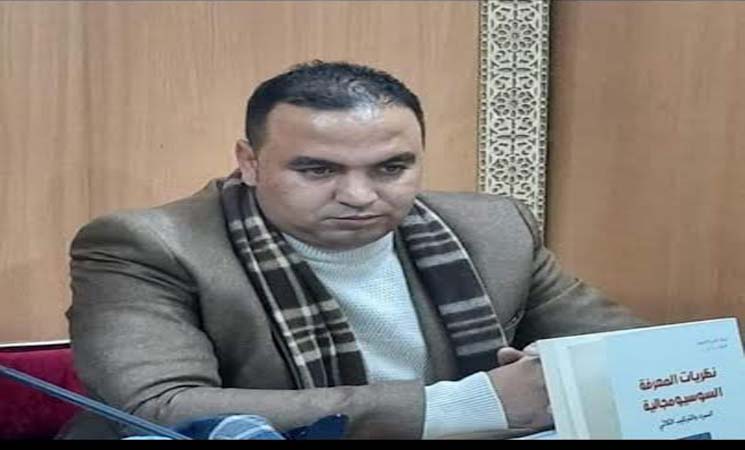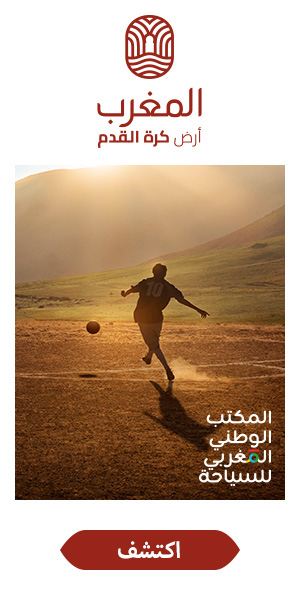لم يعد الآن مفهوم الثقافة مقبوضاً عليه في ترسيمات مُهيكلة. إنه هيكل نظري يُجبرنا أن ننظر إليه في وضعية الانفلات والتبدل الدائم التي تستوي في أشكال ومَسلكيات جديدة مُقوضة للأشكال القديمة. كُلُّ تشكيل للمفهوم أو إعادة تشكيل له تستدعي في المقام الأول توسيع منظورات الأفق التأويلي بما يستوعب كثافة التحولات الجارفة التي تحدث في سوق المعرفة وعالم السياسة حتى يتهيأ توطين مفاهيم الديمقراطية والحداثة والتقليد…
تقع الثقافة في هذا الزمن الشديد التعولم في مواجهة ضِدية مع عقيدة الربح والمال والافتراس، وتُسرِّعُ خدماتها نحو تشييد فلسفة جديدة قائمة على أنطولوجيات اللامعنى والفراغ. ففي محور طنجة طشقند يُعاد باستمرار طرح سؤال تموقع العرب ضمن جغرافيات القرية الكونية الواحدة.
وحينما نُصغر مقياس الملاحظة تساهم عولمة الثقافة في حياكة مقاسات لا تناسب جميع الثقافات، وتُثير تبعاً لذلك مفارقات صارخة يتردد صداها في ثقافات الهوامش والأرباض بارتدادات مثيرة للانتباه، ويعقب الأمر نقاشات وجدالات بين المثقفين حول أسئلة الهوية وتدبير مسافة الذات والآخر، وهي نقاشات غير منتهية، لا في الزمن، ولا في المكان…يتعلق الأمر، بثقافة تنسج رؤية مركزية عِرقية على الجميع، وتتدفق في مسارات خطية تحمل سيولة واحدة تسير بها نحو تكثيف رؤية مبتذلة حول لإنسان والوجود، وهي ذاتها الرؤية التي تنهض من فاعل مُهيمن يُسيِّر هامشاً يقع خارج مدارات التحول في وضعية اتفق على توصيفها ب «المجالات الهامشية أو في طور الاندماج».
حول مخاضات هذه القضية صاغ الاثنولوجي جان بيير فارنيه Jean-Pierre Warnier رؤية جديدة تمخضت عن ولادة كتاب بعنوان: «عولمة الثقافة» La mondialisation de la culture، والكتاب حينها كان قد صدر سنة 2008. ومن خلاله، تظهر الرغبة من وراء التشكيل المنهجي نحو القبض على مفهوم «التحول الكبير» بالمدلول الذي يُشيده المؤرخ البولوني كارل بولانيي، ولتعقب عتبات التحول في المسار التاريخي يُكثف فارنيه رؤيته لفكرة انفصال العوالم الثقافية بين ثقافة إثنومركزية وثقافات أصيلة تواجه خطر الانمحاق. في هذا السياق، تُشركنا الترجمة العربية للكتاب التي تكلف بها باقتدار فائق الباحث المغربي في الأدب والترجمة الأستاذ عبد الجليل الأزدي في التقاط القضايا الكبرى للكتاب.
كتاب «عولمة الثقافة» جاء مَحضوناً بسياق اقتصادي خنق الأنساق الرأسمالية سنة 2008م؛ وهو سياق أزمة الاقتصاد العالمي واحتباس مؤسساته المالية بفعل حالة الاطمئنان المخاتل على قدرة النظام الرأسمالي إدخال عالم القرية الكونية الواحدة في مرحلة الأحلام السعيدة ونهاية سرديات الحرب والعنف والألم…والواقع، لم تكن الأزمة حادثاً عارضاً في مجرى التحول، بله اهتزاز اً كبيراً لا تزال ارتداداته تُحرك جغرافيات الاقتصاد العالمي بدرجات متفاوتة. العالم الذي صرنا نملكه الآن مُؤثث بمشهديات ثنائية: رفاهية الأغنياء في بلدان الشمال، وبؤس الفقراء في بلدان الجنوب؛ أقلية ترفل في النعيم وتتقلب في خيراته، وأغلبية تعيد تدوير الفقر والهشاشة جيلاً عن جيل دون أن يكون لها حظ في تقاسم الثروة.
من بين القضايا المركزية التي تُهيكل متن الكتاب نجد قضية انفصال العوالم. عالم منفصل عن آخر، والقاسم المشترك بينهما تنازع الرغبة بين الهيمنة والمحو. لقد تعززت روح عولمة الثقافة بالاستفادة من اختراق السلع والخدمات للسياجات الوطنية. من حق البعض أن يقرأ في التحول روح هيمنة جديدة على العالم، ويقرن بين عولمة العالم وأمركة العالم، وفرض رؤية مركزية بسيولة واحدة على باقي الثقافات الأصلية. من هنا، يقترح الكتاب في صيغة الترجمة العربية من ضمن ما يقترح سفراً في جغرافيات وعوالم الثقافة، ويأمل في استعادة التعبيرات الثقافية الأصلية، وتمكين القارئ من تملك الأدوات المنهجية لفهم وضع الاضطراب والانزلاق الثقافي الخطير.
تنضح المدونات المعولمة في عالم اليوم بمتابعات نقدية حول انشغالات الهوية والعِرق والخصوصية والاختلاف…وما يصحب ذلك من نقاشات حول غياب التوافق في بناء الآليات المفهومية وتدبير الاستعمالات والتوظيفات. ثمة استشعار بانغلاق الأفق وانحباس المسار التاريخي وعدم قدرته على استيعاب كثافة التعبيرات الثقافية والإبداعية إلى المدى الذي يجعل العالم مهيكلاً في ثنائيات ضدية: مستفيدون ومحرومون في غياب مؤسسات وسيطة تجسر الفجوة بينهما وفق ما ينتهي إليه مترجم الكتاب.
لم تتوفق الثقافة في لجم نزوعات الاستهلاك النيوليبرالي ذات المنزع البيولوجي في الذات البشرية كما نجدها عند الفيلسوف كيصادا، لأن فعل الثقافة يتطلب إحداث نقلة بشرية من الطبيعة إلى الثقافة بالمنظور الذي يُلح على تقاسمه الأنثربولوجيون. ففي علاقة الصياد بالطريدة، بالاستعارة الجميلة التي يبنيها المفكر المغربي محمد عابد الجابري، تُجبر الذات الجريحة على أن تتحصن بذاتها، وتنكمش على ذاتها بشكل يُحيي ويبعث الأصوات المحلية لمواجهة عنف العولمة.
يبدو أن عولمة الثقافة أسهمت في تدفق سيولة في اتجاه خطي واحد، سقت الجميع، لكن إنتاجها لم يوزع بعدل. وبذلك، لم نصل بعد إلى إنتاج ما يمكن توصيفه ب»العولمة البستانية» التي تسقي الجميع بلا استثناء، وهي عولمة تُغدي الانقسامات الثقافية، وتُوسع يوماً بعد آخر من سديم الفجوات، وتنهض نحو صناعة عوالم التباعد الثقافي مع ما يُرافق ذلك من نظرات متشائمة حول مستقبل الثقافة في العالم.
سبق للمفكر الاقتصادي كارل ماركس أن حَذَّر من تعسف الرأسمال، لأنه سيفضي نحو تشييد عوالم «العنف المتدفق» بما يفجر سلسلة لا منتهية من الاحترابات البشرية، ويصعد ب»الوحشية المنظمة» التي نجدها عند مالشفيتش، ويُحرض على تعميق الانشطارات المذهبية والصراعات الطائفية والاختلافات العرقية…إنه عالم مغلف بتعددية العنف، عنف رمزي (بيير بورديو)، عنف تضليلي (لويس ألتوسير) عنف المخاطر المفترضة (صامويل هانتنغتن) عنف الفوضى الخلاقة (لويس برنارد) عنف نهاية التاريخ (فرنسيس فوكو ياما) وعنف البروباغاندات (دونالد رامسفيلد وآخرون)…لقد استحكمت هذه القوى في تحويل البشر إلى كائنات شهوانية تستهلك بلا حدود خدمة للشركات والمقاولات متعددة الجنسيات.
لم يعد للهامش صوت ولا صدى. أضحى صوتاً مستبعداً يحيل على رصيد الثقافات الأصلية التي تعاند التغيير. وصار يجد نفسه في وضعية حرج مقلق لتدبير مسافة التجاوز: كيف يستطيع أن يربح رهان تدبير الاختلاف وتحويل التجاوز إلى استيعاب؟ وكيف يستطيع أيضاً تحويل تعدديته إلى تنوع منسجم؟ والحق، فلا يمكن للثقافة أن تتدفق في اتجاه واحد، إذا لم يكن هناك عدل في توزيع الموارد. وهنا يأتي إلحاح المترجم في خاتمة الترجمة العربية على وجوب الاحتراس من «مثلنة الماضي» بما يعني ذلك من إضفاء الطابع المثالي على الماضي واعتباره ماضيًّا ذهبيا.
في المُجمل، يقف الكتاب عند قضية التحول الكبير الذي شيَّد عالماً مُنفصلا بين ثقافته واقتصاده، بسبب حدوث انزياح معيب في النظرة إلى اقتصاد السوق واقتصاد المعرفة. لقد تحوَّل الإنسان بمضمون هذه النظرة من كائن اجتماعي ببعدٍ تكافلي إلى فرد اقتصادي ببعدٍ تنافسي يُوجه المنتجات الثقافية نحو التسليع، ويُخضعها لتلبية رغبات مالكي وسائل الإنتاج والإكراه…الأمر في ماهيته يُكثف ضمن نسق عام يمتلك رغبة استراتيجية في تسليع الإنسان والأرض والمال، وفي تفكيك السَّدى الاجتماعي وتهديد التوازن الايكولوجي وشروط العدالة…وفي جانب آخر، ضمن نسق يستثمر في العاطفة والوجدان، ويُعيد تشكيل الوعي الجمعي عبر الخوارزميات والصور والطقوس الرمزية…
بالنهاية، كُلُّ توسع في منطق واختيارات السوق يُولد في الضفة الأخرى ردود فعل مضادة؛ وكلُّ هيمنة امبريالية للسوق على حساب باقي الأنساق الأخرى تخلق تشوهات وانهيارات وتشققات، ويُعجل بالتفكك السريع…ما يعني الآن أننا واقعون في خضم معركة حيوية بين بناء المعنى أو الاستسلام للتفاهة، وبناء المعنى يتطلب ترشيد الفعل الثقافي كفعل وسيط لتحرير الضمير البشرين غواية الدعاية.