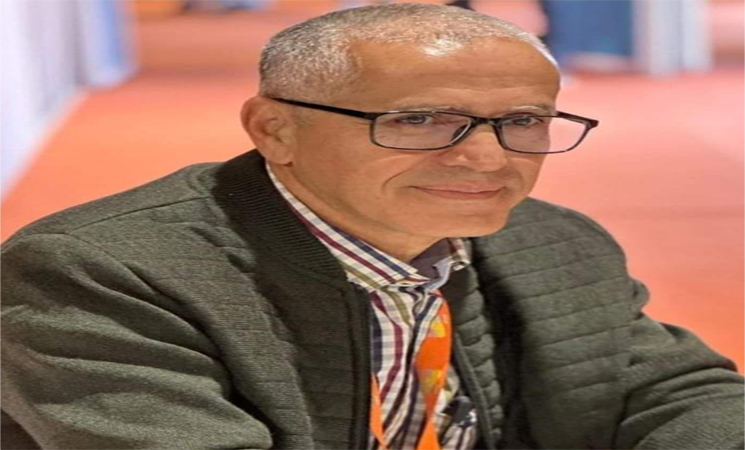كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الشعر، وما آل إليه من تقهقر وتراجع، بسب التحولات التي عرفتها المجتمعات، على مستويات عدة. فما عاد الشعر حديث الركبان، ولا مجالا للتفاخر بكونه ديوان العرب، وما غدا الشعراء، كما في السابق، يتبعهم الغاوون. وضعية تطرح أكثر من سؤال. لكن الشعر، بالرغم من القيل والقال، سيظل حيّا بيننا في الذاكرة وفي الوجدان.
لعل نظرة سريعة، في تاريخ الأدب العربي، تفيد أن الشعر كان منتشرا ومنتظِما في المجالس والمحافل، مطلوبا ومسموعا من العامة والخاصة. وأن الشعر لم يكن مجرد إلهامٍ تمثلَ في لفظ ومعنى أو في وزن ومبنى؛ وإنما تبدّى رؤيةً ورؤيا لا يعدَم ناظمهُ معرفة وحدسا. فلم يكن الشاعر شاعرا إلا باختلافه عن الآخرين بإحساسه الزائد والفائض عن المألوف. يرى ما لا يراه الآخرون وينفعل بما لم ينتبه إليه العابرون. وما القصائد التي تداولها الناس في أيامهم سوى تجلٍّ ملموس لما ارتبط بها من دهشة وإبهار، ظل معها تعريف الشعر مستعصيا بعيد المنال.
لقد تعددت تعريفات الشعر، منذ إرهاصاته الأولى، تبعا لطبيعة المرحلة الزمنية التي ظهر فيها وتبعا للخلفيات التي صدرت عن شعرائها وقتذاك؛ غير أن الأمر لم يُلغ وجود قواسمَ مشتركة بين تلك التعريفات والتحديدات، في ميْلها النقدي إلى اختيار اللفظ وابتكار الصور وتشكيل الإيقاع، بأنواعه المختلفة وبمفهوم الأوسع.
بهذا المعنى، ظل الشعر ولا يزال، مجالا تعبيريا يختزل الواقع والعالم في كلمات. فبقدر ما منحه الشعر من أفق للتأمل والتفكير، بقدر ما حرص هذا الشاعر أو ذاك، على وصف مكابداته ومعاناته ورصد تفاعلاته وانفعالاته مع الآخر ومحيطه الاجتماعي. فجاءت نصوصه محملة بالقيم الإنسانية والجمالية وظل محافظا على ديناميته الإبداعية، فترة بعد فترة وجيلا بعد جيل.
ولأن ما تبقى يؤسسه الشعراء، بتعبير هولْدَرْلين؛ فإن الشعر يعد نضالا في الحياة وبالحياة، ولحظة فارقة يستعيد خلالها الكائن الشعري ألقه وعنفوانه في مساراته الراهنة واليومية. ولا يتأتى ذلك للشاعر إلا بما توافر لديه من قدرة على التصوير ومهارة في التعبير، معجما وصورا وتركيبا وتخييلا وكل ما من شأنه أن يثير دهشة المتلقي. فلا جدوى من الشعر إن لم يكن كشفا واستجابة لنداء داخلي يستمد غموضه ومعناه من تفاعل صاحبه مع الواقع، إن بالاقتراب منه تارة، أو بالابتعاد عنه تارة أخرى.
ولنا في المشهد المغربي أسماء عديدة راهنت على القول الشعري وتركت نصوصُها انطباعا بقدرة القصيدة على البروز والحضور والاستمرار، كما جددت ذائقة المتلقي وحفزته على الانخراط الإيجابي مع تشكلاتها وتشاكلاتها الجديدة، من خلال التحولات التي وسمت بنياتها وإبدالاتها المتعددة.
فالقول بتراجع الشعر، فيه نظر، ولا يمكن التسليم به بجرة قلم، لأن واقع الحال يكذب ذلك، من خلال ما ينشر الآن، من أعمال شعرية تتباين من حيث الحجمُ والبناءُ، مثلما تتباين من حيث الموضوعاتُ والدلالة. من ثمة، ينبغي أن نفهم حاجتنا إلى الشعر، في ضوء هذه المتغيرات الجديدة التي طبعت المشهد الشعري الحديث. فالشاعر، في مخيّلته، دائمُ البحث عن أجوبة تمس قضايا المجتمع وقلق الوجود وسؤال الكينونة. وهو أيضا، في كتابته، ماضٍ في غير كلَلٍ أو ملَلٍ، يزرع في أرض الشعر بذور المعنى ويسقيها من هُويّته وأصالته ما يعتمل في نفسية الشاعر من أحاسيس متباينة ومشاعر متدفقة، إلى أن يزهر الكلام في حدائقه ويغرد الطير في سمائه.
إن الشاعر، بتعبير ميخائيل نعيمة، «شاعر ورسول وفيلسوف ورسام وموسيقي ورجل دين». تأخذ القصيدة معه أشكالا متفاوتة. لذلك، فإن من محاسن العصر الحديث والمعاصر، أن شعراءه لم يتوقفوا عن تجديد رؤاهم وتنويع مرجعياتهم، عبر ترسيخ انتمائهم لدائرة الخلق والإبداع. فقد نظروا إلى القصيدة بما يليق بها من طموح فني وإنساني بالغين، وبما فيها من مساحات كبرى للتعبير الحرّ والتواصل المتشعّب.
من ثمة، لا غرابة أن نلفي أنفسنا أمام كمٍّ نوعيّ من النصوص والأشعار تعكس انخراط الشاعر في بثِّ قيم الحرية والعدالة والحب والجمال، وتصور ما بدواخل النفس من هواجسَ وهموم ورغبات؛ دونما التفات للمناوئين أو الرافضين لمشروع التحديث، من مشارقة أو مغاربة. وهم أولئك الذين ينظرون إلى شعر اليوم بغير قليل من التبخيس والدونية، أو بعين السخط التي تبدي المساويا، بتعبير الإمام الشافعي ذات قصيدة.
ولأن الحاجة إلى الشعر ظلت قائمة ودائمة، كان لاقتراح الشعراء في مرحلة متقدمة، إضفاء تعديلات على القصيدة تمس الشكل والمضمون في آن، ما يبرر تلك الحاجة الملحة نحو التجديد والتجدُّد، دفعا للنمطية القاتلة ورفعا لتكريس الماضوية، في بعدها الثابت لا المتحرك. هي تجربة لم تحِدْ عن تمثيل الفرد والجماعة ولم تتخلّ في كتابتها عن إعلان انفتاحها على التجارب الشعرية الأخرى.
سُئل الشاعر محمود درويش ذات حوارٍ، وقد بلغ من الشهرة شأوا بعيدا، عن ماضيه الشعري فأجاب: «أنا لا أنظر إلى ماضيّ بالرضا ولو أتيح لي لحذفْتُ نصف أعمالي.» ولعل تأويلَ ذلك، أنّ قدر الشاعر أن يعيش التحوُّل والتبدُّل على الدّوامِ، وألا يستكين أبَدا للنموذج العليلِ أو الميّت. فثمةَ عيونٌ من شعر الأمسِ، البعيد منه والقريب، لا تزال حاضرة بين متون الشعراء إلى اليوم، وتكشف، بالمقروء والمسموع، عن مدى التواصل الإبداعي الحاصل بين الأجيال، تناصا نجيبا لا تلاصّا معيبا.
لقد تبنى الشاعر العربي، خلال مساره التاريخي، نماذج مختلفة في القول والكتابة، فمن تبنّيه للقصيدة العمودية ثم للقصيدة التفعيلية إلى انتصاره لقصيدة النثر والقصيدة البصرية ثم للشذرة أو لغيرها من المحاولات والمقترحات التي يمكن أن تأتي بعدها. ومن تعبيره عن صوت الجماعة إلى التعبير عن الذات.
بعبارة إنه الانتصار للإنسان والميْل للجمال، تصورا وممارسة يروم من خلالها الشاعر إلى المواجهة وإعادة طرح السؤال، في زمن غدت فيه الكلمة مهددة بالإهمال والصمت أو بالنسيان والموت.
نحن في الحاجة إلى الشعر، من حيث هو انتماء وهوية، وأيضا، من حيث هو صنعة ومتعة. شعر لا يغير صاحبُه جلدَه اعتباطا؛ وإنما تبعا لما يستلزمه مجرى التاريخ من تغيُّرٍ في نظرة الأشياء ومن رغبةٍ في ترميم الانكسارات المتعاقبة للذات الشاعرة وفي رفضٍ لانفلات القيم وفساد العالم.
إننا إذْ لا نسبحُ في النهر مرتين، فإن التجدُّد سمة القصيدة. تلك القصيدة التي تشارك الشاعر قلقه وسؤاله الوجودي. فيصيران معا، شاعرا وقصيدة، تجربة في الحياة وتجربة في الكتابة.
وإذا كان تمجيدُ الشعر قد استدعى اقتراحا باختيار الواحد والعشرين من شهر مارس من كل سنة مثلا، يوما عالميا للاحتفاء الرمزي بالكلمة؛ فإنّ ذلك لا يعني كونه احتفالا موسميا، بقدر ما هو احتفال بعمق الشعر في ارتباطه بالجمال من جهة، وبالإنسان في انشداد أفقه إلى المحتمل والإمكان، من جهة ثانية. هكذا، يحق لنا، في سياق الحاجة إلى الشعر، أن نعتبر قوتَه كامنةٌ في ما يوفره للشعراء من إمكانيات تأملية ولغوية وبلاغية للتعبير عما يقضّ مضاجعهم الإبداعية، وفي ما يثيره من قضايا تواصلهم أو لا تواصلهم، مع المتلقي المفترض.
يظل الشعر سؤالا فلسفيا ومطلبا إبداعيا، يتداخل فيه الذاتي والموضوعي ليبعث الوجود في الحياة الجديدة. يقول الشاعر التشيلي بابلو نيرودا:
يموت ببطء../ من لا يسافر/ من لا يقرأ/ من لا يسمع الموسيقى/ يموت ببطء..
من يصبح عبدا للعادة../ يعاود كل يوم نفس المسافات../ يموت ببطء../ من لا يغير المكان/ من لا يركب المخاطر/ لتحقيق أحلامه.
وسواء أكانت القصيدة تُقرأ في ديوان أم تُنشد في مجلس؛ فإن صداها يصل إلى الأذهان قبل الآذان. إنها مخْبرُ الشاعر ومنتهى رُؤاه. هي لفظ ومعنى، شكل وصورة، سكن وسكينة؛ بله إشارة وإثارة: وجهان لخطاب إبداعي واحد.
نعم، في الحاجة إلى الشعر، ما دام استحضارًا للمقروء والمرئي والمسموع. ما دام ورشا مفتوحا للكتابة في حركيّتها الدؤوب.
نعم، في الحاجة إلى الشعر مهما تصادفنا نصوص قد لا تعجب أو لا تطرب، نصوص لا تزال تبحث عن معنى المعنى، فالحق في الشعر مكفول والحكم للتاريخ موكول.
هكذا، حين يصير الشعر ضرورة وجودية، يحق للشاعر أن يمسك بتلابيب الزمن، من خلال تفاعله مع الآخر والمكان. ذلك التفاعل الذي يدفعه لارتياد آفاق رحبة وشاسعة، تتسع باتساع أفق الحياة نفسها.
دوما، في الحاجة إلى الشعر.