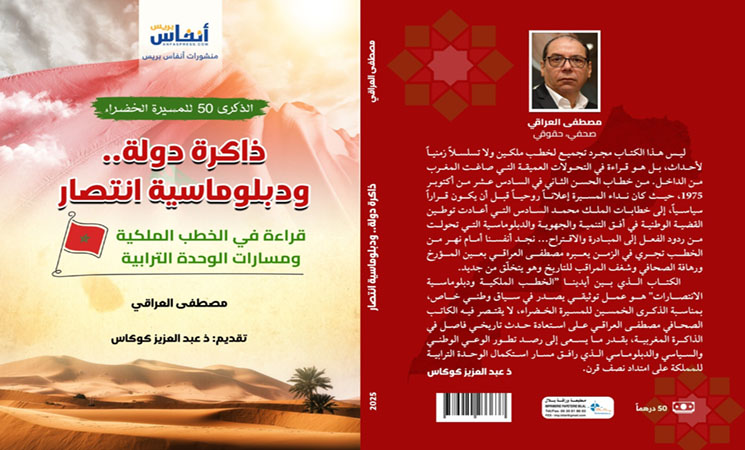في عز الغم، جاءني صوت المؤذن رخيماً من مئذنة جامع حيّنا القديم: إن الله يدعوك…
هذا طبعي.. وماذا أنا فاعل؟ لا أطرق باباً غير بابي، ليس جبناً، ولا احترامناً حتى… إنه الخجل. هكذا أنا، مذ ولدت، شديد الخجل ما لم أفقد الصواب مني، وأخرج عن نطاق الصبر.. أما النوافذ، لم تراودني الرغبة، يوماً، في الغناء تحتها. كانت مشرعة أو مفتوحة، لا أمل لي في الدخول منها كناية في الأبواب…
أنا في باب الله، ولو أن محراب الصلاة ينتصب أمامي كباب موصد، لكن أملي كبير في الذي ينتظرني خلفه… عش كريما يا أنا، وربك الأكرم..
لا أستثمر في مظهري الخارجي بإفراط، ولو أن الداعي لكم بالخير كان في «الهينون» يقول للأناقة ها أنذا !وكانت ممارستنا للرياضة تزيدنا حلة: قد مقدود ولياقة ورشاقة، يواتيها الطول الفارع والشعر الغزير… والبشرة التي لا تلفعها الشمس ولا تنال من نضارتها البرودة… اللهم حسّن أخلاقنا كما حسنت خلقنا.
كان سلوكي، ولله الحمد، حسناً ولايزال، إلا على من ينظرون إلينا ويمعنون في النظر إلى الفراغ في الأعلى..
وزادنا من العواطف كان أوفر، لذلك لا نلتمس من غيرنا سوى الحفاظ على (مسافات الود) التي تضيق مع مرور الأيام وكثرة نقط التقاطع في المجموعات العددية الطبيعية وغير الطبيعية، الصحيحة والمعتلة، المتناهية والمفتوحة…
لو رجع بي الزمن إلى الوراء، وأعدت العزل من جديد، سوف لن أكون سواي. لذلك، ولغيره، أقفلت الباب، خلفي، وسرت حيثما أسير..
عشقت الحكيم زفزاف لأنه لاذ بالهامش وعاش، طوعاً، في «بيوت واطئة» حتى تألق كثيراً في «محاولة عيش» ولم تخذله «الأفواه الواسعة» وروّض «الثعلب الذي يظهر ويختفي» كما ينبغي لنبيل يحب «بائعة الورد» حتى صار هو «الأقوى» تحت «الملاك الأبيض» وفوق «ملك الجن»، وكان نصيبه من «الشجرة المقدسة» ما يغنيه عن جر «العربة» في ركاب «غجر في الغابة»…
أنا، بعده، لا أجر عربة ولا أدفع شاريوها. انفلت من جاذبية نيوتن وقاومت دافعة أرخميدس. المستوى الديكارتي هو الذي يشتتني ويوزعني، كرهاً، قطعة قطعة ونقطة نقطة على شساعته الرهيبة. وكل ما أتمسك به هو هذا الشكل المغلق الذي أؤوب إليه كلما خذلني ارتفاع منتصب على طولٍ وعرضٍ منبطحين كما اتفق…
أحكمت إغلاق الباب بصفاقة، لكني تركت، عمداً، القوس مفتوحاً، ليس لإتمام الحديث، بالضرورة، ولكن فقط لأوضح، يوماً، لأحبابنا أن الفراشات لا تنتحر جزافاً إنما طريقها المشتهى إلى النور لا تحجبه ستارة…
نلتقي !