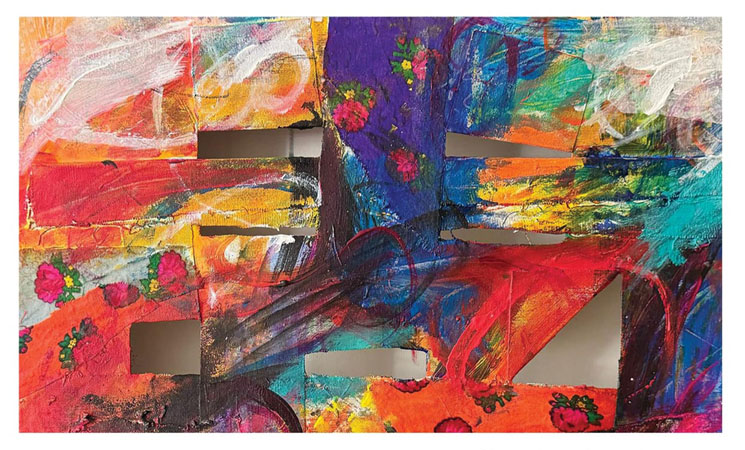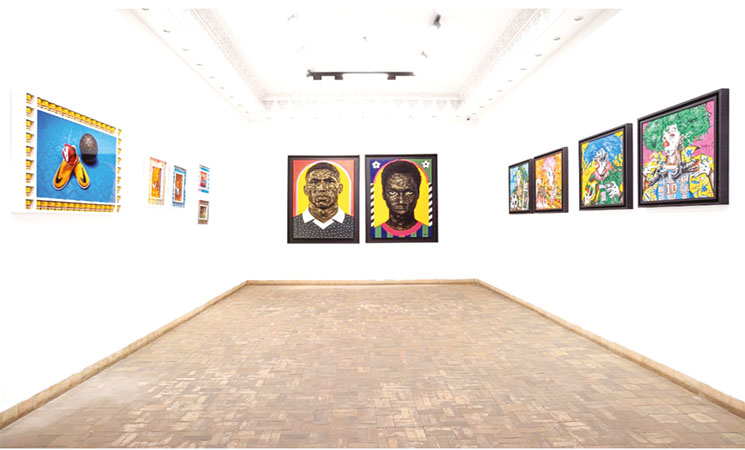في هذا المقال نسلط الضوء على أحد أكثر الأفلام التي أثارت الجدل عند عرضها، ولعله من الأفلام الأكثر شهرة في محاكاة وتحليل فئة معينة من العقليات التي نصفها بالمثقفة.
عرض الفيلم في العام 2004، وهو عمل درامي يحمل هوية إنتاجية لثلاث جنسيات، فرنسية وأمريكية وإيطالية، الفيلم من إخراج بيرناردو بيروتولوتشي صاحب الفيلم الشهير «التانجو الأخير في باريس»، وتأليف جلبير أدير. وعلى الرغم من علمي بقدم وشهرة هذا الفيلم، وبالأمر الذي جعله معروفًا لدى الكثيرين، فإنني أرى ضرورة التذكير به من جديد في سياق تشابه عقليات شخصيات الفيلم، بعقليات الكثير ممن يحيطون بنا اليوم. الأمر الذي يعكس مدى جمود هذه العقليات التي لا تزال نرى أنها مستمرة في ضخ ذات الأوهام واجترار ذات آليات التفكير.
تدور محاكاة الفيلم للذات المثقفة والمنتمية لطبقة معينة من المجتمع، والتي تتصف بالغنى إلى حد ما، تلك التي تتعامل مع النظرية والواقع بشكل منفصل، وليس كوحدة تتمم إحداهما الأخرى، حيث النظرية تبقى نظرية بدون تجربة عملية، أنه وهم ذات هؤلاء المثقفون المتأخرون عن ركب الشارع ومتطلباته وغضبه، ولأسباب متعلقة بالحس النخبوي العالي، الذي يجرك لتكون غارقًا بين الكتب والسينما والنقاشات السياسية والثقافية وما إلى ذلك من تفاصيل فضاء الثقافة والنخبة، والذي يحرض على فهم المسائل وتحليلها ونقدها، لكنه يُبقي الفرد عالقًا بين فلسفة النظرية والكتب، وبعيدًا كل البعد عن الشارع.
ومن هنا نبدأ بلمس أطروحة فيلم الحالمون The Dreamers، والتي تتمحور عن مثالية قابلة لتكون حالمة أكثر بكثير من كل ما يحتاجه الواقع من عمل.
من أبرز ما كُتب لوصف هذا الفيلم، كان بقلم الكاتب والناقد البريطاني بيتر براتشا في عام 2004، والذي كتب واصفًا: «مشاهدة هذا الفيلم، كأنك تشرب زجاجة من النبيذ على بطن فارغة من الطعام، فذلك ممتع بطريقة شريرة».
تدور أحداث الفيلم في زمن ربيع باريس، أو كما سُمي بـ»حركة ماي»، لقيامها في شهر ماي، فإنه لم يكن شهرًا عاديًا. كان العالم فيما بعد الحرب العالمية الثانية هادئًا تمامًا، ولكنه فجأة اشتعل بالحلم وكان الطلاب هم الشرارة التي حركت ذلك الحلم، فانطلقوا إلى الشارع معلنين نبوغ صوت جيل جديد يعلن رفضه لكل شيء: الاستبداد، القهر، الاستعباد، توحش رأس المال، النفاق الاجتماعي، والجمود العقائدي.
ومن مكسيكو سيتي وبيونس أيرس إلى براغ، مرورًا بباريس دفعت فكرة البحث عن الغد الأفضل الطلاب إلى الحلم الثوري. لكن حركة «ماي» الباريسية أعلنت أنه ليس لديها مصلحة في مسك زمام الدولة، حيث اعتُبرت ثورة ثقافية بتعابير سياسية، كما وصفها إغناسيو راموني أحد قادتها ومدير جريدة اللوموند.
في ربيع باريس، عام 1968، ذروة الحركة الطلابية، وانتشار الفكر الهبيي، في تلك الحقيبة عاش توأمان، الأول الشاب (ثيو) وهو الذي يقوم بدوره الممثل وصانع الأفلام الفرنسي (Louis Grrel)، والثانية (أزابيل) والتي تقوم بأداء دورها الممثلة والعارضة الفرنسية (Eva Green)، اللذان يملكان حياتهما الخاصة من نوعها والمثيرة للدهشة في بيتهما الكبير في باريس، وحيث يتعرفان على الطالب الأمريكي ماثيو والذي يقوم بدوره الممثل والموسيقي الأمريكي (Micheal pitt).
ماثيو يقيم في باريس لداعي الدراسة، ويتم التعارف فيما بينهم في كامبوس الجامعة قبل دقائق من بدء مظاهرة طلابية ضد الرقابة السينمائية، لكن بعد فترة من الزمن كانت كافية لملاحظة الفتاة إزابيل بأن الشاب الأمريكي ماثيو يتردد بكثرة على صالات السينما، حيت تكون مع أخيها، وهذا ما كان يثير فضولها للتعرف عليه.
ينتهي اليوم الأول من التعارف بعد مظاهرة كانت تبدو شرسة بين الطلاب ورجال الشرطة، ليعود الشاب الأمريكي ماثيو لكتابة رسالة إلى أمه، يقول فيها إن كل شيء أصبح جيدًا، وإنه متحمس جدًا لبدء صداقته الأولى اليوم في باريس، مع صديقين يشاركانه المقاعد الأولى في السينما.
ويضيف ماثيو قائلًا لأمه: أنه من يتلقى رسالة العرض والفحوى منه أولًا هم من يجلسون في مقدمة الصالة، ففي منظوره، أن من يجلس في المقاعد المتقدمة لصالات السينما تصله رسالة الفيلم أولًا، ويتشكل وعيه قبل الآخرين، وبالنسبة لرؤية ماثيو، تلك المكتوبة في الرسالة لأمه، فإن الصفوف الأمامية في صالات العرض، هي للبشر الذين يريدون أن يكونوا ذوي معرفة مميزة، مثله ومثل أصدقائه الجدد، وكأن ماثيو يفهم بُعد صالات السينما بطريقة طفولية لحد خيالي.
ومن سذاجة المثالية، وبعدها عن الواقع أو عن الشارع، يتحول المخزون السينمائي القابع في عقول هؤلاء الشباب الثلاثة المثاليين بكل بساطة إلى مسابقة، أو كما نسميها حزورة، هكذا كانت أوقات الشباب الثلاثة في الشقة الباريسية بعد أن انتقل (ماثيو) الطالب الأمريكي للعيش معهما، وذلك بعد سفر أهلهما، فمن يخسر المسابقة عليه فعل شيء مجنون يطلبه منه صاحب السؤال المطروح، ولعل أبرز الأسئلة التي كانت تُطرح في تلك المسابقة فيما بينهم، كانت أسئلة عن مقاطع محددة ودقيقة جدًا من بعض الأفلام السينمائية، ويتم المزج بين ما يجري في عقولهم بطريقة يسود فيها التماهي بين أفلام السينما والواقع إلى حد الهوس.
يدعونا الفيلم لنلاحظ العلاقة بين المثالية وارتباطها بمفهوم التحرر الاجتماعي المفرط، الذي كان يُصور التحرر بين الأخ والأخت بطريقة مبالغ بها، فغالبًا، وخلال المسابقات يتجلى جزاء الخاسر حول مطلب جنسي عليه أن يقوم به، ومن هنا تمرر صورة يحاول الفيلم طرحها عن مدى تحرر هؤلاء البشر أصحاب النظريات الثورية، الذين يحملون دلالة معبرة عن تراكم ثقافي كبير في عقولهم، ورغم ذلك التحرر الذين طالما مارسوه كسلوك مرتبط بجميع ممارسات حياتهم، إلا إنهم يبقون بعيدين عن الحراك الذي يدور في الشارع، ذلك الحراك الذي كان من أساسيات مطالبه هو التحرر من الممارسات الاجتماعية البالية والتقليدية في ذلك الوقت، وكانوا منغمسين في تحليل السينما والثورات، ومنهمكين في تصنيف الثورات بسلميتها وعنفها ومثاليتها، بينما كان الشارع يشتعل.
الفيلم يدعونا للنظر في مسائل مستمرة خلافاتنا حولها إلى يومنا هذا، حيث يطرح مفهومي العنف واللاعنف بطريقة تشعرنا بالإحباط، لشعورنا أن مؤيدي المدرستين، العنفية واللاعنفية بعيدون عن الواقع القاسي المتعلق بالصراعات اليومية، فالنقاش يدور بشكل حاد بين الشابين الفرنسي والأمريكي، الجالسين في حوض الاستحمام الراقي.
حيث عبر الشاب الأمريكي عن رأيه بقضية فيتنام والجنود الأميريكيين المشاركين في القتال هناك، فكان رأيه مستفرًا بالنسبة للشاب الفرنسي ثيو، الذي عمل منذ بداية الفيلم مطالبًا أبيه بأن يشارك في بيان إدانه للقوات الأمريكية التي تقتل الناس في فيتنام، لكن من وجهة نظر الشاب الأمريكي الرافض للعنف أو اللاعنف، فإن الجنود الأمريكيين في فيتنام مجبورون على أن يكونوا هناك من طرف الحكومة الأمريكية، ليس لأنهم دعاة للعنف، بل لأنهم أكثر من ذلك، ضحايا لتلك الحرب. وفي الوقت الذي كان الشاب الفرنسي رافضًا لهذا الرأي، وعبر عن أنه لو وضع نفسه مكان الجنود الأمريكيين، فإنه سيقرر الذهاب للسجن على أن يقتل المدنيين في فيتنام.
في محاكاة آخرى لوهم الغارقين في أبعاد النظرية، نرى أن الشاب الفرنسي ثيو شديد الحماس للاحتجاجات الجارية في الشارع، لكنه يجلس في سريره يقرأ عن الثورة والماوية، ويذكر في قراءته أن الثورة عمل شاق، يتطلب الكثير من العمل، وأنها ليست مجرد صورة أو لوحة تلصق على الحائط كمدلول على إيماننا بالثورة. فكان يردد هذه الجملة بصوت عالٍ ونبرة ثورية عند قراءته تلك العبارة بالتحديد، دلالة على أهميتها في خوض العمل الثوري.
إلا أن الفيلم في طرحه النهائي للشخصيات وعقلياتهم، يصور الشبان الثلاثة وهم ينضمون إلى ركب الشارع، ليس لدواعي وعيهم بضروة ذلك، لكن لمصادفة مرور المظاهرات من تحت شرفة منزلهم الباريسي وكسر شباك الغرفة التي ينامون فيها بسبب أحد الأحجار المتطايرة، وسماعهم لصوت غضب المتظاهرين، إذ عند انضمامهم إلى مسيرة الاحتجاج، نكتشف أنهم لم يكونوا قد وصلوا لأي نقطة مجدية في جدالهم النظري المثالي الذي كان يدور في المنزل لوقت طويل، بين العنف واللاعنف مثلًا.
فنرى من مارس العنف، وقد قام بالاشتباك مع رجال الشرطة في المظاهرة، قام بذلك مع رفض قاطع لكل ما قاله الشاب الأمريكي خلال نقاشاتهم في المنزل، وأما الشاب الأمريكي فقد انسحب من المظاهرة، مع علامات الخيبة على وجهه كأنه فقد الأمل بتغيير العالم للأفضل بسبب العنف الممارس.
يدعونا الفيلم لفهم إشكالية هذه العقول، وأنها لم تكن آنية أبدًا، بل تلك العقليات المثقفة التي كانت وما زالت تفترض نفسها أنها الأجدر بقيادة أي حركة تدعو للتغيير، كما أنها تجلس في الصوف الأمامية للسينما كدلالة على وعيها للمحتوى الثقافي، هم أكثر العقليات بعدًا عن التغيير والواقع. ولهذا ربما أشار والد التوأمين الفرنسين في بداية الفيلم، أنه إذا أردتم تغيير العالم فتذكروا أنكم جزء منه.