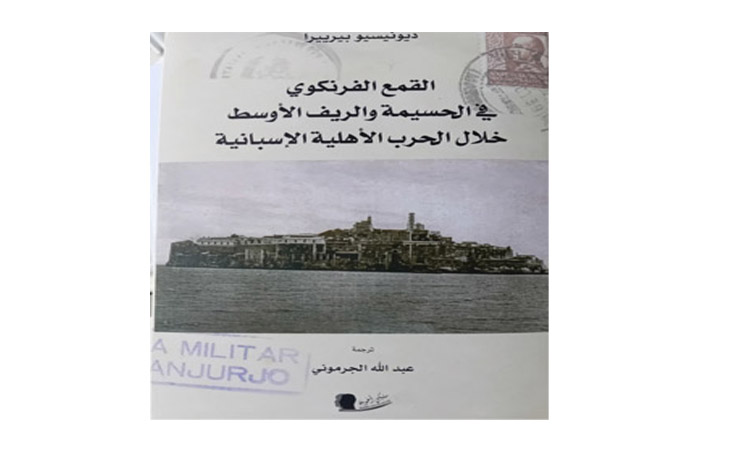عند نهاية العقد الثالث من القرن الماضي، صدر كتاب مُؤسِّس لما يمكن تسميته لحظة الوعي/ الإحساس بالشعر المغربي الحديث. وإن كان الكتاب لا يعدو مُصنَّفا عاما لـ»لأدب العربي في المغرب الأقصى»، على غرار التصنيف المعهود للشعراء إلى طبقات، فإنه حمل التفاتة قوية إلى الأدب المغربي باعتباره القُطْري، من خلال إثارة جملة من الأسئلة، عرضها محمد بن العباس القباج مستنكرا على النحو التالي « ولكن لما حانت منا التفاتة إلى قطرنا المغربي الذي هو جزء من أجزاء الأمة العربية ونظرنا هل له مثل هذه السمعة الأدبية والشهرة العالية، وهل أوتي أدباؤه وشعراؤه ذكرا يرفع مقامهم ويُطير شهرتهم ألفينا من خمول الذكر ما لا ترضى به أمة تنشد الحياة وتؤمل أن يكون لها مركز في الوجود»
تبدو النزعة القطرية في التصنيف المذكور واضحة جدا. والملاحظ أنها لا تذهب إلى حد الغلو، بحيث تُنكر واقع التجاوب المغربي مع ما يصدر عن المشرق العربي من نهضة في الأفكار والأساليب. في موضوع العلاقة بالمشرق العربي، جرى كثير من السجال الأدبي والثقافي، وما يزال مستمرا إلى يومنا هذا. والحقيقة أن هذه العلاقة يمكن أن تشكل مدخلا لقراءة مُقارنة خصبة، بعد أن يتم إدراك حدود الذات، في صلتها بالآخر المُتعيِّن: جغرافيا في المشرق، وتاريخيا في الأندلس. ولعل في ضوء هذا الإدراك الشَّرْطي، يمكن تقبل غير قليل من الملاحظات، مثل ما خاطب به عبد المومن الموحدي الشاعر الجرّاوي: «يا أبا العباس، إنا نباهي بك أهل الأندلس» .
في مقابل الانحياز الشعري قُطريا، نجد أنفسنا منساقين إلى انحياز آخر: حداثي هذه المرة، بالمضامين التاريخية والفكرية والجمالية. وإن كان القبّاج عرض إلى بوادره الأولى، من خلال إشارته إلى النهضة الفكرية الحاصلة في المشرق، فقد خصّ الشعر المغربي بطبقة ثالثة «تربت وتثقفت في عصر تحلق فيه الطيارات في الأجواء…» على حدّ تعبيره.
بالانتقال من الانحياز الأول إلى الانحياز الثاني، سينفسح المجال أمام أسئلة متعددة، من صميم الوعي بالشعر صناعة وثقافة وفلسفة. والحال على هذا النحو، من البدهي أن تتحول الوجهة إلى الغرب عموما، في إطار ما راكمه على مستوى منجزات الحداثة، في مجالات الأدب و الفن والفكر. ونحن نشرف على نهاية العقد الثاني، من القرن الواحد والعشرين، يمكن التساؤل حول إمكانية وجود انحياز ثالث، بفعل تأثير وسائل الاتصال الحديثة، التي لها أكثر من صلة بالأدب في طريقة بنائه وفلسفته واستهلاكه.
بين المحلي والكوني، بين الحديث والقديم، يتحيّز السؤال الأهم: إنه سؤال الجدارة الفنية والجمالية. وفي هذا الإطار، نفترض أن يسمح السؤال بالانتقال من الحديث بلغة الجمع إلى الحديث بلغة الفرد.. من الحديث عن الشعر إلى الحديث عن الشاعر/ النص. وأعتقد أن بهذا الانتقال، يكون كل شاعر/ نص متفردا في حد ذاته، بما يجعله متمنعا عن أية محاولة اختزالية أو تنميطية. وعلى الرغم من تقديرنا لهذه الحقيقة، المترتبة عن نوعية الفن الشعري وطبيعة تلقيه، فإننا سنعرض إلى أهم القضايا، التي يطرحها البحث في الشعر المغربي، على أنظار المؤرخ والناقد والشاعريّ على حدّ سواء.
– قضية التاريخ الأدبي: أهم إشارة بهذا الصدد، أنه باستثناء « النبوغ المغربي» لعبد الله كنون، لم يظهر كتاب آخر من حجمه في التاريخ الأدبي، سواء بالمعنى اللانسونيّ أو الجنيتيّ. وقد مرّت الإشارة إلى «طبقات» القباج، فإن مفهوم الأجيال الشعرية المتداول اليوم، يستدعي معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مقومات اللغة والأسلوب والفن بصفة عامة. وأتصور أن ما يطرحه مفهوم التجييل من مآزق نظرية وإجرائية أكثر مما يطرحه مفهوم التحقيب، المستند إلى التقسيم السياسي للعصور والدول والمماليك؛
– قضية التحقيق الأدبيّ: من المؤكد أن لقضية التحقيق علاقة بقضية التأريخ للشعر المغربي. ذلك أنه بدون نصوص مُحقّقة، يصعب على المؤرخ الأدبيّ إنجاز تأريخ شامل ومفصل للشعر المغربي. وهنا، تحسن الملاحظة إلى ما كابده عبد الله كنون في نبوغه، وهو يجمع بين عمليْ المُحقق والمؤرخ دفعة واحدة. ومن الطبيعي، والحال على هذا النحو، أن تظل شجرة النسب بالنسبة للشعر المغربي مقطوعة. ومهما جهد الشاعر المغربي الحديث، في تواصله مع أسلافه الشعراء، فإن الذاكرة الشعرية لديه تظل مخترقة بالعديد من الفراغات. ويبدو أن إشارة محمد بنيس، في «ظاهرة الشعر المغربي المعاصر»، إلى أن ما يعتري الممارسة الشعرية المعاصرة في المغرب من ثقوب في امتدادها الزمني، نجد بعض تفسيرها في ما ألمحنا إليه بخصوص عدم «نجوز» الذاكرة الشعرية المغربية؛
– قضية النقد الأدبي: إضافة إلى التاريخ والتحقيق، تبرز الأهمية القصوى للنقد الأدبي، باعتباره «الفلتر» الذي بحسبه تُصنَّف النصوص الشعرية وتُقيّم بحسب مستوياتها الفنية والجمالية. ولعل من نتائج فقدان النقد الشعري، بالمقارنة مع نظيره في مجال السرد، أن يَتسيَّد الانطباع الذاتي على حساب الدراسة الأدبية الموضوعية، الواعية بخلفياتها النظرية، وانتساباتها المفاهيمية، وإجراءاتها المنهجية. ويمكن أن يتساءل الباحث عن أي أساس، تُنجز الأنطولوجيات والتراجم والمنتخبات والملفات الشعرية. وإذ يقف بنيس على واقع غياب حركة نقدية موازية، يكون تطلع القباج إلى النقد الأدبي «لنتبين مواطن موطن الضعف وموضع الخلل في أدبنا وتفكيرنا» قد خالفه التحقق إلى أجل لاحق. ولولا ما أنجز من أطاريح جامعية في الموضوع، لما كان لنقد الشعر في المغرب شأن يذكر، باستثناء تلك المقالات الصحفية العَجِلة، على صفحات بعض الملاحق الثقافية.
اعتمادا على القضايا الثلاث المذكورة، سعينا إلى تنظيم بعض ملاحظاتنا بخصوص شعرنا المغربي الحديث والمعاصر. وبحكم الطبيعة المركبة للشعر المغربي، من حيث تعدد ألسنته وأساليبه وخلفياته، فإن أية محاولة للإحاطة بقضاياه وأسئلته جميعها تصير مجرد قبض ريح. وليس بأيدينا في هذه القراءة التقديمية الآن، غير استحضار ثلاثة عناوين محددة، نعرضها مُجملة على النحو التالي:
– الخلفية التشكيلية ومساهمتها في تعميق الوعي البصري لدى الشاعر المغربي، في إطار بناء الصورة التخييلية، وتوزيع فضاء الكتابة، وكذا إبراز الرمزية الثقافية للخط المستعمل (المغربي في هذه الحالة)؛
– الخلفية الأكاديمية ودورها في تحقيق ممارسة شعرية تجريدية، بحكم تركيزها على التفكير الشعري في النص ذاته. وفي هذا الإطار، غالبا ما يصير النص الشعري موضوعا للتفكير والتأمل، مثلما نرصد ذلك لدى ما يسمى شعراء السبعينيات، وفي طليعتهم الشاعر العالمي محمد بنطلحة؛
– الخلفية التجريبية وفاعليتها في «تحولية» النص الشعري المغربي على أكثر من صعيد. ومن هذه الناحية، يبدو هذا النص «قلقا» في طبيعة تخلقه، بحكم المتابعة النقدية المستمرة للشاعر/ الناقد على كتاباته. وأتصور أن لهذه الخلفية الأخيرة علاقة بالخلفيتين السابقتين، بما يؤشر على وجود ما يمكن تسميته شعرا مغربيا، أي في مستوى انفصاله عن جغرافيات شعرية أخرى.
عن التقابل الحاد بين النزوع البصري والنزوع التجريدي، تنشأ تلك المفارقة الكبيرة التي أجتهد في توضيحها، بما يسهل معها القبض على طبيعة ما نسميه الشعر المغربي. وإن كانت الأمثلة مسعفة بالقدر الكافي، فإن نظمها نظريا يحتاج إلى تأمل أوسع وأعمق.
في الشعر المغربي المعاصر: قضايا وأسئلة

الكاتب : عبد الدين حمروش
بتاريخ : 22/03/2019