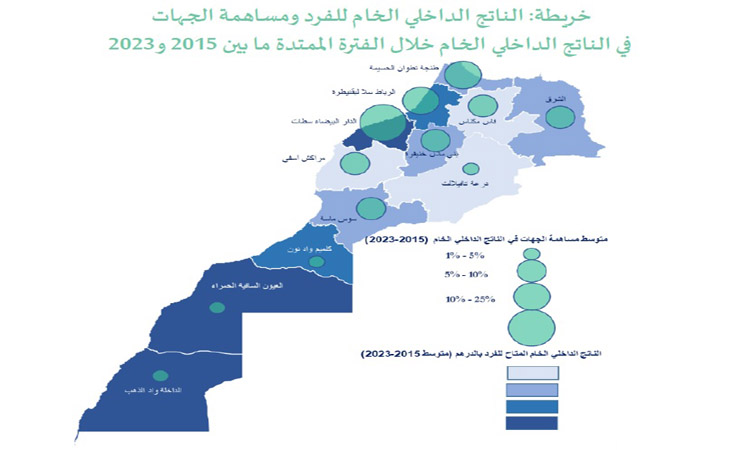كل هوية لا تفرض تفاصيلها إلا حين يتدخل حاملها في الحاضر، ويُبدع، وحين يتحقق ويتذوَّت
– يعتبر دستور المغرب الجديد أول دستور ترد فيه إحالات على الثقافة (وردت الكلمة قرابة ثلاثين مرة عكس الدساتير السابقة)، حتى قيل أنه دستور ثقافي. في رأيكم أية دلالة نعطيها لهذا التغير؟
– صحيح أن دستور 2011 تضمن العديد من الصيغ التي تُحيل على الثقافة، من قبيل «الهُوية الثقافية المغربية»، و»التعبيرات الثقافية»، و»السياسة اللغوية والثقافية»، ودعا إلى إحداث «مجلس وطني للغات والثقافات»، وإلى أن تتكلف السلطات العمومية بدعم «الإبداع الثقافي والفني»، إلى غير ذلك من الإحالات على»«التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية». ولا شك أن الحديث عن الثقافة، في الدستور، خضع لصياغة معيارية يتوقع منها انتهاج سياسات عمومية، سواء على صعيد المسؤولية الحكومية أو الجماعات المحلية، تضع في حسبانها الأهمية الكبرى التي منحها الدستور للثقافة حتى تكون في قلب كل السياسات والمخططات.
ولعل حضور مصطلح الثقافة في الدستور بهذه الكثافة يعكس، بشكل ما، ما سبق أن شهده المغرب قبل سنة 2011 من عناية بالشأن الثقافي مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وتعيين محمد الأشعري وزيرا للثقافة، باعتباره شاعرا وروائيا ورئيسا سابقا لاتحاد كتاب المغرب. وقد ظهر هذا الاهتمام، بكيفية جلية، في أول تصريح حكومي. كما أن الدولة، على أعلى مستويات اتخاذ القرار فيها، انخرطت في إطلاق تظاهرات كبرى مثل «مهرجان مراكش الدولي للسينما»، وحثت على تنظيم مهرجانات متعددة الاهتمامات الفنية والثقافية في المدن المغربية، والزيادة في حجم تمويل الإنتاج السينمائي (الذي بلغ أكثر من ثلاثين فيلما سنة 2023)، ودعم الكتاب، والمسرح، والأغنية، واقتناء اللوحات التشكيلية، وإطلاق عملية واسعة لإصلاح وتطوير مجال المتاحف، وغيرها من المبادرات التي سبقت صياغة الدستور الجديد؛ وهي قرارات وسعت دائرة الاهتمام بالشأن الثقافي، وزاد من انخراط الدولة والجماعات، وأحيانا المقاولات الخاصة الكبرى، في دعم بعض التظاهرات والأنشطة الثقافية. وهذا أمر محمود على كل حال، ومطلوب دستوريا.
لكن المعطيات الموضوعية التي تحصل فيها هذه التطورات، تُبين أن ثمة تفاوتات كبرى بين الإقرارات المعيارية، والبرامج التي توضع تحت عنوان الثقافة التي تُسطَّر وتُنفذ، جزئيا أو كليا، وبين الأصداء التي تنجم عنها في التكوينات، والأذواق، والسلوكات، والعلاقات. ذلك أن أكبر المشاتل التي من المفترض أن تكون حاضنة للثقافة والتربية عليها، وهي المدرسة، تعاني من نقائص مَهُولة على مستوى المضامين الثقافية والتربية الجمالية التي من المفترض ضخها في البرامج والمناهج، كما أن الإعلام العمومي الذي من المفروض أن يعزز الدور الثقافي للمدرسة، وبالرغم من وجود بعض البرامج ذات الطبيعة الإخبارية، والتوصيلية، فإنه لم يرق إلى ما هو مطلوب دستوريا. ثم إن هذه التطورات، والتي لا شك تخلق ديناميات في الجهات الترابية المختلفة، تجرى في سياقات تتميز بمنسوب كبير من الغموض، والتزاحم، والتنافس غير المنتج، والممارسات «الثقافية» التي لا ينجم عنها التراكم الضروري، ولا تترك أصداء لدى الشباب، بشكل أخص، وذلك في زمن يشهد، أيضا،تراجعا ثقافيا وفكريا بيِّنًا للجامعة المغربية.
وفي كل الأحوال، فإنه لا يكفي تكرار الحديث عن الثقافة، ولا سيما أنها تتعرض لكثير من الالتباس والتشويه غالبا؛خصوصا في وقت كثر فيه الكلام عن اقتصاديات الثقافة، أو الصناعات الثقافية. نحن أمام ثقافات متنوعة الخصائص والتعبيرات، فيها ما يعود إلـى الثقافة الشفوية، وإلى الثقافة العالِمة، بمستوييها التقليدي -الذي لا يزال يتحرك ضمن رأسمال رمزي ووجداني واسع ومؤثر-، والمستوى العصري -وقد وجد في الماضي القريب ولا يزال يجد مقاومات كبرى-؛ ثم الثقافة الوسائطية الجديدة التي خلخلت كل تعبيرات الثقافة ومستوياتها، وأصبحت تحدد مضامينها، وأنماط تأثيرها، وانعكاساتها على العقل والوجدان.
وفي ظني،أن كل سياسة نهضوية حقة عليها أن تبدأ، كما ورد في تقرير «النموذج التنموي الجديد»، بضخ البرامج التعليمية بما يلزم من مضامين ومواد ثقافية وفنية، وتزويد أماكن العيش العامة بمنشآت ذات عروض ثقافية في المجالات الترابية المختلفة، بكل ما يلزم من تأهيل وكفاءة من حيث البرمجة، والتدبير، والتخطيط، وضمان استمرارية المنشآت، وهو شرط ضروري لم يعمل أصحاب القرار على التحضير له بالشكل المطلوب.
وأعتبر أن إقرار سياسات مناسبة مندمجة توفر مقتضيات عدالة ثقافية تشمل الجهات والمدن والقرى كافة، لا تزال في حاجة إلى من يخرجها من مستواها المعياري الدستوري وترجمتها إلى رافعات للارتقاء، حقا، بالإنسان المغربي.
– لعلها المرة الأولى التي يتم فيها التوافق بين كل مكونات الأمة المغربية حول تعريف هوية المغرب الثقافية بروافدها المتعددة، هل يمكن أن يكون تأصيل الهوية دستوريا، سبيلا نحو تحصين المجتمع من التوترات الثقافية التي تخلق في عالمنا العربي بؤرا للنزاع وأحيانا للتفكك؟
– معلوم أن مسألة الهوية من بين الألفاظ المشحونة انفعاليا، والإشكالية مفهوميًا، والأكثر إثارة للجدل. ولكن، النخب المغربية التي عملت على صياغة النص الدستوري، وبعد الاستماعات الواسعة والمتنوعة، والتفاعل الكبير مع الفاعلين كافة في المجتمع، اهتدت إلى ضرورة الربط بين «تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية» وبين مكوناتها وروافدها ذات المضامين والتعبيرات والكثافة الثقافية.
ولعل القراءة الهادئة لمختلف مكونات الهوية المغربية وروافدها قد تفيد، بالفعل، أن العقل المعياري المغربي، أثناء صياغة الدستور، تشكل لدى أصحابه وعي تاريخي بالحاجة الوجودية إلى الإقرار بالمشروعيات الدينية واللغوية والثقافية والتاريخية المختلفة التي يتكون منها النسيج المجتمعي المغربي في تنوعه، وتعدد مكوناته. غير أن دلالات هذا التعريف تتكامل وتكتمل، بالضرورة، مع ما ورد في الفصل الأول من الدستور من حيث تأكيده على استناد «الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي».
ويبدو لي أن العديد من الخطب الملكية ، وقرارات سابقة، كانت لها دلالات رمزية وسياسية كبيرة وجدت صياغتها المناسبة في متن دستور 2011؛ منها أن أول زيارة للملك محمد السادس، بعد جلوسه على العرش، قام بها خارج العاصمة كانت لمدينة الحسيمة ولمنطقة الريف، ثم جاء خطاب أجدير في 2001 لإعلان الاعتراف الوطني بالمكون الأمازيغي للهوية المغربية، والعملية التاريخية والسياسية الكبرى المتمثلة في «هيئة الإنصاف والمصالحة»، وقرار بناء ميناء كبير على الواجهة المتوسطية لتأكيد الانتماء المتوسطي للمغرب، والذي كان قد تم استبعاده لعقود؛ فضلا عن الاشتغال المستدام على الوحدة الوطنية بتنمية الأقاليم الجنوبية والاعتناء بالثقافة الحسانية، وتأهيل الشأن الديني، والاهتمام بالروافد المختلفة الأخرى للهوية. وهكذا يظهر أن وعيا عميقا بحاجة المغرب إلى إعادة بناء مرتكزات «الهوية الوطنية» كان يعتمل داخل النخبة السياسية الجديدة، في ذلك الوقت، سمحت أحداث 20 فبراير2011 بتسريع وتيرة إقرارها وتثبيتها في الوثيقة الدستورية.
وبذلك تمكنت الجماعة الوطنية من التدبير الهادئ والواعي بوقائع التنوع والاختلاف،والاعتراف بمشروعيتها، وتحييد تعبيرات التشنج الهوياتي،من خلال وضع أسس معيارية تسند العيش الوطني المشترك، في إطار من السلم المدني، ومن الإقرار بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية كافة.والمؤكد أن للملكية المغربية في بلادنا أدوارا حاسمة، في تكامل بيِّن مع القوى السياسية الفاعلة، في تأمين البلاد من أسباب الفتن ومن الصراعات التي أدت ببلدان عربية إلى التفكك، بل وإلى الخراب.
أما الحديث عمَّا يجرى في بعض هذه البلدان العربية من انقسامات، و»حروب أهلية»، وتنازع هوياتي، فذلك موضوع يتطلب مجالا أوسع لتناوله.
– يلمس المتتبع للحالة المغربية، وجود حالة ذهنية تستثمر في «الأنا الجماعية» المتميزة تأخذ أحيانًا شكل مديح جماعي «لتمغرابيت»، في نـظركم هل يمكن اعتبار ذلك دليلا على تغير نظرة المغاربة الى أنفسهم؟ عودة الاعتزاز بالذات الجماعية التي تكون قد قوَّضتها نوعا ما، السطوة السياسية الضاغطة لقرابة أربعين سنة؟
n n قد يبدو طرح سؤال المعنى عن «الأنا الجماعية» المغربية، اليوم، سهلا في صياغته لكنه، في العمق، يفترض قضية إشكالية بالغة التعقيد؛ إذ ما المسوغ الوجودي – أو السياسي- للتساؤل عن «معنى» أن تتقدم إلى ذاتك وإلى العالم بوصفك مغربيا؟ كيف تكون – أو تعبر عن كينونتك – بمعنى ما من المعاني؟ بل وكيف تكون مغربيا اليوم في زمن انتشر فيه المغاربة في كل أصقاع العالم، وفي سياق إعادة النظر في كثير من «بديهيات» الخطاب السائد الذي كرسته عقود من التسلطية، وفرض الهوية الواحدة؟
ثم كيف يمكن مقاربة سؤال الثقافة والهوية حين نعلم، اليوم، بأن هناك ملايين من المغاربة ينتقلون بين مختلف القارات، وبأن ضخاً متزايداً للأصوات والصور يخترق جميع البيئات والأمكنة (تلفزات مربوطة مباشرة بالأنترنت، وقنوات بكل اللغات والمذاهب والسياسات، وهواتف أكثر من ذكية..) ومواقع إلكترونية تزداد أهمية في التواصل والدردشة، وتبادل الأفكار والأذواق وحتى المشاعر، وجماعات افتراضية متنوعة البيئات والثقافات، فضلا عن الأدوار التي لا تزال تقوم بها المدرسة والجامعة في تعلم اللغات الأجنبية والتفاعل مع ثقافات الآخرين؟
ومعلوم أن الاستعمال المفرط، اليوم، لمصطلح الهوية، سبقه استعمال مصطلحات الأصالة، والخصوصية، والوطنية، وغيرها من الكلمات التي كانت، بطرق متفاوتة، تعبر عن ارتباط النخب المغربية برأسمالها الرمزي المتوارث، لمواجهة «مخاطر» المعاصرة، والكونية، والعدمية الوطنية. ولعل سؤالك، والأسئلة التي يمكن أن تتفرع عنه، قد يعود بنا إلى ما أنتجه المثقفون المغاربة حول هذا الموضوع، منذ كتاب «النقد الذاتي»» لعلال الفاسي، و»صمود وسط الإعصار» لعبد الله إبراهيم، و»الجذور الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية»و»استبانة» لعبد الله العروي، وما كتبه عبد الله بونفور حول ما أسماه «الذاتية المغربية في الحاضر»، وكتابات سعيد بنسعيد العلوي حول التعبيرات الثقافية للوطنية المغربية، وما أنتجه حسن رشيق، وحسن طارق حول «الوطنية»، وما كتبه الطيب بياض عن «الشخصية المغربية»، وغيرهم ممن انخرطوا في مناقشة هذا الذي أطلق عليه «تامغرابيت».
ثمة إنتاج فكري مغربي محترم حول هذا الموضوع يستحق عرضه ومناقشته، لكن ليس هنا مجال ذلك. والأمر ليس بديهيا تماما، ويصعب تحديد وفهم إشكالية مُركبة بإطلاق شعار، مهما كانت المحاولات والكتابات والبرامج والنوايا، وأشكال التواصل التي استثمرت من أجل إشاعة مصطلح «تامغرابيت». فمثل هذا النوع من المصطلحات سبق أن رفعه آخرون منذ أكثر من قرن، في مصر، ولبنان، وفي تونس بورقيبة، وتركيا، واليونانLa grécité،وفرنسا La francité، وغيرها من البلدان؛ وتبين أن استعمال هذه التسميات لم يعمر طويلا نظرا لما تختزنه من مخاطر التقوقع، والتعالي، والتشنج الهوياتي.
تدور الهوية الثقافية المغربية، تاريخيا ورمزيا، حول ما يتم التعبير عنه من خلال المتخيل الجمعي للمغاربة، وإبداعهم للحكايات والأمثال (من حِكم وأساطير وروايات…)، وموسيقاهم وأغانيهم (من إيقاعات متنوعة، وأهازيج، وأنماط تراثية وعصرية…)، وفي مختلف حقول التعبير الفني المتجددة (في الكتابة الأدبية، والسينما، والفنون البصرية…).كما تبرز تجليات هذه الهوية في أساليب الطبخ (والطبخ المغربي صار عالميا من دون منازع، وينتشر بشكل مضطرد منذ أكثر من خمسة عقود…)، واللباس (المتنوع الأشكال حسب المناطق والجهات، كما أضحى القفطان المغربي مرجعا في الأناقة…)، وفي طرق الاحتفال (حيث أصبح العرس المغربي نموذجا مطلوبا في أوروبا، والخليج، وغيرهما من المناطق…)، والعمارة (من زليج، وزخرفة مميزة، وقد بنيت منشآت على منواله في باريس منذ عشرينيات القرن الماضي، وفي أمريكا، والصين، وماليزيا، وفي الخليج، …). تمَّ ويتم ذلك اعتمادا على طرق إنتاج وإعادة إنتاج وتجديد القيم والصيغ العملية التي تميز المغاربة؛ هذا فضلا عن نمط التدين المخصوص، وتقاليد الضيافة المشهود لهم بها وبحسن تدبيرها، وما ارتبط بالآثار المادية واللامادية، وغنى وتنوع جغرافية المغرب. هذه الأساليب في العيش والإبداع وغيرها هي جُماع ما يمكن أن يندرج ضمن التعبيرات الثقافية المميزة للمغرب كوطن وكتسمية؛ ولذلك فلسنا في حاجة إلى اصطناع مصطلح فيه بعض التكلف ولا يغري بالاستعمال، في ظني.
نشهد تحولات جوهرية في تعريف المغربي لذاته بحكم تطورات الأوضاع الاجتماعية، والنفسية، والثقافية، وهجرة الأجساد والعقول، وتطورات أشكال التفاعل مع الماضي والعالم. فضلا عن أن أحداثا كبرى مثل المسيرة الخضراء، و»حكومة التناوب»، مرورا بالتوجهات السياسية المختلفة للعهد الجديد، وتقرير الخمسينية، والإنصاف والمصالحة، ودستور 2011، وغيرها من اللحظات المفصلية التي عاشها المغرب؛ حيث وجدت النخب نفسها مطالبة بتجديد فهمها للانتماء وللوطنية،وتغيير أسلوب تصريفها لها، وطرق تعبيرها عن «الذاتية المغربية»، كما سماها عبد الله بونفور.
والمؤكد أنه مع «حكومة التناوب» دخل المغرب في ما يشبه تبرمًا، متدرجا، من تعبيرات التسلطية التي سادت في المغرب طيلة أكثر من أربعة عقود، وانخرط في فهم مُغاير للوطنية تولد عنه إحساس جديد بالانتماء.ويتصاعد هذا الإحساس كلما طرأ حدث كبير، كما حصل في أحداث 16 ماي 2003، ومع محنة كوفيد19، وفتوحات الفريق الوطني لكرة القدم في بطولة العالم سنة 2022، والمد التضامني الذي تحرك بعد زلزال الحوز… وغيرها من الأحداث التي تنتج شعورا وجدانيا يقضي بالقول بأن ثمة انتسابا جماعيا مميزا لهذا الوطن.
غير أن كل هوية لا تفرض تفاصيلها إلا حين يتدخل حاملها في الحاضر، ويُبدع، وحين يتحقق ويتذوَّت. تتساوى، من هذا المنطلق، كل المرجعيات والتجارب والنماذج أمام مساحة الوعي لأن الاختيار، في هذه الحالة، لا يتم على قاعدة الانتماء العرقي أو الإثني أو الديني، وإنما استنادا إلى أسس فكرية، إلى جاهزية وجدانية، وإلى اعتبارات عملية، وإلى إرادة لإثبات الذات، فردية كانت أو جماعية؛ خصوصا وأننا نشهد على تنامي محموم لمظاهر العنف والعدوانية عالميا، وعلى عدوانية تتهدد جنوب جغرافيتنا وشرقها، ساهمت، بقسط لا بأس بتأثيره، في تشكيل وعي جمعي بالانتماء للوطن.
ومع ذلك لا مجال لتبرير القول بهوية أحادية البُعد؛ لأن كل الهويات صارت مُركبة، تستمد مقوماتها من مصادر مختلفة منفتحة على عوالم متعددة، وهو ما نص عليه الدستور المغربي. لذلك فالتقدم إلى المجال العام باسم حضور منغلق على حدوده الخاصة، كيفما كان الشعار الذي يرفعه صاحبه، إزاء آخرين– مهما كانت أصولهم ومقاصدهم- لا يعني أبدًا الانفلات من السياق الثقافي والإنساني العام الذي تعمل الحضارة والثقافات الحالية على نحته. وكما هو حال بعض البلدان الإسلامية القليلة، مثل مصر، وتركيا، وإيران -بغض النظر عن الموقف من أنظمتهم السياسية الحالية- فإن المعطيات كافة تؤكد على أن للمغرب تجذرا تاريخيا، وعمقا أنثروبولوجيا متراكبا لا يتوقف عن التمازج، وكثافة ثقافية في منتهى التنوع والثراء، ودولة ممتدة في الزمن، تتغير بتغيره، وتتكيف مع مقتضياته.
– أحد مظاهر التغير، بالنسبة لمجتمعات الانتقال(ديموغرافيا، سياسيا ومؤسساتيا) كما هو حال المغرب، هو التحول في منظومة القيم، وقد لاحظنا تشديدا على التغير الذي طالها، كما في المسح القيمي الذي أجري في2005 مع تأكيد رسمي من أعلى هرم الدولة على قيم الجدية والمعقول الخ، هل نحن بصدد عودة مركزية القيم؟ وهل يمكن أن نقول بأن الدولة نفسها تسعى الى أن تكون فاعلا أخلاقيا؟
– يؤكد المختصون على أن المغرب يعيش انتقالا ديمغرافيا هائلا، وأن شعبه أصبح يعيش في المدن بأكثر من 65 في المئة. وما لا يهتم به الناس، بعامة، هو أن المجتمع المغربي شهد ديناميات كبرى على صعيد التمازج والاختلاط بين الجهات، واللغات، والأقاليم بفعل الدور التاريخي الكبير الذي لعبته الإدارة المغربية، منذ ستينيات القرن الماضي. فتنقلات رجال ونساء التعليم، والداخلية، والفلاحة، والجيش، وغيرهم، من مدينة إلى أخرى في جغرافية المغرب الفسيحة، سمحت بأشكال غير مسبوقة من اللقاء، والتزاوج، والتصاهر، والتفاعل بين المكونات الجهوية والثقافية للمغاربة.
ولا شك أن تحولات كبرى مثل تلك التي جرت في المجتمع منذ أكثر من نصف قرن، بما فيها الانتقال من العائلة الممتدة إلى الأسرة النووية، وتوسع المدن اللامتوقف، والأدوار الجديدة للمرأة، والتدفقات البشرية التي تجري بفعل الهجرة المتنوعة الأشكال والأهداف، وطرق التنقل والسفر اللامحدودة التي أصبحت متاحة لأكبر عدد من الناس؛ لهذه العوامل كافة تداعيات واضحة على صعيد ما ينعت ب»منظومة القيم». ولكن لعل أهم عامل أحدث خلخلة كبرى في عادات المغاربة وقِيَمهم،يتمثل في حَشْرهم في نظام استهلاكي مفتوح، مما ساهم في انتشار الاعتبارات المادية وفي سطوتها على النظر إلى الذات وإلى قيمة الآخر. وقد حصل ذلك من دون مقدمات ولا تحضير على قيم هذا النظام بالتربية المناسبة، لاكتساب الوعي الضروري بانعكاساته لتفادي السقوط المدوي في قيمه الضارَّة، وأشكال استلابه، وما ينجم عن ذلك من توترات، وصراعات، وأنماط هدْر، واستخفاف بالآخر، وتعبيرات جديدة من العنف، وتفاوتات، وفساد، ومظاهر زيف وغش، وغيرها من الآفات التي يعاني منها المجتمع المغربي.
ثمة تضخم لفظي يضغط على الحديث عن القيم وعن أزمتها في بلادنا. ومن جميع الفئات والجهات والمراجع. وقد صدرت تقارير ودراسات عدة طيلة العقدين الأخيرين حول القيم، سواء من منطلقات بحثية متخصصة، أو من طرف جهات تسترشد بتوجهات دينية أو حقوقية. غير أن هناك فوارق صارخة بين ما يحصل في المجتمع من تغيرات سلوكية واستهلاكية، وبين الخطب الرائجة حول القيم، سواء دبجت هذه الخطب تحت عناوين وعظية، أو دينية، أو حتى تلك التي تحرص بعض هيئات الدولة على إشاعتها. والحال أن مؤسسات الدولة هي أكثر من يعرف ما يجري في أحشاء المجتمع من تعبيرات، أو تغيرات، أو تجاوزات قيمية؛ مثلما يتم معاينته في رَدَهات المحاكم، وفي مصالح الشرطة، والدرك، والجمارك، والإدارات الترابية، وغيرها من الهيئات التي تستقبل مشاكل المجتمع،وتنصت لمعاناة المواطنين ولانزلاقاتهم، وتعاين تصرفاتهم، وتنتبه للتغيرات التي تحصل عليها، وتحرص على حلها أو الحد منها.
أما بخصوص ما أسميته أن «الدولة نفسها تسعى إلى أن تكون فاعلا أخلاقيا»، فمناقشة هذا الأمر ليست هينة. وأحسب أن من واجبات الدولة، في كل مستويات القرار فيها، أن تحرص على ترجمة وتفعيل ما عمِل «الضمير الجمعي» المغربي على بلورته وصياغته في تصدير الدستور من قيم، المتمثلة في:»بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ….وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن،يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، فضلا عن التشبث ب»قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح»، وقيم أخرى عديدة وردت في متن مواد ومقتضيات الدستور.
يتعلق الأمر بجُماع قيمِ تم تثبيتها في دستور البلاد، بما يتطلب ذلك من التزام مبدئي بها، ضمن التبني الصريح لحقوق الإنسان كافة، «كما هي متعارف عليها عالميا». فلا يبدو لي أننا في حاجة إلى التحسُّر عن قيم مفتقدة، لأن ما هو مطلوب من كل أجهزة الدولة، إذا احترمنا منطوق سؤالك، هو «الوفاء» لهذه القيم من خلال القانون، الذي هو «نَحْوُ» المجتمع وضابط توازناته؛ وذلك من خلال ضخ هذه القيم في التربية، والمنظومة التعليمية، ولا سيما العمومية منها؛ وفي الإعلام العمومي، والخاص أيضا بحكم التزامه في دفاتر التحملات بتقديم خدمة عمومية (ولعل تجربة الإذاعات الخاصة، منذ 2006 تُبين أن العديد من المتعهدين لا يحترمون، هم أنفسهم، ما التزموا به من مقتضيات للارتقاء بالذوق العام، ونشر قيم المواطنة والتمدن)؛ فضلا عن الحرص على مراعاة هذه القيم في المرافق العمومية، والمجال العام، وغيره من مستويات أماكن العيش.
ويظهر أن ثمة مشاكل كبرى لم يتمكن الفاعل السياسي في بلادنا من وضع السياسات المناسبة لحلها وتجاوزها، وهي مشاكل ناجمة عن نقص كبير في تفعيل القيم الواردة في الدستور. ومنها تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتنافى مع قيمة التضامن والعدالة الاجتماعية؛ واستشراء مظاهر الفساد، وهو ما يلغي قيمة النزاهة والكرامة؛ وتضارب المصالح، وهو ما يُعطِّل قيمتي المساواة وتكافؤ الفرص. وبالرغم من بعض مظاهر التآزر التي تبرز أثناء بعض الأحداث، فإن بلادنا، حسب ما يبدو لي، في حاجة إلى هبَّة وطنية كبرى عنوانها التضامن، للمساهمة في تقليص التفاوتات التي تُميز المغرب في العديد من المجالات، بين القرى والمدن وأحياء داخل نفس المدن؛وبين الفئات الاجتماعية بعامة؛ وبين أوساط الشباب، بشكل رئيسي. فهناك شعور مرير بأن أغنياء البلاد، ومن اغتنى في العقدين الأخيرين بسرعة مثيرة،يتميزون ببُخل صادم، ويفتقدون إلى الإحساس الإنساني بوضعية الفقراء والمستضعفين؛ اللهم إلا بعض الالتفاتات «الإحسانية» المحدودة والعابرة.ولا ننسى أن أغنياء وميليارديرات بلاد رأسمالية غنية كأمريكا، فضلا عن تمويلهم السخي لمؤسسات الرعاية والاحتضان، تبرعوا كلهم في الأزمة المالية لسنة 2008 بنصف ثرواتهم لخزينة الدولة لتعويض بعض الخسارات التي أحدثتها الأزمة. فما بالك بالنسبة لأغنياء يتقدمون إلى المشهد العام بكونهم فضلاء مسلمين.
ولعل الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية بدأوا يهتمون بما يكشف عنه الشباب المغربي من تعبيرات الغضب والمرارة في مدرجات الملاعب، ونصوص الأغاني، وفي السينما، وفي فنون أخرى، بل وفي أشكال اللباس وقص الشعر، وغيرها من التعبيرات الاحتجاجية الحاملة لرسائل يتعين على من هو مطالب بالتقاطها أن يجد المداخل المناسبة للتفاعل السياسي معها. لا سيما وأن هذه المرارة ازدادت مع الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار المواد الغذائية الرئيسية في السنتين الأخيرتين (يعاين المراقبون والمسافرون أن ثمن السمك والسردين المصطاد في المغرب يباع في إسبانيا بثمن أقل من ذلك الذي يباع به في بلادنا؟؟؟؟…)، وتصاعد كلفة الخدمات التي لا يمكنها، حسب الاقتصاديين والباحثين والصحفيين، أن توفر شروط تشكيل طبقة وسطى في المغرب، أو التخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة.
وتأكد أن هذه الإشارات والمعطيات الموضوعية، مهما كان موقفنا منها ليست بعيدة، إطلاقا، عن تبادلنا بخصوص مسألة «منظومة القيم» كما سطَّرها الدستور، وفي طليعتها: العدالة، والمساواة، والكرامة، وتكافؤ الفرص، والتضامن… وغيرها.
-هناك صور بمعانيها المجازية والحقيقية تعكس نوعا من التقدير الذاتي، منها صور الفرح الجماعي. هل يمكن أن نقول إن الفرح حرر المغاربة من عقود من التقشف العاطفي بسبب السياسة؟
– شهد المغرب أحداثا كبرى تميزت باندماج جمعي، وبإحساس بقوة الرابطة الوطنية؛ لكن لكرة القدم سحرها الخاص، وقدرة غير مرئية على تعبئة الوجدان، والنفوس، والجُموع، وعلى الإحساس بالفرح العارم في حالة الانتصار، وبالإحباط الكبير في حالة الهزيمة. وقد جعلت انتصارات الفريق الوطني في بطولة العالم لسنة 2022، صور المغرب في قلب العالم، ولربما بشكل أفضل من كل السياسات السابقة التي وُضعت للتعريف بمقدرات المغرب في الخارج؛ وحركت الانتصارات المتوالية لهذا الفريق مشاعر دفينة باعتزاز قوي بالانتماء إلى وطن وإلى تسمية، وبفرح جماعي عبَّرت فيه، كل الفئات والأعمار،عن نوع من الكاتارسيس الجماعي بخروجها للإعلان عن المشاركة في الاحتفالات الجماهيرية، والتلاحم مع الآخرين.
ومعلوم أن هذه الإنجازات الكروية جاءت بعد معاناة كبرى تجرَّعها المغاربة بسبب كورونا، وتحملوا مآسيها، وإحباطاتها، واستبطنوا المشاكل كافة التي صاحبتها، حيث ترتب عنها أشكال كآبة استولت على عدد كبير من الفئات، نساء، ورجالا، شبابا، وشيوخا.ولعل انتصارات الفريق الوطني بوصوله إلى نصف النهاية،سمحت باسترجاع نوع من أنواع التعبير عن الفرح والابتهاج،وعما أسماه سؤالك «التقدير الذاتي». فالاحتفال الشعبي العارم الذي عاشه المغاربة بعد كل مباراة عكس، في العمق، تفجير عظيم لفرح جماهيري في سياقات تندر فيها لحظات الانتصار؛ وتصاعد هذا الشعور مع توالي الانتصارات على الكبار، أو على فرق لم يكن إلا القليل يراهن على الانتصار عليها، إلى أن بلغ الفريق الوطني نصف النهاية، التي هي نفسها قيل في تحكيمها وإدارتها الشيء الكثير. ومهما يكن،فإن ما جرى سمح بتعبيرات غير مسبوقة عن نوع من إثبات ذات جماعية شعرت بنوع من الابتهاج، ليس فقط بفضل الانتصارات التي أنجزها الفريق الوطني، وإنما بسبب الانتصار على الشعور الدفين بصعوبات إنجاز الانتصار، حين لا تتوفر الشروط الاجتماعية، والوجدانية والمؤسسية التي تحتضنه وتحفز عليه.
غير أن هذا الأمر يستدعي وضعه في سياقه المناسب، فالتقدير الذاتي أو الجماعي يكون أكثر قوة وإنتاجية حين ينجم عن سياسات مستدامة تعتمد على قيم رئيسية عمادها الثقة والاعتراف. وقد أظهرت طرق تدبير عملية تشكيل الفريق الوطني ومشاركته عن بعض هذه القيم. وأتصور أن أصحاب القرار قرأوا جيدا رسائل التلاحم العظيم الذي عبَّر عن صوره في الشارع العام. فلا يتعلق الأمر بحدث عابر؛ إذ إن المجتمع العصري بني على أساس الثقة والاعتراف، الذي بدونهما لا يمكن تصور نهضة أو تقدم فعلي تستفيد منه أوسع الفئات.والظاهر أنه من المطلوب، اليوم، من السياسة ومن المؤسسات أن تجعل من الاعتراف آلية محفزة على العطاء والمبادرة،وآلية لإنتاج الرضا؛ حتى تصير أخلاقيات الاعتراف مُكونًا للبناء الاجتماعي، وأساس النظرة إلى الإنسان، ونتاج ثقافة منتجة للمبادرة، والمشاركة، والإبداع، والإحساس بالارتياح. فالتقدير الذاتي، في امتداده المسترسَل وليس العابر،يتيح ممارسة جديدة للحرية، والثقة في الذات، وإنتاج أفكار جديدة، والقيام بالنقد الذاتي، والتصريف المبدع للزمن.
ولذلك يعتبر عبد الله العروي أن الوطنية هي «شعور، وسلوك، وتطلُّع… الشعور هو الاعتزاز بالذات وبالأجداد…السلوك هو الإيثار والتضحية…والتطلع هو طلب الحرية والتقدم والرفاهية»(استبانة:ص 83).
– ما هي في نظرك أهم صور العهد الجديد أي ربع قرن من الحكم الجديد،( الصور الخاصة بالملك نفسه، بجسديه deux corps du roi أو التي تخص لحظات مفصلية معينة كما هو حال الكوارث الطبيعية ) من حيث الدلالة ؟
– من المعروف أن البيئة السياسية للمغرب يتشابك فيها البُعد الرمزي بمتطلبات المرحلة، وثقل التاريخ بإرادات القوة الفاعلة في الحاضر، والعاطفي بالاعتبارات العقلانية، والتقليد بالتحديث. عوامل شبه كيماوية تتراكب بشكل فعال ومُنتج أحيانا، وتتنافر أحايين أخرى؛ لكنها حاضرة بقوة في مسارات التحولات والقرارات والمصائر. وللاقتراب من الوقائع السياسية، المنفلتة والملتبسة أحيانا، يتعين الاهتداء إلى كيفية الإنصات إلى حركات وسكنات وخطب الملك أساسا، وإلى رجالات المغرب والفاعلين في سياسته. فغالبا ما تبدو السياسة بسيطة وراكدة على السطح،كما تبدو مع الحكومة الحالية على سبيل المثال، ولكن معطياتها، في العمق، معقدة ومتحركة من حيث اشتغالها وأدوات توصيلها.
ولعل الملك محمد السادس تميَّز بمنظومة تواصلية خاصة به، قياسا إلى ما كان يتفرد به المرحوم الحسن الثاني من بلاغة، وخطابة، ونمط حضور. ومنذ اعتلائه العرش؛ بل وحتى أثناء مراسيم التوقيع على انتقال المُلك، عبَّر الملك محمد السادس عن إرادة واضحة لتغيير أساليب التواصل والتخاطب مع النخب والشعب. وقد أعطى أهمية كبرى للصور، وللتعبيرات الرمزية، وللتقارب الجسدي مع المواطنين؛ وتميزت خطبه بالاقتضاب، والدقة، والوضوح، والتركيز على إطلاق المشاريع والمخططات، وبكثير من منسوب النقد الصريح. بداية بخطاب «المفهوم الجديد للسلطة» سنة 1999، والتنقلات اللامتوقفة في مدن وقرى ومداشر البلاد طيلة العقد الأول من توليه الحكم، مرورا بإطلاق مسلسل «الإنصاف والمصالحة»، وتعبئة الذكاء الجماعي المغربي لإعادة قراءة التاريخ الحاضر للمغرب في «تقرير الخمسينية»، وتغيير مُدونة الأسرة، وخوض إنشاء مؤسسات الضبط لتعويض النقص الديمقراطي في تدبير المؤسسات والسياسات، إلى خطاب العرش لسنة 2005، الذي تحدث فيه عن «مَلكية مواطنة». أما بخصوص الصور، فثمة صور كثيرة لوجهي الملك باعتباره «أميرا للمؤمنين» و»ملكا-مواطنا»، كما يؤكد على ذلك. فصور أول زيارة للحسيمة، وتنقلاته عبر المغرب، وخطاب أجدير، واستقبال عائلات المعتقلين السابقين، وعناق مغاربة العالم في ميناء طنجة، ونظام البروتوكول، والمناسبات، وغيرها من الصور والدلالات يصعب حصرها في هذا المقام.
ولا شك أن الأمر لم يكن ينحصر على صور، فقط؛ وإنما عن تعبير مسترسل، منذ البدايات،عن إرادة سياسية تمثلت في إطلاق «الأوراش التنموية الكبرى لتحسين المعيش اليومي للمواطن ببرامج محلية لمحاربة الفقر والهشاشة»؛ وفي «توسيع الطبقة الوسطى لتُشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع».
لكن هل تمكَّن المغرب من رفع هذين التحديين؟ هذا سؤال كبير يتعين على الاقتصاديين وعلماء الاجتماع والسياسة اقتراح أجوبة موضوعية عنه؛ علما أن الملك نفسه، ومنذ بداية العقد الماضي، وهو يُنبه في خطبه، إلى محدودية نتائج السياسات العمومية. لذلك طالب بتشخيص «الثروة الإجمالية للمغرب» المادية واللامادية سنة 2014، مطالبا بوضع سياسات عمومية مغايرة؛ ولكن لم يتمخض عن ذلك نتائج تذكر، وكأن البحث الذي أنجزه «بنك المغرب» و»المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي» لم يكن؛وبقي «حبرا على ورق» ثم إن خطاب العرش لسنة 2017 كان أكثر نقدية حين أقرَّ بأننا نعيش «مفارقات صارخة من الصعب فهْمُها، أو القول بها…بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع وتتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المُخْجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم».
لا أريد الاسترسال في معاينة الملاحظات النقدية الواضحة التي ترِد في الخطب الملكية من حيث تسجيل ضعف نتائج السياسات المتبعة،والعوائق التي تحول دون الاستفادة الاجتماعية من سياسات الأوراش والبرامج؛وهو ما أدى، مرة أخرى، إلى المطالبة بالتفكير في «نموذج تنموي جديد» لعله يكون مدخلا خَلاصيًا «لتنمية متوازنة ومنصفة… تضمن الكرامة للجميع، والشباب منهم بالأخص، وتعميم التغطية الصحية، وتعليم جيد، وقضاء منصف، وإدارة ناجعة»، وغيرها من الأهداف النبيلة في ذاتها.
لكن هل يمكن التعويل على إنجاز هذه الأهداف،وفي الآن نفسه يستمر الإصرار على تشجيع الاستثمار الرِّبْحي في التعليم والصحة، علما أنهما قطاعان اجتماعيان من الاختصاصات ذات الأولوية لكل خدمة عمومية؟ وكيف يمكن فهم أو تقبُّل كون المواطن يدفع الضرائب ويجد نفسه، مُكرهًا، لكي يصرف على تعليم أبنائه، وتغطية مصاريف التطبيب والعلاج، وعلى غيرها من الخدمات؟وهل حقا يمكن اعتماد سياسات تقوم على حرية السوق والنهج الليبرالي وفي الآن نفسه نتوقع الحد من الفوارق وتجسير الفجوات بين الفئات والجهات؟
لا شك أن هذا النمط من الأسئلة ليس جديدا، وطرح بأكثر من صياغة ومن طرف جهات مختلفة أثناء جلسات الاستماع والتواصل التي نظمتها لجنة «النموذج التنموي الجديد». والمؤكد أن استمرار اقتصاد الريع، وتضارب المصالح، والفساد، وتنامي التفاوتات، خصوصا في القرى والمدن الصغيرة والأحياء الهامشية في المدن الكبيرة، وتجبُّر جماعات الضغط المصلحية (كما تبيَّن، بشكل غريب، في ما جرى في مجلس المنافسة بخصوص موضوع المحروقات)؛تبدو هذه العوامل المتظافرة أنها بصدد إفراغ ما يقترحه «النموذج التنموي الجديد» من سياسات وتوجهات، يعتبر العديد من العلماء والمثقفين المغاربة، الذين شاركوا في تحريره، أنها الأصلح لتجاوز عوائق النهوض، والتي من دون التغلب على هذه»العوامل»المعيقة يصعب على المغرب خوض الاستحقاقات الكبرى التي انخرط فيها، سواء في أفق الارتقاء بالإنسان المغربي إلى مستوى المواطنة وتحقيق العدالة والإنصاف، أو ما يتعلق بشروط إنجاح تحدي المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة2030؛ والذي سيجعل المغرب، هذه المرة، ليس في قلب العالم فقط؛ بل سيجد نفسه مطالبا بضرورة توفير الشروط الموَحَّدة عالميا لاستقباله.
ومن أجل تحقيق ذلك،وفي ضوء الكثير من الإنجازات الكبرى التي تحققت طيلة العقدين الأخيرين من دون منازع، ومنها قرار الحماية الاجتماعية؛يبدو أننا أمام حاجة تاريخية ملحة إلى حزم سياسي صريح، وإلى تنشيط ما تواطأ عليه المغاربة من قيم، دستوريا، وإلى تعبئة وطنية واسعة لمحاصرة الفساد في إطار القانون، والحد من الهدر المريع في المشاريع والالتزامات والأموال العامة، مهما كان مصدر هذا الهدر ومن يسببه، وتقليص الفوارق المتنامية، وضبط الأسعار التي تقهر العقول والنفوس، والانتباه إلى انتظارات المرأة والشباب، والحرص المستمر على خلق بيئات حاضنة للإبداع بكل حقوله وتشجع عليه، والرفع من قيمة الكفاءة والاستحقاق والمبادرة، وإطلاق الحريات ضمن «الاختيار الديمقراطي»، الذي أضحى ثابتا من ثوابت البلاد، وسن سياسات تستجيب حقا لمتطلبات المواطنة، وتثمين مقومات الهُوية الثقافية، والاستمرار في الإعلاء من شأنها بالتجديد والتطوير والإضافة، واستنبات الثقة والاعتراف، المقترنة بالجدية الضرورية؛وغيرها من المقتضيات التي إذا ما تحررنا قليلا من آفة النسيان، وأعدنا قراءة تقرير «النموذج التنموي الجديد» سنجده يتضمن أكثر مما ذكرناه، وأكثر مما سبق أن سماه تقرير الخمسينية ب»المغرب الممكن».