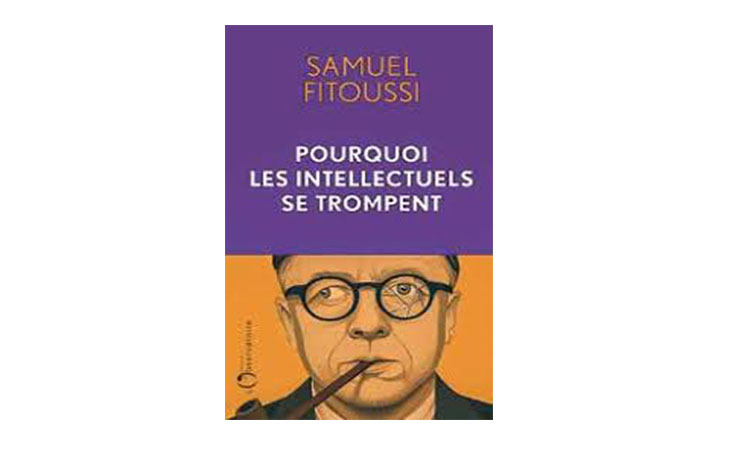المرئي والمهمل
ميثاق القرب:
«هل يجدي المكان؟» (ص: 49). يصعب إغفال الحديث عن العلاقة الوثيقة التي تجمع الشاعر عمر العسري بالأماكن. فالمكان في النص هو الفكرة السائلة والمعنى المتحرك، بل هو «المنطق» الذي يصنع الشكل على مستوى الإيقاع المكتظ بالإشارات الهندسية اللافتة.
إن المكان في «المقر الجديد لبائع الطيور» ليس مجرد خارطة يتكفل الشاعر باستعراض حجمها وأسماء مدنها وأحيائها، وخطوط طولها وعرضها، وتمدداتها وانحناءاتها، كما أنه ليس أبعادا هندسية تتأسس على الانفصال والاتصال، بل «شيئا «مرئيا يصهر العلائق التي يكتظ بها النص، ويمنحها حياة أخرى. إنه بمعنى من المعاني «إقامة بالقرب من الأشياء»، والإمعان في اقتطاعها من «العابر»، ودفعها دفعا جميلا نحو البروز في «إمكان شعري متداخل ومتشابك ولا يرتاح للأطراف.
يقول الشاعر: «أحد ما/ حفر اسمي/ على الأسوار الخلفية للمدينة» (تمثال من فراغ. ص: 13).
إن هذا الترابط بين «الاسم والأسوار»، أي بين الذات والمكان، هو ميثاق التماسك الشكلي بين جميع نصوص الديوان. إنه بمعنى من المعاني «الوصلُ الفاصل» بين الذات وموضوعها. ليس هناك أي شكل عرضي غير مفكر فيه يخترق «لوغوس النص» إذا صح التعبير. فـ»الاسم» يمتحن ذاته عبر رؤية نفسية ووجودية لـ»الأسوار» من خلال فجوة ساخرة مبنية على تمايز المعنى وإخفائه، مع ضرب من «الإدهاش القصدي المبجل»، من قبيل «الثلاجة المليئة بالبطارق المقهقهة»/ «تلفاز يبث مشاهد مباشرة من الفردوس»/ ‘قلامة أظافر الأرواح المتسخة»/ الفيل الإفريقي الذي يستلقي على ظهره بعد الظهيرة في حديقة المدرسة».. إلخ.
يعمل هذا الترابط، إذن، من أجل خلق «فرجة» قائمة على «الواقع الفائق» أو على ما يمكن تسميته بـ «الحفر من أجل ملاحقة الأثر السريالي المتبدي في الواقع». ألا يقيم الشاعر في «إناء دافئ/ يطفح بحساء الحياة الساخن» (ص: 21). وهي فرجة تتأسس على خلق الاشتباه، وعلى القضاء على أي إمكانية للتمييز بين الواقع والخيال على المستوى النصي. فليس في النصوص أي انسحاب (رمزيا كان أم حقيقيا) من المكان. بل هناك إحساس قوى بالانتماء في العلاقة مع الغير (الأسوار)، ومع جميع الأشكال الأخرى المتاحة، بما فيها اللغة والمجاز، والمعنى أيضا.
الالتواء والتوسع:
إن قراءتنا للأعمال السابقة للشاعر عمر العسري: («عندما يتخطاك الضوء»، «يد لا ترسم الضباب»، «من أي جهة يأتي الصياد»)، تسمح لنا بالقول إن هذا الديوان «قفزة» في إحساسه بالمعنى، وخروج من «الملجأ اللغوي الآمن» إلى ما يمكن تسميته بالإنجاز المرئي أو «أفلمة اللغة» أو عرض «الأشياء والأسماء» على الشاشات المبهرة.
وبطبيعة الحال، لا يمكن لهذا «الحكي المرئي شعريا» أن يتحقق خارج الإلحاح على التمثل الخاص للمكان، وخارج ميثاق الترابط بين الأصبع والإشارة على مستويات عدة، صوتيا ونحويا وسياقيا. وهذا ما يمكن الوقوف عليه في مختبر نص: «منديل أبيض مدرج بالفراشات الميتة». إنه نص شعري مسرود يتمتع بقوتين أساسيتن سبق أن انتبه إليهما رولان بارث، أي الالتواء والتوسع. ذلك أن المدلول السردي يتوزع، هنا، على عدة دوال يبتعد كل منها عن الآخر، فيما تمتلئ هوة المعنى بالتماسك السردي. إننا أمام قصة متكاملة الأركان يتأسس وجودها على ما نسميه «مسرود الطريق». يقول الشاعر:
«هاأنذا يا سادتي/ أركب/ الحافلة السريعة/ الماضية إلى وادي «زم»/ غايتي الوصول/ إلى أرض الفشار/ كنت/ وحدي.. وحدي فقط/ على المقعد الأخير/ ولم أكن/ أتبين وجه السائق/ غفوت/ طيلة المسير / لم تكن ثمة دوريات/ أو إشارات مرور/ وصلنا/ فنزلت/ هنالك/ كانت الأرض حامية كأعماقي/ كالبركان النشيط/ فشرعت/ أتقافز/ على منوال/ كل من يحيطون بي/ نتقافز/ نتقافز/ نتقافز/ كالكناغر الصغيرة/ وفي ومضة/ صرنا فشارا أبيض/ أحمر/ أزرق/ أخضر/ أصفر/ نتناثر في شتى الجهات.. إلخ».
إن هذا النص الدال الذي يشكل كلا واحدا، يقدم شكلا حادا من الالتواء، ليس على مستوى «خطية الجملة الشعرية»، بل على مستوى التخييل بالدرجة الأولى، مما يقوى التماس مع القارئ، وذلك بإبقاء السلسلة مفتوحة على بناء مزيد من التشويق، خاصة أن التثغيرات يمكن أن تُملأ إلى ما لا نهاية بمصائر «ركاب الحافلة» الذي تحولوا، في «أرض الفشار»، إلى «قطع فشارية» متعددة الألوان. وهذا يذكرنا بما يمكن تسميته بـ»سرديات التحول» على نحو ما نجده عند أوفيد في «تحولاته» أو لويس كارول في «بلاد عجائبه». التحول ليس بوصفه فعلا تاريخيا، ولكن بوصفه فعلا جماليا يستبدل المعنى باستمرار، ويتيح له الاتجاه نحو أرض أخرى غير مطروقة، والاندماج مع المعنى الذي يتحقق خارج التعاقدات الواعية المسبقة، أي خارج الموانع وإشارات المرور.
نقرأ من نص: «أحلام معطوبة في مقبرة السيارات الصدئة»: (أحرس/ مقبرة مهجورة/ تنعق بداخلها غربانُ الشعر/ أصنع بحرا/ بحرا بداخلي/ بحجم سفينة/ ترقص فوق حجر بركان/ أجمع/ شتاتي/ وحيدا/ وحيدا ثم أغيب مثل أفعى/ يافعة في الرمل).
نلاحظ هنا بشكل واضح أن التحويل يتأسس على نوع من التصعيد الشعري المفكر فيه والمعبر عنه إلى درجة الإفصاح (التكرار، القطع الحاد، الخيار الإسنادي، الوصل الغجائبي..إلخ). ذلك أن الإيقاع يحضر بوصفه أكثر انحيازا إلى الإحساس العاطفي الخافت، والحال أنه نوع من «التجلي» للمكان في تشوهاته العاكسة للتشوه الداخلي، من خلال آلية التحويل التي لا تحصر التجربة النصية في إطار مغلق، بل إنها «حياة المعنى المتغير من صورة إلى أخرى التي تنشأ في المكان، وتأتي لمقابلتنا»، كما يقول الشاعر الفرنسي ميشيل ديغي. ليس هناك أي وضع نهائي للأشياء، وكل الصور، حتى الأصلية، تحتاج في الشعر إلى إعادة ابتكار، ولن يتحقق هذا الابتكار إلا عندما نجعل الصور نفسَها تقول أي شيء آخر، بمجرد حشرها في مفترق طرق الخيال، أي في ذلك المكان الشعري الذي يحافظ على علاقة فريدة ومعقدة مع أشيائه، ويعود بها دائما إلى شبابه الأول، أي إلى «نضارة التخييل».
إن الشاعر بهذا المعنى يخترع أمكنته الخاصة من خلال استبعاد إغراء السرد المباشر. إنه يسرد، كما قلنا آنفا، بالالتواء والتوسع. وتسمح له هذه الاستراتجية بإطلاق كل قدراته الحسية والذهنية من أجل بناء صوره المفارقة أو إيقاظِها من غفوتها على جدار مهمل، أو على مقعد مهجور، أو يخرجها من قيدها الدعائي أو التلفزي أو السينمائي أو التشكيلي، فيدمجها على نحو مدهش في سياق يرتقي بها نحو أصقاع وخرائط شعرية لا تضاهى، كما يتجلى ذلك في نص «منفذ الإغاثة» (ص: 117)، أو نص «طارق الصواني النحاسية» (ص: 119).
إننا نزعم بأن «رسكلة» المرئي تعتبر من أهم الدوال التي تبرز الاغتناء النصّي، على مستوى المكان، وذلك من خلال توظيف المتاح والعابر واليومي في لعبة «مونتاج» سينمائي خاص يرتبط باستدعاء «المتلاشي» وتقطيعه وتركيبه في سياق نصي متحرك يتيح إنتاج معاني أخرى. ولذلك ليس غريبا أن نجد في هذا العمل الشعري ترتيبًا للنصوص خاضعا لشكل متنوع من المونتاج، على مستوى الصياغة والتشكيلات البصرية، فضلا عن الإيقاع، وخاصة الإيقاع بمفهومه الشامل، كما يراه الفيلسوف جان لوك نانسي.
انعطاف «الأتوبيوغرافيا»
ما يستوقفنا، أيضا، في تجربة «المقر الجديد لبائع الطيور» هو إحساسنا الكبير بالتنوع الهائل للأزياء الأدبية (النصوص، المرجعيات، المشاهدات.. إلخ). هذا الإحساس يبرز عبر اكتشاف «الجوار التخييلي» المثير للدهشة أحيانا. كل شيء كان هنا. كل شيء موجود سلفا. كل شيء قابل للفوتوغرافيا والتحويل. كل مكان هو شكل ناقص علينا إكماله، ولا يحتاج سوى إلى «دوامة نفسية تقمصية» بتعبير بيير ميشون صاحب «حيوات صغيرة»، كما لا يحتاج إلى أي شي آخر عدا «قراءة قريبة» مبنية كليا على إعادة إنتاج المكان داخل بنية نصية تعمل من الداخل على الخرق والتعديل. وسنجازف بالقول، في هذا المستوى، إن هناك نوعا من «الوثائقية الشعرية» تجري في عروق هذا العمل الشعري.
لا يمكن إغلاق هذه المقاربة دون الاعتراف بالدور المحوري لـ»السيرة الذاتية» و»التخييل الذاتي» في الديوان. صحيح أن صوت البوح الشعري خافتٌ. لكن من باب الإنصاف أن نقول إن النصوص بنتٌ شرعيةٌ للشعور الذاتي المرير والساخر بالخيبة، إذ رغم نهوضها، إجمالا، على المشهديّة السرياليّة المدهشة، فإننا نسجل بوضوح أن «الأتوبيوغرافيا» على قيد الحياة. ومن ثمن، فإن ضخ السريالية في «الأتوبيوغرافيا» هو الحصن الذي يلغي الإحساس المدمّر بالخواء.
إن الشاعر عمر العسري يضعنا أمام «قردة تتقافز بين أشجار المجاز»، و»مرآة أصيبت بالعمى»، و»امرأة تعيش مع تنين حزين» إلخ، لكنه مع ذلك يأخذ بتلابيب «الأتوبيوغرافيا» بمحكي حار ممتلئ بالمعنى والغرائبيّة والسخرية من كل شيء. بل إننا ندعي أن هذا هو المنعطف المربك لكل نص من نصوص الديوان.
نقرأ من نص «الإقامة مع حيوان غامض»: (بعد اليوم/ لا أريد سوى حياة عادية/ أن أسير في طرق غير شاقة/ أن أمضي/ وأن أرى نفسي من بعيد/ كشبح/ يقولي لي: باي باي) (ص: 86).
إن للمسافة بين الذات ومضاعفِها شكلَ القذيفة في وجه الانكسارات والهزائم والخيبات. شكل يسخر من الأمكنة الهامشية المنفلتة من ثقل المؤسسات، حيث يصل الإقناع الجمالي إلى ذروته، وحيث تصبح السخرية والباروديا والديستوبيا والأوتوبيوغرافيا إحدى المقومات الأنطلوجية التي لا غنى عنها في الكتابة.
تمثال من فراغ
أحد ما
حفر اسمي
على الأسوار الخلفية للمدينة
أحد ما
أراد أن يقلق سكينة
القطط المتسافدة
أن يطير أنثى الحمام
من عشها
أن يفزع اللقلق
كي يغادر القمة المتبقية
أن يمزق نسيج
العنكبوت الحكيم
هو وحده
هذا القادر على إزعاج
سلم ريختر روحي
يظل غارقا في قلقه الأبدي
إذ أنا… مجرد تمثال
من فراغ
مجرد غبار على حافة الشرفة