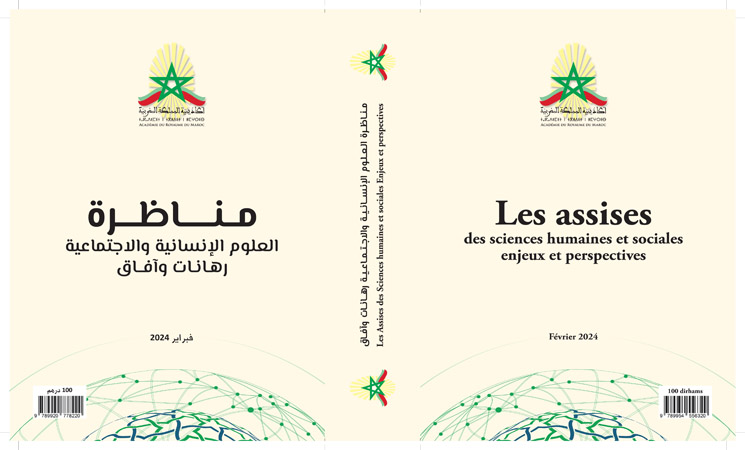السؤال الأول:
هل نتحدث عن مشروع ثقافي اتحادي فعلي، أم عن تراكُمٍ ذاكراتي يُعيد إنتاج رمزية قديمة دون مساءلة راهنية؟
الجواب:
الحديث عن «مشروع ثقافي اتحادي» لا يستقيم إلا إذا توفّرت شروط المشروع بالمعنى الفلسفي والسياسي، وهي على الأقل ثلاثة:
1- حضور رؤية مستقبلية.
2- تحديد لمفاهيم التدخل.
3- وأفق إنجازي مبرمج يتجاوز حدود التراكم الخطابي والنوستالجيا التنظيمية.
أما الاكتفاء باستدعاء المنجز الاتحادي الثقافي بوصفه «ذاكرة مشرّفة» فهو انزلاق من أفق التأسيس إلى فخّ التقديس من جهة وممارسة جماعية لا واعية لاستعلاء أخلاقوي على جزء من مكونات المشهد السياسي، بل على جزء من المكون الاتحادي نفسه، تحت ذرائع الثقافة والمثقف بوصفهما امتيازا لا بوصفهما مسؤولية تجاه المؤسسة الحزبية والمناضلات والمناضلين والعاطفات والعاطفين.
المشروع، كما يُفهم في سياقات الفكر السياسي، ليس استعادةً للذات، بقدر ما هو تمرين على إعادة بنائها في ضوء الأسئلة الجديدة التي يفرضها الزمن الجديد. يمكن أن يجري كل هذا بعيدا عن الاطمئنان وركون العقل الاتحادي المثقف إلى بعض مسكوكات المفاهيم التي يعتبرها مبادئ تأسيس، والتي يمكن أن يكشف افتحاصها النقدي عن عدم موافقتها للزمن السياسي الراهن. كما يمكن أن يجري ذلك قريبا من الانخراط في زلزلة المفاهيم وتفكيك مسلمات السردية الاتحادية الثقافية في أفق وطني لا حزبي.
بعبارة أدق: نحن أمام نداء ثقافي في حاجة إلى أن يتحوّل من طقس موسمي، ما قبل الائتمار إلى مشروع معرفي وفلسفي له أدواته وآلياته ورهاناته المعلنة، في توزيع أدوار عقلاني قوامه ثلاث حلقات تغذي كل واحدة منهما الأخرى:
1- بصيرة المثقفين: دورها بسط الرؤية
2- شجاعة القادة: دورها ريادة التحول والتعبئة له
3- ونضال القوات الشعبية: وهي الآلة التنفيذية بوعي وتبصر
السؤال الثاني :
ما المقصود بـ»الثقافة الاتحادية»؟ وهل يمكن تحويلها من هوية خطابية إلى رؤية نقدية تتفاعل مع تحولات المجتمع؟
الجواب
إن الحديث عن «الثقافة الاتحادية» يستلزم تخليصَها من وهم كونها كينونة صلبة بنوع من الإحالة على جوهرانية ثقافية مفترضة، تكاد تنزع عن هذا الكائن المفترض طابعه التاريخي الجدلي. والحال أن أي ثقافة حزبية، إن لم تُبنَ على وعي بتأثيرات الزمن والمجتمع، فإنها تغدو نسخة غير محينة من ماضٍ يُعاد إنتاجه تحت ضغط مبادئ التأسيس التي هي نتاج شرطها التاريخي وليس تحت ضغط الضرورات التي هي نتاج الحاجات الناشئة.
الثقافة الاتحادية، إذا أريد لها أن تكون رؤية لا مجرد ذاكرة، فسيتعين أن تتجاوز منطق الهوية إلى منطق التفاعل، وأن تُعرّف نفسها من خلال الأسئلة التي تطرحها لا من خلال الصفات التي تسبغها على ذاتها.
فهي ليست عقيدة، ولكنها أفق تأويلي للواقع؛ وليست لائحة شرف نضالي، بل نسق مقترح للحلول في لحظة تاريخية موسومة بالتحوّل والسيولة، والانفصال عن المرجعيات/أو السرديات الكبرى التي لطالما روجت لوهم خلاص كامل.
إن شرط ولادة «الثقافة الاتحادية الجديدة» هو قدرتها على إعادة إنتاج ذاتها نقديًا، وعلى مقاومة غواية التكرار التنظيمي، والانفتاح على صيغ جديدة للفكر والتربية والتأطير والإبداع دون أن تفقد صلتها بالتقاليد النضالية التي منحتها شرعية الوجود الأول.
هو إذن تحويل في ضوء ثابت
المجموعة الثانية: سؤال العلاقة بين الثقافة والسياسة في زمن التفاهة الرقمية
السؤال الأول:
-ألا تزال الثقافة قادرة على لعب دور البوصلة القيمية للفعل السياسي في زمن التأثير الخوارزمي والشعبوية الرقمية؟
الجواب:
لقد تغيرت بنية سلطة القيم في العصر الرقمي. لم تعد الثقافة – كما كانت في سبعينيات القرن الماضي – هي ذاك الحقل الرمزي المؤطر للنضال السياسي والمعنوي أي قاطرته، بل غدت عرضة لتقنيات الاختزال والتفكيك والابتلاع داخل منظومات خوارزمية تشتغل بمنطق الربح الفوري، لا بمنطق التأسيس الفكري.
السؤال الذي يجري طرحه حاليا «هل ما زالت الثقافة قادرة؟»، غير أن السؤال الذي يتعين طرحه في أفق تغييري: «أي نوع من الثقافة ما زال قادرًا؟».
الثقافة التي تنطلق من فكرة المعنى العميق، من القدرة على تأطير الوعي وبلورة الضمير الجمعي، باتت اليوم مهددة بثقافة الصورة، وثقافة التفاعل الخاطف، والانفعالات الجماعية المصنَّعة. في هذا السياق، فإن الفعل السياسي إذا لم يُعد تعريف علاقته بالثقافة، وإن هو لم يُحصّن خطابه من الابتذال التقني، فقد يفقد بوصلته القيمية.
من هنا، فالثقافة – إذا أُعيد بناؤها بما يليق بسؤال العصر – يمكن أن تستعيد مكانتها كبوصلة، لا من خلال الارتكاز إلى سلطة الماضي، بل من خلال التموقع في قلب التحول التواصلي والسيبراني، والاشتباك مع الشروط الجديدة لإنتاج الفهم وتأويل العالم.
السؤال الثاني:
ما موقع «المثقف الحزبي» اليوم أمام صعود المؤثر اللامنتمي وتراجع سلطة النص والخطاب العقلاني؟
الجواب:
لقد تحوّل المشهد القيمي من «المثقف العضوي» إلى «المؤثر الخوارزمي»، ومن منبر الجرائد إلى خوارزميات المنصات. هذا التحول لا يعني زوال المثقف، بل إعادة ترتيب السلطة القيمية حول أشكال جديدة من التأثير لا تشترط التراكم المعرفي، بل «قابلية الاستهلاك».
في هذا السياق، يبدو «المثقف الحزبي» وكأنه عالق بين نموذجين: نموذج الرسولي الذي فقد جمهوره، ونموذج التأثيري الذي لم يتقن تقنياته. لذلك فإن إعادة التفكير في وظيفة المثقف داخل الفضاء الحزبي تقتضي الاعتراف أولاً بتحول بنيات التلقي وآليات إنتاج الوجاهة الاجتماعية.
لم يعد كافيًا أن يكون المثقف «صاحب موقف»، بل يجب أن يكون قادرًا على تفكيك الزمن القيمي الجديد، والتدخل داخله، لا ضده. فإما أن يُنتج الحزب مثقفين بوسائط جديدة وخطابات تجريبية، أو يترك المجال فارغًا أمام المؤثرين، فيتحول هو نفسه إلى جهاز إداري بلا روح ثقافية.
للتأكيد، فحديثي هنا عن مثقفين ينتجهم الحزب لا عن مثقفين يكتفي باستقطابهم.
(*)عضو لجنة الثقافة ومسيرة الجلسة الثالثة في الملتقى الثقافي