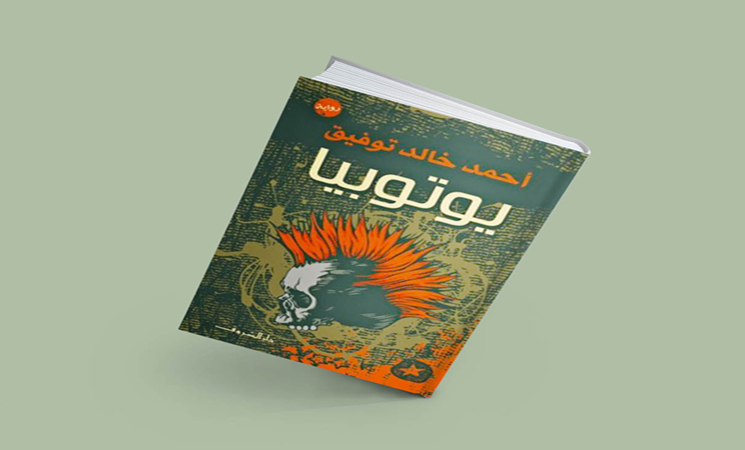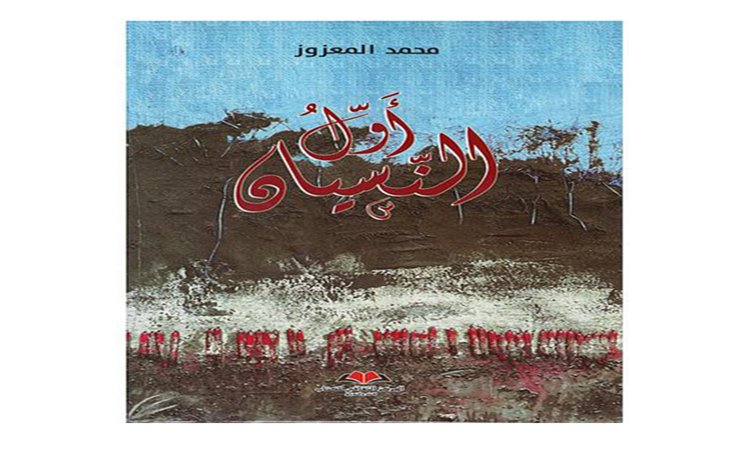الترجمة والثقافة والهوية: الأنا والآخر
نظم المركز الثقافي بالداوديات، ندوة ثقافية برحاب قصر البديع يوم الأحد 3 نونبر 2022 الماضي. وقد شارك فيها كل من الأستاذين عبد الكبير الميناوي وعبد العزيز البومسهولي كما قام بتسيير أشغالها الأستاذ عبد الجليل بن محمد الأزدي.
1 – الأصل والنسخة .
ا- لأنا والآخر
ينطلق الأستاذ عبد الكريم الميناوي في هذه الورقة من جملة أسئلة حول الترجمة، مشددا على دورها الأساسي والمحوري في التقريب بين الشعوب والثقافات.كما ترصد ما تثيره من نقاش على مستوى نقل النصوص الأدبية، عربيا وعالميا، قديما وحديثا، مع التمثيل لذلك بنماذج.
لماذا نترجم؟ من أجل ماذا نترجم؟ لمن نترجم؟لعلها ثلاثة أسئلة، من بين أخرى، يثيرها كل تأمل حول الترجمة، يروم تبيان ملامحها الجوهرية.بالنسبة للباحثين والمهتمين، فنحن «نترجم لاختلاف اللغات والثقافات»، يقول أمباروأورتادو ألبير، في «الترجمة ونظرياتها». هذا يعني أننا نترجم بغرض الاتصال، وتجاوز الحاجز الناجم عن هذه الاختلافات اللغوية والثقافية، أي أننا «نترجم لشخص لا يعرف اللغة المترجم عنها، وعادة ما يجهل ثقافتها»، حيث أن المترجم لا يقوم بعملية الترجمة لنفسه، وإنما لـ»متلق هو في حاجة إليه كوسيط لغوي وثقافي»، حتى يتمكن من «فهم نص بعينه».فيما «لا يمكن أن نطلب من هذا العلم تطابقات لا يمكنه الوفاء بها نظرا لطبيعته»، الشيء الذي يطرح «قضية استحالة الترجمة أو عدم القابلية للترجمة».
لقد وجدت الترجمة «لأن البشر يتكلمون لغات مختلفة»، الشيء الذي يفسر عدم إمكانية تجاوز وظيفتها التي تتمثل في «تقريب البعيد وضيافة الغريب»، كما نقرأ في «المترجم كاتب الظل» لكارلوس باتيستا.
ولعل ما يمنح الترجمة حضورا متجددا على مستوى البحث والنقاش أن «الترجمة المثلى قد لا تكون سوى حلم يوتوبي»، على رأي جن دي، في «الترجمة الأدبية»؛ إلا أنها «هدف واقعي جدا لأغلب المترجمين الجادين، وعلى الأخص لأولئك الذين كرسوا أنفسهم للترجمة الأدبية»، التي يتمثل هدفها النهائي في أن «تنتج تأثيرا على قراء اللغةِ الهدفِ قريبا قدر الإمكان مما يحدثه الأصل على قراء اللغة المصدر». وبما أن التطابق غير وارد، فإن الهدف الأفضل الذي يستطيع المرء العمل من أجله هو «تقريب قدر الإمكان»، ما يعني أن «التأثير المكافئ ممكن فقط عندما تقدم الترجمة رسالة قريبة من رسالة الأصل قدر الإمكان».
بين الوفاء والخيانة:
يختصر بول ريكور، في كتابه «عن الترجمة»، الصعوبات المرتبطة بالترجمة – باعتبارها «رهانا صعبا، وفي بعص الأحيان من المستحيل رفعه»- في لفظ «محنة»؛ وهي المحنة التي يجد المترجم نفسَه خلالها بين نارين: «رغبة الوفاء وشكوك الخيانة»، الخيانة التي يقتضيها، كما يكتب سعد سرحان، في «مرايا عمياء»، الإخلاص للنص».
يمكن للترجمة أن تتحول إلى فعل انتقائي، تتمخض عنه تبعات تتجاوز حدود العمل المترجم إلى نوع من المحاكمة للعلاقة التي يفترض أن تربط بين اللغات والثقافات، يقول عبد الفتاح كيليطو، في «مسار»: «لما ترجم غالان كتاب ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية في بداية القرن الثامن عشر، لم يحتفظ بما فيه من مقاطع شعرية. وهكذا تكونت عند الأوربيين فكرة مفادها أن العرب أهل سرد قصة؛ بينما يرى العرب أنهم شعراء أولا وقبل كل شيء».
بالنسبة لكيليطو، في كتابه «الأدب والارتياب»، فترجمة ألف ليلة وليلة جعلت هذا النص «يبتعد مؤقتا عن أهله وذويه، قبل أن يعود إليهم، بعد أن أهملوه ولم يولوه ما يستحق من عناية.فـالكتاب لو لم يترجم لما اهتم به العرب، فالترجمة هي التي أعلت شأنه ورفعت قدره».
مفارقات الترجمة:
يصير الأمر أكثر مدعاة للقلق حين نكون مع ترجمات متفاوتة القيمة للنص الواحد. نمثل ذلك بكتاب «بنية اللغة الشعرية» لجون كوهن، الذي يبقى، بحسب محمد الولي،»من أبرز آثار الشعرية المعاصرة»، كما أنه كتاب «لا يمكن تجاهله حينما نكتب تاريخاً للشعرية».
لكن، لماذا العودة إلى كتاب نشر في لغته الفرنسية، في 1966، وترجم إلى اللغة العربية، في نسخة «مصرية»، سنة 1985، من طرف أحمد درويش، تحت عنوان «بناء لغة الشعر»، وفي 1986، في نسخة «مغربية»، من طرف محمد الولي ومحمد العمري، تحت عنوان «بنية اللغة الشعرية»؟
أولاً: لأن الكتاب ظل حاضراً، تقريباً، في كل نقاش أو مبحث يخوض في المسألة الشعرية، تماماً كما كان الشأن مع كتب أخرى لكتاب غربيين، وإن بدرجات متفاوتة، وذلك تبعاً لسياق التناول؛
ثانياً: لأن تداول الكتاب في مشهدنا الأدبي، يثير قضية، على درجة من الأهمية، يتواصل بصددها النقاش، وربما التفاوت في وجهات النظر، بين المهتمين، تهم فعل الترجمة، بشكل عام، وترجمة أعمال أجنبية إلى اللغة العربية، بشكل خاص. ولنا في الجدل الذي طرح بين مترجمي هذا الكتاب، خير مثال.
يخصص أحمد درويش، حيزاً مهماً، من تقديم الطبعة الثالثة، لترجمته لكتاب جون كوهن، تحت عنوان «بناء لغة الشعر»، للحديث عن ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، التي حملت عنوان «بنية اللغة الشعرية». ولقد ركز أحمد درويش على سؤال لماذا تركت، في النسخة «المغربية»، نصوص شعرية دون ترجمة، مذكراً بأننا نترجم نصاً فرنسياً «لمن لا يستطيع قراءة هذا النص في لغته الأًصلية»، الشيء الذي يستدعي، بحسب أحمد درويش، من قارئ الترجمة المغربية إلى العربية معرفة جيدة باللغة الفرنسية، مشيراً، في ذات الوقت، إلى غرابة مفردات لغة الترجمة. بل إننا نجده يدقق في جزئيات، يؤكد التفاوت بصددها كيف يمكن للأمور أن تكون عليه حين يتعلق الأمر بنقل مفاهيم وقضايا وإشكاليات أدبية كبرى، ومن ذلك تخصيصه، في مقدمة الطبعة الأولى، حيزاً للحديث عن طريقة اختياره كتابة اسم المؤلف بالحروف العربية. في النهاية، سنكون مع «بناء لغة الشعر» عنواناً و»جون كوين» كاتباً، في ترجمة أحمد درويش، ومع «بنية اللغة الشعرية» و»جون كوهن» في ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري.
من جهته، يقول محمد الولي، مستعيداً سياق الترجمة «المغربية» لكتاب جون كوهن: «حينما انتهينا من ترجمة «بنية اللغة الشعرية» وسلمناه لدار توبقال قصد النشر، علمنا بأن الكتاب منشور في مصر، بترجمة الأستاذ أحمد درويش. وقد سبب لنا ذلك بعض الاضطراب. وألححنا بعد إخبار الناشر دار توبقال على ضرورة الاطلاع على هذه الترجمة المصرية. وبعد الاطلاع وإعداد تقرير جد مفصل عن هذه الترجمة، تأكد لنا أن الترجمة المصرية لم تكن تستوفي الشروط الدنيا لترجمة مقبولة، ولقد امتنع الناشر المغربي امتناعاً كلياً عن الخوض ضمن تقديمنا للكتاب في نقاش بشأن الترجمة المصرية، وبالفعل نشر ترجمتنا. ولقيت من الترحاب ما لقيت. (…). ولعل أهم الملاحظات المتعلقة بالترجمة المصرية عدم إلمام الأستاذ أحمد درويش باللغة الفرنسية، بحيث أنه وقع في أخطاء لا تليق بباحث من هذا العيار».
لا ينسى الولي أن يدلي برأيه في ترجمة أحمد درويش، حيث يقول: «إن ما لاحظناه من أخطاء في اللغة الطبيعية، وفي اللغة الواصفة عند الأستاذ درويش، شيء فوق أنه يبدد المحتوى العلمي».
لسنا، هنا، في وضعية مفاضلة بين الترجمتين والمترجمين، بل نحاول إبراز تداعيات أعطاب الترجمة، وكيف أنها يمكن أن تؤثر في ما يتم البناء عليه من نقاش ووجهات نظر وأفكار. وهي حالة ليست جديدة على الثقافة العربية. يقول عبد الفتاح كيليطو، في «الأدب والارتياب»: «قد يكون لترجمة فاشلة قوة حدث. ذلك حال ترجمة متى بن يونس لـــــفن الشعر، ترجمة بشعة شنيعة لم تيسر فهم كتاب أرسطو، بل حجبته وصدت عنه، فكأنها أنجزت وصممت أصلاً لإضماره وتغييبه، لإقامة حجاب سميك وسد منيع دونه. حياتها موت، ووجودها عدم؛ وبهذا المعنى، أي بسبب إخفاقها المطلق في أن تكون جسراً ومعبراً، شكلت حدثاً، سلبياً بالطبع».
حديث كيليطو عن ترجمة فاشلة، بشعة وشنيعة، يضعنا على نقيض «الترجمة السليمة»، التي تنطلق من «الفهم السليم للأصل»، يقول جن دي في»الترجمة الأدبية».لكن، قد يكون المترجم عارفا باللغة المنقولة التي ينقل منها تمام المعرفة، ومع ذلك قد يتعمد الإخلال بها لتحسين النص المنقول وليضفي عيه جمالا ليس فيه ويرفع من شأنه…
شروط الترجمة:
ولأن الترجمة فعل إنساني قديم، فقد عملت كتابات النقاد والباحثين على تحديد شروطها وضوابطها، وصولا إلى ما يؤدي الغاية المرجوة منها. يقول الجاحظ في «الحيوان»: «ولا بد للتَّرجُمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلمَ الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواءً وغاية».
ما شدد عليه الجاحظ قديما، سيتوسع فيه أمبرطو إيكو حديثا، وهو يستعرض طريقة «أن نقول الشيء نفسه»، منتهيا إلى أن الترجمة تتلخص في «قول الشيء نفسه بلغة أخرى».
ما بسطه الجاحظ قديما وتوسع فيه أمبرطو إيكو حديثا، ربما يصلح مدخلا لتناول الكيفية التي تم بها التعامل مع «الترجمة» في عصر النهضة العربية، التي «اتخذت شكل التعريب الحر»، بحسب عبد الله إبراهيم في «موسوعة السرد العربي»، وخضعت للذائقة الأدبية المتأثرة بالمرويات السردية المزدهرة في تلك الفترة، بعد أن تصرف بعض المعربين في أسماء الكتب، وغيروا في أحداثها، وأخضعوا أساليبها لمقتضيات الأساليب النثرية العربية بما تتضمنه من صيغ سجعية في بعض الأحيان، أو لمقتضيات الأساليب المرسلة السهلة التي أشاعتها المرويات السردية في أكثر الأحيان.
يفضل عبد الله إبراهيم استعمال مصطلح «التعريب» بدل «الترجمة»، بمبرر خروج التعريب عن الضوابط الخاصة بالترجمة، بعد أن اختار المعربون الروايات الغربية التي توافق المرويات السردية في الأحداث والموضوعات، وجردوها من سماتها الفنية «امتثالا لمعايير تلك المرويات، ويضيفون إليها خصائص أدب العامة، الأمر الذي جعلها، من ناحية الأحداث والشخصيات، تماثل في ملامحها الأساسية المرويات العربية»، إذ كانت النصوص المعربة تتعرض إلى «تغييرات جذرية لتوافق الذائقة»، بعد أن «كانت تنتزع من حواضنها الثقافية والنوعية، ويعاد إدراجها في نسق ثقافي آخر»، ما يعني أن هذه الوضعية التي لم تأخذ في الحسبان «الدقة في النقل بين اللغتين المعرب منها والمعرب إليها».
يمثل عبد الله إبراهيم لخروج التعريب عن الضوابط الخاصة بالترجمة بعدد من النماذج، ومن ذلك أن رفاعة رافع الطهطاوي في «مواقع الأفلاك في مغامرات تليماك» قد «غيّر عنوان الرواية، ونقلها إلى أسلوب السجع المعروف في المقامات، ولم يتقيد بالأصل الذي ترجمه إلا من حيث روحه العامة، أما بعد ذلك فقد أباح لنفسه التصرف فيه، تصرف في أسماء الأعلام، وتصرف في المعاني، فأدخل فيها آراءه في التربية وفي نظام الحكم كما أدخل الأمثال الشعبية والحكم العربية، فلم يكن رفاعة مترجما فحسب، بل كان ممصرا للقصة».
هكذا «أصبح الحديث عن ترجمة أمينة غير ممكن»، والدليل الآخر شاهد عيان ينتمي إلى تلك الحقبة، ويمتثل لسنن التعريب الجديدة التي شاعت. يتعلق الأمر بخليل رينه الذي «أورد في مقدمة رواية «ناجية» التي أصدرها في عام 1884 ما يأتي: «رأيت أن أتحف خلاني برواية غرامية الموضوع، أدبية المغزى، كنت طالعتها في اللغة الفرنساوية تحت عنوان «خريستين» (كريستين)، وهي لا تزيد على العشر صفحات، فبسطتها ما احتمله المقام، وزدت في نكاتها، وغيرت ما لم أجده موافقا لذوق العصر، وخالفت المؤلف في روايتها؛ (…). فلست أعرف ماذا أسميها أ تعريبا أم تأليفا؟ على أنني أرى أن اسم التأليف أليق بها من التعريب، فإن من تصفح أصلا بعد مطالعتها، يرى ما بينهما من الفرق الواضح، والبعد الشاسع».
بحديث خليل رينه عن التأليف بدل التعريب، نصير أمام «تداعيات خطيرة»، تتمثل في «تغييب التأليف الأصلي من ناحية المؤلف والعنوان والتلاعب الكامل بالنص».
إيديولوجيا المترجم:
يثير خروج التعريب، في بداية النهضة الأدبية العربية، عن الضوابط الخاصة بالترجمة، وإخضاع الكتب موضوع الترجمة لمقتضيات الأساليب النثرية العربية، نقاشا حول «إيديولوجيا» المترجم وضوابط وشروط الترجمة، مع التركيز، بحسب أندري لوفيفر، في «الترجمة وإعادة الكتابة والتحكم في السمعة الأدبية»، على اللحظة حيث»يقررالجنس الأدبي المهيمن على الثقافة المستهدَفة إلى حد بعيد أفق توقعات القراء بخصوص العمل المترجم الساعي إلى دخول تلك الثقافة»، و»إذا لم يكن متفقا مع متطلبات الجنس الأدبي المهيمن على الثقافة المستهدفة زادت الصعوبات أمام استقباله».
ويذهب أندري لوفيفر أكثر في تناول النقاش حول إيديولوجيا المترجم وضوابط وشروط الترجمة، ملاحظا أن «صورة العمل الأدبي، كما تطرحه الترجمة، تتقرر بعاملين أساسيين؛ هما بحسب الأهمية، إيديولوجيا المترجم (سواء فرضها بمحض إرادته أم فرضها عليه كالقيد شكل من أشكال الرعاية)، والشعرية السائدة في الأدب المستلم للترجمة خلال وقت إنجازها»؛ حيث «تملي الإيديولوجيا الاستراتيجية التي سيستخدمها المترجم»، ومن ثم فهي «تملي الحلول للمشاكل المتعلقة بكل من «فضاء الخطاب» المعبر عنه في الأصل (أشياء العالم الذي كان يحيط بكاتب النص الأصلي، ومفاهيمه، وعاداته)، ولغة التعبير في الأصل».
على سبيل الختم:
نختم باستعراض أربع حالات تبين استحالة «الترجمة المثالية». يتعلق المثال الأول بميلان كونديرا، الذي جرد من جنسيته التشيكوسلوفاكية عام 1979، بعد أربع سنوات من مغادرته بلده للإقامة في فرنسا، التي سيحصل على جنسيتها بمبادرة من الرئيس فرنسوا ميتران. كانت روايات كونديرا قد لقيت شهرة عالمية بفضل ترجماتها إلى لغات عديدة، لا سيما «كائن لا تحتمل خفته» عام 1984، وفي عام 1995 انتقل إلى الكتابة باللغة الفرنسية مباشرة بعد تمكنه منها. وكان مما قام به مراجعته وتدقيقه لكل رواياته المترجمة إلى الفرنسية من قبل.
كتب عبد الله العروي في مقدمة «الإيديولوجيا العربية المعاصرة»: «سبق أن اشتكيت مما ألحقه بي التراجمة من الضرر».وأضاف: «أحصيت ما لا يقل عن مائة وخمسة وأربعين خطأ»؛ وقد «وصل الخطأ في مواضع كثيرة إلى قلب معنى النص».
تطرح الترجمة «مشكلة أخلاقية»، تتمثل، بحسب بول ريكور، في كتابه «عن الترجمة»، في «تقريب القارئ من الكاتب وتقريب القارئ من القارئ»، ضيافة لغوية، مع أنه ينظر إليها، أحيانا، بحسب عبد الفتاح كيليطو، في «الأدب والارتياب»، بعين «الريبة والحذر»، من منطلق أنها «حتى في أرقى مستوياتها، لا يمكن أن تفي بالنص الأصلي وأن تؤديه تماما». والأدهى من كل ذلك، أنه «ليس من النادر أن ينقل المترجمون، عوض النص الأصلي، إحدى ترجماته؛ يترجمون ترجمة»، الشيء يمكن أن يعطي لمزية التقريب بين الثقافات أبعادا سلبية، غير مفيدة، نجد ما يبررها أو يوضحها في جانب من «موقف معرفة المعارف» للنفري، حيث نقرأ: «من اغترف العلم من عين العلم اغترف العلم والحكم. ومن اغترف العلم من جريان العلم لا من عين العلم نقلته ألسنة العلوم وميلته تراجم العبارات فلم يظفر بعلم مستقر ومن لم يظفر بعلم مستقر لم يظفر بحكم».فهل علينا أن نقول إنه «لا حاجة بنا إلى الترجمة إن كنا نستطيع قراءة الأصل»؟لكن، قراءة الأصل تتطلب معرفة بلغات أخرى. وبين دراسة اللغات للقراءة من داخلها وقيمة الترجمات: مثالية، فاشلة، سليمة،ماذا، مثلا، عن إعجاب جيمس جويس بــ»الكوميديا الإلهية»الذي دفعه إلى دراسة الإيطالية، وشروع الشاعر السينغالي ليوبولد سيدار سنغور في تعلم اللغة الألمانية لكي يقرأ غوته في لغته الأصلية؟
يبقى أنه لا يمكن لفعل الترجمة إلا أن يثير المزيد من الجدل والنقاش ووجهات النظر بخصوص الأصل والنسخة،الأنا والآخر. إذ لا يمكن لسفر النص من لغة إلى أخرى إلا أن يتواصل. تلك ضرورة إنسانية وأكثر. سفر قد يفقد أثناءه النص بعض حقائبه، يقول سعد سرحان، في «مرايا عمياء»، مثلما قد يجد في نهايته حقائب بين أمتعته.
2 – الترجمة في أفق الغيرية أو كيف تغدو الترجمة ممكنة؟
يطرح علينا مفهوما « الغيرية» و» الترجمة» إشكالا جوهريا حسب الأستاذ بومسهولي، حيث يرتبط بسؤال الميتافيزيقا عامة، أي بشروط إمكانها، ولهذا يمكننا اعتبار سؤال الترجمة، سؤالا ميتافيزيقيا؛ من جهة كون مفهوم الترجمة، مفهوما بعديا (زمنيا وليس منطقيا)، إذ أن كل ترجمة هي بعدية، لأنها تتأسس في ما بعد الأثر، وهي لذلك لا تستعيد ذلك الأثر في تطابقه بذاته كأصل، وإنما تستعيده في ذات الغير، أي في فهم هذا الغير كذات، لبرانية ذاك الآخر الغريب. وما دام هذا الأمر على هذا النحو، فإن السؤال أعلاه: كيف تغدو الترجمة ممكنة؟ يندرج ضمن التساؤل، عن شرط إمكان الميتافيزيقا ذاتها، أي ضمن السؤال الكانطي: كيف تغدو الميتافيزيقا ممكنة؟
ولهذا علينا أن نفكر بكيفية مزدوجة، مع كانط وضده في الوقت عينه، في طبيعة هذا السؤال، أي من جهة أولى بكيفية «ترنستدنتالية» نحدد من خلالها الشروط القبلية لإمكان الترجمة؛ و من جهة أخرى، بكيفية محايثة، نحدد من خلالها الترجمة، لا كانكشاف للغيرية، بل بوصفها هي الغيرية ذاتها.
من الوجهة الأولى، ليست الترجمة ممكنة، إلا بفعل القدرة التركيبية للفكر، والتي تقوم في الذات، أي ذات الغير، مقابل ذات الآخر، ومعناه أن الترجمة لا تنشأ من الخبرة مباشرة، بل تنشأ من قدرة الذات كغير، على فهم ونقل وإعادة بناء أثر الآخر. وإذا كانت القدرة على الترجمة قائمة في الذات كغير، وكان موضوع الترجمة ينتسب لذات الآخر، فهذا يكشف بأن الترجمة تعبير عن علاقة أنطولوجية بالأساس، قائمة في كون الذات كغير، والذات كآخر، مشاركين للوجود. وهو ما يعني أن الترجمة هي تعبير عن «الاحتياج الأنطولوجي»، وهو غير القصور الأنطولوجي، الذي يدل على كون كل ذات في الوجود، هي ذات متناهية، منخورة بالنقص، إذ أن «الاحتياج الأنطولوجي»، إنما يدل بالإضافة إلى ذلك كله، على كون كل ذات هي في حاجة إلى شيء ما، بوصفه أثرا للآخر، أوهي في حاجة إلى ذات أخرى.وهذا الأساس، هو ما يحدد وضعية الذات، كغير إزاء الآخر.وبناء على ذلك يمكننا اعتبار الترجمة كفعل وجود، منشأه الرغبة في إرضاء الاحتياج الأنطولوجي. وفق ذلك يمكننا اعتبار الترجمة، تعبيرا أصيلا عن نمط الكينونة في العالم. وهذا يكشف عن كون كل وجود ليس مكتفيا بذاته، بل هو في حاجة للآخر، وأن هذه الحاجة هي ما يجعل هذا الموجود، ينكشف كغير، ما دام أن كينونته، هي في سعي دائم، منشأه الرغبة القائمة في الذات، نحو كل آخر، تتقاسم معه الوجود.وهذه الرغبة تسعى إلى فهم مزدوج للآخر، ولذاتها أيضا، ولهذا فهي بقدر ما تفهم الآخر، فإنها تسعى إلى فهم ذاتها ، وذلك لأن من شأن هذا الفهم، أن يعينها على صوغ نمط وجودها الخاص. ولهذا نستطيع أن نقول بأن السعي نحو الترجمة، إنما هو سعي نحو الكينونة. ونحن لا نترجم لأننا نصبو إلى اختزال الآخر في ذواتنا، بل نحن نترجم لكوننا في حاجة إلى إقدار كينونتنا على الغيرية، بما هي اقتدار على الوجود.
ومن الوجهة الثانية، يمكننا بكيفية محايثة، المطابقة بين الغيرية والترجمة، أي بكيفية يمكننا أن نقول – من خلالها- بأن «الغيرية والترجمة هما الشيء ذاته». وهذه المطابقة ليست اعتباطية، أو من قبيل المجازفة في القول، بل هي تعبير عن نمط الكينونة الأصيل. ومعناه أن الترجمة بمعنى الغيرية، يمكن تأويلها كمنبع للكينونة، أي أن كل ما تعيشه الكينونة من تجارب وأحداث إنما هو تعبير عن الترجمة؛ وهكذا تصير كل الأفعال الكلامية التي تعبر من خلالها كل ذات، عن إحساساتها ورغباتها ومواقفها وتصرفاتها،ترجمة أصيلة لهذه الذات، ومعناه أن الذات هي مفعول لفعل الترجمة، فالذات لا تظهر للعالم بوصفها ذاتا، إلا كترجمة. أما قدرتها على ترجمة وضعيتها، كغير إزاء ذاتها، في أفعال كلامية، ومواقف، وسلوكات، وتصورات، فهو الذي يجعل منها ذاتا، أي يجعل منها ذلك الغير على الإطلاق، إزاء ذاتها وإزاء العالم، بوصفه فضاء للغيرية. وهذا الوضع هو ما يجعل كل ذات في وضع ترجمة دائم؛ ترجمة ذاتها من جهة، وترجمة الآخرمن جهة ثانية. وليست الغيرية وفق هذا التأويل سوى هذه الترجمة التي تحدث أنطولوجيا، والتي تجعل كل ذات –تصير- غيرا، تجاه ذاتها وتجاه الآخر، كما تجعل كل علاقة «بيذاتية» – (Intersubjective) تصير- غيرية.
إن تأصيل الترجمة في هذا الأفق، لا يجعل منها فقط، وسيلة أداتية لترجمة آثار الآخرين، بل يجعل منها أيضا أسلوبا أصيلا يكشف نمط الوجود الأصيل للكينونة.
هذه الأرضية هي مجرد مدخل، لإثارة إشكال الترجمة والغيرية والمثاقفة، من أجل المساهمة في بناء تصور فلسفي، يمكنه أن يشكل إضافة في أفقنا الفلسفي والحضاري.