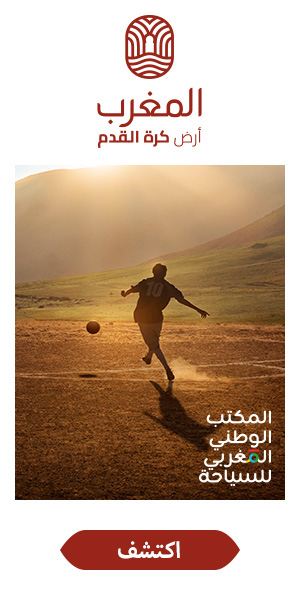هذا مؤلف الباحثة المغربية «نزهة بوعزة»، «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطيــن، الدين»، والصادر حديثا عن مركز «المغرب الأقصــى للدراسات والنشر، 2025». وتعتبر الباحثة من الأقلام النسائية المغربية التي اشتغلت على مباحث الفلسفة السياسية ومحاولة تأطيرها في السياق contextualisation المغربي، المغاربي، العربي، في محاولة رصد الواقع السياسي العربي والاسلامي وفق «سياق التجربة الراهنة لبعض المفاهيم السوسيوسياسية والمعرفية»، عبر ربطها بأفق الانتظار التاريخي والتجربة المفهومية واعادة قراءة الماضي بشكل نقدي. يضم الكتاب في أحشاءه مقالات عدة، موجهة بخط مفاهيمي ناظم، عن الدولة الوطنية في العالم العربي، والمسألة القومية la question nationale ، وإشكالية التقدم، ويعرج في ذلك، اي المؤلف، على اشكاليات راهنة، مرتبطة بمحورية القضية الفلسطينية، والذكاء الاصطناعي، والدور الأيديولوجي لكرة القدم، والحركات الاسلامية في العالم العربي، والزواج، والخطاب النسوي في السياق الاسلامي…
بعد الاحداث التي عرفتها المنطقة العربية، خصوصا منذ احداث 2011، الى احداث السابع من اكتوبر، والتي جعلت المفكر العربي المعاصر، ينصب مرة اخرى، على قضايا سياسية ونظرية هامة… انها القضايا التي ترسم «افق انتظار» و»الزمان التاريخي» (هذا المفهوم الذي يشكل احد الخطوط المفهومية العريضة في المؤلف، تستلهم الباحثة هنا اعمال راينهارت كوزيليك) الذات العربية منذ الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، الى «عصر الصورة» و «العولمة»… لكن هاته القضايا دوما ما نوقشت بشكل أيديولوجي، لكن من النادر ان تكون قد نوقشت بشكل علمي كثيرا…. (ومن هنا سياق المؤلف)
يساجل الكتاب مفهوم الدولة في التمثلات الجماعية العربية، ومن الطريف ان تكون البداية، في المقال الاول، عن اعمال تومس هوبس Thomas Hobbes، والذي يعتبر بحق، احد رواد النظرية السياسية في الغرب، الى الحد الذي يرفع عمله Léviathan الى عرش «الانجيل المدني» (لقد كانت اعمال رواد الليبيرالية السياسية، مقدمة لمنطق تصاعدي في التاريخ= من حالة الطبيعة الى حالة مدنية، ومقدمة لفصل سوسيوسياسي، بين العام والخاص، الروحي والزمني).
نشير الى فرادة هذا البدء : ففي العادة، كان بعض التقدميين العرب ينطلق من «نقد الليبيرالية»( وهو عنوان لعمل رئيسي لماوتسي على سبيل المثال Contre le libéralisme) دون مرور بالليبيرالية نفسها ومحاولة تأطيرها السياقي contextualisation في بنية الفكر السوسيو-سياسية العربية. ونسجل هنا اهمية هوبس النظرية في السياق الخاص بنا، فأحداث 2011، والتي مست عددا من الدول العربية، تبرر هاته العودة، ففي الوقت الذي كانت الاحداث، على الاقل على مستوى الشعارات (اقيم تمييزا بين مستوى الشعار ومستوى المضمون)، تنادي بالحريات الفردية او الديمقراطية او حقوق الانسان، سينتهي الحال الى الخراب، مظاهر الفوضى الخلاقة، التقسيم الطائفي، الميليشيات… اننا نعود الى ما يشبه الحالة التي وصفها هوبس بحرب الكل ضد الكل la guerre de tous contre tous، وفي عدد من الدول العربية، لقد اصبح الجسد دون رأس، المجتمع دون دولة…
كما ان تلك الاحداث ابرزت ذلك الوعي السلبي بحركة التقدم في التاريخ، اي ان تلك الاحداث لم تشكل، عتبة تاريخية (هذا المفهوم الرئيسي في الصيرورة التاريخية)، فمن جهة، يظهر ان هنالك تعطش ما لقيم الحرية، لكنها في نفس الوقت، مشوبة بكثير من النزعة الاخلاقية واللاتاريخية المتعالية على شروط التاريخ.
كما ان الاحداث، اعادت الاعتبار للمسالة القومية والاندماج بين الدول العربية. اننا نعتقد ان الامة (تقيم الباحثة ايضا تمييزا بين القومية والقومنة، والامة)، هي «امة متحققة بالقوة»، هنالك حس قومي يجعل المغربي يتعاطف مع الفلسطيني، والمصري يحتفل بفوز المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم/قطر2022، ومشاعر التضامن عقب الكوارث البيئية (كارثة مدينة درنة وزلزال الحوز)، لكنها غير متحققة بالفعل… انه حس قومي بقي حبيس التنظير… من هنا-تقول الباحثة، ضرورة «تحويل مطلب التحرر القومي الى مشروع وجودي يرتبط بمصالح اقتصادية/سياسية وثقافية»، وهنا تطرح عدة اشكالات في هذا المسار التاريخي، كإشكالية شخصنة القومية (نحيل بسرعة هنا، الى الاشارة الطريفة التي قام بها المفكر سمير امين، عندما قال ان عبد الناصر نفسه لم يصبح ناصريا الا بعد سنة 1956)، وقضية «هاجس الوصاية السياسية» وعلاقتها بالوحدة الاندماجية (نشير الى التمييز الذي يقيمه بعض المفكرين التقدميين بين شكل ومضمون النظام السياسي في تحليل البنية السياسية لكل دولة وطنية). هاته القضية التي تتجلى راهنا اكثر، على مستوى الاتحاد المغاربي، والعوائق التي تطيل زمن التفرقة في ازمنة التكتل، ومن هنا تأتي الدعوة «لرفع الوصاية السياسية بين الدول الاعضاء-الخمس- والقبول بمنطق الاستقلال الوطني، المؤسس للوحدة المغاربية وتوجهاتها، لان مطلب الوحدة لا يقوم على التجزئة ودعم التوترات الداخلية لدول الجوار (…) مما جعل الصراع على زعامة الوحدة المغاربية وقيادة التوجه السياسي يخلق تمويهات والهاءات… كما اننا امام طواحين دونكيشوطية» (ص 74و 75 من الكتاب).
ان الوحدة المغاربية هي عتبة تاريخية ووحدة تكامل (هكذا يفترض)، وليس وحدة صراع بين متناقضات (لأن التناقض الرئيس هو مع الاستعمار الجديد)، نظرا الى العناصر المشتركة (كاللغة والدين والمشاعر والمصير المشترك والمعنى الزمني)، لكن هاته العناصر مرتبطة بالماضي (اي بالحس المغاربي القومي)، لذلك وجب الاستفادة منها لبناء مفهوم الوحدة الحديث، وهذا الانتقال لا يتم الا بالتحول من النظري الى الملموس، مع تحليل علمي للبنيات السياسية والاقتصادية والخصوصيات الثقافية المرتبطة بكل قطر مغاربي، ومنع اي شكل من اشكال الوصاية على شكل النظام السياسي في اي قطر مغاربي… هنا نمسك بشيء من روح المفكر التقدمي عبد السلام المـؤذن، في رفض «التوظيف الأيديولوجي للحس القومي للامتداد السياسي داخل البنية الداخلية للدول» (انظر مقدمة كتاب الدولة المغربية : قضايا نظرية)، حول مسالة الأخذ بالشرط الوطني، والذي يرى ان تقوية الدولة الوطنية (من منطلقات ديمقراطية)، هو المدخل الموضوعي لبلورة قوة اقليمية، ولكل اندماج مغاربي او عربي (وليس العكس).
يهتم المؤلف ايضا بعلاقتنا بالغرب، إن الغرب يشكل جزءا من «حقل التجربة التاريخية» الراهنة للعرب، ان الغرب هو الذي يحضر دوما في ذهن المفكر العربي عندما يكتب وينتج. الغرب هو الحداثة، هو التقنية، هو التقدم… وفي المقابل، تشير الباحثة الى «التبعية السلبية» لهذا الغرب المسيطر. وهي تبعية على وجهين : اما التماهي مع هذا الغرب =فنومين حداثي، (نستحضر على سبيل الاضاءة التحليلية، هنا، التمييز المفهومي الذي يقيمه الباحث الكندي John W. Berry بين التماهي والاندماج) ، او العداء الايديلوجي النكوصي المجاني (العودة الى بنية التراث المتعالية على التاريخ بوصف هذا التاريخ تاريخ دائري، ما ينفك يعود الى نقطة ارخميدية=نومين اسكاتولوجي) والتي تعزز-للمفارقة، مشاعر الدونية الحضارية المادية عند الانسان العربي، والتي تعوض بأوهام (او قل حجب) التفوق الاخلاقي على العالم، ان هذا النقاش هو نقاش بزنطة، وقد استنزف الكثير من ممكنات العقل العربي، منذ عصر النهضة، الى مرحلة التحرر الوطني، ودولة ما بعد الاستقلال-دون أثر عملي في الواقع. وهنا تدعو الباحثة الى شيء من «رفع الحكم» (حتى لا يعيش الانسان العربي وفق تصورات مجردة قبلية بحاكم بها الواقع)، اذ ليس قدر العقل العربي، ان يقع بين استلابين، إما ان يلوذ بالأب الغربي المسيطر على المستوى المادي (كما يصفه ادوارد سعيد)، او الاب الرمزي الشرعي (كما يصفه طرابيشي في مؤلفه عن العصاب العربي الجماعي)… الاستلاب الاول يجعل من التاريخ العربي محاولة محاكاة زمانية، اما الثاني فيجعل منه يعيش في ضرورة «الزمن الدائري»… دون ان يفتح الامر امكانية اخرى لمستقبل اخر… بل يدور بنا (كما بندول الساعة) بين اطلاقيتين، تنتجان الدوغمائية حينا، او التطرف والاقصاء في حالات كثيرة…
نختتم هاته القراءة السريعة، في النقاش الذي يخص القضية الفلسطينية، من خلال مواقف الفيلسوف الالماني هابرماس، والتي اثارت نقاشا واسعا في المنطقة، اذ ان ادانة فيلسوف نظرية التواصل لهجوم المقاومة الفلسطينية في 7 اكتوبر، يشير الى نوع من التراجع العملي عن النظرية التواصلية بالمعنى الكوني، عندما اصطدمت بواقع سياسي غربي. اذ كيف يمكن تقبل موقف هابرماس، والذي كان يجب عليه ادانة الهمجية الاسرائيلية وحرب الإبادة (لأنها تنسف احد شروط الحوار التواصلي نفسه القائم على توازن القوة بين الثقافات)، ينتهي به الحال الى ضرب من «التنافر الاخلاقي»، فمن جهة هنالك الايمان ب»عقل تواصلي كوني»، ومن جهة ثانية، الإذعان لضمير ألماني مثقل بمشاعر الذنب بعد المحرقة، انه تصور اورو-مركزي، لا يدرك فيه الفلسطيني كذات تحتاج التحرر السياسي، بل الى تربية على المدنية (وهاته الدعوة، هي التي اسماها ادوارد سعيد-كما تمت الإشارة سابقا- بالعقل الأبوي الغربي الذي يعتبر نفسها وصيا على بقية مكونات الانسانية ومسؤولية تحضرها ونشر رسالة الديمقراطية فيها)…
لكن، ودون السقوط في النقاش حول مدى تطابق الغرب السياسي مع الغرب الثقافي، من باب اقتناص اي فرصة لإدانة هذا الغرب=حيث يصير الغرب هو المتهم والمنقذ بتعبير الباحثة… (ومن المفارقة ان اكثر اشكال التضامن واكثرها فعالية مع مأساة الشعب الفلسطيني كانت في هذا الغرب نفسه=الحراك الطلابي في جامعة كولومبيا على سبيل المثال)… هنالك ضرورة لنقد الطهرانية الاخلاقية في خطاب المثقف العربي (تستحضر الباحثة مقالة طه عبد الرحمان عن الشر المطلق واعمال وائل حلاق في النقد الاخلاقي للحداثة)، فالشر المطلق (اي الانحدار الاخلاقي الغربي في الحالة) كما الخير المطلق، شرطان انسانيان، لا تعلق لهما بثقافة او عرق او دين، انه ديمومة حضور… ان الفارق الاساسي هو فقط : ان همجية الحرب الاخرى، اصبحت تنقل على الهواء المباشر، تلازمها حالة عجر سيكولوجي وشلل حضاري عربي مقابل.
وبين موقفي هابرماس وعبد الرحمان، هنالك ضرورة اعادة فلسطنة Palestinisation القضية الفلسطينية، قضية شعب يحب الحياة، واعادة القضية الى افق الدولة الوطنية، واعادتها الى القيم الانسانية التقدمية الكونية… ان هاته الاعادة على مستويات ثلاث، تفترض ما اسمته الباحثة ب»المشاهدة بالمغايرة»، ان نفكر في تعديل طرق تفكير غير العربي/غير المسلم في المأساة… بما في ذلك الغربي الليبيرالي العلماني، خصوصا مع الصورة السلبية والمشوهة (خصوصا في العصر الذي هو عصر الصورة) التي اختزنها اللاوعي العربي بخصوص «العربي» و»الاسلامي» والذي تقرنه (منذ احداث 2001) الى التشدد، التطرف، الاصولية…الخ… فالقضية الفلسطينية فوق الأيديولوجيات، لأنها قضية حب للحياة، من هنا ضرورة الفصل بين الايدلوجية التراثية المهمة في التعبئة الروحية، عنها، فيما يتعلق بالصورة الاتصالية بالخارج… المغاير.
الكتاب مهم في السياق السياسي العربي الراهن، لا من الناحية المفهومية او المنهجية، وهاته القراءة، لم تهدف الى عرض كل قضايا الكتاب الممتدة، او عرض جامد لمضامين الكتاب، بل هي محاولة لإشعال الرغبة في الاطلاع على هذا المؤلف الذي يثري المكتبة المغربية والعربية، ودعوة لكل قارئ ان يخوض تجربته الخاصة مع قلم نسائي مغربي واعد…
قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»
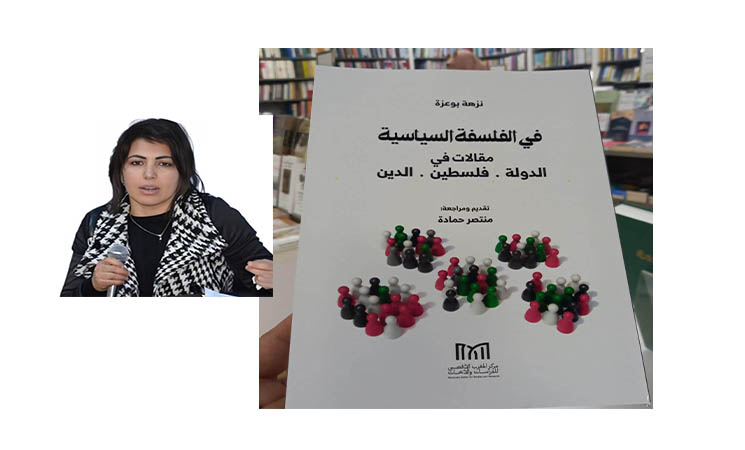
الكاتب : عبد الرزاق ايت بابا
بتاريخ : 12/11/2025