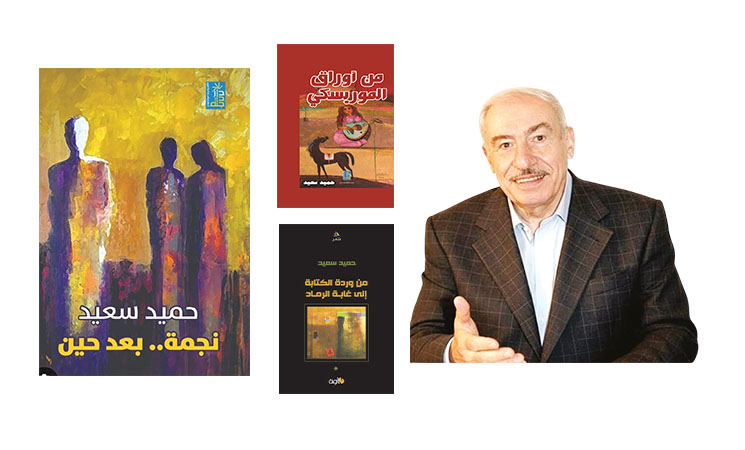توزع كتاب»كلام الأبكم» إثنا عشر بابا.كل باب اختص بموضوعة مستقلة تروم تحديد مفاهيم من قبيل الغربة والعشق والوفاء والخيانة والانتحار وما شابه ذلك. مفاهيم وردت في شكل شذرات تراهن على قول الكل بالجزء وتكتب بالمحو والبياض كما تكتب بالحبر. علما أن بياض الكاتب غير بياض القارئ وهنا تكمن صعوبة إيصال معنى البياض لارتفاع الخلفية المشتركة بينهما. «كلام الأبكم» بالنتيجة أقرب إلى النص المفتوح المستعصي على التجنيس حيث يتجاور فيه السرد بالشعر والتأمل الفلسفي بالسخرية. نصوصه مفتوحة على تجارب وجودية متعددة. تحديدات يتلذذ فيها السارد بتشظية السرد وفتحه على الشعر والحكمة والتأمل واصفا الخيانة والوفاء والحب بشكل مختلف تماما وكأني بالسارد يصفي ثأرا قديما مع ذهنية تقليدية أو يمارس دعابة مرة يطلق فيها الرصاص على كل المفاهيم المتكلسة. لكل هذا جاء «كلام الأبكم» خارج الكتابة النسقية المعهودة يحتفي بالنسبي ضدا على المطلق ويمجد النقص واللااكتمال بطرح السؤال أكثر مما يجيب مستثمرا السخرية والمفارقة والصدمة لخلخلة الاطمئنان الزائف الذي اعتاد عليه المتلقي التقليدي..
عتبات الكتاب:
1-1 دلالة العنوان
تطرح العناوين دائما إشكالات نظرية شائكة ومركبة من قبيل: هل العنوان أصل أم فرع؟ وهل هو تتويج للنص أم استهلاك له؟ وبأي معنى عملية التأثير والتأثر بين العنوان والنص تسير دائما في صالح العمل؟ ولماذا ثمة حصر لوظائف العنوان في أربعة وظائف فقط حسب جيرار جنيت «الإغراء والإيحاء والوصف والتعيين؟»(1) وهل حقا أن العنوان عاجز على أن يصبح بنية دلالية مستقلة لها اشتغالها الدلالي بأبعادها المختلفة؟ بل أكثر من هذا، ألا يمكن اعتبار العنوان سؤالا إشكاليا والنص إجابة عنه؟ جملة من الأسئلة القلقة سنحاول الاهتداء بها ونحن نقارب عنوان ونصوص «كلام الأبكم».. إن عنوانا مماثلا يبدو صادما ومفارقا إن أخذنا بمعناه القريب، إذ لا يعقل أن يتوفر الأبكم على كلام. لكن بقراءة الشذرات يتضح أن السارد يقصد الكلام المسكوت عنه والمغيب عنوة إن لم نقل اللاشعور الجمعي الذي يحتفظ بكم وافر من الوجع والألم. كلام يسكننا جميعا دون أن نتوفق في التلفظ به لاعتبارات مختلفة أو لأننا تعودنا على السهل والمستهلك بقوة التكرار والعادة ونفضل الإيمان على الشك والجواب على السؤال والطمأنينة على القلق. يقول الكاتب في تقديم الكتاب (ص17/18): «الأبكم ليس بالضرورة شخصية خيالية مرتبطة بكاتبها وإنما هي شخصية قابعة فيك.في جزء من كينونتك المضمرة بفعل تهافتك على امتلاك المبتذل. وإذا أردت أن تصل إلى كنه كلامه، عليك أن تتوحد به وأن تتجاوز تمثلانك الموروثة عن إعاقته مادامت هذه الأخيرة تظل مرتبطة بك لما جنيت به على نفسك من جلد للذات.» السؤال المقلق هنا هو التالي: هل توفق الكاتب في هذا العمل في استكناه أحشاء القارئ وبأي وسيلة؟ أم أن الأمر مجرد رهان ذهني يطمح لحيازته؟ مقاربة النصوص وحدها يمكنها أن تقدم جوابا نسبيا لهذا السؤال. يقول مجددا الكاتب عن الأبكم في تقديمه للكتاب (ص18): «لا يحكي عن أحزانه وإنما يدعوك للتعرف على تلك التي تسكنك.»
تبقى الإشارة إلى أن حروف العنوان كتبت بحجم أكبر من الحروف التي كتب بها اسم الكاتب.. والأمر مبرر على اعتبار أن الكتابة تقتات من دم وأعصاب وجهد ووقت الكاتب..
1-2 صورة الغلاف.
توسطت صورة الغلاف نافذة مهشمة وعاكسة لظلام الداخل. علما أن دور النافذة كفتحة في الجدار هو سماحها للضوء والهواء بالعبور. بل إن النافذة لها دور السماح للقاطن بأن يكون داخل وخارج المكان المسكون فيه في الآن نفسه. وهنا تكمن وظيفتها الجوهرية يكفي أن نعلم أن فعل نفذ يفيد الاختراق وأن الشخص النافذ هو صاحب الذهن الثاقب. وبالعودة إلى نافذة الغلاف المهشمة تماما كما هي تمثلات المجتمع لوفرة من المفاهيم الأخلاقية يجد المرء نفسه أمام ثنائيات لا حصر لها ومنها ظلام جواني ونور براني.. الداخل والخارج.. غير أن السؤال هنا ما علاقة النافذة بعنوان الكتاب وهل ستكون نافذة الأبكم شرفة على تقرحات المجتمع؟ سؤال تتأكد جديته وجدوائيته عندما نربطه بالحمامة البيضاء المديرة الظهر للرائي.. مذكرة إيانا بحنظلة الطفل الغاضب لناجي العلي. وعموما الحمام شغل في التاريخ الإنساني دور الرسول وساعي البريد الحامل للخبر الطارئ كما أن هديل الحمام عد معاتبة.. ترى ما رمزية ظلام الداخل وعتاب الحمام؟ أسئلة سنستثمرها في صلب المقاربة..
1- 3 عنوان التعيين الاجناسي.
وسم الكاتب كتابها ب»شذرات في القول الأصم» ونحن نعلم أن التعيين الاجناسي يروم عقد اتفاق أولي حول هوية النص المقروء وإعداد المتلقي لاستقبال جنس أدبي بعينه.فالتعيين الأجناسي يناشد ذاكرة القارئ وعدته القرائية وتاريخ تراكماته الجمالية. كما يترجم الوعي النظري للمبدع. فالكاتب مصطفى شكدالى وهو يضع على صدر كتابه شذرات يوجه الاهتمام لكتابة مكثفة تعتبر بياض الورقة نصا موازيا ومنفلتا من قبضة الحبر والكلام. الشذرات بهذا المعنى، يتساوى فيها الحبر بالبياض والكلام بالصمت. والبياض هنا ليس معادلا موضوعيا للفراغ بقدر ما هو صمت مقصود بغاية توريط المتلقي في قول ما سكت عنه النص (2). البياض بالنتيجة ليس صدقة تتكرم بها الورقة ولكنه آلية إبداعية لهندسة النص بصريا.بياض شذرات «كلام الأبكم» صمت مقصود وليس إضراب عن الكلام. بياض يسعى لتكسير سلطة الحبر المفردة التي تعودنا على أنها وحدها تصوف معنى المقروء. ولهذا أتصور أن قارئ شذرات الكتاب دون بياضها قارئ أعمى.
1-4 عتبة الإهداء
جاء خطاب الإهداء طافحا بالشجن والوجع بسبب استحضار الكاتب للأم التي رحلت عن عالم الحياة. ونحن نعلم أن الأم هي الموضوع الأول للحب.. وإذا كان الأب رمز لفرض النظام فإن الأم مصدر للمنح والعطاء ولذلك عدت على مر التاريخ البشري موضوعا للتغذية وإرضاء الحاجيات الفعلية والرمزية.. صورة نشأ عليها المجتمع منذ أن كان. فقط تجدر الإشارة هنا أن اسم الأم اسقط وثم استدعاء وظيفتها كأم تأكيدا على الرابطة الدموية التي ربطت الكاتب بها على خلفية حنوها الفادح الغياب. فقط باستدعائه لها في اللحظة الراهنة، ينتزعها من العدم ويعيد منحها الحياة.. إذ أن الميت هو من غادر الذاكرة لا من فارق الحياة (3)، يقول الكاتب في ص7: «إلى تلك التي ظلت تحترق لتنير أركان بيتنا المعتم والتي صارعت هبوب الرياح دون أن تحتمي بأي فانوس يقيها خطر التحول إلى رماد، ظلت مشتغلة إلى أن نقلت شرارة نارها إلى كل تلك الرؤوس التي كانت من حولها فأصبح بيتنا موكبا للشموع.تلك الشمعة كانت أمي رحمها الله.»
1-5 التقديم الغيري والذاتي
توزع الكتاب تقديمان على غير العادة. واحد للأستاذ إدريس القري والثاني للكاتب نفسه. أما تقديم القري فقد ركز على علاقته بالكاتب أكثر من المكتوب وإن كان الكاتب والكتاب وجهان لعملة واحد. راصدا الخلفية الذهنية التي احتكم لها الكاتب في تحديده لجملة من المفاهيم بوعي قلق. بل إن الأستاذ إدريس القري وهو يقدم الكتاب شدد على المراجع والأسماء التي استضاء بها الكاتب (نتشه، بريشت، بكيت، العروي، الجابري، المرينسي..) وعرج على المجال الجغرافي الذي نشأ به (مكناس، فاس، طنجة)، أمر جعل التقديم ينحاز لأسلوب الشهادة أكثر من التقديم.. تبقى فرادة شهادة الأستاذ القري في كونه التقط بألمعية انبناء الكتاب ككل على السؤال ضدا على الثقافة الإطلاقية ..
في تقديم الكاتب لكتابه شدد على خلخلة مسلمات التلقي حيث ورد تقديمه صادما لجهاز التلقي التقليدي بسبب اعتياد القارئ على حيازة صفة الكرم وهو ما أسقطه الكاتب مستفزا إياه بحثه على استنطاق كلام الأبكم وتأويله.. بل إن الكاتب أصدر أوامره للقارئ بالتوقف عن مواصلة القراءة إن هو رفض الانخراط في قراءة منتجة. وبالتالي تعالق التقديم مع صورة الكتاب وعنوانه المفارق في إعطاء فكرة أولية عن نوعية المقروء المختلفة قبل أن يقر نصوصه الداخلية المخلخلة لما تكرس من تمثلات ورؤى.
موضوعات «كلام الأبكم»
في الباب الأول طالعنا الأبكم وهو يستدعي زمن الغربة بتصور جديد للوطن حيث تحولت المسافة الفاصلة بين حدي المعادلة إلى عامل مساعد في رؤية الوطن بشكل مختلف على غير العادة. لنتأمل القرينة النصية في ص26:»ما الوطن أيها البكم إلا ذلك الكتاب الذي لم يكتب بعد.» الوطن في هذه الشذرة وغيرها ليس شيئا جاهزا بل هو تحفة على المواطن نحتها بما يليق به من سمو ورفعة. وإذا كان الناس قد اعتادوا على ربط الغربة بالإقامة خارج الوطن فإن الأبكم لا يعتبر الغربة المكانية إلا أحد أوجهها المتعددة.. فهناك الغربة في اللغة وفي الزمان وفي اللون وفي المعتقد… الغربة بهذا المعنى هي حالة عدم التجانس مع البيئة المعاشة وليست مجرد حزن على مكان أجبرنا على مفارقته. هي وعي ناتج عن وطن لا يتوقف عن النزيف بسبب الإحساس بالعجز عن التوافق مع مسلكيات حافلة باللامعنى وغياب المعيار. يقول الأبكم في ص26: «ما الغربة إلا تلك الوحشة والترقب بالعودة ليلا عبر أحلام تلك الوجوه الصفراء في غفلة من الكائنات النحاسية ودوريات الحراسة.» غربة الأبكم في المحصلة هي حالة وجودية مبنية على عدم التوافق مع الواقع الراهن. غربة تتماهي مع غربة الكتاب الذين يتوقون إلى وطن خال من الضغينة والتطاحن إلى درجة أن بعضهم اعتبر المنفى الاختياري وطنا. منفى به هامش أوسع من الكرامة ولذلك أضحى عندهم أرحب مقارنة بقيود الوطن. وطن بات مدحه مرثية بلا لون وكأني باللاوعي الكاتب المغترب يسأل «كيف لي أن أحب وطنا يكرهني؟»
في الباب الثاني أكد الأبكم على «نهج الطير لا منطق الزواحف» وهو يطرح الأسئلة عن الحلم حيث ورد بالصفحة 23: «ما قول الأبكم في ذلك الذي يحلم ولا يحققه حلمه؟» والحلم عند الأبكم طاقة ذهنية ومهارة وجودية تحرر من الارتهان للأمنية وتربط صاحبه بتحقيق الحلم.. وهو في ذلك يتقاطع مع قولة بسكال «إن الحرفي الذي له ثقة في تحقيق حلمه يعيش بسعادة ملك.» بالنتيجة الحلم المتحقق هو تمرد على الرقابة والمنع بصرف النظر عن الجهة القامعة.. وفي سياق تساءل الأبكم عن الحرية الشخصية انتهي في (ص39) إلى: «إن أشد أنواع العبودية هي تلك التي تمارس باسم الحرية الشخصية. أن تكون عبدا لنفسك باسم الحرية معناه أنك تعيش وهم الظن الفاسد.» تحفظ الأبكم على التمثل السائد للحرية الشخصية ناتج عن كون المفهوم بذات القدر الذي ينتسب للمجال الحقوقي والسياسي يستوطن أحواز الوجدان والذوق ويتوزع بين الفرد والجماعة ويتلون باختلاف الجنس. لكن رغم انفلات ضبط المفهوم تبقى الحرية هي الشيء الوحيد الذي ليس لنا الحق في التخلي عنها.صحيح أن الأبكم كان محقا عندما اشتغل على المفارقة في تعارض الحرية بالعبودية غير أن معنى الحرية لا يستمد خصوصيته إلا من وعي الممارس لها والذي عليه أن يحتاط من عدة سلط تترصده بما في ذلك سلطة الماضي وسلطة العادة وهاجس الخوف من النبذ، فالمواطن في أخر المطاف فرد يواجه قوى مؤسساتية لها تقاليد في إقصاء المختلف والمتنور أساسا..
في الباب الثالث رصد الأبكم مفهوم «فلتات اللسان» كتجل يفضح سريرة المتلفظ على اعتبار أنها تشبه الشرارة المنبعثة من جوف الرماد والتي تعتمد غالبا للوصول إلى الضمير الباطن. ولذلك فالوعي بخطورتها يحفز البعض على تفضيل الصمت عن الكلام أو على الأقل التروي في ترجمة ما يعتمل بالأحشاء إلى خطاب.. لكن مع ذلك تبقى فلتات اللسان واضعة الفرد في حالة حرب نفسية داخلية بين رغبة النفس وإرادة العقل حيث يعيش في حالة تمزق بين المأمول والواقع. لنتأمل شذرتين للأبكم بص53: «أن تكون صادقا مع الآخرين عليك أن تتعلم الكذب على نفسك.» ثم بص55 يقول:»عندما ننظر للأخر على أساس أنه نصفنا.نكون قد اعترفنا أننا مجرد نصف.»
في الباب الرابع استأثرت موضوعة الحب بوجدان الأبكم. الحب كعاطفة مركبة وتجربة وجودية متفردة تنتزع الإنسان من عزلته وتذكره أن السر في شقاء الفرد هو ارتهانه لمن يحب أو الارتهان للحب نفسه. صحيح أن الحب في بعده الأول خروج من الذات وهجرة نحو الآخر، لكن هذا لا يعني التطابق مع المحب دون أن يفهم من هذا الكلام أن العشق استغراق في أنانية مرضية. يقول الأبكم في ص68:»إن الحب يلزمنا بفك الارتباط مع كل شيء يستعبدنا حتى ولو كان الحب نفسه، إنه يحررنا من كل القيود، فلا فائدة منه إذا جعلنا عبيدا في يد من نحب.» ولعل الأبكم كان محقا عندما استنكر على المحب غيرته والتي اعتبرها عربون حبه. بمقاربة فعل الحب على خلفية الغيرة يمكننا أن نقول: الحب أنانية اثنين فالمحب يحب وجهه الثاني الذي لا يراه بشكل مباشر. ويمكننا القول أن حب امرأة لرجل بعينه هو تذكير واستدعاء للذكر فيها والعكس صحيح. إن خوف المحب من فقدان محبوبته خوف على الذات من البقاء في عزلة لا خوف على المحب. ولهذا تبدو ماهية الحب غامضة ومستعصية على الضبط لأنه مرافق بأسئلة لا جواب لها.. ومنها لماذا أحب هذه وليست تلك؟ ولماذا الآن وليس غدا؟ الغيرة حسب الأبكم نار تحرق المشاعر وحجة ضد المحب وليست له. إن الغيرة بالمعنى أعلاه تترجم التكوين المتناقض للإنسان. وتاريخه العاطفي الجريح يكفي أن نتذكر أن الطفل يتعرض لأول فعل غدر من طرف الأم التي تحرمه من حليب ثديها تحت تهديد الأب وفعل الفطام. ومن تلك اللحظة يبدأ في مراكمة جراحه العاطفية بشكل موجوع.
في الباب الخامس كان الأبكم -وكنا معه- على موعد لتحديد الوفاء كخصلة اجتماعية تترجم الصدق في القول والفعل بل والنبل الإنساني في عكس الخلق الكريم وإن كان الوفاء في أيامنا هذه خصلة نادرة. فرادة تحديدات الأبكم للوفاء نبعت من تصوره الجدلي للقيم إذ لا معنى لها دون حضور نقيضها. قال في ص79: «في خيانة الآخر وفاء للذات»، وفي ذات الصفحة يضيف «الحديث عن الوفاء يمليه إحساسنا بالخيانة، فما الحاجة للحديث عنه في مجتمع لا يعرف الخيانة.» غير أننا نختلف مع الأبكم عندما تصور أن الآخر هو من يفرض على الذات التحلي بقيمة الوفاء.. والحال أن انتهاج قيمة الوفاء يفرضها ما هو مبدئي لا ما هو طارئ. إذ لا يهم إن كان المتعامل معه وفيا كي تكون الذات وفية… قد تعتبر هذه مثالية مطلقة لكن كل القيم بنيت على المثالية وإذا أخرجت من سياقها الإنسانية فقدت كل جدوائية.
في الباب السادس انصرفت تأملات الأبكم لتحديد الخلوة كفسحة تتحدث فيها الذات إلى نفسها وتتفرغ لقضية بعينها. دون أن تعني الخلوة العزلة والانقطاع عن العالم .. فالآخر يضل يسكننا على نحو غريب.. وعلى حد تعبير الشاعر الفرنسي الشهير أرتر رامبو «أنا آخر» (Je est un autre ). قيمة الخلوة بالنتيجة لا يعرفها إلا العارف بمسألة التأمل والتدبر بداية من الذات نفسها في أفق إنتاج الحكمة وممارستها.. الخلوة بهذا المعنى ليست نهاية الطريق ولكنها بدايته. يقول الأبكم في ص 87: «في واقع الأمر، لا يكون المرء وحيدا لمجرد انزوائه لوحده، إنه يظل محملا بحضور أولئك الذين كانوا السبب في طلبه للخلوة والتي لا يذهب إليها وحيدا»..
في الباب السابع كانت المناسبة مواتية لتوقف الأبكم عند معنى كلمة (لا) بعيدا عن تعريفاتها النحوي(النفي، الجزم، النهي) واشتغل عليها باعتبارها رفضا وممانعة وتمردا في وجه الاستسلام.. فقط يلزم معرفة متى وكيف نقول (لا).. فإذا كان الشخص الذي يقول دائما نعم دون شخصية. فقول كلمة لا دائما لا معنى له.. يجب أن تقال في وقتها وليس من باب خالف تعرف حتى تكتسي صفة الاعتراض والاحتجاج.. علما أن الصمت في واقعنا المغربي الراهن يقرأ على أنه نعم غير مصرح بها والجهر بلا يشكل الاستثناء.. قد نتفق مع كون الصمت جبن لكن ليس دائما مترجما لنعم. يقول الأبكم في ص97:»لا أداة لتأكيد الذات وصرخة ضد السياق وخارج الأنساق»، ويضيف الأبكم في ص98: «كم من اللاءات تستعمل فقط ابتزازا للآخرين وطلبا للمزيد من انبطاحهم،إنها تغذية للذات المتمركزة حول نفسها»
مفردة (لا) كما باقي الكلمات لا تملك قيمة في حد ذاتها ولكن السياق هو الذي ينتج المعنى كما يقول أهل المنطق.
في الباب الثامن تمحورت شذراته حول مفهوم الانتظار كفعل ارتبط بالمكان كما بالزمان والإحساس. أقصد بذلك فعل الانتظار خصصت له (قاعة الانتظار) كما في كل المؤسسات العامة والخاصة. فضلا عن اقترانه بمدة الانتظار التي تجعل من الفرد يعيش حالة ترقب واحتراق شوقا لمعرفة القادم والمجهول. بل إن هذا الفعل اقترن بنبوءة الفرج والخلاص. الانتظار بالنتيجة فعل مفارق فبين انتظار وانتظار هناك مسافة.. فأن ننتظر عملا ونعمل على إنضاجه غير أن تتمنى حدوثه كيف ما اتفق.. الانتظار المؤسس له غير الانتظار المجاني.. يقول الأبكم في ص110: «يكون الانتظار بصيغة الأمل تعبيرا عن العجز في تحقيق رغبات معينة هنا والآن، مما يجعل هذا العجز يتحول إلى أماني مستقبلية.»
في الباب التاسع حدثنا الأبكم عن تمثله للانتحار ليس كحالة نفسية تتوج اليأس والاكتئاب والاضطرابات النفسية ولكن كإدانة للسياق الذي أوصله لحالته. فقبل أن يحاسب الأبكم المنتحر على معصية ضرب قدسية الحياة حاول أن يفهم لما وصل إلى ذلك المآل. كما أن الأبكم عرج على وسائل الانتحار بما في ذلك الحرق والشنق وما شابه ذلك. منتهيا إلى أن المنتحر دوما يريد إيقاف ألمه بألم أكبر وهو الموت. فالمنتحر بالنتيجة شخصية لا يهب الموت بقدر ما يخطب وده. يقول الأبكم في ص 115: «عندما يلجئ المنتحر لإضرام النار في جسده أمام الملأ،فإنه يسعى إلى نقل الشرارة من جسده إلى جسد المجتمع برمته، إنه بذلك يريد أن يظل حيا ومشتعلا في أذهان الناس.»
في الباب العاشر توقف الأبكم عند النفاق الاجتماعي باعتباره انفصام بين ما نقول وما نفعل أو لنقل هو التلون في العلاقات والتملق والحربائية المؤذية لأنه يتأسس على الخديعة والغش.. صحيح أن المنافق نتاج نفاق مجتمعه لكن علينا أن لا نكرس النفاق باسم استشرائه في المجتمع. يقول الأبكم في ص120: «عندما يصبح النفاق سلوكا اجتماعيا بامتياز، فإن الصدق قد يتحول إلى نفاق في أعين المنافقين.» إن الأبكم في واقع الأمر يقارب النفاق بخلفية ساخرة ومرارة موجعة وذلك بتوسله بالمفارقة كما في الشذرة التالية ص123: «عندما يشكو المنافق من عدم صدق الآخرين، فإنه بذلك يعبر عن إفلاس زاده من النفاق.» وسخرية بهذه الخلفية تضع القيمة وضدها محل استفهام مترجمة توترا يعري الأعطاب والاختلالات وسيلتها في ذلك المبالغات والتشويهات سخرية مماثلة تضحك من واقع مبك وتستهزئ من مواقف جادة.. وعلى المستوى النفسي هي أداة مقاومة لأنها تحمي الساخر والمتوطئ معه من السقوط في هاوية الاستسلام والضعف. (4) وذات السخرية حضرت في البابين الحادي عشر والثاني عشر مع تخصيص الباب الأخير للمرأة في يومها العالمي منبها أن الرجل ليس هو الخصم بقدر ما هي البنية الثقافية ككل على اعتبار أن الصراع ليس فرديا ولكنه طبقي. يبقى على المرأة والرجل أن يراهنا على تغيير نظرة المجتمع للمرأة والكف عن اعتبارها قطع غيار ما يصلح منها للالتذاذ يتم إبرازه (صدر، أرداف،خ صر) وما دون ذلك يتم تركه جانبا. بمعنى الكف عن اختزال المرأة إلى جسد واعتبارها صوتا وذاتا فاعلة في الحياة كما في الكتابة وإنتاج الفكر.
ينتهي المتلقي لشذرات الأبكم وذهنه يشتعل بأسئلة لا قرار لها: هل البياض الذي سبح فيه حبر شذرات الأبكم هروبا أم مواجهة، جرأة أم خوفا، حضورا أم غيابا؟ وهل قيمة البياض المكتوب به يستمد ماهيته من الحبر أم من جهاز التلقي الجديد للشذرة أم منهما معا؟ ومتى يمكن اعتبار الحبر والبياض نغما كتابيا يعطي الورقة إيقاعا؟ وإذا كان الصمت ملونا للكلام فهل يمكن اعتبار المعادلة صحيحة في مقام الحبر والبياض؟ وبأي معنى اعتبر البعض إقحام البياض على النص مجرد بذخ جمالي دون وجه حق؟ وهل البياض دلالة على حيرة المبدع أم دلالة على عجز الكلمات في قول كل رغبات الكاتب ؟ وهل البياض دائما قول للكلام بالمحو؟ ومتى يمكننا اعتبار البياض كلاما مسكوتا عنه لا فراغا؟ جملة من الأسئلة نتركها مفتوحة كما هي أعطاب وجراح المجتمع المغربي.
——————
إحالات:
(*)مصطفى شكدالي.كلام الأبكم. شذرات في القول الأصم.Alia concept-Tanger. 2015.
1-محمود الهميسي. براعة الاستهلال في صناعة العنوان. الموقف الأدبي. اتحاد الكتاب العرب. دمشق. ع313. السنة 27. أيار 1997. ص12.
2-Anne-Marie Christin. Poétique du blanc- Vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris. Vrin . coll. Essais d’art et de philosophie. 2009. p208.
فايز قنطار. مجلة عالم المعرفة.ع166. أكتوبر 1992. ص43.
4-Beda. Alleman . L’ironie en tant que principe littéraire. in. Poétique. coll.Flammarion. 1965. p15.