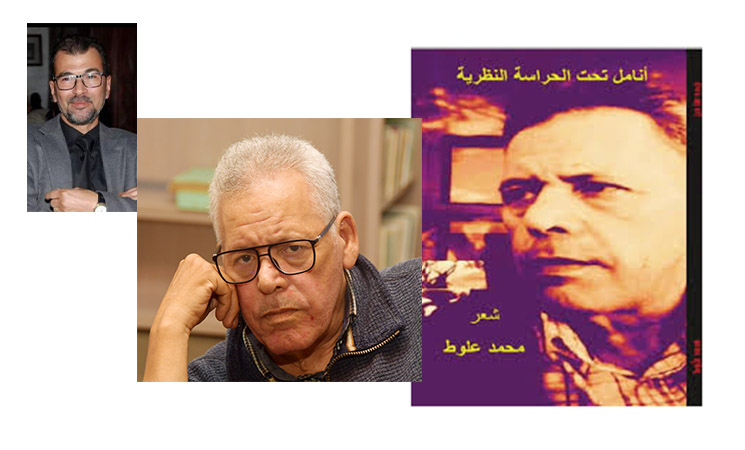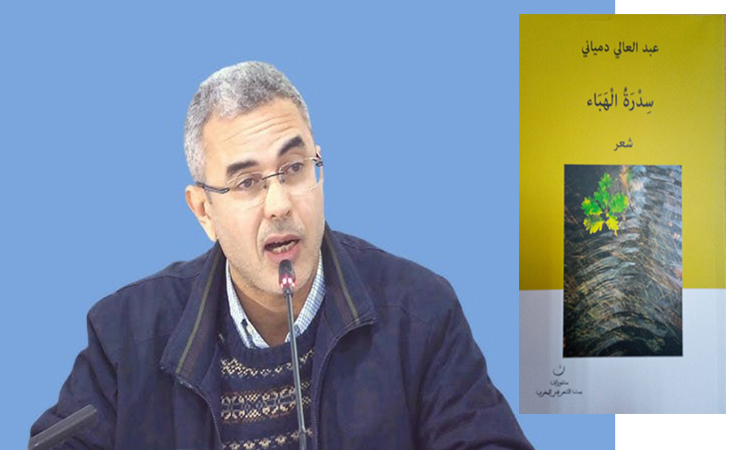العنوان وحده يجعل القارئ متشوقًا للتعمق أكثر في أسرار هذه الرحلة. من البداية نعلم أنها رحلة، يعني بعبارة أخرى يوميات سفر: «ذهبنا إلى الصين وعدنا … من المستقبل!»، في الحقيقة شيء مستحيل، حيث يعدنا الكاتب برحلة غير عادية تتناقض بشكل صارخ مع وجودنا وتطلعاتنا، كما ستحيلنا هذه التجربة على عالم العجائب والغرائب والمثير للدهشة والانبهار و»الدوخة» كما يحلو للكاتب أن يسميها في بعض الأحيان، تعتبر هذه الرحلة أداة قوية للتعلم، التطوير والنمو ومساهمة مهمة وهادفة في توثيق الأحداث والانطباعات، في تعزيز التبادل الثقافي بين المغرب والصين، وفي التلاقح واكتساب المعرفة.
تم اختيار عنوان هذا المؤلف بذكاء، ويمكن اعتباره بمثابة السمة المميزة لهذا العمل؛ لأنه بلا شك يثير مشاعر شديدة، ويستحضر صورًا قوية كما يثير ارتباطات سحرية، وبالتالي يثير فضول القارئ ويخلق جوا إيجابيا. وإذا كلفنا أنفسنا عناء قراءة هذا الكتاب، فلن نشعر بخيبة الأمل أبدا، لأنه يحتوي على الكثير من الكنوز الثمينة. حيث يقدم لنا على طبق من ذهب، باقة من المعارف، التسلية، الترفيه والالهام.
اللون الأحمر السائد على غلاف الكتاب يتناسب مثل القفاز مع الموضوع؛ لأن المؤلف كان يدرك أنه يتعامل مع موضوع صيني بامتياز. وفي الصين يرمز اللون الأحمر في أول الأمر إلى الحياة، ولكن أيضًا إلى السعادة، الدفء العائلي، القوة والحب، حيث يرتدي كل من العروس والعريس ألبسة حمراء خلال مراسم الزواج للتأكيد على حبهما لبعضهما البعض، كما يقال أيضًا إن اللون الأحمر، إن لم يكن يطرد، فعلى الأقل يبعد الأرواح الشريرة.
أما صورة سور الصين العظيم الموجودة في الجزء العلوي من غلاف الكتاب فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهوية الصينية، باعتبارها شعورًا ذاتيًا ضاربا في القدم، وبالتالي فهي ذات أهمية قصوى للوعي الجماعي ولتعزيز التماسك. على النقيض من الرموز الوطنية الرسمية مثل العلم، الشعار، والنشيد الوطني الصيني، فإن الرموز غير الرسمية تستند إلى تجارب جماعية، ذكريات وأحداث تاريخية، وهي في الأساس مستقرة نسبيًا في طبيعتها لأنه لا يمكن تعديلها بسبب ظروف سياسية عابرة أو جديدة، إلى جانب رمزية سور الصين العظيم، يأتي تمثال ابن بطوطة ليشير إلى الهوية الثقافية للكاتب والرغبة الملحة في نقل المعرفة، المعلومات، الخبرات وتوسيع المدارك، والتي ستـتجلى بالتأكيد بقوة في رحلة مثل هاته.
إن رحلة الاستكشاف التي يقوم بها المؤلف تساعد بالتأكيد على اكتساب وجهات نظر وطرق تفكير جديدة، ويمكن اعتبار المقارنة الدائمة بين «الآنا» و»الآخر» مفتاح العلاقات الناجحة والتواصل الفعال الذي يضمن الاحترام المتبادل، التقدير والتعايش السلمي والاستعداد للتعلم من بعضنا البعض، وهو ما عبر عنه المؤلف أكثر من مرة، حتى أنه كان على استعداد شرح بعض الكلمات الصينية للقارئ العربي، مثل «شنغهاي»: «شانغ هي فوق» و»هاي» هي «البحر»، ص 98.
منذ البداية يخبرنا الكاتب أنه يقوم بتوثيق، تدوين رحلة مرتبطة بمهنته كصحافي والتي يريد الاحتفاظ بذكرياتها، تفاصيلها ومشاركتها مع القارئ قصد تعميم المعرفة والاستفادة منها في المستقبل، حينما يقول: „هي المرة الرابعة التي أزور فيها الصين، بقبعات مختلفة يغلب عليها الطابع المهني، وعلى عكس ما يمكن أن يخالج التفكير، زادت ألغاز الصين وزادت الدهشة في جوارها..“ (ص 5)، ومع ذلك، من وقت لآخر، ينتصر الكاتب للشاعرية على حساب عملية التوثيق والتدوين الصرفة: „عندما ندفع بالبطاقة أو بالهاتف النقال، أصبح في خـبـر كان. لا تحمل بطاقة، ولا تحمل هاتفا، فقط لا تنس وجهك في البيت، ولا تكن صاحب وجهين حتى لا تضيع الملامح لدى الآلة، وقتها يمكنك أن تشتري…“، ص 29. أو „لقد رأينا بلدا يقيم، منذ الآن، في المستقبل…“، ص 31. „يا إلهي حتى ابن السماء قابل للقتل“، ص 48. „تندلع موسيقى تبلبل الحواس، لتعلن عن موعد إغلاق الحديقة … نتدرج خارجين، والناي عصفور، والوتر نهر…“، ص 49، „المطر في الطريق يخيم برماديته، شيء ما يقول إننا متشابهان في هذا الطقس، لنا ما يجمعنا بالصين، مطر على النافذة، وسماء رمادية، تبعث دفئا مبهما، في الكآبة!“، ص 55. „هذه المدينة المقيمة على خط التماس مع شقيقتها المتمردة تايوان“، ص 55. „سبق لي أن بحثت في زيارات سابقة عن تمثاله، وها هو اليوم منتصب أمامنا، أحمله في فؤادي كما نحمل دمعة قديمة.. في بلادي يعيش تحت تراب بسيط“، ص81.
من أجل تخفيف حدة أسلوب السرد وتدفقه، يتم استخدام أسلوب فكاهي من وقت لآخر. وهكذا يريد المؤلف أن يكسر الحواجز الموجودة بينه وبين القارئ. وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر بكسب ثقة، حواس وولاء القارئ؛ لأن الموضوع أو الأسلوب الجاف من المرجح أن يؤدي إلى الملل والعزوف، كما سيوضع الكتاب جانباً، والأسلوب الفكاهي يزيد من متعة القراءة، والمقاطع المضحكة بالتأكيد مفيدة، حيث سنتذكر بحب وشغف أكثر التفاصيل والفقرات التي كانت غنية بالفكاهة من تلك التي كانت جافة ولا تترك مجالا ولو للابتسامة خجولة واحدة. إن العناصر السردية الفكاهية تثير الاهتمام وتثير ردود أفعال عاطفية أكثر، مما يضمن المزيد من القراءة من خلال خلق جو لطيف ومريح؛ والشخص الذي يستطيع أن يروي ليس قصة فحسب، بل يستطيع أيضاً أن يمتع الآخرين بفضل الفكاهة، فمن المرجح أن يُسمع صوته ويُقرأ ويُقدَّر، خاصة أن هذا المؤلف ليس عملاً أكاديمياً.
يعتبر هذا الكتاب بمثابة شهادة ومعاينة دقيقة لتسليط الضوء على تطور الصين ونهضتها السريعة، لأن ولا شك صعود الصين سوف يجلب تغييرات كبيرة إلى العالم الذي نعيش فيه. إن النمو الاقتصادي الاستثنائي وغير المسبوق الذي شهدته الصين في الآونة الأخيرة، ولحاقها السريع بالركب في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحضورها القوي بشكل متزايد على الساحة الجيوسياسية، كل هذا يعمل على تغيير التوازنات العالمية. وفي افتتاح معرض „الطريق إلى التجديد“ في بكين في نوفمبر 2012، تحدث الرئيس الصيني شي جين بينج لأول مرة عن „الحلم الصيني“ („تشون جو مونغ“)، الذي وصفه بأنه „تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية“.
هذا الكتاب هو في العمق مقاربة فكرية متداخلة ومتشابكة، كما يعكس جانبا مهما من المضامين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما يتم سرده عن طريق الدهشة والانبهار بشكل متكرر، كما هو الحال بالنسبة لأرسطو، حيث تمثل الدهشة حافزًا مثمرًا للمعرفة، وتعبيرًا صادقا عن التعطش للمعرفة المتجذرة في الجهل الذي يجب التغلب عليه أولاً من خلال المعرفة، والاندهاش يمثل التعبير المباشر عن جهل غير متعمد، الذي يمكن أن يكون مصحوبًا بالإعجاب والاحترام والتبجيل، ولكن أيضًا بالحيرة والانزعاج، يعرب الكاتب عن دهشته لما يكتشف أنه يوجد عيد للقراءة: „ومن أجمل ما ترسخ في ذاكرتي، صورة لعيد القراءة!“، ص57، أو مركبات بدون سائق: „ركبنا السيارة بدون سائق، وكان بعضنا يتساءل كيف سيتم احتساب الغرامات في حال اصطدمت السيارة بسيارة بها سائق؟“ ص 71، أو 30 كلومترات يمكن قطعها في 9 دقائق: „قطعنا المسافة التي تقدر بثلاثين كيلومترا بين المطار ومحطة للسيارات، وبوابة ميترو بشنغهاي في 9 دقائق تقريبا.“ ص 98، أو طريقة اشتغال الصحفيين الصينيين في بعض دور نشر الصحف: „كانت أقوى تجربة سنعيشها ويعيشها المسؤولون في الوفد المغربي، هي وجود لوحة تقنية إلكترونية بها تم نشر مقالات كل صحافي وعدد قرائه وترتيب منتوجه في اليوم ضمن كل ما يكتب، وارتباط ذلك بالأجرة!“ ص 107. علينا أن نعلم أن المنافسة والروح التنافسية لها تقليد طويل في الصين ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل المسيحية، عندما كان المسؤولون والموظفون في عهد أسرة هان (206 ق.م. – 220 م) على سبيل المثال، يخضعون لفحوصات وامتحانات صارمة، بحيث لم يتم قبول سوى المرشحين الأكثر تعلمًا وكفاءة. بلغت هذه الاختبارات ذروتها في عهد أسرة مينغ (1368-1644)، مع تطوير مراحل هذا الاختبار خلال عهد أسرة سونغ (960-1279)، والتي كانت تتألف من كتابة مقالات حول مواضيع من الكتب الأربعة: „داشيو“، „لونيو“ و“تشونغ يونغ“ و“مينغزي“ بالإضافة إلى الكتب الكلاسيكية الخمسة (كتاب التغيرات، كتاب الأغاني، كتاب الشعائر، كتاب الوثائق، حوليات الربيع والخريف). تتكون هذه الكتب من 431 ألف حرف صيني كان على الممتحنين حفظها عن ظهر قلب؛ وحتى يومنا هذا، يتقن التلاميذ والطلاب الصينيون الحفظ، وهو ما يعتبر، وفقاً للعديد من الدراسات، أفضل من التعلم عن طريق الفهم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد العلمية أو الرياضية.
إن المنافسة ملموسة في جميع مناحي الحياة في الصين، من الجهات المختلفة إلى المدارس والجامعات، إلى الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية، حيث تقام المسابقات وتوزع الهدايا والجوائز باستمرار؛ لنلقي نظرة على أحد الأمثلة: من يغني بشكل أفضل، من يتحدث لغة أجنبية بشكل جيد، من يتقن فنون الخطابة والبلاغة، ومن له خط جميل باللغة الصينية، من يلتقط أفضل الصور، من هو الأسرع، من يعزف بإتقان، من هو أفضل معلم، ومن هو أفضل أستاذ جامعي إلخ.
وتواجه الدهشة أيضًا بالانزعاج، لما تساءل الكاتب لماذا يأكل الصينيون بالعيدان: „لا شيء مأٌلوف حقا، بالرغم من أنهم تداركوا الموقف وحملوا إلينا الشوكة والسكين لعلنا لن نستطيع معهم صبرا على القضيبين (العودين) الخشبيين الخاصين بالأكل“، ص 145. وقد انتشر هذا النوع من ثقافة الطعام أيضًا في اليابان وكوريا وفيتنام وأجزاء من تايلاند. في البداية، اكتشف الطهاة أنه من الممكن توفير الوقود عن طريق تقطيع قطع صغيرة من اللحوم أو الخضروات بحيث يتم طهيها في وقت قصير. وبالإضافة إلى ذلك، كان كل ما وضع في القدر كان بحجم اللقمة ومضغه بدون أي صعوبة. ولكي لا يحرق الإنسان أصابعه، جاءت فكرة استخدام الأغصان الصغيرة الطويلة، والتي تم تحسين جودتها مع مرور الوقت، ومنذ 3000 عام حتى الآن، أصبح هذا النوع من ثقافة الأكل جزءًا من العادات الصينية الأصيلة.
وبطبيعة الحال، لا يمكن أن تخلو هذه الرحلة من ذكر اسم ابن بطوطة؛ وللتغلب على ظاهرة الغربة والاستغراب، كانت الرحلة إلى „تشوا نغزو“ ضرورية، وهو ما تم النظر فيه وترحيبه بالتأكيد ليس فقط من قبل المنظمين الصينيين، بل أيضًا من قبل الوفد المغربي. ربما تكون هذه مجرد ملاحظة جانبية: كان على العديد من المدن والقرى الصينية التخصص في منتجات معينة. تعتبر „تشوا نغزو“ اليوم عاصمة الأحذية الرياضية في العالم، لأن %80 من الأحذية الرياضية يتم تصنيعها هناك، بحيث تشكل هذه المدينة %20 من الإنتاج العالمي، وإن دل هذا الامر على شيء، فهو يدل على حدة المنافسة والتركيز على التميز والابتكار في الصين.
ولتعزير مكانة ابن بطوطة وتقديره وتحسين صورته يختبئ المؤلف وراء أقواله: „وكنت إذا رأيت المسلمين بها فكأنني لقيت أهلي وأقاربي…“، ص89، يشير هنا الكاتب عن طريق ابن بطوطة إلى أن الغربة تجربة معقدة ومرة في بعض الأحيان، نظرا لصعوبة التواصل، التأقلم مع ثقافة جديدة، الشعور بالوحدة والعزلة، التعرض للتمييز بسبب اللغة، البشرة واللباس أو الدين. ورغم كل هذه الصعوبات والتحديات فالرحلة والترحال تجربة إيجابية ومثمرة، حيث نتعرف على ثقافات وطقوس جديدة، نكـوّن صداقات ونوسع الآفاق ونبني حياة ومستقبل أفضل، وإن لم يكن هذا صحيحا لما سافر ابن بطوطة أكثر من 20 سنة وقطع أكثر من 120000 كيلومترا، أي أبعد من أي شخص آخر قبل عصر البخار. إن يوميات ابن بطوطة تقود القارئ إلى الحياة والثقافة الملونة في القرن الرابع عشر وتأخذه إلى العالم الإسلامي في العصور الوسطى.
ولكن من المؤسف أن ابن بطوطة لم يحظ بعد بالتقدير الكافي في موطنه؛ لأنه يستحق نصبًا مناسبًا وجذابًا، ربما يجب علينا أن نحتفل به كل سنة من خلال ندوات، محاضرات، احتفالات وإصدار مقالات وكتب. إن إنجازاته ليست ملهمة فقط لجميع أبناء جلدته، بل لكل من يؤمن بالتلاقح الثقافي، التنوع والابداع، والتعايش السلمي وتبادل الأفكار والسلع إلخ. كما يجب أن تبقى ذكراه حية بغية تخليد إنجازاته والاحتفاء بقيمه النبيلة التي ترمز إلى مجتمع مزدهر وإنساني ومتماسك، مما سيساعد لا محالة على تحقيق التقدم والازدهار.
وبشكل عام، يمكن القول إن هذا الكتاب يعد كنزًا دفينا ومهمًا لكل من كان مهتما بالصين، نظرا للمعلومات القيمة والقيمة المضافة حيث يمثل نافذة على عالم وطقوس مختلفة كما يحمل في طياته الكثير من المعارف والفوائد، وهو جد مثير للإعجاب بشكل خاص بتفاصيله وأوصافه العديدة. أسلوب الكتابة جذاب، دقيق ومقنع كما هو أسلوب واضح ومناسب، والتراكيب جميلة وممتعة، والنبرة هي وليدة المشاعر والانفعالات الصريحة، حيث تم مزج الأسلوب الصحفي بالشخصي والأدبي. وهكذا استطاع الكاتب أن يخلق جوًا لطيفًا يشعر فيه كل قارئ بالراحة حيث نجح في إيصال أفكاره ومشاعره بطريقة سلسة، واقعية ومؤثرة.
ومن أبرز ما يميز هذا الكتاب هو الجمع بين الحقائق الموضوعية والمقاطع السردية الذاتية، وهو ما يؤكد أهمية الحكي. ويعد هذا المؤلف مساهمة معنوية مهمة وعملا ناجحا، حيث يقدم فائدة حقيقية للمجتمع قصد فهم أفضل للصين كما يعتبر مكسبا للعالم العربي المعاصر. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أنه ينبغي تجنب التكرار الذي يقلل في بعض الأحيان من جودة النص، وهذا العمل سينجز في طبعة ثانية إذا رغب المؤلف في هذا. ومع ذلك، يظل الكتاب رحلة ملهمة تترك في أي قارئ أثرا عميقا وتأخذه خارج منطقة الراحة الخاصة به لاستكشاف مناطق جديدة، والسماح بالمفاجآت والتفاعل مع طقوس وأشخاص متنوعين. وإذا كان أي شخص يبحث عن كتاب ومعلومات أولية جدية ورصينة عن الصين، فهذا هو بالتأكيد الخيار الأمثل.