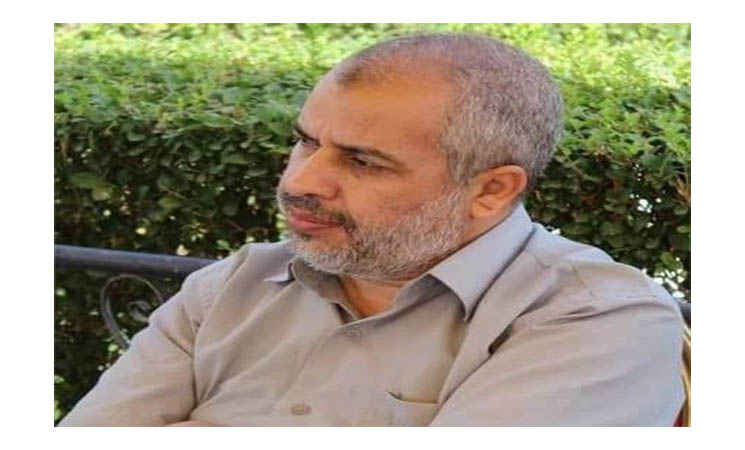وكان الّذي استقبلها في ذلك المساء البعيد أو هكذا اعتقدَتْ حين احتضنها فراغُ الحُجرة الباردة المغمورة بنور المصباح الباهت المُدَلّى فوق التّابوت المُشِعّ بدِهانه اللاّمع في العتمة الخفيفة المُحيطة بالكرسيّ الّذي كان ينتظرها بجانبه كأنْ بالصُّدْفة، هو إحساسٌ غريبٌ بالانشراح جَعَلَها تَشُكّ أو تتصوّر أنّها تَشُكّ في حقيقة وفاة هذه المرأة المُمدَّدة أمامها الآن بلا حراكٍ وقد ارتاحت من أوجاعها إلى الأبد، أو لعلّها ما زالت تُعاني منها وتتألّم – قالت في نفسها – إنْ كانت روحُها المُعذَّبة تُواصِل تحليقها في هذا العالم ولم تلتحق بعدُ بِبَرْزَخِها في الملكوت الأعلى.
لم يَخْطر ببالها قطّ أنّها ستُودّعها الوداع الأخير في هذه الحُجرة الكئيبة، المليئة بالحزن والصّمت، أو هكذا تَهيّأ لها وهي تُحْكم لفّ لحافها وتسير نحو الكرسيّ المنتصِب قُرب التّابوت بَعْد إذْ قُيِّض لها أنْ تقضي الليلة وحيدةً بجانبه رغم قساوة البرد ورهبة الوحشة المُخيِّمة على المكان.
هجمَتْ عليها الذّكريات دفعةً واحدةً قبْل أنْ تلتقط أنفاسها وحَمَلَتْها على الانغماس في ماضيها الدّفين، بينما العاصفة تُدوّي برعودها الهادرة خلف زجاج النّافذة الصّغيرة في أعلى الحائط المُلاصق للتّابوت وقد صار يبدو لها، كلّما غَمز المصباحُ المُعلَّق في السّقف أو تَقطَّعٍ بصيصُه، مثل صندوقٍ أسطوريٍّ يخرج من عمق الظّلام بفعل البروق المُلتمعة في غياهب السّماء، فظَلَّتْ تنقاد لها – أيْ الذّكريات – ولِما يَعْتمل في وِجْدانها من حنينٍ حارقٍ يأخذها إلى سنواتها البعيدة وطفولتها الأولى حيث تبدو لها الفقيدةُ ضاربةً في ريعان الشّباب والجمال والأحلام الجارفة، أو هكذا تصوّرَتْها قبْل أن ينتفض قلبها عندما تراءَتْ لها فجأةً وهي تَعْرض عليها مُرافَقتها إلى تلك الأيّام الغابرة حين كانت لا تزال صبيّةً تتعلّق بِيَدها وتمشي جذلى برُفْقَتها أينما قادتْهُما المشاوير.
نظرَتْ إليها بذهولٍ شديدٍ خلال لحظاتٍ طالت كأنّها دُهورٌ وأغمضَتْ عينيها لتمسح المشهد من خيالها وتقتنع بأنّ هذه الّتي في التّابوت ما هي إلاّ هي نفسها وبأنّ ما تعيشه معها الآن من لحظاتٍ استثنائيةٍ إنّما هو تحايلٌ منها على الموت – أو هكذا خمّنَتْ –، ثمّ تحدَّتْ خوفها وسألَتْها بصوتٍ حائرٍ وهي تتطلّع مفزوعةً إلى تلويحاتها: «كيف تطلبين منّي مُرافقتكِ إلى عالم الخلود الّذي أنتِ فيه الآن، وأنا أُكابد للبقاء في هذه الدّنيا؟»، دون أن تتلقّى منها أيّ جوابٍ عن سؤالها هذا الّذي دار في رأسها ولم يأت على لسانها.
حاولَتْ، رغم الخوف والذّهول، أن تتأكّد من حقيقة ما يجري أمامها، وقرّرَتْ بعد فترةٍ من الارتباك والتّردّد أنْ تُلقي نظرةً أخيرةً على الهالكة تحتفظ بها في ذاكرتها، فنهضَتْ بقلبٍ يكاد يخرج من حَنْجرتها واقتربَتْ من التّابوت وأزاحت غطاءَه وسحبَت الكفن عن وجهها، فإذا بها تقع على عينيها مُشِعَّتَيْن باسِمَتيْن بسعادةٍ وتَهلُّلٍ كأنّ الرّوح عادت إليهما وعاودَتْ إحياءهما من جديدٍ، وإذا بتيارٍ غامضٍ يخترق جسدها ويُدخلها في دوخةٍ بدأَتْ معها حيطانُ الغرفة تدور مِنْ حَوْلها، فاضطرّت إلى الجلوس في ذات اللحظة الّتي صارت تفقد فيها كلّ صلةٍ بمُحيطها وصار يسري في داخلها دبيبٌ غريبٌ فصَلها عن جسدها ودفَعها إلى التّساؤل بهلعٍ وهي تبتعد عنه رويداً رويداً وتُحلِّق في الفراغ: «أهكذا تُفارق الرّوحُ الجسدَ عند الموت؟».
فكّرَتْ في الّذين سيأتون في الصّباح لِحَمْل النّعش وتخيّلَتْ ذهولهم عند عثورهم على جثمانها جامداً مُتيبّساً فوق الكرسيّ، ثمّ دخلَتْ في قلقٍ جنونيٍّ على مصيرها بعد دفن هذا الجثمان: «يا إلهي! أين سأجد جسداً آخَر أستقرّ فيه بعدئذٍ؟»، قالَتْ بتحَسُّرٍ، وندبَتْ حظّها إذ تُركَتْ وحيدةً في حُجرةٍ مُحاصَرةٍ بليلٍ مُرعبٍ ومسكونٍ بأرواح أَبْقَتْها تائهةً في عماءٍ لا تموت فيه ولا تحيا.
تَرَجَّتْ تلك الأرواح إنْ كانت تسمعها أو تلتقط أفكارها أنْ تُرشدها إلى حلٍّ يُخرجها من مأزقها، ثمّ حاولَتْ أن تُقنع نفسها بأنّ الزّمن الذي سبق له أن حطّم فيها أشياء كثيرةً لقادرٌ على إنهاء هذا الّذي هي فيه الآن، ولكنّها سرعان ما تذكّرَتْ أنّ لا أحد أنقذ هذا العالم المُمزَّق بالمآسي، فكيف ستُنقَذ هي من ورطةٍ لا يعلم بها أحدٌ سواها.
توقّفَتْ بهواجسها عند هذا الحدّ، وتفرّغَتْ لسماع نحيب السّكون من حولها، إلى أن أُوحي إليها – أو هكذا شُبّه لها – أنّ انتقالها إلى مَلَكوتها الجديد ما كان ليتمّ لولا أنّها فتحَت التّابوت وتلقَّتْ تلك النّظرات المُشِعّة الّتي اتّخَذت من عينَيْها مَنْفذاً لاحتلال جسدها عن غير قصدٍ، على الأرجح، ما دام أنّ المرحومة انفصلَتْ عن ذاتها بُغية العودة إلى الدّنيا ليس إلاّ؛ فالأمر كلّه، في اعتقادها، قدَرٌ أهْوَج يسرق الحياة مِن خَطْوها وينثرها لشِباك المَرثيات المُتْرَفة بالتّهاليل.
لكنْ، «ما جدوى التّهاليل إذا كانت مُفخَّخةً بالبكاء؟»، قالت بتأفُّف العارف، وجَسَّتْ بِقَلَقِها المذعور ما يتناهبُه الشّكّ من آمال في بالها، ثمّ استطردَتْ سائلةً كأنّما تُؤنّب خَلاصَها المُقيَّد بثرثرات الغيب وتَلُوم أبوابه المُغلقة: «مِنْ أين سيأتيني غدُكِ المُنتقم من جهالات الموت المُقامِر بالأرواح؟ أمِنَ حيلةٍ مُعطَّلةٍ تُلقي بمُريديها إلى رحى المكائد، أمْ مِنَ قبورٍ خجلانة من موتاها المتسامرين حول أباريق الظّلام؟»، وسارعَتْ إلى تَفحُّص روحها الحائرة مثل مُنجِّمٍ يختبر أفكاره، ثمّ شرعَتْ تبني من أنقاض الوقت فردوسها المُشتهى، حالمةً بإلهٍ يحرس أيّامها ويُغيّر سماء السّنين.
وكان أن استجاب لها الزّمان وجاءها راكباً مدائن ملأى بخُطىً ودروبٍ وأصوات تَشْحْذ الليل وتُهلِّل: «طوبى لمن حرّرها المَجاز وتَوَّجها نجمةً تقرأ في كتاب الأبد آيات الفجر المُرمِّم بجَمْره أتراحَ البَشَر»، ثمّ شوهِدَتْ تغيب مُرتديةً وجه الفضاء كفراشةٍ تُلقي بظلّها على صحراءَ من نبوءاتٍ تَندُب خيبتها وتَرُدّ للعدم نبيذ أقلامه.
«فلا تُحاسبني، إذن، أيّها الزّمن المُبعثَر في سيرةٍ شاخت بدسائسَ ابتكرَتْها محبرةُ الأزل»، قالت مُتنهّدةً، وعادَتْ إلى أيّامها المُستنفَدَة بعد إذ أطفأَتْ نار هزائمَها بما يكفي من السُّخرية فكُوفئَتْ بأبجديةٍ مُتمرِّدةٍ على جذورها المتورّطة في رماد القيامة.