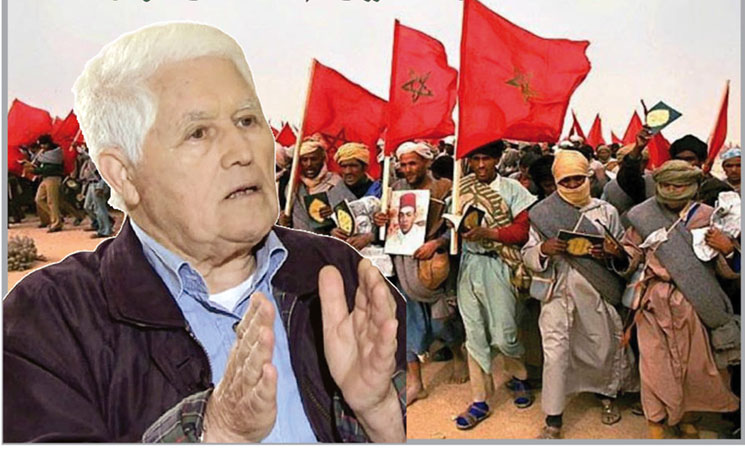عامان مرا على وفاة شقيقي الشاعر محمد الميموني، يوم 12/10/2017 ،وإني !لأعجب كيف يزداد حضوراً في َّ قدر ما تفرُّ مني الكلمات، وتغيب الحياة
لماذاّ؟ الأن حقيقة الموت أقوى من جوهر الحياة ، ومن أي حقيقة أخرى، فأمام الموت ، وحتى دون أن ننهزم ، نشعر أن كل شيء قبض ريح ، بل إن الزمن نفسه ، ما دمنا لسنا قادرين على استرجاعه بالشكل الذي نريد ليس إلا قبضاً للعدم الذي لا وجه آخر له.
معذرة شقيقي ، فإنني أشعر أني كلما ابتعدت عن حضور من كان يملأني وجودهم حياة، أمتلئ بغيابهم موتاً وفراغاً أشد ، حتى أمام ما كنت أعتبره وسيلتي للانتصار على الزمن والموت ، أمام الشعر نفسه،
لكن عزاءنا يا شقيقي أن كل شيء ، كل شيء قبضُ ريح.
فلتسترح روحك ،عنيتً: معنى روحك ، ذات روحك أنى كنتَ.
وسلام على روح الشعر : معنى الشعر في ذكراك، وفيك حيث أنت..
انتبه إلى جسَدِهِ، وهو ينطلق مثل سهم، يطير عبر فضاء، لكنه رغم انطلاقه لم يتخل عن ذاكرته التي كان يستعين بها على السير في طرقات هذه المدينة ، التي لم يُقم بها منذ طفولته ، إلا على فترات، كان تقطع ما بينها دائماً أحداث مؤلمة: تعثر في دروس، أو خصومة مع جهة رفعت في وجهه سيفاً وهي تقرأه ذات عام، فهجرها سنين طويلة، رأى نفسه يسير كما لو أنه في سباق مسافات غير محدودة، لا يدري أكان يصعد من جهة البحر حيث ما زالت قائمة مقهى تحمل اسم النهر الذي أطلق على كامل الشاطئ الذي ظلمت هدوءَهُ أمواجٌ بشر عبثت بأجوائه الصافية، وغيرت وجه الحياة به، أم كان يتهادى محمولاً بين ذراعي رياح مدينة على المحيط تآكلت جدرانها تحت معاول رياح رطوبة قاسية لم تتخل يوما عن ضباب لا تسحب أرديته الثقيلة عنها إلا بعد ساعات الصباح الندية الباردة ، أم كان ما أتى به عاطفة طالما حملته إلى بيت من كانت تمحضه الحب بين شقيقاته ، فأولاها حباً مضاعفاً وهو يراها تختطف كما تقطف زهرة يانعة من بين باقة كانت فرحة الأسرة بها لا توصف، يذكر أنها اختيرت لتختطف وهي قاصرة ، دون أن يكون بين الأقارب رجلٌ رشيد يبدي اعتراضاً ، أو يدعو على الأقل إلى تأجيل ما سمي في حينه زواجاً .فظلت على ذمة من اختطفها حتى غيَّبَه الموت، ثم اختطفها من بعده داء وبيل.
لم أدر أكان الوقت نهاراً أم ليلاً، ولم أعرف أكنت أسير على قدميّ، أم هل كنتُ أشاهد شريطاً تندفع صورُه أمام عيني، دون أن تتوقف أمام تفاصيل الأمكنة، وما تعج به، أتذكر أن العالم كان فارغاً إلا من شيء يشغل بالي، ويوجهني إلى أن أبدأ في السير إلى منزله محلقاً من شارع كبير لم أستحضر مفترق الطرق عليه، حيث يوجد بنكٌ، ومقهى كبير يقدم حلويات ويعج بزبناء لا يشبعون مما يزدردونه من مقبلات يقدمها في كل وقت وحين ، مثلما يعج مفترق الطريق بزحام السيارات التي تندفع في اتجاه مدينة (سبتة) السليبة ، تطل على فردوس مفقود.
المنزل الذي أريد يقع على مرمى حجر، رغم أنني مع وصولي إلى نقطة مفترق الطريق، لم أكن راجلاً، بل كنت كمن أتوجه إلى مكان في خيالي، فَحِينَ وصلت إلى باب البيت الذي كنت عادة ما أحتاج إلى الضغط على زر جرس الأنترفون، ليهب وجه ملائكي إلى استقبالي ، كان باب الفيللا الحديدي مفتوحاً عن آخره، وكان باب البيت الداخلي المصنوع من خشب بنيٍّ فاخر مشرعاً، ولم ألتفت إلى يساري حيث مجلس الاستقبال الذي تزينه لوحة تشكيلية وصورة جميله للمرحوم ، ولا إلى جهة الصالون الذي تزينه أفرشة فاخرة، وتتوسطه ثريا جميلة بمصابيح كثيرة، لا شيء من ذلك استوقف نظري، بل توجهت بأقصى سرعة إلى سلم ألتمس الحجرة التي أعرف أنه ينتظرني بها، وفي خيالي أيضاً كان صعودي سهلاً، دون أن أعاني من هذا الألم الذي أسمع معه قرقعة عظمي ركبتي اليسرى، فقد وصلت بسرعة لأرى الصالة التي تنفتح عليها نهاية السلم الأخير فارغة في الطابق الثاني، ودون أن أضطرب سمعت صوتاً يدعوني إلى دخول الحجرة التي رأيته بها في زيارتي الأخيرة، لم يكن هناك أحد بصحبتي ، ولم أر أي شخص وأنا أخترق بيته من مدخله عند الشارع حتى وصولي إلى حجرته .
لم يكن هناك ، فهل سافر؟ ومتى ؟
لم أنتظر جواباً ، ولم أتوقف، كما أنني لم أختر أن أجلس في نفس المكان في انتظار ظهوره، فقد صحوتُ لأمتلئ بيقين آلمني : بأن من كنت أطلب رؤيته قد أصبح بعيداً، بَعُدَ مكانُهُ عني، كما أن رؤيته بغير عين خيالي أصبحت مستحيلة ، ومع صحوي الذي اشتدَّ، غطَّى عيني غيْمٌ لم أستطع دفعه إلا بعد أن استسلمت لزوابعه في داخلي ، وهطول زخات منه على خديَّ ، حتّى أهدأ بين يْديْ نوْمٍ مختلف.