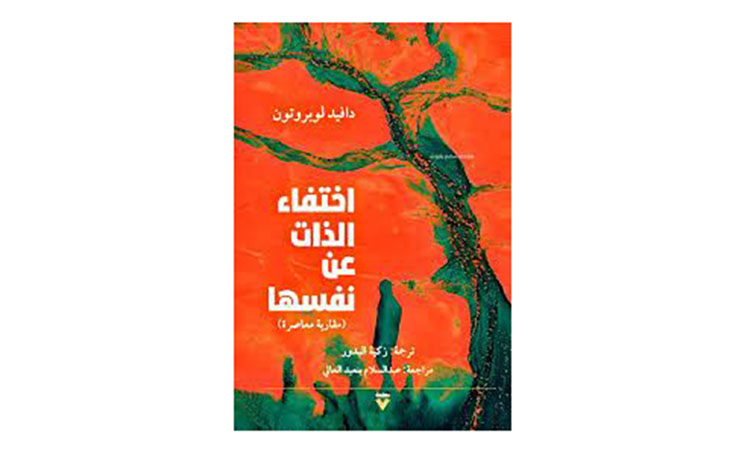من بيسوا إلى بودريار.. الذات كصورة بلا أصل
عتـــبــة
في الاختفاء الصريح للذات عن نفسها، يمكن استحضار النقطة النهائية للفعل الإنساني خارج مدارة الكينونة. وبخطاب أكثر إلغاء وتمردا على المألوف في العيش والحرية، يمكن للنفس اللامبالية، الواقعة خارج التفكير والعقل، أن تتلمس نفيا مستبطنا أكثر تشددا، فتنفذ إلى التحلل «كإمكانية للانسحاب من وضع يبدو ألا مخرج منه»، ذلك أن العلاقة بين التحلّل والحرية السلبية، عندما تُغلق الأبواب، قد يتحوّل الانهيار فيهما وبإزائهما إلى طريق للخلاص، فيصير التفكك والانفصال عن بنية قائمة، سواء كانت مادية أو رمزية/اجتماعية كالقيم أو الروابط، جزءا من فعل إرادي أو لا إرادي للخروج من علاقة أو وضع، في حالة انسداد أو مأزق، تُحسّ وكأنها قدر لا يُتجاوز، وهو ما يجعل وضعية الذات المتحللة، تراجيديا خلاّقة، أي «موت القيم القديمة» الذي يتيح ولادة قيم جديدة، بما هو انسحاب من القيم المتخشبة لا هروباً بل استعداداً لتجاوزها، بتعبير نيتشه.
إنه انسحاب أقرب إلى العدم منه إلى استعادة الطفرة، أو قوى الارتباط بالحياة. وإلا لماذا تنتهي عتبات الإحساس بالأشياء وتجفل بين متاهات الروابط الاجتماعية الباردة وارتداد ذلك على واجهة العلاقات والسلوكيات والوشائج البينية الجماعية.؟
يعيد دافيد لوبروتون تأويل هذه المحطة الاستفهامية الفلسفية، في كتابه «اختفاء الذات عن نفسها»، ترجمة زكية البدور ومراجعة عبد السلام بنعبد العالي، الصادر عن دار صفحة7 بالسعودية 2023، إلى ما يشبه حالة تمرد سلبي أمام عبث الوجود؛ ليس انتحارا بالتأكيد، بل هو تعليق للانخراط في لعبة لا معنى لها، وهو نفس المعنى الذي ارتكزت عليه نظرية ألبير كامو، الذي يذهب إلى أن التحلّل استراتيجية وجودية، كأن تقول للعالم العبثي نعم، ومع ذلك أعيش. وأن الانسحاب ليس موتاً، بل هو تراجعٌ عن لعبة لا تقود إلا للعبث.
لوبروتون يعتبر الانسحاب، في صلب هذه الخبايا والخفايا النازفة، «الإمكانية القصوى والفرصة الأخيرة لكي لا يتعرض المرء للسحق، أو لكي لا يشعر بثقل ذلك على كاهله.. وهو بانسحابه، يظل محافظا على التحكم في وجوده..».
ما يعزز نتيجة اختياره الانعزال والرغبة في الامحاء والتستر، «انحداره من مرتبة الشخص إلى مرتبة القناع، أي أنه يصبح قناعا لا وجود لشخص يلبسه، ويعطيه وجهه، لا شيء يخفيه القناع. لا شخص». وقناع بلا شخص هنا مفارقة عميقة الدلالة؛ إذ القناع عادةً يستر، لكن إذا غاب الوجه لم يعد يستر شيئًا، بل يصبح هو نفسه كل شيء. فالحكمة إذن تصف تحوّلًا، من إنسان حيّ بداخل، إلى سطحٍ محض؛ من ذات إلى صورة. وهيغل يشير إلى ذلك في مقولة بليغة يقول فيها: « الشخص هو وعيٌ يعترف به الآخر. القناع بلا شخص يعكس فشل الاعتراف؛ وجود اجتماعي بلا وعي ذاتي». إلا أنه وفي الحدود التي نتجاوز فيها هذا التوثب، يمكن التفكر في إمكانية أن يعبّر القناع عن سوء النية؛ حين يتخفّى الإنسان وراء أدواره الاجتماعية ليتفادى مسؤوليته. لكن الأسوأ، أنه لم يعد يخفي شيئًا، فقد تلاشت الذات التي كانت تمارس الخداع.
البياض كقوة: الانسحاب الذي يولِّد موت القيم وولادة جديدة
بما أن البياض هو أثر الغياب، تماما كالكتابة البيضاء التي تحتضن النصّ لكنها تكشف هشاشته. فالورقة البيضاء ليست محايدة، بل تُمارس سلطة، ومن دونها لا كتابة، لكنها أيضًا تهدد النصّ دومًا بالمحو. في عتمة هذا الصقيع الممهور بتجاويف الفقد والمخاتلة، يثير لوبروتون في كتاب الاختفاء، مسارا آخر لتذويب «شخصية المعزول»، فهو يقيم مواجهة بين حيوية الفكر وسلطة البياض كقوة مضادة، فليست «لونية البياض» بمعناها الفيزيقي، بل حالة، فراغا، سكونا، محوا، وإمكانا. البياض هو الورقة البيضاء التي تسبق الخطّ، الصمت الذي يسبق الكلمة، الغياب الذي يسبق الحضور. أما إرادة الإبطاء فهي فعل مقصود، لا مجرد نتيجة عرضية. بمعنى، أن البياض يحمل رغبة واعية في تعطيل السرعة، في كبح تدفق المعنى.
إن لوبروتون يصل إلى حتمية سعي الذات المخفية، إلى الفقدان الصيروري، بل إلى «تحويل الفرد لروابطه الاجتماعية إلى صحراء، كي يتصرف كمتفرج لا مبال بعيد عن كل تفكير». ربما إيمانا منه، بأن تمجيد ميتافيزيقا الامتلاء والحضور تذكّر حتما بأن الفراغ (البياض) قوة منتجة، قادرة على تقويض المعنى. في زمن السرعة، حيث يكون «البياض» فعل مقاومة. كما أن الإبطاء ليس دومًا قمعًا، بل قد يكون حكمة تسمح للفكر بالتخمّر، لإعادة صياغة أسئلته. وقد كان لمثال وصف بيير جاني، الذي ساقه لوبروتون في هذه الزاوية مبلغا حصيفا للاستئناس، حيث قال: «مرضى أنهكهم الشعور بالفراغ، إنهم لا يشكون من أي ألم، ولا يهتمون بشيء، ولا يحسون بشيء مثل مادلين التي تقول:» لم أعد أقوى على فعل أي شيء. أنا في عطالة تامة، في حالة خمول لن يخرجني منا أي شيء..».
إن ثمة بياضا قمعيا، باعتباره سلطة الصمت والهيمنة، إرادة تعطيل. هو نفسه الذي ينزف متحورا إلى الشغور والاستبدال، بل ماتحا ومرتويا من عطن العطالة والسلبية. بعكس ما يرغب الفيلسوف، حيث البياض الخلاّق، بما هو فسحة للتأمل، زمن لإعادة ترتيب الفكر، ما ينتج بالتالي فرضية عدم إدانة البياض بقدر الدعوة لوعي قوّته المزدوج. فالبياض هو الميدان الذي يتصارع فيه الفكر مع إمكان عدمه؛ بل هو إرادة توقف، لكنها قد تكون شرطًا لولادة فكر آخر.
يسير لوبروتون بنا إلى منطقة سحرية تسع البياضين معا، القمعي والخلاق، تلعب فيه نواة اللامبالاة دورا استراتيجيا لمعنى «تدبير الظهور»، أو كما سمّاه سيرين كيركغور بـ»الداخلية» حياة الحقيقة التي لا تُقال كلّها، لأن «ما هو أعمق من الحقيقة لا يُقال بل يُعاش»، فاللامبالاة اليومية تصبح أدباً اجتماعياً، نمارسها تفادياً لجرح الآخرين أو لإثارة صراع غير منتج. يشبه ذلك ما لاحظه إرفنغ غوفمان في تحليله للحياة اليومية: نرتدي «أقنعة المجاملة» للحفاظ على «وجه الآخرين» وعلى «وجهنا نحن».
إنه أحيانا يكون التخلي عن الذات هو الطريقة الوحيدة لكي لا يموت المرء، أو لكي ينجو مما هو أشد سوءا من الموت.
إن تلك اللامبالاة النوعية، في ارتطامها الاستعاري بالزجاج الفاصل بين الذات والعالم، جدارا لا مرئيا، هي مبرأة من حدوث أي تأثير ينتج عنه رتابة وتكلس وتكرار. بل «يلغي معنى التجربة كي يحولنا إلى فرجة»، لا رابطة تشدها إلى الذات». فالزجاج الذي يفصل الذات عن العالم ليس جدارًا صلبًا، بل شفافية فاصلة؛ فهو يتيح الرؤية ويمنع اللمس. هنا يمكن استدعاء مارتن هايدغر حين يتحدث عن «الانكشاف « الذي يظل دائمًا مهددًا بحجاب، فالعالم ينكشف لنا لكننا لا نلامسه إلا عبر وسيط. فاللامبالاة إذن لا تعني القطيعة المطلقة، بل علاقة إدراكية بلا تفاعل، رؤية بلا تماس، ووعي بلا انخراط.
وفي ضوء غي ديبور «مجتمع الفرجة» الذي يرى أن الإنسان في عصر الاستهلاك يتحوّل إلى متفرّج على ذاته وعلى العالم. يستحضر جان بودريار الذي تحدث عن «اللاحدث» حيث لا يبقى للحدث أثر لأن التكرار والتمثيل الإعلامي يفرغانه من معناه. وهنا تبدو اللامبالاة كأنها ليست مجرد سكون، بل تعليقا للمعنى، إذ التجربة لا تفضي إلى تراكم أو ذاكرة، بل إلى صورة متكررة، فيتحوّل الإنسان إلى كائن بلا تاريخ حي.
هوية بلا وجه: محاكاة الذات في زمن الشبكة
عندما قلنا إن اللامبالاة النوعية ليست لا مبالاة سطحية، بل موقفا ميتافيزيقيا، تفصل الذات عن العالم بزجاج شفاف؛ وتنقّيها من الأثر حتى لا يعلق بها شيء؛ لكنها تدفعها في النهاية إلى أن تصبح موضوعًا للفرجة، لا فاعلاً للتجربة. فإنها أيضا وبالتتابع، حالة «وجود-خارج-الوجود»، أي مقاومة للمعنى، لكنها محكومة بسطوة الصورة، وكأنها تقول إن أقصى أشكال الحرية قد تفضي إلى أعمق صور السجن، سجن اللامبالاة التي لا تترك وراءها سوى الصمت والانعكاس البارد للعالم.
تلك اليقظة الفارقة، تحول لحظة اللامبالاة إلى طعم لاجتزاء شكل جديد للمحو أو الامحاء، بما هو لذة تخفف من سطوة وثقل الأنا، يعتبرها لوبروتون طريقا بسيطة للتحلل من إكراهات الهوية … (في المحادثات أو المنصات وألعاب الفيديو عبر الأنترنيت، والعوالم الموازية للشبكة العنكبوتية)، بمضاعفة الألقاب أو الصور الرمزية.
إن ثمة توصيفا تشخيصًا نقديًا لظاهرة تفكّك الهوية في الفضاء الرقمي، حيث تذوب علامات التمييز الشخصي، الوجه والصوت في بحر من الصور الرمزية (avatars) والتمثلات الافتراضية. إنها ليست مجرّد ملاحظة اجتماعية، بل تحمل دلالات فلسفية عميقة حول ماهية “الذات” في عصر الشبكة. يقول لوبروتون : إن «الشبكة العنكبوتية تعمل على تحريف أوجه الفرد، فهي تنفع في ألعاب الهوية من حيث إنه لا يكون من اللازم أن نقدم أدلة على صدق الشخص الذي صرحنا أننا إياه. إن اختفاء الوجه، بله الصوت هو شرط مثالي لاختفاء الذات في ظل الصورة الرمزية أو المشابهة مادام التعرف على الذات مستحيلا»، فالوجه هنا هو موقع الأخلاق، لأنه يفرض علينا الاعتراف بوجود الآخر ونداء مسؤوليته. لكن في الشبكة العنكبوتية، يُلغى هذا «النداء» مع اختفاء الوجه خلف قناع رقمي، فينقطع ذلك الرابط الأخلاقي الذي يفرض حضور الآخر.
جان بودريار تحدث عن هذا الأمر في نقده لـ «المحاكاة»، فيمكن أن نقرأ هذه المقولة كإشارة إلى أن الهوية في الإنترنت لا تعود تمثيلاً لشيء أصيل، بل تصبح «صورة لشيء لا أصل له». إن «الصورة الرمزية» ليست مجرد إخفاء للذات، بل استبدالا لها بمحاكاة لا مرجع حقيقي لها. نتساءل: ما اللعب بالهوية، وما قيمتها أمام ثنائية الحرية والعبث؟
يرى سورين كيركغارد أن الهوية مشروع قلق يتطلب الاختيار والمسؤولية، غير أن «ألعاب الهوية» في الفضاء الافتراضي تحوّل القلق الوجودي إلى لعبة بلا التزام، حتى إنه يمكن أن «نكون» من نشاء بلا دليل، وبلا تبعات. فيظهر البعد العبثي الذي تحدث عنه ألبير كامو: «اللامعقول» ليس في صراع الإنسان مع الكون، بل في صراع الذات مع صورها التي لا تنتهي.
الحرية في الاختفاء قد تُفهم كتحرّر من الرقابة الاجتماعية، لكنها تحمل خطر التحلّل الوجودي. فحين «التعرّف على الذات مستحيل» تصبح الذات مجرد قناع قابل للتبديل، ويتهدد إمكان الحوار الأصيل مع الآخر. ومن منظور حنة أرندت، التي ربطت السياسة بظهور الفرد في الفضاء العمومي، يغدو هذا الاختفاء انسحابًا من المجال العام، وبالتالي تقويضًا لأساس الفعل السياسي الحر. نفس الشيء بالنسبة لشارل تايلور، الذي شدد على «الاعتراف» كشرط لتكوّن الهوية، فإن غياب الحاجة إلى الاعتراف يقود إلى هوية بلا جذور، متقلبة، لا تجد سندًا أخلاقيًا.
بهذا المعنى، يطرح الفضاء الشبكي سؤالاً وجودياً: هل يمكن لذات بلا وجه ولا صوت أن تدّعي الاستمرار كـ»أنا»؟
ربما يكون الجواب في استعادة مسؤولية الظهور، أي الوعي بأن التخفي ليس حيادًا، بل فعل يحددنا أخلاقياً بقدر ما يحررنا.
بيسوا أو فن تفريغ الذات من المعنى
خص الكاتب دافيد لوبروتون فصلا كاملا من كتابه «اختفاء الذات عن نفسها» عن تجربة بيسوا في استفراغ الذات، وثناية القناع والفراغ، والحزن والحنين كقاعدة للاستفراغ. عنونها ب»بيسوا (التعدد طريقا نحو اللا أحد).
«الذات» عند فرناندو بيسوا ليست وحدة متماسكة ثابتة، بل حقلا متشظّيا من أقنعة وأسما تتصارع، تتبدل، وتتفكك. و»استفراغ الذات» يلخص عملية متكررة في شعره ونثره، تفريغ للذات من مركز ثابت، تفريغ لمعنى محدد، وتحويلها إلى مادة لغوية/درامية تُبطّنها السخرية والحنين واللايقين.
بيسوا لا يكتفي بوضع قناع فوق وجهه، بل يخلق شخصيات مستقلة، كلٌّ منها يملك سيرة ونبرة فكرية، تُعلن أن «الذات الأصلية» فارغة أو غير موجودة. هذا التعدد ليس تضخيمًا للهوية بل هو طريقة لاستنزاف أي مركز ذاتي صلب: كلما وَلَدَ اسماً جديداً زادت المساحة الفارغة في «أنا» المؤلف. فالذات ها هنا تستفرغ من الثبات وتتحول إلى سلسلة من الإيماءات والأساليب.
في بعض نصوص بيسوا يُقرأ الاستفراغ كطقس تطهيري، إخراج ما يعيق القدرة على الشعور أو الإصغاء. لكن هذا «الإخراج» ليس ارتياحًا؛ بل عملية مؤلمة تُظهر أن الذات لا تحتوي أكثر من رغبة في العدم. بالتالي، الاستفراغ لدى بيسوا هو فعلُ كشفٍ: كشف عن عدم القدرة على تجميع معنى واحد يحيل الوجود إلى أمر يُطاق.
فيما الحنين البرتغالي دائم الحضور لدى بيسوا كخلفية يبدو فيها الاستفراغ كما لو أنه ليس تفريغاً فحسب، بل فقدانًا يعيد تشكيل الحرارة الشعورية إلى ضياع. الذات تستفرغ الشغف فتتحوّل إلى حنين لعدم التعلّق؛ تستفرغ الأنا فتبقى ذاكرة مُشتتَة ومحكومَة بالاشتياق إلى غياب متخيل.
يترجم ألبرتو كايرو هذه القفزة البيسوية كونها تمثل براءة المشاهدة والتجربة الحسية الخالصة. إنه يقرّب الذات من «الطبيعي» عبر نفي بناء المعنى، كأنه إجراء استفراغي للرمزية والفلسفة. كما يمكن ربط ظاهرة الاستفراغ عند بيسوا بتأثيرات فلسفية ورمزية، كالنزعة الوجودية المبكرة، وتأثير الرمزية والديكادنس الأوروبي (Décadence)، ورفض سرديات التماسك الذاتوي. لكنه ليس مجرد تقليد فلسفي؛ بيسوا يحول هذه التأثيرات إلى أداء شعري حيث يصبح التفكك اختبارًا لحدود اللغة والكتابة.
إن استفراغ الذات عند بيسوا ليس مجرد موضوع بل تقنية وجودية ولغوية، تفريغ يتخذ أشكالًا شعرية ونثرية، ويتحقق عبر اختراع هويات، نفي المعنى الموحد، واستعمال أدوات بلاغية تجعل من التفكك ذاته مادة إبداعية. النتيجة ليست انعداماً محضاً بل إنتاج حالة جمالية ترتكز على الفراغ، فراغ يُقرأ، يُحزن، ويُبدع. كما «الاختفاء» حل في مواجهة العياء من أن يكون المرء نفسه، وكذا في مواجهة الإحساس بأن المرء قد أعطى كل شيء، أو أن يرغب في أن يحافظ على نفسه في ضبط النفس أو في العزلة، إلا أنه كذلك حل في مواجهة الشعور بتعدد الذات، والاقتناع بإيواء شخوص متعددة، مع عدم القدرة على التضحية بهم، يقول لوبروتون مؤكدا.
سيكون من المدهش والمثير أن ننهي رحلة بيسوا عبر هذه اللؤلؤة الظامئة، حيث يقول على لسان بيرنار دوسواريس ضمن يوميات أسماها «كتاب اللاطمأنينية»:» لقد سلبوا مني القدرة على أن أكون قبل وجود العالم. إذا ماكنت مضطرا إلى التناسخ من جديد، فذلك من دوني، دون أن أكون أنا قد حللت في جسد جديد. أنا ضواحي مدينة لا وجود لها. أنا التعليق المطول على كتاب لم يكتبه أحد قط، لا أحد، أنا بيسوا. أنا شخصية روائية، مازالت لم تكتب، أنا أطفو في الهواء، متناثرا، دون أن أكون قد وجدت، من بين أحلام كائن لم يعرف كيف يقضي علي.. وأنا، ما هو فعلا أنا، أنا مركز كل هذا ، مركز لا وجود له، اللهم إلا من جغرافية الهاوية. أنا هذا الشيء الذي تدور حوله تلك الحركة».
نص شاهق، يصرخ من داخل فراغ، حيث الذات عند بيسوا ليست ثابتا قبل العالم بل مسروقة منه، فقد حُرمت القدرة على «الوجود قبل الوجود». هذا فقدان أولي يجعل الوجود لاحقًا متزلزلًا، مشتقًا، وكأنه إعادة ولادة بدون حامل؛ تناسخ بلا صاحب. نعم، نص يحتفل باللايقين، حيث الهوية ليست حقيقة مُنجَزة بل فعل سردي مستمر، هروب من ذات ثابتة نحو تعدّدٍ لا يهدأ.
أنوريكسيا الروح:
زهدٌ جسدي ومحوٌ متعمّد للحضور
شيئا فشيئا، يقترب لوبروتون إلى ما يشبه التزحلق نحو العدم/ اللامعنى. يشكل في سياق الاختفاء المتعدد، مظاهر الانتشاء بنزعة مغايرة، طافقة بالجرأة والهروب من الجسد المتعب المنهوك. فخلال ابتداع الطريق نحو خلق نشوة للامتناع عن الطعام والشراب (الأنوريكسيا)، حيث البحث المضني عن نحافة لا متناهية مصحوبة بالطهارة، ثمة مقاومة شرسة من نوع شاذ، ضد الجنسانية، التي تمنعك من الحياد الجنسي، في محاولة لإيقاف زمن الجسد، الرغبة في أن تكون كأنها لم تولد. بل يقايض (الأنوريكسيا) كتربية ومران على الوجود، وحياة زاهدة تمارس في كل لحظة وحين، مقاومة بلاهوادة ضد الذات وضد الاخرين، حتى تتسنى تقوية القلعة الداخلية. وهي علاوة على ذلك، دليل على معاناة الألم، تفرز انتقالا لسخرية حادة إزاء الخطابات المدبوغة بمفهوم «النحافة». بعدها تأتي طقوس الغيبوبة الناتجة عن التخدير (السكر، الخفة، الهيجان، والهذيان)، متحللة من الضغوط الأخلاقية الذاتية، ينتج عن ذلك من الوجد أو النشوة المبتهجة المحاذية للغيبوبة، التي يبحث عنها الآخرون بالمقابل وبإصرار.
إن تعمق التخدير جذريا باستعمال المخدرات أو الكحول، يبرز لوبروتون، إنها لم تعد سعيا وراء الاحساسات، وإنما بالأحرى بحثا عن الاختفاء، وولعا بالغياب عن الوعي. يقول: إنه وجود يتناوب مع مراحل غياب أو انسحاب وليس وجودا ذاتيا مسترسلا. وهو نكران كيميائي للواقع، واستهداف رمزي للغيبوبة، وللبياض، لكي لا تمسه خشونة العالم المحيط بعد الآن.
إننا هنا بإزاء تأمل في جوهر الهروب الكيميائي بوصفه موقفًا أنطولوجيًا أكثر منه نزوة حسية. فالتخدير، حين يتعمق ويتحول إلى عادة، لا يعود بحثًا عن متعة عابرة، بل يصبح مشروع محوٍ للذات، تعطيل متعمد لسيرورة الوعي كي تُعاش لحظة «لاوجود» تُعفي الكائن من قسوة الحضور في العالم.
يذكّرني هذا الموقف بـ نفي الإرادة عند شوبنهاور، حيث الخلاص يتحقق بإخماد الرغبة، لكن هنا عبر كيمياء الجسد لا عبر التأمل. كما نزعة بودلير إلى «مصطنع الفردوس»، حيث الكحول والحشيش يفتحان فجوة زمنية تسمح بالانسحاب من شرط الواقع. غير أن ما يصفه لوبروتون يتجاوز المتعة أو الجماليات، إنه تدمير رمزي للزمن، انقطاع متكرر عن الاستمرارية التي تجعل الهوية ممكنة.
هذا «الغياب الإرادي» هو فعل مقاومة سلبية، قريبة من «اللامبالاة الميتافيزيقية» عند كامو أو من رغبة المعاصرين في «محو الذات» كما عند بيسوا؛ لكنه هنا مبرمج كيميائيًا، حيث تصبح المخدرات أداة لاغتيال الوعي نفسه. إنّه تمرّد بلا صرخة، محاولة لارتداء بياض الغيبوبة اتقاءً لخشونة العالم، لكن ثمنه هو تفكك الأنا وتحوّل الوجود إلى سلسلة من فواصل الانسحاب لا رابط بينها.
إضاءة أخيرة
إنها حقا، رحلةٍ متدرّجة نحو محو الذات، حيث يتحوّل الغياب من فعلٍ عارض إلى إستراتيجية وجودية. يبدأ من تمردٍ هادئ على «لعبة» العالم، فيصبح الانسحاب لحظةَ حريةٍ سلبية تُحطم القيم المتخشبة وتتيح إمكان ولادة قيم جديدة. لكن هذه الحرية تتلوّن ببياضٍ مزدوج، بياضٍ خلاّق يمنح الفكر فسحة صمت وتأمّل، وبياضٍ قمعي يمحو الأثر ويُحوّل الإنسان إلى سطحٍ بلا عمق.
في هذا الفراغ، يغدو القناع رمزًا مفارقًا، قناعا بلا وجه، صورة بلا أصل. الذات تتبدّد إلى مجرّد قشرة مرئية، كما وصف هيغل فشل الاعتراف. هكذا تصير اللامبالاة موقفًا ميتافيزيقيًا؛ رؤية بلا لمس، حضورًا بلا انخراط، في عالمٍ «فرجوي» على طريقة غي ديبور وبودريار، حيث الحدث يتلاشى في تكراره والصورة تبتلع الأصل.
الفضاء الرقمي يضاعف هذا المحو، هوية بلا وجه ولا صوت، أقنعة رمزية تحرر وتُفكك في آن، حتى يغدو الاعتراف الأخلاقي مستحيلًا، فيما تصبح الحرية هنا مفارقة، كل قناع تحرّرٌ من قيد، وكل تحرّر سقوطٌ في عدم.
يجد النص الساحر الذي بين أيدينا ذروته في تجربة فرناندو بيسوا، الذي جعل من «استفراغ الذات» فناً: تعدّد الأقنعة لا لتكثير الهوية بل لاستنزافها حتى العدم، حنينٌ إلى غيابٍ سابق على الوجود، كتابةٌ تحوّل الفراغ إلى جمالٍ مأساوي.
وتمتد هذه الرغبة في التلاشي إلى الجسد نفسه، أنوريكسيا الروح، بما هو زهدٌ جسدي يسعى إلى محو الحضور، وتخديرٌ كيميائي يصبح نفيًا متعمّدًا للوعي، لا بحثًا عن لذّة بل عن «لا-وجود» يُعفي الكائن من خشونة العالم. إنه شوبنهاوريّ في جوهره، تمردٌ بلا صرخة، بياضٌ يتآمر على الزمن والهوية.
هكذا يرسم النص خرائط العدم كجمالٍ مضاد، حيث الانسحابٌ يفتح إمكان ولادة، وصمتٌ يفضح المعنى، وذاتٌ لا تنقذها إلا قدرتها على الاختفاء.
*»اختفاء الذات عن نفسها» دافيد لوبروتون، ترجمة: زكية البدور، مراجعة: عبد السلام بنعبد العالي ـ دار صفحة 7 السعودية، ط 1 العام 2023