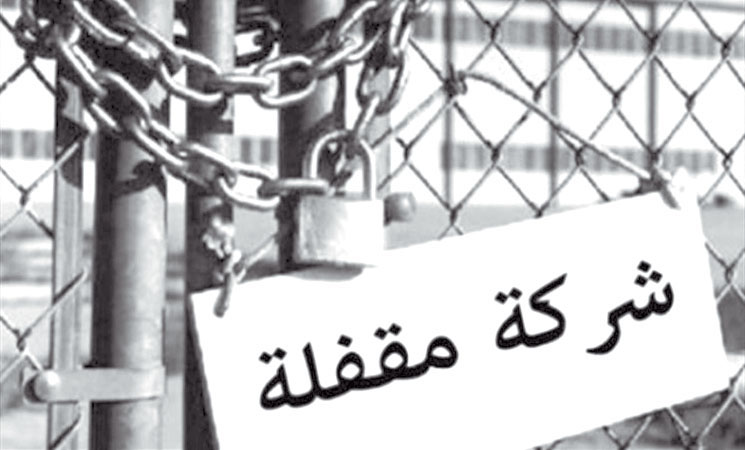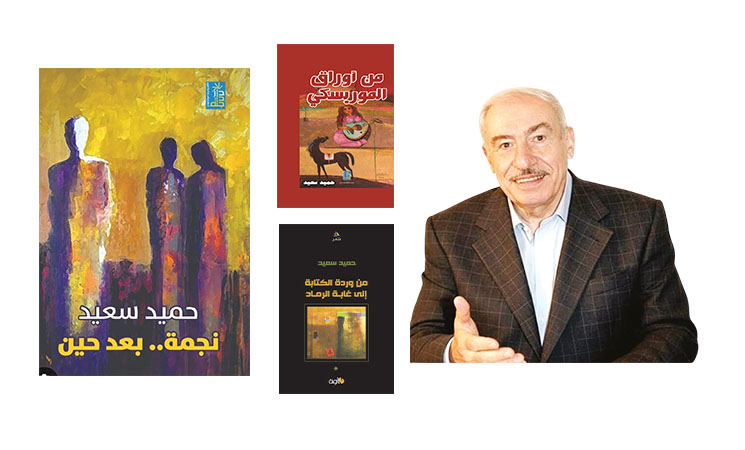تطل علينا إشكالية «فَنّ الكتابة الآلية» بوصفها ممارسة تربك الحدود التي وضعها رولان بارت قبل نصف قرن حين أعلن «موت المؤلِّف»؛ ففي مقاله الشهير (1967) رأى بارت أنّ سلطة المعنى تنتقل من المؤلف إلى القارئ، وأن النصّ فضاء تتقاطع فيه اقتباسات لا حد لها، وأن «ولادة القارئ» أي بمعنى آخر تحرير القراء من سيطرة استبداد المؤلف وإعطاء أولوية لذات النص على حساب ذات مؤلفه، بهدف دراسته دراسة موضوعية، تنطلق من النص ومعطياته الداخلية. لن تتم هذه العملية إلا بسقوط المرجع السلطوي الذي يُدعى الكاتب، أي أن نسبة النص إلى مؤلفه معناها إيقاف النص وحصره وإعطاؤه مدلولا نهائياً. وهو بهذا يلغي تأثير الذات الإنسانية الفاعلة، وهو ما يشكل اليوم حاضنةً فلسفية لظهور نماذج لغوية كبرى تكتب بلا اسم ولا تجربة ولا توقيع، مستعيضةً عن السيرة الذاتية بمستودع بيانات؛ ذلك أن الآلة لا تقول «أنا»، بل تقترح «نحن» إحصائيًّا، فتتفكك الملكية الفردية للنص كما بشر بارت في تنظيره البنيوي لتموُّت المصدر، غير أن هذه الطفرة التقنية تعيد طرح السؤال الذي حاول النقد التفكيكي تأجيله: إذا غاب المؤلف البشري، فمَن المسؤول عن المقصد والدلالة والأثر؟ وهل يمكننا اعتبار كتابة الذكاء الاصطناعي تحقيقًا حرفيًّا لموت المؤلف أم أنها تعيد إنتاجه في شكل مؤلف خفي هو الخوارزمية وقيم الشركات المالكة؟ إنّ الكتابة الآلية تُحوِّل النص إلى «جسد بلا أعضاء» إذ تُفككه إلى وحدات قابلة لإعادة التركيب، لكنّها في الوقت نفسه تنسج علاقة سلطة غير مرئية، لأن من يختار بيانات التدريب ويضبط المعمار يكتب على نحوٍ ما داخل النص، فيصير «مؤلفًا مؤتمتًا» يتخفّى وراء صيغ احتماليّة؛ وبذلك تنتقل سلطة المؤلِّف من الفرد إلى النموذج إلى صانع النموذج، فتستعيد المركزية التي أراد بارت تقويضها وإن بلغة أخرى، بينما القارئ الذي كان من المفترض أن يصير سيد المعنى، يجد نفسه أمام كلماتٍ بلا توقيع حصين فيضطرّ إلى استنباط مقصد خوارزمية لا وعيَ لها، ما يُعيد إنتاج «الكاتب الشبحي» كما وصفه أمجد نجم الزيدي في « مقال الكاتب الشبح .. المخاوف والأبعاد الأخلاقية». وتزداد المفارقة حين نتأمل بُنية الجملة الآلية: فهي جملة بلا ذاكرة حسية، تأخذ شرعيتها من إحالتها المتكررة إلى أنماط سابقة، فتُمثِّل براديغم «الكتابة بوصفها استشهادًا مستمرًّا» كما لَخَّص بارت، إلا أنّ هذا الاستشهاد حين يكون بلا وعي يحاكم النصّ بآثام الانتحال والتكرار، فتبرز الحاجة إلى إعادة تموضع القارئ كمحرّرٍ ومسؤولِ معنًى، أي أنّ موت المؤلّف لا يكفي، بل ينبغي «ولادة المُراجِع» وهو دورٌ لم يتنبأ به بارت صراحة. وإزاء هذه التحوّلات يصبح «فنّ الكتابة الآليّة» اختبارًا حديًّا لنقائض المنظومة البنيوية: فالنص لم يعد تراكب اقتباسات فحسب، وإنما صار النص عبارة شبكة احتمالات لا نهائية، والقارئ لا يتسلّم مفاتيح المعنى بقدر ما يتسلم عبء التحقُّق من أصالة التوليف، فيتحول إلى طبقة نقدية دائمة الحضور، بينما يتقهقر المؤلف/المهندس إلى خلفية الخوارزمية مثل أوريست في مأساةٍ لا اسم لصانعها؛ ومع ذلك فإن موت المؤلّف في الكتابة الآلية لا يعني موت الخبرة البشرية، لأنه ما إن تظهر فراغات الوجدان، غياب القصد، التجربة، الذاكرة الثقافية، حتى يشتاق القارئ إلى «اسمٍ» يحمل النص حرارةً وسيرة، فتتكون أشكال هجينة من التأليف التشاركي حيث تُقترح الجمل آليّاً ثم يُعاد تشريبها بذاتية الكاتب، هنا يبرز مفهوم «المؤلف-المُحرِّر» كاستجابة معاصرة تنتزع للإنسان موطئ قدم داخل نص تُقترحه الخوارزمية، فتحقق مقولة بارت في مستوى وتُخرقها في مستوى آخر: يموت المؤلِّف-المُهيمن، لكنه يعود بشكل «مؤلِّف ثانوي» يُضفي الشرعية العاطفية والرمزية على بناءٍ لغوي جاهز؛ وفي ضوء هذا التوتر تطرح ثلاثة مستويات جديدة للبحث: (1) كيف تُعاد صياغة المسؤولية القانونية للنصّ في ظل تأليف خوارزمي؟ (2) ما ملامح التلقّي الجمالي عندما يعلم القارئ أن المؤلف آلة؟ (3) إلى أي حدّ تُعيد الكتابة الآلية إنتاج مركزية سلطة جديدة باسم «البيانات الضخمة»؟ وللإجابة يُقترح تفكيك الخطاب الآلي عبر أدوات تحليل الأسلوب لاكتشاف التكرار الاحتمالي، ومقارنته مع الانزياح البشري في نصوص مثل «بريد الليل» لبركات التي تجعل العنوان مُقامًا سرديًّا ضائعًا، أو «الموت عمل شاق» لخليفة حيث يتحول موكب الجنازة إلى استعارة لحسد الأحياء، أو قصائد عبد الله زريقة، وهي أمثلة تُظهر أن الدلالة تولد من معاناة الكاتب خلال عملية الكتابة وليس من إعادة تركيب بيانات؛ هكذا يظهر أن الكتابة الآلية تحقق موتًا تقنيًا للمؤلِّف وتفشل في إنجاز موتٍ شعوري أو رمزي له، فيظل الإنسان، بخبرته ومرجعيته، شرطًا كي يستعيد النصّ حيويته وأفعاله الحضارية.
نقلُ السلطةِ الإبداعية داخل النص المشترك، أنسان – آلة
في أواخر ستينيّات القرن العشرين، حين أعلن رولان بارت «موت المؤلِّف»، بدا أن النص الإبداعي صار فضاءً تُلغى فيه سلطة القصد الفردي لصالح حركة اللفظ الحر داخل شبكة علامات لا متناهية، وأنّ القارئ وحده يملك حقّ «التشييد» لأنّ الكاتب غدا ،في المنظور البنيوي ، مجرد وظيفة لغوية متنحّية. غير أنّ ما رآه بارت صورةً رمزيةً للافتراق بين السيرة والكتابة أصبح اليوم واقعًا ماديًّا متجسّدًا في النماذج اللغوية التوليدية؛ إذ يُنتج الذكاء الاصطناعي نصوصًا تخلو من أيّ «ذات» متموضعة، إنما تنهض على سرد آلي مُستمد من كم هائل من البيانات تجمع معارف شتى دون الاعتراف بتوقيعٍ أو تجربة. وبذلك تتحوّل الكتابة التوليدية إلى نقطة تَلاقٍ بين حَديْن متباعدين: حدّ الهرمنيوطيقا الكلاسيكية التي ترى العمل الفنيّ فعلًا ذا قصد متخفٍ في العمل نفسه (غادامير)، وحدّ البنيوية التي تشيع المعنى في «عمق اللغة» بلا وسيط ذاتي. يظهر، من هذا المنظور، أنّ سؤال التأويل الجديد لا يُعنى بكشف نيّة شخصٍ غائب، لأنّ لا شخص خلف النصّ أصلًا، كما لا يُعنى بإماطة اللثام عن ذات لغويّة خفيّة، لأنّ الشبكة الاحتمالية للنموذج لا ترى نفسها إلا بوصفها خوارزمية إكمال. وبذلك ينتقل التفسير من البحث عن مقصد إلى البحث عن إجراء: بأيّ خوارزمية تراتُب معطيات السياق؟ وكيف تُولَّد الدلالة إحصائيًّا من دون أي موطئ للإرادة؟ بل إنّ المفسِّر يجد نفسه أمام نصّ بإمكانه أن يتوالد إلى ما لا نهاية، لأنّ كلّ إعادة صياغة Prompt تُنجب نسخة جديدة؛ فيعود النصّ «دالة رياضية» تولِّد إصدارًا مختلفًا متى تغيَّر معطى الإدخال، الأمر الذي يسلب القارئ التقليدي استقراره في مواجهة عمل «مكتمِل»، ليضعه أمام عمل «متغير» يجب أن يُعاد فهمه بدينامية اللحظة. هنا تتغيّر بنية «أفق التوقّع» عند القارئ (ياوس) من قدرةٍ على مقارنة النص بمدونة سابقة إلى قدرةٍ على مفاوضة نصّ يتغيّر لحظيًّا وفق طلبه، فيصبح التأويل مساومةً مع آلة: كلّما ضاق المعنى أعاد القارئ توجيه الآلة بتعليمات أوضح فيوسع الدلالة أو يضغطها، فينشأ تأويلٌ تداولي ظرفي ينسب المعنى إلى حدث الحوار لا إلى النص ذاته، وعند هذا الحدّ تُواجه الهرمنيوطيقا أزمةً: فهي تفكّر في نص ثابت يحتاج مجهرًا تاريخيًّا لقراءته، بينما النصّ التوليدي لا يصل إلى لحظة ثبات تتيح هذا المجهر؛ هو كائن احتمالي، أو «جُملة في حالة تَشرُّد»، بحسب استعارة يمكن استنباطها من فكر بول ريكور حين تحدث عن النص الغريب في «من النص إلى الفعل». إنّ هذا التشرد الاحتمالي يُفضي إلى مفارقة: كلّما تكرّست ديمقراطية النص بغياب المؤلّف، استحوذت الخوارزمية (ومن ورائها الشركة المالكة) على سلطة تأطير الاحتمالات، فتولد طبقة سلطة غير مرئية تُدير «احتمال المعنى» دون أن تحمل أيّ مسؤولية شعورية أو أخلاقية، فتغدو القراءة فعلَ مقاومةٍ مزدوجًا: مقاومة لحياد الآلة ومقاومة لهيمنة مالكها في آن.
التأويل وإشكالية الكتابة الآليّة
منذُ بدأت الهرمنيوطيقا الحديثة مع فريدريك شلايرماخر وصولًا إلى غادامير وريكور، ظلّ التأويل فعلًا يبحث عن «قصد» أو «فهم» أو «أفق» يربط النصّ بذاتٍ إنسانية، سواء أكانت ذات المؤلِّف أو ذات القارئ. لكن ظهور النماذج اللغويّة التوليديّة – ولا سيّما بعد إعلان رولان بارت (1967) «موت المؤلِّف» – قدّم مشهدًا جديدًا تتعرّى فيه الكتابة من تجربة شخصيّة أصيلة: هنا لا يقف خلف النصّ كائنٌ متعذَّب أو راغب أو متذكّر. إنّ هذا الغياب الجذري للمقصد يقلب أساس التأويل الكلاسيكي رأسًا على عقب؛ فإذا كان فهمُ النص، وفق غادامير (1960)، حوارًا بين «أفق المؤوِّل» و«أفق العمل»، فأيّ أفق نتفاوَض معه حين يكون العمل آنيًّا، متغيّرًا مع كلِّ طلب (Prompt)؟ الواقع أنّ النص التوليدي يتحرك داخل حلقة زمنية مغلقة: مع كل إدخال جديد يُعاد توليده، فلا يكاد يبلغ اكتماله حتى يباشر التشظّي؛ فتتبدّد فكرة «العمل المغلَق» التي يفترضها التأويل الهرمنيوطيقي، ويُستبدل بها «مسوَّدة دائمة» يحقّ للمستخدم تعديلها بلا حد. هكذا تنحرف وظيفة القارئ من استكشاف المعنى المطمور إلى صناعة سياق لحظي يضع النص داخل رغبةٍ تشغيلية: طلب التبسيط، طلب الإيقاع، طلب الاختصار. ومع زوال الثبات البنيويّ للعمل، يتغيّر «أفق التوقّع» عند القارئ (ياوس، 1982): لم يَعُد ينتظر مفاجأة نصٍّ مكتمل، ولكن في الحقيقة أصبح يقيس قيمة النص بقدرته على الاستجابة لتوقعه الفوري، فيصبح التأويل ذاته جزءًا من عملية التوليد لا استجابة لاحقة لها؛ التأويل يسبق النصّ ويتلبّس به بصفته تعليماتٍ موجِّهة.
على هذا الأساس يتجلّى التحدّي الأبرز: كيف نحكم على صدقيّة معنى لا يستند إلى تجربةٍ موقَّعة؟ فإذا أخذنا بمبدأ إدموند هوسرل القائل إنّ «إن التعرف على الغير لا يتم بوصفه موضوعا أو باعتباره ذاتا مستقلة عن الأنا، إنما باعتباره ذاتا تشبهني، وتختلف عني. إن الغير يوجد مع الأنا في العالم، وعن طريق التوحد به حدسياً، يصبح هو أنا وأنا هو، فالذات تدرك العالم وتدرك الغير كعنصر منه. إنه عالم البينذاتية الذي يؤسس العالم الموضوعي، إنهم ذوات تدرك العالم، العالم ذاته الذي أدركه »، نجد أن النصوص الآلية تُلغي «الآخر» الحيّ، وتتركنا أمام انعكاسٍ احتماليٍّ لبيانات الماضي؛ وبالتالي لا يتحقّق في القراءة أيّ عبور أُفقي نحو ذاتٍ تاريخية، ولكن عبر نزول عموديّ إلى طبقاتٍ إحصائية تتكرر بلا ذاكرة شعورية. هذا الوضع يُعيد الاعتبار إلى تفكيكية جاك ديريدا التي ترى أنّ المعنى كامنٌ في «أثر» يتأجل إلى ما لا نهاية؛ لكن في النصّ التوليدي يتضاعف هذا التأجيل لأنّ أثر المعنى يُعاد خَلْقه رياضيًّا في كل مرة. ولعلّ أخطر ما يترتّب على ذلك هو تسوية الفوارق الأسلوبية: فالآلة، بحكم نزوعها إلى المتوسط، تُنتج نصوصًا «قابلة للتأويل العام» خالية من الانزياح الثقافي أو الرمزي الشيق؛ هنا يفقد التأويل مادته الحيويّة – الغموض المولّد للدهشة – ويتحول إلى تمرين وظيفي: شرح مفردات، إعادة تنظيم أفكار، ربط معلومات. بمعنى آخر، يتهدّد التأويلُ بأن يصبح خدمةً تقنية لا مغامرة hermeneutic ، فيفقد القارئ متعة الاصطدام بالمسكوت عنه، لأنّ الخوارزمية مستعدّة دومًا لإزالة الالتباس بطلبٍ بسيط: «اشرح لي»، «بسّط لي»، «اضرب مثلاً». تبدو هذه الاستجابة الفورية مكسبًا معرفيًّا، لكنها تحرم القارئ من «اكتشاف نفسه عبر العالم» في مواجهة الغريب، وهو الشرط الذي اعتبره ريكور (1976) قلب الخبرة التأويلية ويقصد بها تغـير محـور تأويـل سـؤال الذاتيـة إلى سـؤال العـالم .”من البحث عن قصد المؤلف إلى البحث عن معنى العالم الذي يتولد عن النص.
غير أنّ هذا المشهد ليس قدرًا حتميًّا؛ فالمسافة بين «نصّ بلا مؤلف» و «نصّ بلا تأويل» يمكن ردمها عبر استراتيجيات تُعيد شحن النصّ بالاختلاف الوجداني والثقافي: أوّلها أن يتحول القارئ إلى مُبرمجٍ تعبيريّ، يستخدم هندسة التوجيه ليحقن في الخوارزمية أسئلة جوهرية بدل طلبات تبسيط آنيّة، فيعيد إلى النصّ شيئًا من غموض القصد: كأن يطالب الآلة بكتابة حكايةٍ بمنظور سردي منفيّ، أو إعادة صياغة نصٍ بلغة مجازية كثيفة، أو إدراج لهجة محلية تُحيي ذاكرة مكانية. وثانيها الإصرار على تحرير ما بعد التوليد بحيث يضفي القارئ توقيعه على الجملة الخام، جاعلًا من عملية التأويل لحظة خلق جديدة أكثر منها لحظة استهلاك معنى. وثالثها سنّ معايير نقدية تعاقب النصوص التي لا تحتوي على انزياح ثقافي أو تصرّف أسلوبي، وتكافئ النصوص التي تُظهر جرأة لغوية، مؤكدِّةً أنّ «قيمة التأويل» تُقاس بقدر ما يكشف النصّ من طبقات. بذلك يتحقق توازن جديد: الآلة تمدّنا بوفرة الاحتمال، لكن التأويل يستبقي شرطه الوجودي أن نقرأ لنعيش تجربةً تتجاوز نافعيه المعلومة. في هذا الأفق يصبح القارئ «مؤلِّفًا مشاركًا» لا بالمعنى البنيوي الذي ألغى الشخص لصالح اللغة، لكن الأمر هنا جاء بالمعنى التقني والأخلاقي الذي يجعل من كل قراءة فرصة لإعادة كتابة العالم، وهنا ينهض التأويل من كبوته، متبنّيًا أدوات التقنية ليعيدنا إلى أصل المغامرة.
أدوات القارئ التقنية:
إذا كانت سلطة المعنى تحولت بتغير أفق التوقع، فإن ظهور أدوات القارئ التقنية يُضفي طبقةً أخرى على معمار التأويل؛ إذ لم يَعُد المتلقي رهين عبقرية تمتعه البلاغي أو خبرته الهرمنيوطيقيّة فقط، بالأحرى صار يمتلك عدة تدخل مباشرة في بنية النص. أول هذه الأدوات هندسة التوجيه، التي تمكن القارئ من تطويع الخوارزمية عبر توجيهات دقيقة تفرض أسلوبًا أو نبرة أو معجمًا مخصوصًا؛ فتغدو الكتابة الآلية حوارًا شبه براغماتي يتحدّد فيه المخرج ببلاغة التعليمات، فلا يعود النص مُعطى طبيعيًّا. ثاني الأدوات عرض الأمثلة القليلة، وهو تمرين يزرع أنماطًا في ذاكرة السياق، حيث يقتدي النموذج بالصيغة المقدَّمة ليُعمم القاعدة على المدخل الجديد. ثالث الأدوات التحرير البشري ما بعد التوليد: هنا يعود القارئ ليمارس دوره التقليدي كناقد ولغوي، يضبط التشكيل والإيقاع ويحقن الرمز الثقافي الذي تم تهميشه بحيادية البيانات. أما الأداة الرابعة فهي استرجاع المعرفة، إذ يزود القارئُ النموذجَ بمقاطع أو وثائق خارجية ليُلزم الآلة بالاستناد إليها، فيمنعها من الهذيان ويحاصرها داخل أفق معرفي محدّد. هذه الأدوات لا تجعل القارئ سيد النصّ المطلق، لكنها تضعه في موضع «المُخرِج» الذي يفرض رؤيته على مواد خام تولّدها آلةٌ لا تفرق بين خيال ووثيقة. إلا أن امتلاك العدة يجر معه تبعات أخلاقية: فالقارئ إذا افتقر إلى حس نقدي، قد يستسلم للإغواء السهل بتحويل الخطاب إلى مكرر أو إلى بَيانات معادية لمجرد أنّها أسهل في التوليد وأكثر انتشارًا في بيانات التدريب. يحدث هنا ما يسميه بورديو «العنف الرمزي» الخفي: سلطة اللغة الشائعة تضغط على الخوارزمية فتنتج ما يريده ”المتوسط الحسابي“ لا ما يريده الانزياح اللغوي، وبذلك يخسر النص احتماله الجمالي. على الناقد الرقمي إذن أن يتزوّد بمقاييس جديدة: الإحصاء الأسلوبي لقياس التنوع، مؤشرات الانزياح، واختبارات التحيز. هذه المقاييس تعيد إلى التأويل وظيفته النقدية، شرط أن يُدرَّب القارئ على استعمالها بوصفها جزء من إستراتيجية أخلاقية تحفظ التنوع الرمزي من الذوبان في المتوسط العالمي و«رأسمال اللغة» الذي تهيمن عليه الشركات التكنولوجيا الكبرى.
حدود الإبداع التشاركي:
ورغم هذا التمكين الظاهري، فإنّ حدود الإبداع التشاركي تبرز حين نتساءل عما يتبقّى من فرادة العمل الإبداعي بعدما يتم توليده وتحريره بالتعاقب بين آلةٍ وقارئٍ وتجار بيانات. التحدّي الأول هو اختفاء التوقيع؛ إذ ما إن يدخل النص سلسلة تدوير آلية ← قارئ ← آلية حتى يتقلص حضور الصوت الفردي، فتظهر نصوص متشابهة الإيقاع والديباجة، تذكّر بتشخيص أدورنو لصناعة الثقافة: إنتاج كميّة ضخمة من أعمال متقاربة الشكل لخدمة الاستهلاك السريع. والتحدّي الثاني هو خطر الانتحال اللاإرادي: بما أن النموذج يُدرَّب على ملايين النصوص، فإنّه قد يعيد جُملاً شبه حرفية بلا وعي، والقارئ غير المتخصّص قد يمرّرها بوصفها «إلهامًا»، فيتراكب نصّ جديد على ملكيات فكرية سابقة. التحدّي الثالث أخلاقي – قانوني: من يُحاكم على خطاب كراهية كتبته آلية استجابت لتوجيه ضبابي؟ هل يُحاسَب القارئ الذي قدّم الـ Prompt ، أم الشركة التي دربت النموذج، أم يُعفى الأمر بذريعة «خطأ خوارزمي»؟ هذا الفراغ يُلزم بسنّ تشريعات «إسناد الخلق الرقمي» وتحديد نسب الاقتباس الآلي وتوثيق البيانات. إلى جانب هذه الحدود التقنية والأخلاقية، هناك حدّ جمالي لا يقل أهمية: افتقاد التوتّر العاطفي. فالنصوص التوليدية مهما أتقنت النسج الإيقاعي لا تُظهر تلك الرجفة الداخلية التي يصفها درويش في قوله «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، لأنّ الآلة لا تعيش خوفًا أو حبًّا أو حنينًا؛ إنها تعيد توزيع أنماطٍ عاطفية بلا مركز حسي. لذلك تبقى حرّيّة “القارئ المحرِّر” رهينة قدرته على «حقن ذاته» في النصّ، وإلا تساوت الكتابة كلها في حياد إحصائي لا يفرّق بين قصيدة رثاء وإعلان إشهاري. من هنا تنشأ حاجة ملحّة إلى تربية نقدية مزدوجة: تربية تقنية تُدرّب المتلقي على الأدوات والضوابط وتربية جمالية تُذكره بأن عجينة اللغة لا تصبح فنًّا إلا حين ترتجف بخبرة بشرية حية. فإذا نجح هذا الازدواج، أمكن تخيل مستقبل يظل فيه الكاتب (بصورته المعدَّلة: كاتب–محرّر–قارئ) ركيزة المعنى، فيما توفّر الخوارزمية وفرة الاحتمال ومساحة اللعب البلاغي، فيتكامل الطرفان بدل أن يتنازعان سلطة النص. أما الفشل فيعني انزلاق الأدب إلى سوق هائل من «نصوص بلا أحد» تُستهلك ثم تُنسى، وتتحوّل فيها القراءة إلى تمرين تفاعلي بلا أثر وجودي، لينبّهنا من جديد إلى أن موت المؤلف لا يعني بالضرورة ولادة القارئ، إنما قد ينتهي إلى «حياةٍ بلا أحد»، ما لم يتدارك الإنسان نصَّه بحضورٍ نقدي يرد للغة نبضها المشروط بالخبرة. هكذا يُختتم هذا المقال بضرورة الإقرار بأن التأويل بعد الذكاء الاصطناعي ليس انعتاقًا نهائيًّا من سلطة الكاتب، ولكن يمكننا أن نقول ببساطة أن التأويل هنا هو بداية مفاوضة جديدة مع سلطة التقنية؛ ونجاح هذه المفاوضة يقاس أو يحدد بقدرة القارئ على استخدام الأدوات دون أن يفقد استشعاره لحرارة المعنى الكامنة خلف الأرقام، ليظلّ النص الإبداعي فضاءً يستحقّ التأويل.
*مهندس متخصص تطبيقي في هندسة المناخ والطاقة
*روائي
*طالب باحث في الجماليات، مجال الذكاء الاصطناعي والكتابة الابداعية بجامعة محمد الخامس كلية علوم البيئة
مراجع
1- رولان، بارت. درس السيميولوجيا. ترجمة عربية، عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال، المغرب ط3 1993، ص86
2-Brown et al. MathPrompter: Mathematical Reasoning using Large Language Models 2020
3- جريدة الصباح العراقية،2023
4-Bender & Koller 2020; Meaning without reference in large language models
5-Brown et al. MathPrompter: Mathematical Reasoning using Large Language Models 2020
6-المؤلف: هانز جورج غادامير. ترجمة: د. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. الناشر: دار أويا للطباعة والنشر- طرابلس. سنة2007 ص 212 ص 249
7-Bender & Koller (2020) Meaning without reference in large language models.
8-Jauss 1982
9 هانز جورج غادامير. ترجمة: د. حسن ناظم وعلي حاكم صالح. الناشر: دار أويا للطباعة والنشر- طرابلس. ص243 ص249
10-Jauss 1982
11Edmund Husserl. Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique. Gallimard
12- بول ريكور، من النص إلى الفعل، ترجمة محمد برادة وحسان بورقية. عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ص 91 ص92
13-Bender & Koller .Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data. ACL. (2020).
14- محمد رمضان بسطاوسي، علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت، ص 97 ص98
15-مُطالبة (prompt) هي نص بلغة طبيعية يطلب من الذكاء الاصطناعي المولّد أداء مهمة محددة.