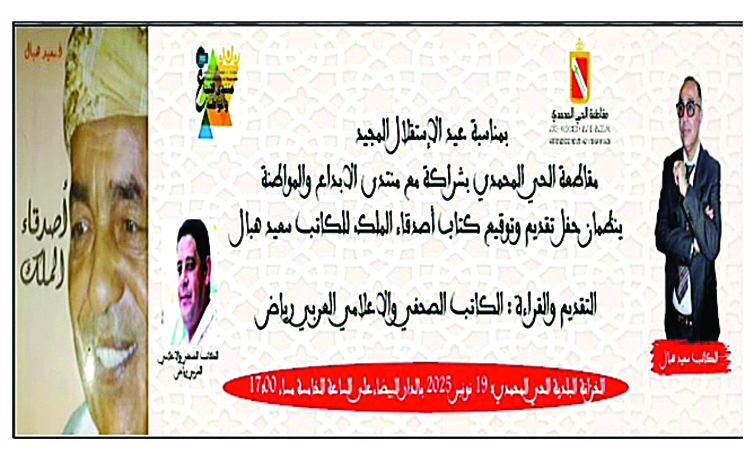كنت قد سمعت وقرأت الشيء الكثير عن ميشال خليفي، لأسباب لا علاقة لها بالسينما، ولكن بسبب ارتباطنا بالقضية الفلسطينية. ففي ذلك الوقت كان كل ما له علاقة بهذه القضية لا يُناقَش، ويكون بالضرورة موضوع إعجاب يفرضه الواجب النضالي، فلا يحتمل وجهة نظر شخصية، ولا يحتمل النقاش أو النقد.
كان موعد الأسبوع الفلسطيني السنوي، والاحتفال بيوم الأرض من المواعيد القارة في برامج أنشطة العمل الجمعوي والحركة الطلابية. وبطبيعة الحال كانت خلال هذه المناسبات تُعرض أفلام فلسطينية، أو بالأحرى أفلام المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى المنتوجات الفلسطينية، ومعرض الكاريكاتير للفنان ناجي العلي، وندوة حول القضية، ويكون الختام غالبًا بأمسية غنائية ملتزمة وقراءات شعرية.
كنت قد قرأت ورقة عن السينما الفلسطينية متداولة مكتوبة بخط اليد – ولم تكن الوحيدة – تعتبر أن الفيلم الفلسطيني ليس هو فقط الفيلم المنتج من طرف إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية أو من طرف مخرج فلسطيني، ولكن أي مخرج وأي مؤسسة عربية أو أجنبية تنتج فيلمًا عن القضية الفلسطينية يُعتبر الفيلم فلسطينيًا، أي أن نسب الفيلم يعود للقضية وليس للمنتج.
في هذا السياق قرأت الكثير عن ميشال خليفي، رغم أن وضع هذا المخرج كان مختلفًا عن المخرجين الآخرين، حيث إنه درس السينما ببلجيكا وأقام بها، وكانت أفلامه تُموَّل بشكل عام، بعكس الأفلام الفلسطينية الأخرى التي كانت تُنتَج بإمكانيات بسيطة.
في برنامج الأسبوع الفلسطيني الأول الذي حضرته كان مُبرمجًا فيه فيلم «ذاكرة خصبة» (1981) سيُعرض بآلة 16 ملم. كنت متحمسًا لمشاهدة هذه النوعية من الأفلام، لأنني كنت قد قرأت عنها كثيرًا، وتعرّفت على ظروف إنتاجها التي كانت تجعلها بالنسبة لي متاحة وقريبة، بالمقارنة مع أفلام تُنتج بإمكانيات ضخمة.
بعد دقائق من عرض الفيلم بدار الشباب وقع عطب في جهاز العرض، وحاولنا بكل ما أوتينا من معرفة تقنية إصلاحه، لأنه كان عطبًا كهربائيًا وليس ميكانيكيًا. تخلى المنظمون عن عرض الفيلم، وتم تعويضه بنقاش حول القضية الفلسطينية، والذي احتدم مباشرة بين مكونات اليسار الحاضرة، كلٌّ يدافع عن فصيل المقاومة الفلسطينية الأقرب إليه سياسيًا وأيديولوجيًا، وكأننا انتقلنا إلى إحدى المخيمات الفلسطينية ببيروت.
بعد سنوات، عرضنا نفس الفيلم بجهاز الفيديو، وتمكنت أخيرًا من مشاهدته. ويمكن أن أُجزم أنها كانت أول مرة في حياتي أشاهد فيلمًا وثائقيًا على أنه فيلم سينمائي. بالنسبة لي كان الفن السينمائي هو السينما الروائية فقط، وقد ساهم ارتباطنا بالقضية الفلسطينية في تغيير هذه الفكرة، كما ساهمت أفلام أخرى شاهدتها خلال تلك الأسابيع. وعموما ارتبط عندي مفهوم الفيلم التسجيلي أو الوثائقي بالسينما الفلسطينية.
ضاع جزء كبير من أرشيف الأفلام الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي لبيروت سنة 1982.
فيلم «ذاكرة خصبة» (1981) ربما، حتى لو كنت قد شاهدته خارج أجواء الارتباط بالقضية الفلسطينية، كان سيغيّر نظرتي للسينما الوثائقية، لأنك تحس أنك أمام فيلم أُنجز برؤية ومقصدية سينمائية، ويختلف عمّا كنا نشاهده على أنه أفلام وثائقية، وهي في الحقيقة لم تكن إلا روبورتاجات ليس إلا.
تحس أن هناك اختلافًا في وضعية اللقطات ووظيفتها داخل السرد الفيلمي، في الطريقة التي يُحاور بها المخرج الشخصيات، ولو أن ذلك كان نادرًا داخل هذا الفيلم، وبطريقة استعمال الموسيقى، ونحسه قبل كل شيء في نسيج الصورة المصوَّرة بفيلم خام.
بعد سنوات جاء الفيلم الذي أثار الجدل «عرس الجليل» (1987)، وهو يُعتبر أول فيلم فلسطيني روائي. أذكر أن من بين الانتقادات التي وُجّهت إليه كونه عوض أن ينتقد العدو، انتقد الجانب الفلسطيني الذي كان يُعتبر مقدسًا لظروف الاحتلال والتهجير. اتُّهم بذلك بـ«نشر الغسيل الفلسطيني»، الشيء الذي لا يمكن إلا أن يخدم العدو.
ما زال الكثير يتذكرون الفيلم، ولكن لا أحد ما زال يتذكر تلك الانتقادات.
عرض في برامج النادي السينمائي بالعرائش «عرس الجليل» (1987) في إحدى الأنشطة الموازية، وغالبًا ما كان ذلك في نشاط مرتبط بالقضية الفلسطينية. الحقيقة أن الفيلم كان مستفزًا في وقته حكايةً ومعالجةً. يضطر رجل فلسطيني لقبول حضور الحاكم العسكري للمنطقة في حفل عرس ابنه للحصول على ترخيص لذلك. رغم حضور الجنود الإسرائيليين يمر الحفل في أجواء عادية، فيتحول الفيلم إلى لحظة تطبيع مع العدو، ويجعل المتفرج، من دون وعي منه، يتصالح مع ذلك، بالإضافة إلى أن نهايته جاءت صادمة:
يعجز العريس في نهاية الحفل عن الدخول بعروسه تحت ضغط العائلة التي تنتظر من الجهة الأخرى للباب دليل عذرية العروس وفحولة العريس. تتدخل الأخيرة وتقترح أن تقوم هي نفسها بالتخلص من بكارتها باستعمال أصابعها، ثم تواصل وهي تسأله: إذا كان شرفها في فرجها، فأين هو شرفه هو؟
لكي أعطي فكرة عن الأجواء، أتذكر أنه قبل ذلك عرض النادي السينمائي فيلم «الطبل» (1979) للمخرج الألماني فولكر شلوندورف، وكان النشاط بغرفة التجارة بالفيديو. عندما ظهرت النجمة السداسية، انتفض أحد الحاضرين وكان فلسطينيًا مقيمًا يعمل بالعرائش، معتبرًا ذلك استفزازًا، والحقيقة أنه لم يكن يعرف اللغة الفرنسية، لغة الفيلم. حاول البعض شرح السياق الذي ظهرت فيه النجمة السداسية لتهدئته، حيث إن الفيلم تدور أحداثه في بداية صعود الحزب النازي. لكنه استمر في انفعاله، وأخذ تلفزيونه الذي كانت تُعرض به الأفلام، وانسحب.
جاء فيلم «نشيد الحجر» (1991) في ظروف ظهور شكل جديد من المقاومة، كان أبطاله أطفال الحجارة. حصلت على تسجيل فيديو للفيلم الذي فاجأني، إذ كانت أول مرة أشاهد فيها فيلمًا يجمع بين الوثائقي والروائي، حيث أنهما في الفيلم لا تجمعهما علاقة مباشرة، أي أن الأمر يتعلق بحكي متوازٍ لحكايتين لا تجمعهما إلا أرض فلسطين والزمن الحاضر.
أعجبني أنه لأول مرة أرى فيلمًا حميميًا قريبًا جدًا من شخصيات معزولة عن الواقع المحيط بها، ومكتوبًا بلغة عربية شعرية. فيلم قريب وثائقيًا من حاضر القضية الفلسطينية، وبعيد عنها روائيًا بمسافة نقدية، تُذكّر بفيلم «عرس الجليل».
قرأت حوارًا مع المخرج أجراه الناقد التونسي خميس خياطي، تحدث فيه عن كتابة الفيلم واختياراته الجمالية، واكتشفت أن الفيلم هو عبارة عن اقتباس لفيلم «هيروشيما حبيبتي» (1959) للمخرج آلان رينيه عن سيناريو أصلي للكاتبة مارغريت دوراس، الذي شاهدته فيما بعد على قناة «آرتي» الفرنسية-الألمانية.
أعجبني أسلوب حوار فيلم «نشيد الحجر»، وقمت بتسجيل الشريط الصوتي على كاسيت كنت أستمع إليه على جهاز «ووكمان»، وكأن الأمر يتعلق بموسيقى، وحفظته عن ظهر قلب، خصوصًا وأنني كنت قد حصلت فيما بعد على النسخة الأصلية من السيناريو التي كانت قد نُشرت على حلقات في مجلة لا أذكرها.
في الجزء الوثائقي من الفيلم صوّر ميشال مجموعة «صابرين» الموسيقية وهي تقوم بالتدريب، وكانت المغنية كاميليا جبران ما تزال شابة. عندما أخرجت فيلمي الأول «زمن الرفاق» استعملت أغنية لهذه المجموعة كموسيقى تستمع إليها الشخصيتان في أحد المشاهد، وتخلق بينهما نوعًا من التقارب الخفي، كالذي نحس به مثلاً عندما نركب في سيارة مع شخص، وعندما نضغط على زر الراديو كاسيت نكتشف أن آخر ما كان يستمع إليه كان أغنية كانت عنوان مرحلة من حياتنا، الشيخ إمام مثلاً.
أُتيحت لي فرصة مشاهدة الفيلم في عرض على شاشة كبيرة جدًا وأنا أحضر الدورة الثانية للجامعة الصيفية للأندية السينمائية بالرباط، التي جاءت بالموازاة مع مهرجان الرباط، حيث شاهدنا الفيلم في فضاء الوداية بالهواء الطلق. وفي نفس الدورة اكتشفنا أول فيلم قصير للمخرج إيليا سليمان «Hommage par assassinat» (1996)، في إطار مجموعة من الأفلام القصيرة أنتجتها قناة الأفق الفرنسية، والتي كان مديرها آنذاك نور الدين الصايل، حول موضوع حرب الخليج الأولى، وشارك فيها مجموعة من المخرجين من العالم العربي، من بينهم مصطفى الدرقاوي من المغرب والنوري بوزيد من تونس. رسم هذا الفيلم القصير بخط واضح الأسلوب الذي سيتبعه هذا المخرج في أفلامه القادمة.
في إحدى دورات ملتقى تطوان السينمائي شاهدت بسينما مونيمنتال فيلم «أسطورة الجواهر الثلاث» (1995) لميشال خليفي، فيلم جميل لكنه مرّ دون أثر. ربما لأني شاهدته مرة واحدة، فلو أعدت مشاهدته قد تتغير فكرتي عنه. أتأسف أن أعمال هذا المخرج، وأعمال مخرجين آخرين، بعد فترة قصيرة تغيب، ولا نجد لها أثرًا في حصص الاسترجاعات في المهرجانات أو في إعادة التوزيع بعد ترميم النسخ.
سنوات بعد معاهدة أوسلو شاهدت صدفة مقطعًا من حوار مع ميشال خليفي على قناة تلفزيونية عربية يقول فيه بمرارة ويأس إنه يحس بالملل، وأنه لم يعد له ما يحكي بعد هذه المعاهدة. كنت حينها أحلم أن أصوّر فيلمًا، وبالنسبة لي كان الفيلم يصبح ممكنًا فقط عندما تتوفر الإمكانيات، وأنه لا يمكننا أن نملّ من صنع الأفلام. وجدت وقتها في تصريح ميشال خليفي الكثير من المبالغة، ولكن بعد هذه السنين، وبعد تجربة طويلة في السينما والحياة، فهمت أخيرًا إحساس هذا المخرج عندما صرّح بذلك.
أنجز ميشال خليفي أفلامًا أخرى، لكنها لم تحظَ بما حظيت به الأفلام الأولى، ربما لأن الواقع العربي نفسه تغيّر. هناك العديد من الأفلام الفلسطينية التي سافرت بعيدًا ولاقَت نجاحًا، لكنني لا أحتفظ إلا بأفلام هذا المخرج وأفلام إيليا سليمان.
كيف غيرت أفلام ميشيل خليفي نظرتي للسينما الوثائقية

الكاتب : محمد الشريف الطريبق
بتاريخ : 22/10/2025