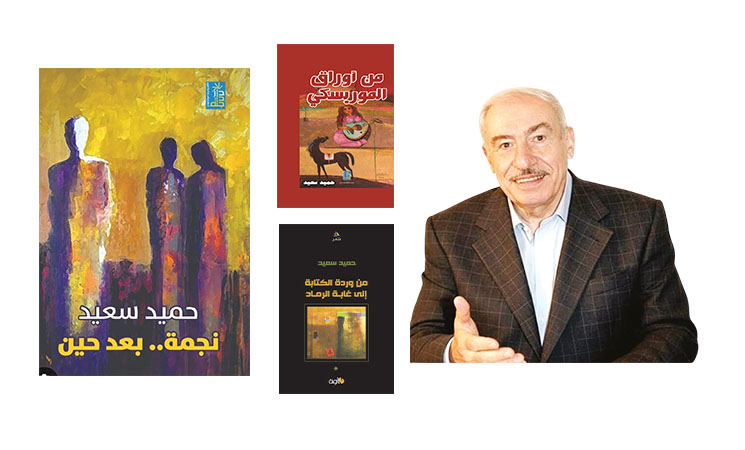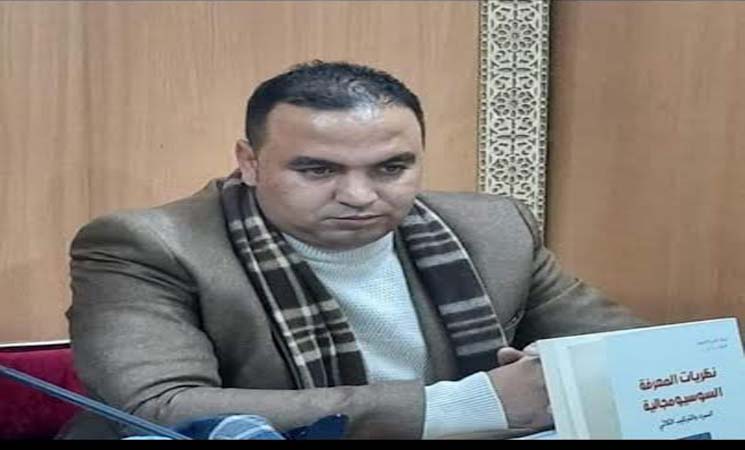يتأسس الخطاب السردي لرواية “ابن اللسان”(1) على لعبة السرد والتخييل وتقوم هذه الاستراتيجية على تضعيف المحكي الإطار عبر إدماج ملفوظات ميتاـ حكائية، وتنويع الصيغ السردية، وقد أسهم تعدد الأصوات في تشييد توليفات حوارية بين الشخصيات وعامل التواصل السردي، أي الراوي، الذي كان شاهدا ومشاركا للشخصياتفي بناء المسارات الخطابية والدلالية نزولا عند رغبتها في مراقبة ما يُقال أو يُكتب عنها، ما دامت الرقابة قد فرضها صراعها مع السلطة بجميع تجلياتها كما جاء على لسان الشخصيات في المقطع السردي التالي: “صعب علينا، نحن الثلاثة، أن تُحكى حكايتنا بلسان غيرنا. لذلك عندما رأينا إصرار الراوي على أن يحكي عنا، (توافقنا) معه على أن نحضر في الحكي .. فقد علمتنا السنوات أن الرقابة ضرورية…لذلك نرجو ألا يفهم القارئ أننا أقحمنا أصواتنا كي نشتت انتباهه، وأن أهدافنا ماكرة..” (ص98). لم يكن إصرار الشخصيات على دمقرطة الخطاب السردي عبر مشاركتها السارد في تشييد المحكي، مانعا أمام عامل التواصل من المراوغة والاحتيال في اختيار سيناريوهات المحكي الخاضع بالضرورة لإكراهات إبداعية وضرورة خلق مسافات جمالية بين الواقع والتخييل، الأمر الذي لم يكن مقبولا من قبل الشخصيات يقول السارد: “اُتهمت من قبل الكثيرين بحكي يُخالف ما عاشوه، وكنت أعذرهم لأنهم يخلطون بين ما يُحكى، وما يُعاش. وعندما كانوا يستشهدون بذلك الذي كتب (نعيشها كي نرويها). كنت أقول لهم، لكنه رواها كي يعيشها، فخلق بها حياة ثانية” (ص103).تتحدد مقاصد عامل التواصل إذن، في تخييل تجربة ثلاث شخصيات من خلال تشذير البنية السردية وجعلها قائمة على ثنائية التوازي السردي والتضمين الحكائي حيث أصبح النص لا يُحيل إلا على نفسه(2)، ولا يمكن فهم تجربة شخصية من الشخصيات إلا من خلال باقي التجربتين وكأن الخطاب السردي يوظف مرآة ثلاثية الأبعاد(3).
مرايا تعكس صور المعاناة والمرارة التي عاشها ثلاثة متكلمين وهم:المعلم والمحامي والصحفي، تلك الشخصيات التي احترفت الكلام، وما كان الكلام إلا ابن اللسان كما تؤشر على ذلك الصيغة التركيبية والدلالية لعنوان المنجز الروائي، فالكلام حسب تقدير سوسير هو تصرف في اللغة وإنتاج فردي،فلا غرو إذن، أن يكون الكلام محملا بفكر صاحبه معبرا عن رؤيته للعالم، وعليه، كان الكلام مناط التقاطع بين تلك التجارب بالإضافة إلى تجربة السارد/ عامل التواصل الذي يُقر أيضا باحترافه مهنة الكلام يقول: “حرفتي الكلام، أرويه وأكتب به، وأعيش منه” (ص102).
تبعا لما سبق، يكون الانتماء نفس المؤسسة الثقافية، بتعبير بيير بورديو، قاسما مشتركا، تلك المؤسسة التي تظل تاريخيا على طرف نقيض السلطة بكل مؤسساتها وتمظهراتها، لهذا قام البرنامج السردي للمنجز الروائي بتصوير التوتر والصراع بين المتكلمين والسلطة من خلال تقديم مسار تجربة ثلاث شخصيات، وهو ما جعل تلك التجارب قائمة على التماثل والتكامل، إذ تحول كل محكي إلى مرآة تعكس جانبا من ذلك الصراع وتحول كل صوت سردي إلى صدى أو ترديد لباقي الأصوات السردية.
تتحدد المماثلة بين الشخصيات في كونها شخصيات ذات انتماء بدوي أصيل، رغم التباين الجغرافي الممتد بين الجنوب والوسط والشرق، شخصيات عاشت التحول وسط المدينة، يقول المحامي: “كنا طلبة مشبعين بالطموح والأمل، أغلبنا وافد من قرى مهمشة لا تذكرها الخرائط، تُعرف بأسماء أسواقها، أو قواد ساموها الخسف في زمن مّا أسماء تشبه أثار تعذيب على جسد لا ترغب جهة ما في نسيانه” (ص67). لقد سعت تلك الشخصيات إلى الخلاص من نذوب وشروخ ماضيها المؤلم، أو الهروب من سلطة القبيلة وتأثير عاداتها وتقاليدها، ومؤسساتها الدينية التي تخلط بين ما الديني والميثولوجي؛ بين المقدس والمدنس. ويُصادف القارئ مجموعة محكيات تصور خوارق الشيخ وكرامات بوله، إنها محكيات ميتا سردية، يعتبرها فيليب هامون كاذبة مقنعة بقناع الحقيقة(4).
تكون المماثلة أبدا ممكنة، في كون فضاء المدينة، شكل وجهة للشخصيات الثلاث بحثا عن فرصة لاكتساب المعرفة، فكانت فرصة لبناء سانحة لبناء وعيها، والوعي، حسب دافيد هيوم، طريق للتعرف على الذات والانخراط في الذات الجماعية والاهتمام بقضايا الحياة والوجود. سريعا ما تحول وعيها إلى وعي شقي جرّ عليها نقمة السلطة والحصار والرقابة التي عبرت عنها مجموعة محكيات تشخص، حسب تعبير ميخائيل باختين، تمظهرات السلطة، وقد جاءت تلك المحكيات في صيغة استعارات سردية، منها محكي اغتصاب الملكية الفكرية للمحامي من قبل القصير (ص76)، ومحكي الوصاية الحزبية التي همشت المحامي ورمت بجهده إلى الظل (ص78) وغيرها من الملفوظات التي يشكل تعالقها مرايا عاكسة أو مضيئة للكل الدلالي(5).
يمكن اعتبار الشخصيات الثلاث ممن احترفت الكلام أنموذجا للمثقف الذي يتعرض للتهميش والمتابعة والاضطهاد على جميع المستويات. فالمعلم يعيش الحصار الروحي، والصحفي متهم في أحلامه وإبداعه، والمحامي معتقل العقل (ص85)، اختلاف قاد الشخصيات إلى التكامل والاتحاد في مواجهة مظاهر السلطة، يقول المعلم:” كنا ثلاثة أرواح مختلفة، فرغم أن أصولنا جميعا مشوبة ببداوة أصيلة، لكنها بداوة مختلفة، لذلك تآزرنا، مادامت المحن تجمع ” (ص85).
من أهم خصائص لعبة السرد والتخييل في المنجز الروائي، بنية التقابل التي يقوم عليها المسار السردي، حيث أمكننا استنباط نوعين من الخطابات، خطاب المحللين (غير المؤثرين)، وخطاب المهللين (المؤثرين في صناعة التفاهة). كما يمكن التمييز بين خطاب السلطة، في الفصل الرابع، والذي تمت صاغته بناء على التقارير الاستعلاماتية، وخطاب الشخصيات الثلاث في الفصول الثلاثة الأولى، وقد لعب استحضار خطاب السلطة من أجل غايات نقدية(6)، إذ يكشف عن نمطين من الوعي وهما وعي المثقف الذي يمتلك سلطة الكلام ووعي السلطة التي تمتلك، كما يقول ميشيل فوكو، إلى جانب قنواتها الإيديولوجية، آلياتها القمعية الضامنة لاستمرارية وجودها. لم تقدم إذن، محكيات التقارير إلا صورة مغلوطة ومشوهة عن الشخصيات الثلاث.
في ضوء ما سبق، نقول إن المنجز الروائي “محنة ابن اللسان” تجربة إبداعية تنحو صوب التجريب عبر التعدد الحكائي وتشذير المسار السردي وتنويع الصيغ السردية لدمقرطة الخطاب، وإدماج الاستعارات السردية في شكل ملفوظات ميتا سردية وغيرها من التقنيات التي دفعتنا إلى مقاربة المنجز الروائي من زاوية البلاغة النوعية للسرد. ومن أهم الملاحظات التي لا يمكن التغاضي عنها، هو البعد الأطروحي والذي يتحدد في بلاغة الإدانة والنقد لمفهوم السلطة، بجميع تمظهراتها، بدءا من المؤسسة الفكرية حيث نزعت الرواية نحو دمقرطة خطابها السردي والحد من سلطة السارد الإله العليم بالظاهر والباطن من حياة الشخصيات، كما وجهت الرواية نقدها إلى المؤسسة الدينية التقليدية التي تخلط المقدس بالمدنس والواقعي بالميثولوجي، والمؤسسة الحزبية اليسارية التي انحرفت عن مسارها التاريخي وتنكرت لماضيها النضالي وتحولت إلى حزب براغماتي بامتياز، يمارس التعتيم الإيديولوجي، نيابة عن السلطة الرسمية يتولى تدجين وإخماد شعلة التغيير والتمرد في نفوس الأجيال الصاعدة.
لقد أسهم التعدد اللغوي والحكائي في فضح المؤسسة الاجتماعية وما يسودها من نفاق وأنانية وانحطاط دائرة للقيم الإنسانية، حيث مكنت التقارير الاستعلاماتية من كشف مصادرها وإماطة اللثام عن هوية البصاصين والمتجسسين،وقد كانوا من أقرب المقربين إلى الشخصيات الثلاث، من الجيران والأصدقاء وذوي الأرحام، الأمر الذي يؤدي إلى بث الريبة والشك في النفوس، ويهدد العلاقات الاجتماعية والأسرية بالتوتر والانفصال.
تلك بإيجاز بعض الإضاءات الأولية التي تؤكد انشغال الخطاب الروائي، جماليا وتخييليا، بأهم القضايا الواقعية وأهمها قضية “الكلام” الذي تحول إلى جريمة وغدا المتكلم مجرما رغم أن في البدء كانت الكلمة كما جاء في الكتاب المقدس.
مراجع:
(1) محنة ابن اللسان، جمال بندحمان، منشورات إفريقيا الشرق، 2024.
(2)Todoro v (T) : Les catégories du récit littéraire. In communication. col. Point. Ed. Seuil. 1981. P.274.
(3)Dallenbach (L): Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme. Ed. du seuil. 1977. P 18
-4Hamon (Ph) : L’ironie littéraire. Hachette. 1996. P. 19
(5). Batillion (M) : Précis d’analyse littéraire. 1. Structures et technique de fiction. Edfermand Nathan. 1986, P. 21
(6)Genette (G) : Palimpsestes. Ed. Seuil. 1982. P20