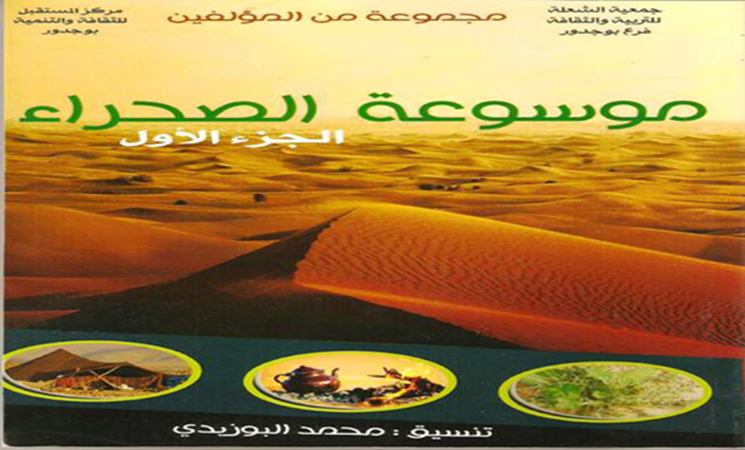منذ أواخر القرن التاسع عشر وإلى حدود 1912، سنة بسط الحماية الفرنسية على الإيالة الشريفة، أصبحت الرحلات الأوربية لاستكشاف المغرب ونشر المؤلفات حول أوضاعه وأهله، هواية نسائية أيضا بعد أن فتحت الصحفيات والكاتبات هذا الحصن الذي كان محتكرا من طرف الرجال. وقبل ترسيم الوجود الفرنسي في المغرب، كانت للبريطانيات حصة الأسد في زيارة البلد ونشر الارتسامات حوله، لكن الوضع سينقلب رأسا على عقب إثر معاهدة فاس لتتسلم الفرنسيات مشعل الريادة في المجال.
ماثيلد زييْيس إحدى أولى الفرنسيات اللواتي زرن مغرب ما قبل الحماية ونشرن كتابا عنه. وهي أديبة اشتهرت بترجمة العديد من التحف الأدبية الإنجليزية والألمانية للغة موليير، واشتغلت في الحقل الصحفي أيضا. سنة 1907، ستحل بالمغرب، في طنجة بالضبط، مبعوثة من طرف مجلة «تور دي موند» (Tour du Monde) المتخصصة في جنس الرحلات الصحفي. وقد نشرت الكاتبة/الصحفية سلسلة مقالات حول مشاهداتها في البلد وحول أوضاعه ونمط حياة رعاياه في المجلة المذكورة، قبل أن تنقحها وتضيف إليها تفاصيل أخرى لتنشرها ضمن مؤلف وسمته بـ «فرنسية في المغرب»، صدرت طبعته الأولى سنة 1908 عن دار النشر الباريسية «هاشيت وشركاؤه»، ليعاد طبعه لاحقا عدة مرات، وتنال عنه جائزة «مونتيون» من قبل الأكاديمية الفرنسية.
وضع مقدمة الكتاب في طبعته الأولى غابرييل هانوتو، الذي كان عضوا في ذات الأكاديمية سنة النشر ووزيرا لشؤون الخارجية الفرنسية عام 1896، وقد ورد ضمنها: «اليوم، لم يعد الرحالة الرجال والجنود والمستكشفون هم من يتناولون القضية ويرفعون الحجاب عن لغز المغرب، بل النساء أنفسهن. وهن يطبقن، في استقصائهن هذا الذي يعتبر اكتشافا بكل تأكيد، نظرتهن الآنية والنافذة، وإحساسهن النفسي الحاد وقوة ملاحظتهن الثاقبة والمُلمحة.» ويضيف الأكاديمي في التقديم نفسه: «ثمة جوانب من حياة المسلمين مخفية، لا يمكن لغير النساء ولوجها، ولذا فشهادتهن نادرة بشكل مزدوج لأنها متفردة.»
تحافظ القبائل غير الخاضعة للسلطة المركزية أو «بلاد السيبة»، على علاقات مع المخزن رغم كونها في وضع تمرد ضده. وهي لا تزوده، بطبيعة الحال، لا بوحدات عسكرية ولا بأموال، مكتفية، على الأكثر، بدفع إتاوة غامضة موجهة إلى الزعيم الديني. وتنتمي المدن الواقعة في السهول، ومعها المناطق الموجودة على مرمى الحكم، إلى «بلاد المخزن» بقوة الواقع، ومن ثمة، فالإدارة المغربية تمارس حيالها حق الأقوى بشكل واسع. وبالمقابل، فالقبائل الجبلية متعذرة الوصول على القوات السلطانية، ما يفرض على المخزن التعامل معها باحتياط حذر. وإذا كانت بعض القبائل خاضعة بوجه عام، فإن أخرى متهيجة على الدوام، فيما تتميز طائفة ثالثة بتأرجح ولائها باستمرار بين «بلاد المخزن» و»بلاد السيبة». ويُلزم السلطان القبائل الموالية بضمان عبور المسافرين لأراضيها بحرية، وحماية حياتهم ومتاعهم. وهي التي تمده أيضا بالجنود الذين يوظفهم لمحاربة المنتفضين، وكذلك بالأموال اللازمة لتغطية مصاريف حملاته العسكرية وتمويل ميزانية المخزن.
كانت الضرائب محصورة، إلى حدود الحقبة الحالية، في الضرائب المفروضة في القرآن: «العشور» التي تجزم الشريعة المحمدية بأنه لا يجوز أداؤها إلا عينا وبأنه يحظرأن تتجاوز عشر محصول الحبوب والزيتون وغيرهما. لكن مستخدمي المخزن، المتسمين بكونهم عديمي الضمير في ما يخص تطبيق هذا القانون، تمادوا إلى حد فرض الأداء نقدا لثلث المحصول الفلاحي تقريبا، علما أن تقدير مبلغ الضريبة كان يتم في عين المكان، ما كانت تتولد عنه تجاوزات إضافية. وبالفعل، فقد كان الموظف المكلف بتقويم المبلغ الضريبي، بسبب سعيه إلى نيل مبالغ مالية من الخاضعين للضرائب قصد إنماء حافظة نقوده الشخصية، يبالغ في تحديد قيمة المحصول في البداية، قبل أن يخفضها لاحقا بتناسب مع المبلغ المحصل من طرفه مقابل تساهله. وفضلا على ما سبق وعموما، فثلث ما يفضل تقريبا للأهالي يُستخلص منهم على شكل ضريبة على ماء الأنهار. ذلك أن المياه هذه التي يُحول مجراها بواسطة «ساگيات» يتم إنشاؤها في إطار السخرة، مياه في ملكية السلطان في الواقع، الأمر الذي يجعله يفرض على رعاياه أداء ضريبة مقابل الاستفادة منها. أما «الزكاة»، فتطبق على المواشي وتسلب الأهالي أيضا ثلث ما يتبقى لهم تقريبا، وهي تنضاف إلى ضريبة أخرى يؤديها كل «گوربي» (كوخ). مثقلا بالجبايات، يجد البدوي المغربي المسكين نفسه مضطرا لإخفاء كل أثر ليس لثروته، بل حتى للرزق الذي يقتات منه، لكي لا يقع في مخالب إدارة الضرائب المستعدة دائما وأبدا لسلبه كل ما جمعه بمشقة وعناء.
لقد أراد عبد العزيز تغيير الضرائب الجاري بها العمل وإحلال «الترتيب» محلها، وهو عبارة عن ضريبة مفروضة على الجميع، تحتسب بناء على تسعيرة وتستخلص على الأراضي الصالحة للزراعة والمواشي والأشجار المثمرة. وعلى غرار أي قرار يروم إحداث أي تغيير في مؤسسات المغرب الراسخة، فالإصلاح الضريبي شكل منذ القدم مسألة شائكة. وفعلا، ففي القرن الثامن عشر، وحتى يُسَكن الضمائر المتخوفة عقب رغبته فرض موازين الأسواق على الزيت والزبدة، اضطر السلطان سيدي محمد (بن عبد الله) للجوء إلى «العلماء» ليصدروا فتوى تعترف للعاهل بحق سن ضرائب إضافية لما تكون الموارد غير كافية لتمويل جيشه. وفي الحالة الراهنة، فالقبائل لم تستوعب قرار الإصلاح الضريبي، رافضة دفعه، ما أشر على اندلاع الانتفاضة في الشمال الغربي سنة 1902 ويسر بروز بوحمارة.
إلى جانب هذه الضرائب المباشرة والاعتيادية، هناك أخرى عرَضية وغير مباشرة، منها «المونة» التي تقدم للشخصيات الرسمية، و»النايبة» أو الضريبة الإضافية الموجهة لتحمل مصاريف الحروب، والغرامة (الذعيرة). وتعتبر بعض الاحتكارات والرسوم في الأسواق ومدخول الجمارك (علما أن الجزء الأكبر من الأخيرة مستأجر لضمان القروض الخارجية)، موارد استحدثت مؤخرا، تضاف إلى أصناف أخرى من الدخل أقل أهمية. وإذا كان من الصعب تقدير ما تذره كل هذه الضرائب بدقة، فإن العمليات الحسابية الأكثر ترجيحا تجعلنا نفترض أن مبلغا يتراوح بين عشرين وثلاثين مليون يضخ سنويا في «بيت المال»، أي الخزينة السلطانية؛ دون نسيان البقية التي تمثل أقساطا مهمة من الدخل الضريبي، تلك البقية التي تتبخر قبل بلوغ خزينة الدولة لتسبغ نعمتها مختلف الموظفين المحيطين، بصفة أو بأخرى، بالسلطان. وقد اقترح مؤتمر الخزيرات نظاما يؤمن مردودا أفضل للضرائب، مصحوبا بإحداث موارد جديدة ومن شأنه وضع حد للكثير من أصناف الشطط، لكننا نعرف (للأسف!) مدى الصعوبات التي يواجهها دخول مختلف البنود المكونة لمعاهدة المؤتمر الشهيرة حيز التنفيذ.
وفي انتظار الآتي، فالأموال المحصلة من الضرائب، التي تحول إلى قطع نقدية ذهبية، تقسم إلى جزأين غير متساويين: واحد منها يرصد للمصاريف الجارية، والثاني يخزن في المخابئ الخفية لفاس ومكناس والريصاني- أبو عام بتافيلالت. وتنقل المبالغ الأخيرة إلى وجهتها بواسطة مواكب بغال تحت حراسة مشددة لجنود المخزن، وحتى يظل السر محجوبا، فمآل العبيد المكلفين بدفن الكنوز المعنية هو الاختفاء عقب إنجاز مهمتهم.
الخزينة التي يضيف العرب معلقين كلما أتوا على ذكرها: «ليملأها الله!»، الخزينة هذه من المفترض أن تحتوي على مئات الملايين، وذلك اعتمادا على الاحتمالات الأكثر ترجيحا في مجال لا يحكمه سوى التخمين. ويتضمن هذا الرصيد احتياطيا لا يجوز إطلاقا التصرف فيه، إلا في حالة «الجهاد» (الحرب المقدسة)، وهي الحالة التي يرصد لها حصريا.