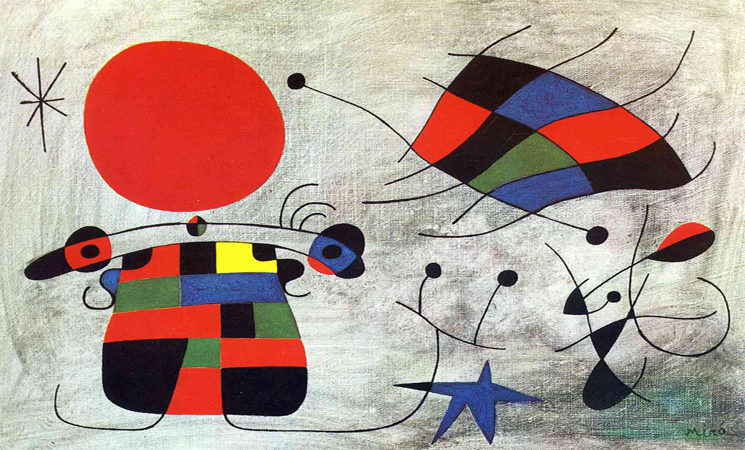هذا سؤالٌ من الأسئلةِ المعقدة في المشغل النقديّ العربيّ، مضى النقادُ في البحثِ عن اجاباتٍ له، تعريفاً، أو مقاربةً، أو توصيفاً، ومن هذه الإجابات ما هو مجترٌ بصياغة جديدةٍ، ومنها ما هو مقترحٌ مبتكرٌ، وتجيء هذه الاجاباتُ مختلفةً باختلافِ اتجاهات النظرِ.
قديماً كانوا ينظرون إلى الشعرِ من منظور بلاغيّ، بناءً على ما توافر من معطيات لغوية، و ما توافر في المشغل الفلسفيّ عبر الترجمةِ، أو مع اشتغالات فلاسفة الإسلام، فلاحقوا الشعر بلاغياً، أي إنهم نقاد بلاغة وليسوا نقاد شعر، فكان ما تركوا للبلاغة حظ أكبر فيه، يتضحُ هذا في مدونات القرن الرابع الهجري، كعيار الشعر لابن طباطبا العلوي، و نقد الشعر لقدامة بن جعفر، مروراً بالقرن الخامس الهجري مع ابن رشيق وعبد القاهر الجرجاني، وصولاً ـ وليسَ انتهاءً ـ إلى القرن السابع الهجري مع حازم القرطاجني في منهاج البلغاء.
واستمرت الإجابات بهذا المسار البلاغيّ حتى عصر اليقظة الثقافية العربيّة أو قبله بقليلٍ. واستمدت هذه الإجابات من الشعر العربيّ نفسه، من نماذجه فقط، فمفهوم الشعر عندهم كانَ متأخراً، منبعثاً من نماذج معينة، وليس من بئر الوعي وضفاف استشرافه وتأملاته، وهي نماذج تتصلُ بشرطها التاريخي، الذي خلقت في ضوءٍ منه، وربّما لهذا سمي الشعر (ديوان العرب)، فالشعر كما يقول ابن طباطبا: «يصور حياة العرب والحالات المتصفة في خلقها من حال الطفولة إلى حال الهرم، وفي حال الحياة إلى حال الموت».
ووصف قدامة بن جعفر الشعر بناءً على ما توافر في المدونة اللغوية، والنزعة الفلسفية من معايير، باحثاً فيهما عن محددات يماز بها الشعر من النثر، ومن النظم، ناهيك بجيد الشعر من رديئه، موجّهاً بذلك الشعر نحو الصناعة. وهذا ما مضى عليه حازم القرطاجني خطوة أبعد ظهرت في توصيفه للشعر، أو في تعريفه.
إما المحدثون فمنهم من لم يفارق ما ذهب إليه المتقدمون، كطه حسين، إذ ذهب إلى أن الشعر: «الكلام المقيد بالوزن والقافية، والذي يقصد به إلى الجمال الفني»، وهو القول الذي ذهبَ إليه الرافعي أيضاً، ومنهم من ابتعد عنهم رؤيةً مختلفة، لما جدّ من النظر إلى الشعر عند الآخر الأوربي، فلاحق نماذج الشعر العربيّ القديم، كالعقاد الذي قال: «ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبه، وإنما مزيته أن يقول ما هو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به»، ووافق العقادَ المازني بقوله: «إنما الشعر استيعاب للمحسوسات، وقدرة على التعبير عنها في القالب الجميل، وقد تكون هذه المحسوسات عامة وشاملة، وقد تكون خاصة محدودة، وقد تكون إدراكاً واعياً لكل ما في الطبيعة والكون والوجدان، وكل ما تتسع له الأرض والسموات»، غير أن العقاد والمازني بقيا محافظين على عنصري الوزن «الموسيقى»، والقافية، بوصفهما قوام الشعر وجوهره، ومضى المجددون إلى مديات أبعد في الإجابة، مبتعدين عن عمود الشعر، ومقتربين من فهم آخر فرضته الحداثة على أن الشعر هو الأمل في الخلاص، و التغيير، أو على حد تعبير سارتر: «إن مهمة الشعر تتمثل بخلق أسطورة الإنسان». وتمثل هذا الفهم في ما سمي بالشعر الحر تجوّزاً، مع السياب بشكلٍ أساس، وهو الفهم الذي رفضه الشعراء الستينيون الأربعة في العراق (فاضل العزاوي، وفوزي كريم، وسامي مهدي، وخالد علي مصطفى) عبر بيان مشترك في مجلة (شعر 69) : «إننا لا نكتب الشعر لأنه يمثل نوعاً من الخلاص بالنسبة لنا، فالخلاص الحقيقي غير ممكن وكل بحث عن الخلاص ليس أكثر من بحث ميتافيزيقي فارغ..»، ومن المجددين قبلهم جماعة (مجلة شعر البيروتية)، فقد وقفوا ضد كل ما يحد الشعر ويقيده، وهو فهم «يربط بين التحول الشكلي وبين الدعوة إلى توجه مفهومي جديد يتجاوز أحياناً الشعر، ليبلغ جماع الموقف الثقافيّ والأنطولوجي بوجه عام»، إذ يرون الشعر ثورة كلية، وكان جبران خليل جبران قد تبنى هذه الثورة الحديثة في الشعر أيضاً، لكنها حسمت بشكل واضح مع رواد الشعر الحر، وجماعة مجلة شعر البيروتية الذين كانوا أكثر تحمساً في التجاوز، والمشابهين، كما يبدو، لجماعة الأربعة (دافيد بيرليوك، الكسندر كروتشينيك، فلاديمير مايكوفسكي، فيكتور خليبنيكوف)، في (صفعتهم في وجه الذوق العام)، عبر ذاك البيان الواثق: «اقذفوا ببوشكين، بدوستويفسكي، بتولستوي، من فوق باخرة الحداثة»!
وهذا الاختلاف في الإجابة يأتي استجابة لتحولات حدثت في الشعر بعامة؛ لأسباب كثيرة، منها ما هو اقتصاديّ، وسياسيّ، واجتماعي، وايديولوجي، ومنها ما هو ثقافيّ، كانفتاح الثقافات بعضها على بعض، ما أسهم باتساع مساحة النظر إلى الشعر، فما عاد الشعر العربيّ الحديث منعزلاً عن العالم، وما عادَ الشاعرُ رهينَ ثقافته المحلية، بل ما عادت الحياة، اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، وثقافياً، ذات أطر مغلقة، بل تداخلت وتشعبت حد التأثير والتأثر، والحديث عن شعر عربي جديد، ضرورةً، يفتح نوافذ لأحاديث مماثلة عن شعر أجنبي موازٍ، أثر فيه وأفاد منه، وهو ما نوّع الإجابات الجديدة تلك، غير أن هذا المقال ليس معنياً بمفهوم الشعر بين القديم والجديد، أو بين الثقافة العربية والآخر المختلف، وإنما جيء به تمهيداً لمجترح مكاشفة، مكاشفة تقول : إن مفهوم الشعر، في ضوء نماذج وتمثلات عراقية جديدة، قد غاب لأربعة عقود، أي من السبعينات إلى اليوم، بلا مقتربات أو توصيفات أو مساءلة، واتكأت الكتابة الشعريّة في هذه العقود الأربعة على ما استقر في المدونة الثقافيّة العربية.
ولم نطالع مساءلة حقيقية لمفهوم الشعر في ضوء من نماذجه وتمثلاته الجديدة، وكأن ما جاء به الستينيون، ومن قبلهم، توصيفاً وأشكالاً، واستمروا في ملاحقته، خاتمةَ الحديث عن الشعر وشؤونه، وما بعدهم جاء مجرد اجترار لجدلية المجايلة، أو صراع الأشكال، أو بيانات فردية لا تقوم على وعي ثقافي ونقدي، بقدر ما تقوم على ردود أفعال عابرة، أو اشتهاءات تميز لم تمكث طويلاً، أو استجابة للمتطلبات مرحلةٍ اقتصادية، كما حدث في فاتحة التسعينيات مع (قصيدة شعر)، جرّاء قسوة الحصار، وصعود مكافأة نشر الكتابة العمودية في الصحف والمجلات الرسمية، وهنا أعني حقبة عود الشعر العمودي مع (أم المعارك) مثلاً، وما بعدها، واتساع المناسبات والاعياد السياسية التي تحرض على فائض المديح، كيوم (الزحف الكبير) و(أعياد نيسان الحزبية) التي كتبت فيها عشرات القصائد العمودية، ولم تكن تحركات (قصيدة شعر)، التي جاءت في منتصف التسعينيات، المحرض الرئيس لرسوخ الشكل العمودي (قصيدة الشطرين) بأداء آخر مختلف، وانما جاء بعد عود هذا الشكل واتساعه، وصعود أسماء شعرية عراقية جديدة توطدت صلتها بهذا الشكل تحديداً كتابة ونشراً ومهرجاناً، وبدوافع لا تخلو من رائحة الايديولوجيا، وفخاخ غواية المكافأة، ولقد صرح أحد كتّاب (قصيدة شعر) بان ما طرح انذاك (مراهقة ثقافية) وسأكتفي بهذه الاشارة، هنا، بلا تمثلات لما كتب من شعر عمودي في تسعينيات الحصار، وكيف تنكر كثير من هؤلاء الشعراء لقصائدهم تلك، بل بعضهم مارس الحذف والتعديل لتنسجم الكتابة مع حقبة الاسلام السياسي بعد 2003!!
ولم يكن نقد الشعر بمنأى عن هذا الاجترار، فبعد المدونة النقدية في الستينيات وما تسرب منها إلى السبعينيات، ما عاد نقد الشعر بالمكانة التي كان عليها، مكتفياً بمحاورات نصٍ، أو عروض صحفية، أو قراءات تطبيقية، ويبدو السبب، في هذا، يعود إلى ما اصاب المشغل الاكاديمي من تهميش وتساهل – بعد ما كان مشغل النقد الرصين، والواضح، والجريء- وربما بسبب اتساع وهيمنة نقد الشعر خارج الاكاديمية، نقابات وملتقيات وورش إخوانيات.
مع كلّ حقبة شعريّة ضرورة أن تضع نماذجها وتمثلاتها مفهوماً جديداً للشعر، ورؤية مختلفة للتحديث أو التجديد، فهي نماذج و تمثلات تجيء في شرط خاص مختلف، أي أنها تعبر عن ذاتها بعيداً عن مقولات قبليّة، أو حدود قارّة، أو توصيفات جاهزة، وترفض انتسابها إلى مقولات الصراع بين القديم والجديد، بل هي «حصيلة الانقطاعات والتعالقات والشكوك الدالة، والفاعلة في هذا التاريخ»، نماذج وتمثلات يُفترض لها أن تجترح مقتربها الخاص بالشعر، وفهما للتحديث، ويعزز هذين (المقترب والفهم) النقدُ الشعريّ، حتى يصدق عليها ما أصطلح عليه بـ (القصيدة المفارقة)، القصيدة التي تترك ذُيولَ الماضي القريب والبعيد، وتغادر صراعاته ومشكلاته وما يعج به من محرضات غير شعرية، وتخلق راهنها بقوة الشعر لا بقوة الصراخ وما يجاوره، وتحدث تحولاً مهماً وفاعلاً وملحوظاً في حركة الشعر العربي بعامة، وتؤثر تأثيراً كبيراً في مسار التلقي، وهي توقظ الوعي الشعري من سباته الطويل.