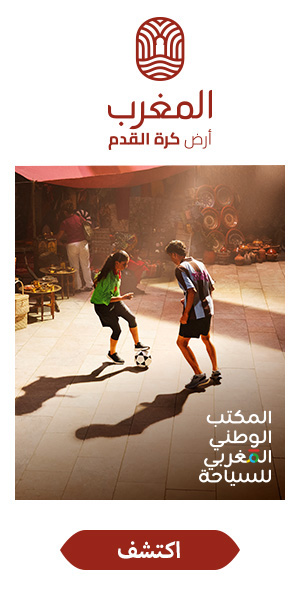تقول عنه زوجته، ورفيقة درب حياته، في رحلة عمر امتدت لأكثر من 70 سنة، السيدة فريدة آكاردي كالودجيرو منصور:
«لو سمح الله للملائكة أن تمشي في الأرض وتتزوج، لكان سي محمد منصور واحدا منها».
إنه المقاوم والوطني والمناضل التقدمي الراحل محمد منصور، الذي سنحاول هنا رسم ملامح سيرة حياته، بما استطعنا إليه سبيلا من وثائق ومعلومات وشهادات. فالرجل هرم بكل ما تحمل الكلمة من معنى، حكم عليه بـ 3 إعدامات و مؤبدين في الإستعمار واعتقل وعذب في الإستقلال من أجل الكرامة والديمقراطية.
هو المساهم والمنفذ لأكبر عمليات المقاومة ضد الإستعمار الفرنسي (عملية القطار السريع بين الدار البيضاء والجزائر يوم 7 نونبر 1953. وعملية المارشي سنطرال بالدار البيضاء يوم 24 دجنبر 1953)، أول عامل للحسيمة سنة 1957، وأول رئيس للغرفة التجارية بالدارالبيضاء سنة 1960.
محمد منصور، هرم، يصعب جديا الإحاطة بسيرته بالشكل المنصف تاريخيا، على الأقل لسببين:
أولهما أن الرجل كان صموتا جدا، يرفض بحزم، البوح أبدا بالكثير من التفاصيل الدقيقة كشهادة أمام التاريخ، بسبب من ثقافته السلوكية، التي ظلت تتأسس على أن ما كان يقوم به، كان يقوم به بنكران للذات من أجل الصالح العام.
ثانيهما طبيعة السرية التي حكمت عمله النضالي ضد الإستعمار وفي أجزاء كثيرة من زمن الإستقلال من أجل العدالة الإجتماعية ودولة الحق والقانون والحريات.
وإذا كانت هناك من خصلة ظلت مميزة عند محمد منصور فهي خصلة الوفاء. الوفاء لرفاق الطريق الخلص، الوفاء للفكرة الوطنية، الوفاء لقرار نظافة اليد، الوفاء للمبدئي في العلائق والمسؤوليات، مما يترجم بعضا من عناوين الجيل الذي ينتمي إليه رحمه الله، الذي يتصالح لديه الإلتزام السياسي مع السقف الوطني، وأن السياسة ليست مجالا لبروز الذات، بل مجالا لتطوير الجماعة في أفق بناء، تقدمي وحداثي (الحداثة هنا هي في تلازم المسؤولية بين الحق والواجب).
محمد منصور، ستكتب عنه كل صحف فرنسا الإستعمارية (ونقلت صدى ذلك صحف باريس أيضا)، يوم وقف أمام القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية بالدار البيضاء سنة 1954، كي يفند التهم الموجهة إليه ويفضح تهافت جهاز الأمن الفرنسي في كافة مستوياته الأمنية والعسكرية والمخابراتية، حين أظهر لهم كيف أنهم يحاكمون سبعة مواطنين مغاربة ظلما بتهمة تنفيذ عملية «القطار السريع الدارالبيضاء – الجزائر»، بينما هو منفذها، مقدما تفاصيل دقيقة أخرست القاعة والقضاة والأجهزة الأمنية. وقدم مرافعة سياسية جعلت مستشارا قضائيا فرنسيا يجهش بالبكاء، حين رد على القاضي، الذي اتهمه بالإرهاب: «سيدي القاضي، نحن وطنيون ندافع عن بلدنا، ولسنا إرهابيين، نحن نقوم فقط بنفس ما قام به الشعب الفرنسي لمواجهة النازية الألمانية لتحرير فرنسا. فهل ما قام به أبناؤكم إرهاب؟».
هنا محاولة لإعادة رسم ذلك المعنى النبيل الذي شكلته سيرة حياته، من خلال مصادر عدة، من ضمنها عائلته الصغيرة (زوجته السيدة فريدة منصور، ونجله الأخ زكريا منصور، وابنته السيدة سمية منصور)، وعشرات الوثائق الموزعة بين مصادر عدة فرنسية ومغربية، دون نسيان الأيادي البيضاء المؤثرة للأخ الدكتور فتح الله ولعلو، في تسهيل إنجاز هذه السيرة كوثيقة تاريخية.
كانت تمة ميزة اجتماعية، في محمد منصور، تعكس وعيه الثقافي السلوكي والقيمي، تتمثل في اعتباره العائلة والبيت مقدسين، حيث لم يكن يسمح أبدا بالخلط بين علاقاته السياسية والتنظيمية وبين علاقاته الإجتماعية. بدليل أنه لم يكن يقبل أبدا أن يتحول بيت العائلة إلى ما يشبه فرعا مفتوحا للحزب، أو خلية للمقاومة، يستقبل فيه الجميع. فالبيت له حرمته بالنسبة إليه، تأسيسا على ثقافة أصوله، التي تصدر عن منطق تربوي للزاوية، خاصة من جهة أخواله، يرى إلى العلاقات بين الناس من زاوية الأخلاق بالدرجة الأولى.
كان الرجل، الذي خبر الحياة، عبر الكثير من امتحاناتها القاسية، قد انتصر دوما للعقلاني في الأمور، معتبرا أن الآخر لا يكون دوما مصدرا للإيجابي في أمور العلاقات الإنسانية. لم يكن له ذلك الشك الذي ذهب إليه فيلسوف الوجودية الفرنسي جون بول سارتر، حين قال جملته الشهيرة: «الآخرون هم الجحيم» (التي ضمنها مسرحيته الأشهر «أبواب مغلقة»)، بسبب أن مرجعية ثقافته الدينية، تفرض عليه عدم الحكم على الآخر بالقطيعة والريبة والشك. بل، كان له تهيب من ذاق اليتم باكرا، وكبر بلا سقف أمان، غير ذاك الذي تبنيه ذراعاه في تحد من أجل البقاء. لهذا السبب، ربما، لم يستطع الكثيرون، تفهم (أو تقبل) ذلك الإحتياط الكبير الذي ميز سلوك سي محمد منصور في حياته الأقرب إلى العزلة والإنطواء. وكثيرون ذهبوا مذاهب شتى في تفسير الأمر (لم تكن دوما تلك التفسيرات منصفة لقيمته وحقيقته كرجل خلوق وفاضل)، بين من اعتبرها «تهربا» ومن اعتبرها «تعاليا»، بينما الحقيقة غير ذلك تماما. فالرجل ظل دوما يمارس الحياة بقلب طفل، لكنه طفل لم يكن يكذب على نفسه، ولا سمح للآخرين أن يستغلوا روحه الطيبة تلك. لقد هزني دوما، في سي محمد منصور قرب دمعته، فالرجل لم يكن يبخل أبدا على روحه في أن تدمع وعينه من أن تبكي، حين يكون ذلك الماء المالح رسالة منه إلى العالمين، وحين يكون ترجمانا لمعدن روحه الداخلية الصافية كالبلور. وفي كثير من المرات، وجدتني مشلولا أمام دمعه الذي ينزل على لحيته البيضاء، حين يذهب التذكار به، في مسارب قصص حياة رجال جمعته بهم دروب الحياة والنضال والرفقة والأخوة. ومعه تليق تماما تلك المقولة الشعرية الخالدة لقيس بن الملوح (الشهير ب «مجنون ليلى»):
«ليس الذي يجري من العين ماؤها
ولكنها نفس تذوب فتقطر».
لهذا السبب، فإن بنية نفسية، مثل التي كانت تميز سي محمد منصور، تعكس أنه كان متصالحا مع ذاته، بضمير حي، مرتاح، لأنه انتصر دوما للبسيط في الأمور، وهو: الصدق. الصدق مع الذات والصدق مع الآخرين والصدق مع الله (فالرجل كان في تدينه صوفيا، عاشقا لخالقه، لا خائفا منه). بالتالي، لم تكن المجاملات من قاموسه أبدا. ليس بالمعنى الذي قد يفهم منه أنه كان حاد الطباع، بل على العكس تماما من ذلك، فالمقصود هو أنه كان شفافا.
بناء على ذلك، يستطيع المرء أن يفهم سر صرامته على مستوى السلوك التربوي لأبنائه وعائلته، المتأسس على ميل واضح للتربية السلفية. تلك التي تشربها منذ شبابه الأول، ليس فقط من أخواله المشتغلين كلهم في سلك القضاء والعدول (وكلهم تابعون للزاوية التيجانية، مثل والده الحاج بلمنصر، وكانوا استثناء بمنطقة أولاد حريز التي أغلب ساكنتها تابعون للزاوية الكتانية)، بل أساسا من خلال العلاقة الإنسانية الرفيعة التي نسجها منذ نهاية الأربعينات مع شيخ الإسلام بلعربي العلوي. فقد كان منصور في مكان ما، أشبه بمريد في علاقته مع ذلك الوطني السلفي التقدمي الكبير. بدليل أنه كان يشد إليه الرحال باستمرار إلى مدينة فاس للإنصات إليه والتعلم منه وأخذ مشورته في الكثير من أموره الخاصة وأموره السياسية. وشيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي، علامة فارقة في تاريخ السلفية المغربية المتنورة، العقلانية، المنتصرة للقيم الإنسانية في معناها الكوني والسامي. فالرجل، خريج جامعة القرويين، الذي حمل الفأس ليجز شجرة الشعوذة والخرافة والدجل، من حياة ووعي المغاربة، لم يكن يرى إلى الإسلام كلحظة محنطة في تجربة تاريخية للسلف (اجتهدوا ومارسوا الحياة بما يليق وزمنهم وتحدياته)، بل كان يرى إليه كدين ممجد للعقل وللإنسان وللحياة وللعلم (بالمعنى الشمولي للعلم، الذي هو إغناء واقع الناس بالمعرفة وأسباب التقدم). مثلما أن وعيه ذاك، قد جعل من قيمة الوطن عنده سقفا عاليا، يتوازى وسقف الإيمان. ومن مثل ذلك النبع الوطني السلفي المتنور العقلاني شرب محمد منصور، وسقى عطشه للمعرفة ولمعنى سلوكي بناء، تتوازى فيه قيمة بناء الذات مع قيمة بناء الجماعة. وليس اعتباطا أن كان إبن ذلك العلامة، مولاي مصطفى العلوي (الذي تقلد أكثر من مرة منصب وزير للعدل بالمغرب ما بين 1981 و 1993)، واحدا من أصدق أصدقائه، وأوفاهم، وأقربهم إلى روحه، في علاقة دامت منذ 1955 حتى وفاة مولاي مصطفى رحمه الله سنة 2007.
لهذا السبب، فإن عفة اللسان التي كانت راسخة في سي محمد منصور، فهو لم يكن أبدا مشاء بنميم، ولا كان أبدا يجرح في الآخرين (بمن فيهم خصومه وممن أساؤوا إليه كثيرا)، ولا كان قاموسه خادشا.. أقول إن عفة لسانه تلك، تجد جذورها في تربيته الدينية والسلوكية هذه، خاصة وأن اليتم باكرا، قد شحذ فيه قوة المواجهة لاستحقاق مكان لائق تحت الشمس، هو الذي كبر أصلا، ابنا وحيدا لأمه رحمها السيدة «قمرة بنت علي»، بعيدا عن أشقائه الذكور الذين بقوا في منطقة أولاد حريز وكانوا يكبرونه كثيرا في السن. بالتالي، فإن الرجل قد كبر على الإحتياط في نسج العلاقات مع الآخرين، من باب اختباره لأنواع مختلفة من الأنفس والعقليات والثقافات، فكبرت في داخله مكرمة تنسيب الحقائق وتنسيب الأحكام. والصمت الطويل الذي كان يلوذ به، لكل من عرفه واحتك به، إنما يجد مصدره من تلك التربية السلوكية التي وطن نفسه على اتباعها طيلة حياته.
من هنا، فإنك حين تحفر للبحث في طبيعة صداقاته الحميمية (من باب محاولة رسم صورة متكاملة لشخصيته)، تكاد تجدها قليلة ومعدودة على رؤوس الأصابع. وأن اولئك الصحب هم وحدهم الذين كان يسمح لهم بالمجيئ إلى بيته والاختلاط بباقي أفراد عائلته. يأتي في مقدمتهم رفيق حياته الكبير وصديقه الحميم سعيد بونعيلات، الذي تشرح السيدة فريدة منصور السبب في قوة تلك الصداقة التي جمعت بين الرجلين منذ تعرفا على بعضهما سنة 1938 بدرب بنجدية بالدار البيضاء حتى فرقهما الموت، إلى القيمة السلوكية لبونعيلات. فهو عنوان عال للإستقامة ثم الإستقامة، ثم الصدق والصدق، ثم النزاهة والنزاهة.
مثلما نجد في صف صداقاته الحميمية الخاصة، علاقته القوية والكبيرة بالشهيد المهدي بنبركة الذي كان بيته بالرباط، بحي ديور الجامع، مفتوحا دوما (عائليا) لمنصور وزوجته، التي ظلت تعتبر بيت عائلة بنبركة بيتها بالرباط، وهو الوحيد الذي كانت تبيث به عند زوجة المهدي، السيدة غيثة بناني، وظلت على علاقة قوية بشقيقاته أيضا. مع التسطير على أن الكثير من القرائن، تسمح بالجزم، على أن علاقة منصور بالمهدي بنبركة كانت علاقة فكرية فيها الكثير من التماهي على مستوى فهمهم لواقع السياسة المغربية، ولواقع طبيعة اللحظة التاريخية التي يمر منها المغربي (المواطن والإنسان)، وللسبيل الواجب عبورها للوصول إلى بر التقدم.
ثم نجد علاقته بعبد الرحيم بوعبيد منذ 1944، وأيضا علاقته بعبد الرحمان اليوسفي منذ 1946، وعلاقته بالدكتور عبد اللطيف بنجلون، والحبيب الشرقاوي ومولاي المهدي العلوي ومحمد باهي ومحمد عابد الجابري.. فهؤلاء هم الذين كانوا الخلص من رفاقه الذين لا يتردد في الإجتماع بهم بمنزله وتبادل الزيارات العائلية مع عائلاتهم.
ولأن سيرة الرجل كانت مضربا للمثل في النزاهة والإستقامة، اجتهد بعضهم (من بعض الأجهزة الأمنية) في محاولة للإساءة إلى تلك السيرة وإلى الصورة التي ترسخت عنها. حيث سيواجه سي محمد منصور على مدى عقود، منذ أواسط الستينات، بتخطيط من أجهزة كانت تابعة للجنرال أوفقير (تؤكد زوجته السيدة فريدة آكاردي منصور)، سيواجه مسلسلا من القصص والأحداث والإشاعات، ابتدأت بإشاعة زواجه من سيدة ثانية، ثم امتلاكه ضيعة فلاحية أخرى قرب الأطلس المتوسط، ثم استدعائه المتواتر إلى دوائر الأمن بتهمة إعطاء شيكات بدون رصيد، ثم استدعاءات متعددة إلى إدارة الضرائب بدعوى التهرب الضريبي، وهكذا.. وكان سي محمد يواجه كل ذلك التصابي بعفة وهدوء وصبر نادر.
القصة وما فيها، أنه قد تم دفع أحدهم ليحمل رسميا إسم محمد منصور، وأن تكون زوجته تحمل نفس الإسم «فريدة» وأن يكون الأبناء بذات أسماء أبناء سي محمد منصور الحقيقي. ولم يكن صاحبنا يخجل من ادعاء أنه محمد منصور المقاوم الشهير، ولا زوجته أن تدعي في أماكن عمومية أنها زوجة منصور المقاوم. بل ستحدث طرائف مثيرة (مضحكة ومبكية في الآن ذاته) حتى مع الصديق الحميم للسي محمد منصور، الأستاذ مولاي مصطفى بلعربي العلوي، حين سيتقدم إلى مكتبه ذات يوم، وهو مدير لشركة الحليب «سنطرال» بالدار البيضاء شخص إسمه محمد منصور، يمتلك ضيعة فلاحية، بها أبقار حلوب، وأنه جاء يطلب تسهيلات وامتيازات بدعوى أنه مقاوم. طلب مولاي مصطفى من كاتبته الخاصة إدخال الرجل إليه، وشرع بدون وجل ولا خجل يحكي له عن بطولاته ضد الإستعمار، والرجل ينصت إليه في استغراب، قبل أن يطلب منه المغادرة لأنه صديق لمحمد منصور المقاوم الحقيقي. لكن لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، لأن صاحبنا لم يكن يخجل في أن يعود لطلب مقابلته بصفته مديرا لشركة الحليب، فأصبحت اللازمة بين مولاي مصطفى بلعربي العلوي وسكرتيرته كلما قالت له عبر الهاتف: «السيد محمد منصور يلح في مقابلتك»، أن يسألها ضاحكا: «أي منصور فيهم الحقيقي أم المزور؟».
المفارقة المبكية المضحكة، في تلك الإساءة المتعمدة لسنوات ضد الرجل ورمزية اسمه وضد عائلته الصغيرة، هي أن سيتوصل ذات يوم باستدعاء من ولاية الأمن، من قسم الشيكات بدون رصيد، حيث تم التعامل مع الرجل كمجرم (رغم علمهم تماما بمن يكون حقيقة). وبلغ الأمر حد إصدار القرار باعتقاله والشروع في نقله إلى سجن عين برجة، قبل أن يتدخل ضابط شرطة ليؤدي قيمة الشيك نيابة عن سي محمد منصور، هو الذي يعرف قيمته ومكانته، أمام استغراب زملائه الذين كانوا ينفذون تعليمات غايتها فقط الإساءة للرجل ومحاولة إذلاله باسم القانون. وحين احتج ضابط سام آخر، مقدما صورة الشخص المعني الحقيقي الذي يحمل ذات الإسم «محمد منصور»، والذي أكد لزملائه أنه يعرف مكان تواجده اليومي، وعليهم بالتوجه لاعتقاله، أجابوه ببرود: «ذاك أمر لا يخصك ولا يخصنا، نحن نتعامل مع من هو في يدنا الآن». كانت الرسالة واضحة، هي الإساءة لشخص محمد منصور وإهانته.. ولقد استمر ذلك الأمر سنوات طويلة، حتى خجل القوم من أنفسهم، وتغيرت الأمور منذ 1994.