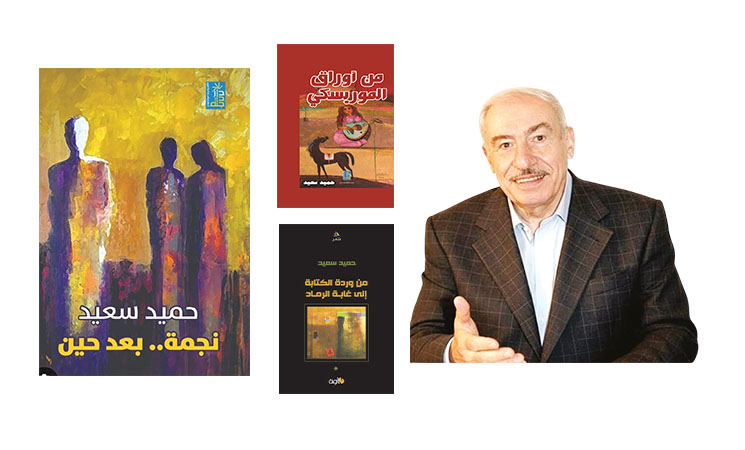ذروة الشعرية أن تتوسل الذات علياء خصوصية البصمة وفرادتها ،لا أن تذوب بين الأصوات وتتنازعها القواسم المشتركة في تجارب الآخرين، كون الانفتاح على نتاجهم الأدبي والمعرفي والفني، يتوجّبُ ألاّ يتجاوز سقف المطالعات المذيلة بالمحو، أو المقاربات المختومة بسلطة ذاكرة مثقوبة، تتيح فضيلة الإنتاج غير المكرور لجملة المعاني التي تشمل الذات والغيرية والكونية.
لسنا نهدف من خلال هذه المناولة إلى ما يُشرعن الهروب إلى عوالم الغموض والتعقيدات التي تزجّ بالشعر في قفص الاتهام، أكثر مما تقترحه في تجليات البراءة، وأن التاريخ ، بشكل عام، هو مجرد صفحات بيضاء نقية، نحن من نلوّنها على سجيتنا، و» نغتصبها» بتجارب تفيض عن معاناتنا، مُنفّسة بذلك عن أسرار وأحلام جيل برمته، وما حاد منها عن مرارة الحقانية والصدق وحرارة مكابدة صروف ونائبات الحياة، شطّ عن المعنى الإنساني المقطّر في انسيابيته و عفويته وفطرته وعذوبته، وتعفّن في سلال المهملات وانتهى إلى مزبلة التاريخ،مهما راهن على ثقافة الواجهة وتقنع بغواية التّسطيح وتشبّع بفلسفة ذر الرّماد في الأعين.
هذا وأحسب الشاعر المغربي محمد بن طلحة المتوج بجائزة» الأركانة» العالمية للشعر، من هذا الصنف الذي لا يغرّد إلاّ ليبرز بروح وذاتية جديدة مغايرة، تأبى الاجترار ،وتنأى عن مشهدية العود الاستذكاري أو « الفلاشباكي» المثقل بتنويعات وتلوينات السرقة الذكية من قشيب الذات والحياتية والتاريخ.
مذ أول ديوان له» رؤى في موسم العوسج»، فنشيده المنذور إلى سلالة البجع « نشيد البجع» ، ثمّ مجموعة « غيمة أو حجر»، مرورا بــــ « سدوم»، فديوان» تحت أي سلم عبرت»، فـ»قليلا أكثر» ،انتهاء بما يشبه هذه الخسارة التي هي بطعم ربح الذات والانتصار على الحياة بشتى صنوف تحدياتها وتجاوزاتها، هذه الخسارة التي هي من نسج القصيدة فقط، ولا يمكن بأي حال مساواتها مع سائر ما سواها، ديوان» أخسر السماء وأربح الأرض».
من جدلية الشّبيه، تولد قصائد محمد بن طلحة، مجدّفة في سراب اللامعنى الطاعنة بلذاذته مقامرات أو بالأحرى تجريبية ، تدغدغ مستويات أبدية عذرية الذات والغيرية والعالم، مغازلة أبجديات عوالم هشة جرفها لتوّه المحو ، وتفتّقت عنها أكمامها النّضرة، طامسة قبلية الانكسار.
منجز ناوش على امتداد ما يربو على أربعة عقود، كي يضيف النوعية التي تحسب للمشهد الشعري العربي الحديث، وليس المغربي فقط.
مدشّنا سلوكا انقلابيا ونكوصيا، يحاور بإيقاعات الذات المنفلتة و القابلة لكل هذا التعدد في الزمكان.
ارتقاء عكسي، من سماء المواقف والأحداث والصور المنضوية تحت ديدن التكثيفات الكاسحة، واستقلالية متحدّرة من لا محدودية ولا نهائي المعنى، باتجاهات ارتجاجية عصية من حيث محاولات القبض على ملامح الشعرية التي قد تشي وتغري بها، تبعا لفصول قزحية تعكس حجم التوغل في القصيدة والإنسان، مجترحة معسول التداخل والتلاقح والتشابك ما بين العرفاني والطوباوي.
من سماء العنفوان إلى أرض الخلاص ، على يد النّص المتطاوس الذي يستفزّ عناصر الآدمية والطبيعة والوجودية فينا.
نقترح الاختزالات الموالية ، من هذه التجربة الباذخة التي تعالج بعضا من خلل في ثنايا كائن ألفية الجنون والفوضى والدموية والاضطراب، وكل ما يفجّر حمولة الرّوح المكلومة ويفتح بعضها على طقوسيات فولكلور أو فانتازية المرثاة.
[أشْلي نار الصَّبابات الدفينة
بلِّغي عني الهوى
(…) لاتلومي جسدي الملقى على أرض المطارات فإني
يهرب العالم مني
أسمع الآن صدى صوت بلادي
صوتها مُر، فيا ويحي!
أنار في دموعي؟
أم رصاص في حوانيت المدينة].
…………….
[أَيّهذا العَجَاج المعتق
نحن كشَطنا المرايا
ونحن اقْتَرحنا الروي
وبيت التخلص
لكننا لم نكن غير سمَّار هذا الهواء المعلق
من قدميه
على
سلمين
وحبل غسيل
كأن لم يكن في لَحاء القصائد غير الصَّراصير
أو غير جمر برد].
……………….
[النهر يجري
وأقدامي/ فيه.
ما العمل؟
كل موجة هادرة علامة ترقيم
وكل صفحة مبتورة، لورانس داريل سوف يستشهد بها
على قوة العباب
الطوفان على الأبواب
وصافو،
كلما تقدمت في السن
تطلعت إلى أشياء كثيرة، من بينها:
الخط الجميل
والعبارات المسروقة.].
……………
[وضيفٌ يفُلُّ قسيَّ رؤانا؛
ويحذف تسعة أعشار هذي القصيدة
أو تلك؛
ثم يحملق في سلة المهملات؛
ويجلس للشرب.
سيان.
يا أيهذا الجليسُ الذي لم
يحنكه
بعد
أنين ُ حُطام الأباريق
ها قد بدت حانةُ ملؤها الزِّنجُ.
فلنتحملْ
-جيدا-
جرعة العمق.
ولنرتجلْ دوْرقا من دخانٍ،
وألسنةَ من خزْفْ.].
يراوح الصوت الداخلي ما بين طبقات التجاذبات الضّدية ،وقوة شعرية أنسنة العناصر الطبيعية، وفق الأيقونة الهذيانية،مشفوعة بالحضور الذهني المحسوب، و المخولة للمتوالية المفهومية الوالجة في ما يشبه إحداث أو صناعة سيمفونية تقع فوق إرهاصات الإقحام المجازي والتدويرات البلاغية التي تنم عن مجرد الإقامة في القصيدة بغرض تهويمات تريد المثل، وتفصح عن دوافع التقعيد لثقافة بديلة في ارتكازها إلى تصالح كلي منطلقه من وإلى الذات.
تزيد على ذلك بما يؤهل لوضع القصيدة فوق الحياة، مع شاعر حرفي مثل محمد بن طلحة، يستحوذ على أسلوبية تعاطيه مع الكتابة إجمالا،زخم الاستنطاقات الهوياتية،وكأنه يجسدّ خسارات الذات ،مفسّرا لا مركزيتها في خضمّ ما يغمرها وتتم مراكمته عليها، وطمرها فيه،من تفاصيل وزوائد تمليها المسيرة الحياتية منشدّة إلى الآخر وإكراهات الراهن.
مركزية ذاتية يخسرها، وأحسب الأصحّ أنه يقايض بخساراته،وانكساراته التي هي من رغوة ما، كائن الاغتراب الروحي في الألفية الموسومة بما جردناه تفصيلا، ويراهن على قصائد نادرة تجفل فتجرّ معها بيادر المعنى إلى أبراج نقض الغزل ، فتحقّق بذلك تخطّي الشعرية المسكونة بروح التكثيف ودينامية التصويرات الفنية ، إلى حقول الدوال المصطبغة بغائية المعاني الأخطبوطية التي قد تبرّر المنظومة الوظيفية للشعر.
*شاعر وناقد مغربي
معاني الأخطبوطية في منجز الشاعر المغربي محمد بن طلحة

الكاتب : أحمد الشيخاوي*
بتاريخ : 13/07/2018