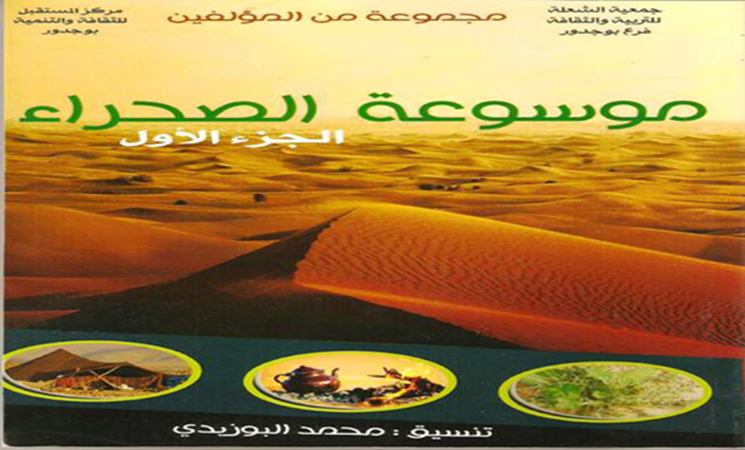لازمت الأوبئة كظاهرة اجتماعية مرضية وضرورة حتمية واقتران استثنائي بتاريخ المغرب، فاختلفت طبيعة العدوى الوبائية، وتنوعت أعراضها ودرجة حدتها واتساع رقعة انتشارها ومخلفاتها البشرية، بسبب الجفاف المتواصل والجذب
الحاد والقحط الشديد.
فمنذ قرون عديدة، وكلمة “الوباء” أو “الطاعون” أو “الجائحة” تثير الرّعب في الناس، تقشعر لها الأبدان، وتضيق أمامها النفوس؛ لأنها، ببساطة، صارت في ذهنية المغاربة مرادفًا لفقدان الأهل وللخوف الرّهيب من الموت، إذ تكفي الإصابة به ليَعدّ المصاب نفسه ممن سيلتحقون بطوابير الموتى الملتحقين زمرا إلى العالم الأخروي. هذه النّظرية التي جاء العلم ليفندها ويثبت أنه يمكن التّشافي من الطاعون والعيش بعده طويلًا لنقل الحكايات عنه لمن لم يعرفوه أو يدركوه.
في هذه الحلقات نرصدبرفقتكم محطات من “اوبئة” ضربت بلاد المغرب، فخلفت ضحايا في الخلف من إنس وحيوان.

عرف المغرب مند عهد السلطان المولى اسماعيل مجاعات كارثية ساهمت فيها عوامل مختلفة طبيعية وأخرى بشرية, وتشير المصادر إلى أن المغرب عرف سنة (1679- 1090) مجاعة نتيجة انحباس المطر حتى اضطر الناس لأداء صلاة الاستسقاء 9 مرات وارتفعت الاسعار يقول الضعيف ( وفي عام 1091 حدث غلاء بسبب تاخير المطر وصلى الناس صلاة الاستسقاء مرارا , ثم انحبس المطر طيلة سنوات 1721- الى1727 وفي سنة( 1724) لم تمطر السماء إطلاقا فيبست أشجار الزيتون والكروم والتين وبذلك انتشرت المجاعة في المغرب غير أن المصادر لا تسعفنا على تحديد مدى تأثر الشمال بهذه المجاعة, رغم أننا على يقين أن هذه المجاعة لم تستثني منطقة الشمال لأنها كانت عامة. يؤكد الباحثين طحطح وبكور
ويؤكد الباحثين أن مجاعة{ 1737- 1738/1150- 1151 } والتي ضربت المغرب خلال فترة الحروب الأهلية التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل, فقد كانت شديدة حتى اسماها بعض الإخباريين بالمجاعة العظيمة, وفي سنة 1150 كانت المجاعة العظيمة والفتن ونهب الدور بالليل بفاس وصار جل الناس لصوصا فكان أهل اليسار لا ينامون
لحراسة دورهم وأمتعتهم وهلك من الجوع عدد لا حصر له أما الضعيف فيصف مظاهرها قائلا ( ماتت عامة الناس بالجوع, وعجز الناس عن دفن موتاهم, وكانوا يرمونهم في الأزقة والمزابل وغير ذلك) ٠
يبدوا أن هذه المجاعة لم تشمل شمال المغرب, تؤكد ذلك رواية الضعيف التي تصف خروج سكان فاس ,وكانت المدن الشمالية هي الوجهة يقول الضعيف قال المؤرخ (وهو سيدي محمد بن الطيب الحسني القادري ) وأما أهل فاس العتيق, فخرج الجل منهم لتطوان وطنجة والعرائش والقصر ووزان, من قلة الطعام وارتفاع الأسعار وكانت تطوان هي التي استقطبت اكبر عدد من هؤلاء االنازحين ويضيف الضعيف وخرج الناس لتطوان وما والاها لجلب الطعام, إذ سخر الله العدو بحمل الطعام من بلاده لأرض المسلمين ..ويؤكد البزاز هذه الفكرة قائلا( يبدو أن المجاعة كانت اخف وطأة في المدن الشمالية المتطرفة كما يفهم من رواية الإخباريين التي تتحدث عن تدفق سيول الجائعين إليها من فاس ومكناس٠
وتساؤلا عن الأسباب التي جعلت الشمال بمنأى عن نتائج هذه المجاعة التدميرية ؟
لقد كانت هذه المجاعة نتيجة تضافر عوامل طبيعية, كانحباس المطر وزحف الجراد , وعوامل بشرية تمثلت في الصراعات العنيفة حول العرش, وكانت هذه النزاعات السياسية والعسكرية تدور رحاها في وسط المغرب, خاصة حول عواصمه التقليدية , في حين ظل الشمال بعيدا جغرافيا عن بؤرة هذا الصراع, وبمعزل عن عبث الجيوش بمحاصيله الزراعية.
هذا من جهة, ومن جهة ثانية فان جلب التجار الأوربيين للحبوب والمواد الغذائية خلال هذه الفترة إلى المدن الشمالية خفف من وطأة تأثير الكارثة.
ونفس الوضعية عاشها شمال المغرب خلال مجاعة( 1155- 1742) حيث يذكر الضعيف {أن جل أهل فاس القديمة باعوا ديارهم من شدة الجوع المفرط ,وخرجوا إلى القصر ووزان والعرائش وتطوان وطنجة بعيالهم ,وكانوا يتكففون, ويسعون القوت من أبواب الديار ,وقد حكى لي من أثق به ( يقول الضعيف) من أهل القصر, انه قال: كانت دراري أهل فاس يسعون في القصر….حتى كانت صبية صغيرة تقول متاع الله الله لله على ربي ياللي اعطيني قدر ما يعطي للقطية
وبنهاية الأزمة السياسية, وتولي السلطان محمد بن عبد الله العرش, دخل المغرب مرحلة الاستقرار والهدوء ,وتزامن ذلك مع سلسلة من المحاصيل الجيدة, بفعل تحسن الظروف المناخية , حتى أصبح المغرب يصدر القمح إلى أوروبا, وبكميات كبيرة خصوصا بعد استصدار السلطان فتوى من العلماء بجواز ذلك لشراء الأسلحة والذخائر. وبدأت عملية التصدير من سنة 1766 مما شكل مجازفة خطيرة على الأوضاع الداخلية في حالة محصول ضعيف ومنذ 1775 ارتفعت أسعار القمح بشكل كبير نتيجة تصديره ويؤكد ذلك جليا تقرير القنصل الفرنسي شيني قائلا إن محصول القمح لم يكن وافرا في السنة الماضية (1774) , والبلاد لا تتوفر على مخزونات منه, بسبب النتائج الوخيمة الناجمة عن
تصديره في السنوات الماضية , وترى ثمنه اليوم يزيد على ما كان عليه بثلاث مرات 10 فأصبحت البلاد مهددة بنقص حاد في الغداء, وبهجوم الجراد واشتداد موجة الغلاء, بدأت الإرهاصات الأولى للمجاعة الكبيرة (1776- 1781)/(1190- 1196). يقول الناصريً( كانت المجاعة الكبيرة بالمغرب وانحبس المطر ووقع القحط وكثر الهرج, ودام ذلك قريبا من سبع سنين…..أكل الناس فيها الميتة والخنزير والآدمي وفنى أكثرهم جوعا.
ولا نجد معلومات في المصادر والوثائق عن مدى تأثر مناطق الشمال بهذه المجاعة الطويلة باستثناء بعض الإشارات الطفيفة الموجودة في مراسلات أجنبية, والتي تحدثت عن انتعاش حركة تجارية بين مدينة فارو البرتغالية وطنجة, حيث كانت بعض السفن تأتي محملة بالفواكه الجافة والزيت والزبدة والقمح ,مما خفف من حدة الأزمة بالموانئ الشمالية12. ويذكر شيني بان الأمطار التي تهاطلت مند شهر ابريل1781 كانت غزيرة في الشمال قليلة في الجنوب يؤكد الباحثين طحطح وبكور