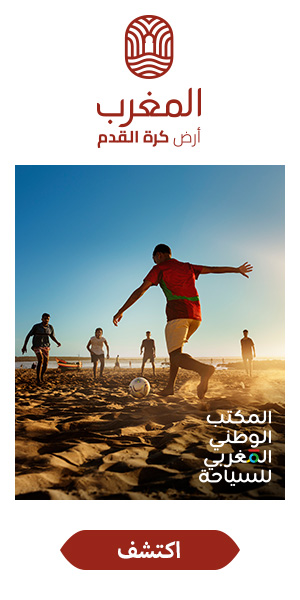لازمت الأوبئة كظاهرة اجتماعية مرضية وضرورة حتمية واقتران استثنائي بتاريخ المغرب، فاختلفت طبيعة العدوى الوبائية، وتنوعت أعراضها ودرجة حدتها واتساع رقعة انتشارها ومخلفاتها البشرية، بسبب الجفاف المتواصل والجذب
الحاد والقحط الشديد.
فمنذ قرون عديدة، وكلمة “الوباء” أو “الطاعون” أو “الجائحة” تثير الرّعب في الناس، تقشعر لها الأبدان، وتضيق أمامها النفوس؛ لأنها، ببساطة، صارت في ذهنية المغاربة مرادفًا لفقدان الأهل وللخوف الرّهيب من الموت، إذ تكفي الإصابة به ليَعدّ المصاب نفسه ممن سيلتحقون بطوابير الموتى الملتحقين زمرا إلى العالم الأخروي. هذه النّظرية التي جاء العلم ليفندها ويثبت أنه يمكن التّشافي من الطاعون والعيش بعده طويلًا لنقل الحكايات عنه لمن لم يعرفوه أو يدركوه.
في هذه الحلقات نرصدبرفقتكم محطات من “اوبئة” ضربت بلاد المغرب، فخلفت ضحايا في الخلف من إنس وحيوان٠
كارثة (1880- 1878 /1295- 1297
بدأت مؤشرات هده الكارثة مند 1877 بمحصول اقل من المعتاد ثم جاء خريف 1877بجفاف رهيب تسبب حسب فون كوزنغ الدي أقام بالمغرب عام 1877 بإقليم الغرب في هبوط كبير في أثمان الماشية والخيول واستمر الجفاف طيلة 1878 ولم تسجل سوى بعض التهاطلات الضعيفة في الأقاليم الشمالية التي غرقت خلال هده الفترة بأعداد ضخمة من النازحين إليها
ركز الباحثين طحطح وبكور على أن هده سنة كانت سنة يبس وجدب عام خصوصا في أهل البادية حيث يقول الناصري ولقد هلك منهم الجم الغفير وكان إخوانهم يحفرون على من دفن منهم ليلا ويستلبونهم من أكفانهم(ج3- ص164) ويشير مييج إلى أن المحاصيل التي أخطاها الجفاف أتى عليها الجراد وقد تجلت مظاهر هدا الجفاف في هلاك الخرفان والماعز والخيول والابقار والجمال فاضطر الفلاحون لبيع ماشيتهم لعدم وجود الكلأ ولحاجتهم شراء الطعام وتشير مراسلة من العرائش إلى أن الفلاحين لم يتمكنوا من تجديد دوابهم بعد الخسائر التي نكبوا بها عام 1878
وعكس الماشية عرفت الحبوب والمواد العدائية ارتفاعا مفرطا في أثمانها. ففي المدن الشمالية يخبرنا ماثيوس بان الأسعار ارتفعت في بضعة أسابيع بنسبة 300 في المائة
وأضافا أنه في شتاء 1878 تهاطلت الأمطار بغزارة بعد سنة طويلة من الجفاف…فبدأت الحالة في التحسن . لكن يظهر من خلال استنطاق الوثائق المغربية أن بعض الأقاليم كانت ماتزال تعاني من ويلات هدا الجفاف وغلاء الأسعار فبخصوص الريف تقول وثيقة بتاريخ (1297/25 يناير 1880 ) المال افنى والأسعار اغلات من قلة المطر في هده النواحي وناحية ايالة الريف وهي من رسالة اقلعي إلى المولى الحسن.
وفي الموسم الفلاحي 1880 – 1881 ساد الجفاف طنجة مباشرة بعد أن قام الفلاحون ببذر المزروعات إلا أن الأمطار التي سقطت في فبراير جاءت في الوقت المناسب لانقاد هده المزروعات. تشير رواية مايتوس إلى أن الأمطار همت الواجهة الاطلنتيكية وأنها كانت غزيرة خاصة في الشمال كالعرائش وتطوان وطنجة وحسب الرواية نفسها فان هده الأمطار أدت إلى هبوط أسعار القمح والشعير.
مجاعة 1890- 1891 /- 1308- 1307
واكدا أن مجاعة 1890 تميزت بالجفاف… وغزو مخيف للجراد. وصل إلى جميع المراسي بما فيها طنجة أما أضراره فقد اختلفت في الأقاليم الشمالية من منطقة لأخرى
كما تفشى داء الجدري.. وظهر أول ما ظهر في الصويرة. ثم انتقل… شمالا إلى الدار البيضاء وطنجة خلال شهر مارس والى غاية شهر دجنبر متفشيا بهذه المدينة متزامنا مع وباء ظهر بين البقر
وبتطوان احدث هدا الوباء خسائر كبيرة 50 في اليوم وذلك مابين بداية السنة ونهاية السنة كما أكد مييج
وفي مثل هده الظروف كانت الأقاليم الشمالية تعلق الآمال على جلب الحبوب من المراسي الوسطى للتخفيف من حدة الغلاء إلا أن هده المراسي كانت تعاني بدورها من الفاقة
الطواعين
وانتقالا إلى الحديث عن الطواعين بداية من (طاعون 1676- 1679/ 1087- 1090) أول طاعون عرفه المغرب في عهد السلطان المولى إسماعيل كان ظهوره بتطوان ونواحيها37 ومنها انتشر إلى باقي المغرب سنة 1089- 1678 فكان عبيد السلطان يردون الوافدين من الآفاق على مكناسة الزيتون وقد تحدث ابن ناصر الدرعي في كتابه الدرر المرصعة بإسهاب عن هدا الطاعون كما أشار الضعيف إلى أن هدا الطاعون استمر إلى سنة 1689 وبعد هدا الطاعون استراح المغرب من هدا الوباء الخطير لمدة تزيد عن نصف قرن لكنه ظل مهدد ا بعودته
– طاعون( 1742- 1744 /1155- 1157 )
حسب المراسلات التي نشرها ا لدكتور رونو والتي اعتمد عليها الدكتور محمد الأمين البزاز في أطروحته فان الاحتمال الأقوى أن هذا الطاعون دخل إلى المغرب في مارس 1742 عبر الطريق البري من الجزائر وقد حملته قافلة تجارية إلى قرية قرب فاس ومنها انتقل إلى باقي البلاد
تزامن هدا الطاعون مع ظروف الحرب الأهلية وعدم الاستقرار التي كان يعيشها المغرب بعد وفاة السلطان إسماعيل وقد زاد هدا من صعوبة الوضع بالإضافة إلى آثار المجاعة التي كانت البلاد لم تسترح من جراحاتها الشيء الذي يسر السبل لانتشار هدا الطاعون بشكل أسرع وا نتشر هدا الوباء بين أفراد الوحدات المتحاربة ومنها القوات التي عباها القائد احمد الريفي باشا تطوان لمناصرة المستضيء ضد أخيه عبد الله والتي ضمت أهل الريف وجباله والفحص والخلط وقد ذكرت مراسلة بتاريخ 16 أكتوبر 1742ان هدا الجيش كان يخسر مابين 25 و30 ضحية من الوباء يوميا . وقد شمل هدا الوباء كل أطراف المغرب واكتسح الشمال خلال فصل الربيع وكان وباءا مدمرا خاصة بالقصر الكبير ووزان ا ذ تفيدنا مراسلة بتاريخ 25يونيو 1742 بان الكثيرين كانوا يموتون… وان من بقي منهم حيا لاذ بالفرار نحو المعمورة إلى حد أنهما خلتا من السكان ويزكي الضعيف هده الرواية بقوله كثر الموت وضاع من الخلائق ما لا يحصى عددها حتى قيل مات من أهل القصر أربعة عشر ألف بالطاعون أما بطنجة فكان عدد الضحايا مابين 30 إلى 40 في اليوم وبتطوان من 10 إلى 12 ضحية وواصل الطاعون زحفه سنة 1 743 مخلفا مزيدا من القتلى بتطوان وطنجة ما بين 70 وبسبته ما بين 10الى 12 ضحية .
– طاعون( 1750 / 1164)
– امتد من فاس ومكناس إلى المدن الشمالية وزان والقصر الكبير والعراش وتطوان وطنجة وأصيلا وكان هدا الوباء فتاكا يقول القادري ومن حوادث السنة
( 1163 – 1750 )ظهور الطاعون وفشوه في المغرب وبلغ الموت في اليوم الواحد بفاس ما يزيد عن ثلاثمائة ودلك في رجب من عام الترجمة. وذكر الناصري أن ه²ا الوباء تزامن مع انحباس المطر فزاد من شدته
– طاعون ( 1214- 1212 / 1799- 1797): من خلال الدراستين التي قام بهما الدكتور رونو حول هدا الطاعون تحديدا يتأكد أن هدا الطاعون حدث مند فبراير 1799 ودلك حسب ما أشار الضعيف ويبدو أن هدا الوباء دخل إلى المغرب من الجزائر وعم سائر البلاد بسرعة بسبب الحركات التي كان يقوم بها السلطان المولى سليمان. ولم يشمل طنجة هدا الوباء إلا في شهر نونبر من نفس السنة وخلف أعدادا كبيرة من القتلى وحسب محمد افيلال كان يموت في بلدتنا تطوان كل يوم 130 يزيد ب 10 أو ينقص بنحوها50.