ما لا يتجلى، وما يمعن في التخفي، ثم أيضا، ما يوحي فقط باحتمال تبدّيه، هو في حد ذاته إشارة ضمنية إلى أحد الحقول الأكثر جاذبية بالنسبة للكتابة الشعرية والفلسفية، والأكثر تأريقا لعقل الكائن الذي يتوصل، بالكاد، إلى إدراك ما يندرج في خانة المرئي، بوصفها الإطار المركزي والعام، لتواجد الأشياء المتناسلة من رحم المادي و الملموس، والموضوعة تلقائيا رهن تفاعله. ما يعني أن كل ما يقع خارج طائلة الرؤية ، هو حتما في حكم المجهول الذي لا يسعف النظر بأي طيف محتمل من أطياف المشاهدة.أما المجهول هنا، فهو ذلك الواقع الآخر، الذي تختص «البصيرة» دون غيرها بمهمة تقصي أثره، واستجلاء خفاياه على أساس ما تمتلكه من مقومات منهجية تستأنس بها البصيرة في بلوغ مسعاها. وبالتالي، فإن الامتياز الذي يمكن أن يتمتع به الكائن، هو استشعاره بعين «البصيرة» ما يعتقد أنه متواجد هناك، في الضفة الأخرى من عالم المعلوم. أي ذلك المجال الغامض والمثالي في آن، الذي تختبر فيه التراتبيات الإبداعية، الفكرية، وكذا السياسية، والدينية، حدود اشتغال «بصيرتها»، باعتبارها إبدالا رمزيا للرؤية العينية، المقتنعة سلفا، بعجزها التام عن تجاوز معلوم الشيء إلى مجهوله. فلكل منزلة من منازل البصيرة اجتراحاتها الخاصة بها، والمنسجمة مع قوة أو ضعف آليات اشتغالها، المجسدة في الإشارات التي يقدمها كل من الحدس، و الاستشراف، بما يعنيه ذلك من توظيف تقني لمقوماتهما الإجرائية، كالقرينة، والقياس، والاستقراء، وغيرها من آليات الحجاج والبرهنة، المستقاة من تراكم مختلف أنماط التفاعل ، التي تمليها مرئيات المادي و الملموس، على العين الرائية .
وهي نفس الآليات الدلالية المعتمدة في التواجد داخل ما يصطلح عليه ب «عالم الكرامات» الذي تعج برموزه وأقطابه المصنفات، ذات المرجعيات العقدية، والعجائبية في آن . حيث ما من جنس بشري، إلا وتكتظ ذاكرته بكل أفانين المحكيات، الموحية بقدرة اختراق «البصيرة!» لحجب العالم المادي، أملا في إدراك مجهوله و»غيبه». لكن مع ذلك، يظل المرئي بمثابة الأفق العام والمشترك، المعني بالسؤال، فضلا عن كونه الأفق الذي تستشرفه العين المبدعة، باعتباره برزخا يصلها بما ينبغي رؤيته، ولو على سبيل الظن، والتخييل، والاستهام. علما بأن اقتناع الإبداع بجدوى رؤيته التخييلية، يعود لما يحدثه من تأثير بالغ في النفس، قد يفوق تأثير أي مرئي حقيقي، مشاهد بالعين المجردة .
يحضرنا هنا على سبيل المثال لا الحصر، أحد الروافد الإبداعية، المعبر عنها بمرئيات الحلم، التي كثيرا ما تحدث في الدواخل زلزالا، تنحفر آثاره المدوية في أعماق الذاكرة، متجاوزة بقوتها، سلطة باقي المرئيات الواقعية ،التي تحاصرنا بها تفاصيل اليومي والمعيش.
وفي السياق ذاته، يمكن القول، إن الفعل الإبداعي يساهم في توسيع حدود ملكية الكائن لفضاءاته الفعلية والمحتملة، كي تشمل العالم اللآمرئي. ذلك أن مرئيات التخييل الإبداعي، خاصة الشعرية منها، فضلا عن مرئيات الحلم والكرامات ،من شأنها توسيع دائرة المعيش، كي تشمل المرئي بشقه الواقعي وغير الواقعي، انسجاما مع طبيعة الحياة، التي يندرج الحلم والمتخيل الإبداعي والجمالي، ضمن أهم مكوناتها .
والملاحظ أن نسبة هائلة من المرئيات الواقعية، تفقد طراوتها وأهميتها إما بفعل ابتذالها، أو بفعل تراجعها إلى أقصى هوامش الاهتمام، لتصبح تبعا لذلك، منسية تماما، ما يؤدي إلى فقدانها لمقوماتها التي تلج بها فضاءات المرئي.
من هنا يمكن القول إن دلالة البحث عن اللآمرئي، على مستوى الفكر كما على مستوى الإبداع، لا تنحصر فقط في ما ينتسب إلى المتخيل، أو في ما يتعذر رؤيته بالعين المجردة، بل تشمل /الدلالة أيضا، ما أمسى غير مرئي، نتيجة صرف الاهتمام عنه، و نتيجة استبعاده شبه التام من دائرة الرؤية، بفعل خضوعه للاستعمال الآلي الذي يهيمن فيه داعي الضرورة اليومية، أو بفعل الاستغناء التام عن خدماته . لذلك ، فإن حيزا غير قليل من الأشياء التي تحيط بنا ، يعتبر في حكم اللآمرئي، بحكم تواجده خارج دائرة اهتمامنا، بما في ذلك الكائنات البشرية، بصرف النظر عن هويتها.
وهنا تحديدا، يكمن الدور الكبير الذي يقوم به الإبداع في استعادة هذه الأشياء، عبر تقنية «التبئير»، كي تصبح ماثلة من جديد أمام أنظارنا، محتلة بذلك مركز الرؤية، ومركز الانتباه، أسوة بجمالية الكتابة الشعرية والسردية، فضلا عن الفنون البصرية، المتميزة بقدرتها الاستثنائية على فتح عيوننا بما يكفي، لرؤية ما لم يكن من قبل مرئيا.
من هذا المنطلق، سنعتبر أن الرؤية بمعناها الشعري والفلسفي،هي في واقع الأمر معرفة، علم، فن، خلق، وإبداع. فثمة بون شاسع بين التعرف على النوع، من منظور بنيته المادية المحصورة في مقوماته الفيزيائية، من قبيل مقومات الطول، والعرض والحجم ، اللون ..الخ، وبين تجاوز هذا الحد، شعريا وفلسفيا ، إلى مستويات أكثر تعقيدا، خاصة منها المستوى الذي تصبح معه الرؤية موضوع تساؤل معرفي، ذي طبيعة فكرية أو جمالية، متجاوزة بذلك الحد المنحصر في ضبط الحيز المكاني والزماني، الذي يتموضع فيه الشيء ، إلى أفق استجلاء أبعاده الرمزية المساهمة في إثراء دلالاته ، والمحيلة على تموضع أكثر عمقا، يستدعي تجديد رؤيتنا لهويته. حيث يمكن الاستدلال بما هو متاح للعين المجردة ، على ما هو كامن بين تضاعيفها، بغاية الانتقال التدريجي من سطحه المرئي إلى عمق أغواره . وهو الانتقال الذي تتباين مساحاته، بتباين مرجعياته المعرفية، المحايثة لفعل الرؤية .
فإذا كان ثمة من يكتفي بالتعرف على الشيء من خلال التوقف عند حدود اسمه، فثمة أيضا الرؤية الشعرية ، المخترقة لقشرة الاسم بحثا عن مسمياته الأخرى التي لا يبوح بها لأحد عداها . علما بأن الأمر هنا، لا علاقة له بثنائية الظاهر والباطن، المستقلة عمليا بقوانينها النظرية .
ضمن هذا السياق، يمكن القول، إن الشاعر و الفيلسوف، و معهما الأعمى الرائي ، وحدهم المؤهلون للتوغل في صحاري الاسم وفي أرخبيلاته، مقابل «المعاين الآلي» الذي لا تلبث مويجات نظرته أن تصطدم بصخرة الاسم، كي تتحول في نهاية المطاف ، إلى محض زبد لا يحيل سوى على ظاهر، لا يشع بأي ضوء . ما يجعله يعيش في عالم مغلق ،لا يتيح له إمكانية اختراق بواباته، رغم أنها في المتناول، حال توفرها على شروط الرؤية والرؤيا.
و لعل أهم ما سنخلص إليه في هذا الإطار،هو كون الرؤية الشعرية للعناصر ،تتميز بقدرتها على ضبط نسيج العلاقات التحتية القائمة بينها، والتي تنبثق من تفاعلاتها المتشابكة والمتداخلة، تلك الإيقاعات الدلالية، التي تضع الكائن على عتبات علامات وإشارات، تبشره باحتمال دنوه من جوهر المرئي. والمراد به في السياق الذي نحن بصدده، ذلك الدنو المؤثر في انفتاح الشيء، وفي قابلية استضافته للفضول المعرفي والجمالي، اللذين تستقيم بهما متعة وخطورة العبور، الذي لا مناص للذات الرائية من الانتماء إليه. فالاسم في حالة انغلاقه الجاف والقاتم، لا يلبث أن يتحول إلى محض صخرة دائرية ملساء، لا يستقر عليها طل المعنى، ومزنه.
منازل المرئي
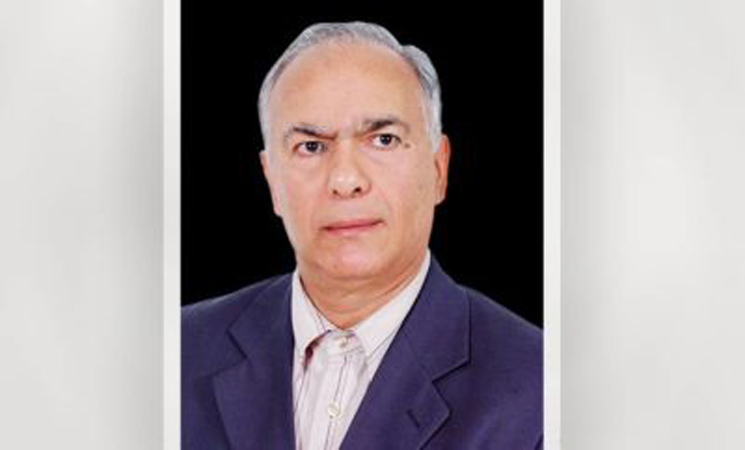
الكاتب : رشيد المومني
بتاريخ : 23/12/2022





