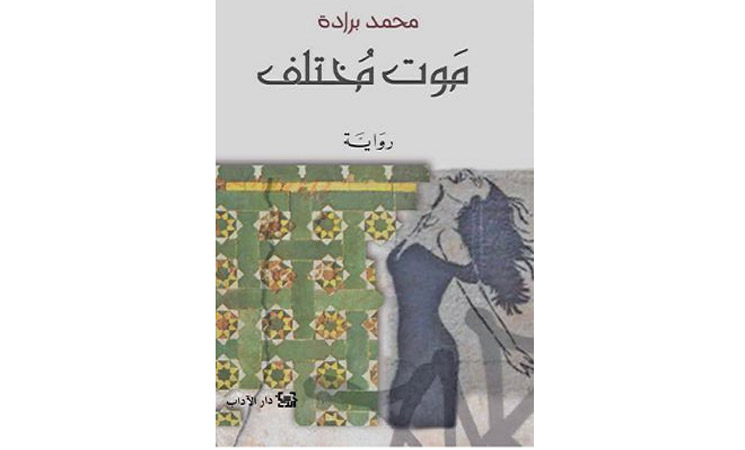السؤالُ الذي يفرض نفسَـه هنا الآن: ماذا نعني بالوريث الإشكاليِّ؟ وكيف ساهمت المحطتان في ظهور أسئلةٍ إشكاليةٍ مرتبطةٍ بعلاقة الوريثِ بِـقَـبْــليته، بما ورِثه من آبائه الطبيعيين( البيولوجيين)، أو من آبائه الرمزيين( آباءِ الإنسانيةِ في الفكر والثقافة والسياسة: فكر الأنوار، ثورة 68، اليسار..)؟
ولأن المقامَ لا يسمح بالكثير من التوسع والتفصيل، أكتفي بالملاحظات الآتية، مركزًا بالأخصِّ على محكيِّ منيرٍ، الشخصية المركزية في رواية محمد برادة الأخيرة:
• دعونا في البدايةِ نميِّــز بين الوريثِ الإشكاليِّ والوريثِ غيرِ الإشكاليِّ، لنقل: الوريثِ الطبيعيِّ؛ فالأولُ تجسده شخصيةُ منيرٍ، السارد / الفاعل الرئيس في الرواية، والثاني تمثله شخصيةٌ هي من أقرباءِ منير( ابن عمه) في مدينته الأصلية بالمغرب: دبدو، ويسمى: ” صادق “( لنلاحظ لعبةَ الأسماءِ في هذه الرواية: منير، بدر، أيشيران إلى فكر الأنوار الذي يعلن الأبُ كما الابنُ أنه الموروثُ الذي يحدد، في النهايةِ، هُــويتَــهما ونسبهما؟ وصادق، أيشير إلى هذا الإنسانِ الطبيعيِّ الذي يظلُّ صادقا في انتمائه إلى عالمه العائليِّ الأصليِّ؟). وفي الأحوال كلِّها، فالوريثُ الطبيعيُّ، مجسَّدًا في شخصية صادق، هو هذا الذي يتميز، على حد تعبير الرواية( موتٌ مختلفٌ، ص 21)، بصراحته ولغته المباشرة، هو هذا الذي ” لا يريد أن يجريَ وراء الأوهام… يفضل أن يبقى قريبا من العائلة… قُــربُــه من الأسرة ودبدو يَـمنحانه، على الأقلِّ، نوعا من الأمانِ والاستقرار..”( نفسه، ص 21 ــــ 22)؛ وباختصارٍ، فإن الوريثَ الطبيعيَّ غيرَ الإشكاليِّ، أي صادق، ” … يعيش فوق الأرض، يُعاين ما حوله من منطلقٍ صلبٍ، ويَـقيسُ الأشياءَ والعلائقَ والناسَ من منظورٍ بسيطٍ لا يتعدى ما هو قائمٌ في الظاهر”( نفسه، ص22). أما الوريثُ الإشكاليُّ فإنه هو هذا الذي عرفت حياتُــه، على الأقلِّ في محطتين أساسيتين ركزت عليهما روايةُ الأنا( الشباب / الشيخوخة)، تحولاتٍ ذاتِ طابع إشكاليٍّ، بالنظر إلى أنها كانت، في كل مرةٍ، تستدعي موتـــًا مختلفـــًا، أي إعادةَ النظر وإعادةَ تقييم العلاقة بالموروث الأصليِّ، بالعالم العائليِّ الأصليِّ، وبالموروثِ المتبنَّى في بلد الأنوار:
– يجري التعبير عن المحطة الأولى بما نسميه محكي ” الرواية العائلية “، بحيث نجد الوريثَ الإشكاليَّ، منيرًا، هو هذا الذي وُلد ونشأ، مثلُ صادق، في مدينة دبدو المغربية، لكنه صار شابا، وأصبح يطمح إلى التغيير، إلى ولادةٍ جديدةٍ بعيدًا عن عالمه العائليِّ الأصليِّ: ” منذ أربعين سنةً، كنت أعيش في دبدو مثلُـه، يقول منير، غير أني كنت محمولا على أجنحة الحلم، مشحونا برغبةٍ عارمةٍ في تغيير نمط حياتي”( نفسه، ص 22). وسمينا هذه المحطة الأولى بـــ ” الرواية العائلية “، كما فهمها فرويد( 7 ) وكما طبقتها مارت روبير( 8 )، وهي تعني أن الإنسانَ يكونُ في مراحل حياته الأولى معجبا بأبويه، لكن مع التقدم في العمر يكتسب حسّـــًا نقديا هو وليدُ الإحساسِ بالإحباط، فالعائلةُ الأصليةُ التي كانت مثاليةً قد أصبحت واقعيةً جدًا، ولا بد من البحث عن آباءٍ آخرين أفضلَ وأسمى وأنبلَ، وذلك ما يعبِّـر عنه منيرٌ بقوله: ” حين أستعيد الآن تلك الأيام، تبدو لي مُـختزَلةً في حرصي على التفوق، ورغبتي في النزوح بعيدًا عن فضاء دبدو الذي كان يزداد ضآلة وانكماشا، في عيني، كلما انتقلت من سنة إلى أخرى.”( نفسه، ص 16)؛ ويوضح في مكانٍ آخر، فيقول: ” ..” هل كان الدافعُ إلى سفري، عدا الدراسة، هو شعوري بما يشبه الاختناقَ في دبدو ووجدة؟”…” لم أكن أدرك تماما ذلك الشعورَ المبهمَ الذي كان يوحي إليَّ أن السفرَ إلى فرنسا هو ما سيفتح بابَ المستقبلِ أمامي. كنتُ في مطلع الشباب، وما درسته بلغة فولتير فتح أبوابا ومسالكَ في وعيي وثبَّــت الحلمَ لديَّ بالانتقال إلى فضاء الحرية والتجربة المفتوحة على احتمالات مفاجئة حين العيشِ على أرضِ حضارة مغايرة…” ( نفسه، ص 61). وفي الأحوال كلها، فالإشكالُ الأولُ الذي اعترض طريقَ منير هو: كيف السبيلُ إلى ولادةٍ ثانيةٍ بعيدًا عن العالم العائلي الأصلي؟ فكان السفرُ خارجَ الوطن للدراسة بالفرصة الثمينةِ التي حققت هذه الرغبةَ في ولادةٍ ثانيةٍ داخل عالم جديدٍ بعيدًا عن العالم العائلي الأصلي الذي لم يعد جذابا بالنسبة إلى الذات: ” أنا كنتُ مشدودًا إلى عالم جديد بالنسبة إليَّ، حريصــًا على النفاذ إلى أعماقه وإرواء عطشي إلى المعرفة، والإسراع بالاندماج في فضاءٍ يوقظ الحواسَّ والعقلَ ويستحثُّ الفضولَ. اخترت دراسةَ الفلسفة ثم تدريسَها بعد التخرج؛ والتحقتُ بجمعيات ثقافية، وانخرطت في نقابة يساريةٍ محمولا على جناح أحزاب اليسار المعارضة(…) كنتُ كأني قيدَ الولادة مرة ثانية ولا أريد أن أعرقلها بزيارة دبدو أو الالتفات إلى ما يجري في أنحاء الوطن. كنتُ أقول مع نفسي: لتتمَّ الولادة أولا، وبعد ذلك ألتفتُ إلى ما أستطيع أن أفعله وقد اكتملتْ شخصيتي وفقَ معرفةٍ ومبادئ أعادت خَــلْــقي واندماجي في عالم اليوم.”( نفسه، ص ص 13 ــــــ 14).
– أما المحطة الثانية، فإنها ترتبط بتقاعد منير وشيخوخته، بخيبته وانكساره، هل نقول بفشل روايته العائلية: ” منظرٌ غيرُ مريح أن نرى المبادئ الجميلة، الواعدة، تشيخُ على وجوه الثائرين السائرين نحو الانهزام”( نفسه، ص115). ويجري التعبير عن هذه المحطة بما نسميه ” محكي الانتساب العائلي “، وهو محكي يتميَّــز بعودة ما كان مكبوتا في المحطة الأولى( العلاقة بالعالم والموروث الأصليين)، أي أنه يرتبط بأزمة في الهوية والانتساب، تعود بلا شك إلى أسبابٍ، من أهمها غيابُ الدلائل repères، فنحن أمام إعادة مساءلةٍ للدلائل والقيم والمرجعياتِ والخطاباتِ والرغبات، أمام إعادة مساءلةٍ للذاتية وللغيرية( 9 ): ” خلال أَصْباحٍ متواليةٍ، بعد التقاعد، …، تطفو في ذهني مشاريعُ وأسئلةٌ طالما تفاديتها عندما كانت حَوْمةُ العمل والنشاط التطوعيِّ تستحوذ عليَّ. في مُــقدَّم ما يطفو علاقتي المكبوتة بــــ” دبدو ” والوطن، وتجاهلي لحصيلة المسار الذي سرتُ فيه محمولا على أجنحة الحُــلم والافتتان ومنطقِ الحدس والقلب.”( نفسه، ص 20). ويتميز محكيُّ الانتساب العائلي الذي يعبِّــر عن هذه المحطة بالعودة إلى التعرف إلى موروث الآباء والأجداد الأصليين من جديد، إلى البحث في تاريخ الوطن ولغته وذاكرته وثقافته الأصلية: ” .. تنبَّــه إلى سهوه الطويل عن ثقافته الأولى العربيةِ التي وضعها على الرفِّ منذ تعرَّف على لغة فولتير وآفاقِها المشرعة..عندئذ بدأ يقرأ بالعربية وزار عدةَ أقطار في المشرق.. وغاص في إشكاليةٍ لها جذورٌ في تاريخه الشخصي وتاريخ التربة التي استقبَــل النورَ في أرجائها..”( نفسه، ص153). والأكثرُ من ذلك، فالذاتُ في محكيِّ انتسابِها العائليِّ تعود إلى مساءلة ما يعنيه عالمُها الأصليُّ بالنسبة إليها، تحفر عميقا في دواخلها من أجل استجلاء معانيَ الوطن ومسقط الرأس: ” كل ليلة، …، يَجفوني النومُ، وأجدني أمام نفس السؤال الذي كان وراء زيارتي للمغرب: ما موقعُ دبدو في نفسي لأنني أحسها متغلغلةً ما تزال في السويداء والوجدان؟ أعود إليها وقد انجلتْ أوهامُ الشباب، وتعبتُ من الجري وراء أحلام الثورة وتغيير الجِلد، وأريد أن أعرف حقيقةَ شعوري داخل عالم ملتبسِ الحدود، مُـختلَّ الإيقاع، كلُّ يوم هو في شأن؟”( نفسه، ص 23). ولكن الذاتَ في هذه المحطةِ تُـمسي موزعةً بين عالمين مختلفين، وتشعر كأنها مرة أخرى إزاء ولادةٍ جديدة: ” أحسُّ في هذه اللحظة، …، أحسُّــني موزَّعـــًا بين ألق الغرب ومهارته التكنولوجية، وبين ما ترمز إليه دبدو من بساطةٍ وعتاقةٍ وبِــلًى وبُــعْــدٍ عن دينامية المعرفة والخيال. أين تكون ذاتي مُــرتاحةً في جِــلدها؟( نفسه، ص 29). وغيرُ بعيد عن ذلك: ” أحسُّ كأني عدتُ بعد ستةِ عقود من عمري إلى نقطة الصفر، نقطة البدء، هل هناك من بدءٍ؟”( نفسه، ص 30). وباختصار شديدٍ، فمحكيُّ الانتساب العائليِّ الذي يُـعبِّـر عن هذه المحطة، هو علامةٌ على عصرٍ موسومٍ بالقلق والشك، بالخيبة والفشل، علامةٌ على ذاكرةٍ مليئةٍ بالثقوب والبياضات، علامةٌ على بحثٍ أركيولوجيٍّ في أشياء آلت إلى الضياع والاختفاء؛ فهو محكيٌّ تتجلى قيمتُــه بالأساسِ في أنه يُـحيي مسألةً جوهريةً وأصليةً في الأدب: أن تقولَ الذاتُ، في أقصى حدودِ الأسئلةِ الميتافيزيقية، شيئًا عن أصولها المجهولة، وأن تقود التخييلَ إلى هناك حيث لا يمكن لأيِّ بحثٍ أن يُـقدِّم معرفةً: مَـن أنا؟ من أين أتيتُ؟ وماذا ورِثتُ؟ وهل يمكن للذات، الفرديةِ، أن توجدَ، وأن تستمرَّ في الوجود، من دون أن تتموضع داخل حكايةٍ فرديةٍ وجماعية؟ كيف نمارس الحفرَ في بقايا إرثٍ إشكاليٍّ ضاع وانتثر؟ كيف نعمل على إصلاح مصابيحَ ذاكرةٍ أقبرتْ العديدَ من الذكريات؟
ومنيرٌ الذي غادر بلدتَــه الأصليةَ، دبدو، أواسطَ الستينيات، ليعودَ إليها بعد أكثرَ من أربعين سنة، ليس بالوحيد الذي يمثل شخصيةَ الوريثِ الإشكاليِّ، الممزق بين الغرب والشرق، وإن كان هو الأكثرُ حضورًا، فالأصح أنه يمثل جيلا سابقا، ويتحول هو نفسُه إلى جيل الآباء، بعد أن أنجب ابنا من امرأة فرنسية، أسماه: بدرًا، نشأ وشبَّ على مبادئ الأنوار وثورة 68، وظل يظن أنه من أبناء فرنسا، وأنه ينتمي أصلا إلى بلد الأنوار؛ لكن التحولات التي عرفها بلدُ الأنوار والعالمُ من حوله( انتشار التطرف أو العنف أو الإرهاب المنسوب إعلاميا إلى الإسلام والمسلمين، وازدياد العنصرية والكراهية عند الفرنسيين تجاه كل من ليس من أرومة فرنسية أصلية) جعلته يكتشف أنه ينتمي إلى موروثَــيْــن اثنين( الغرب / الشرق)، هما ربما متعارضان، وأن في هُــويته شيئا ما يدعو إلى الخوف والقلق والشك والمساءلة: ” الابن( مخاطبا أباه): ” ألستَ أنت من علمني التشبثَ بمبادئ عصر الأنوار واتخاذَها أفقا للمستقبل؟ ( …) لا يتعلق الأمرُ بخطأ أو صواب. بل بوضعي أنا الآن بعد الأحداث المروِّعة المتتالية التي زعزعت فرنسا وانعكست على سلوك الناس وعلاقتِهم بالقيم وبالذين ليسوا من ” أرومة ” فرنسية ” أصيلة “..أشعر أن خطرًا يتهددني عند المنعطف. هل تلومني لأنني أكشف خوفي وحيرتي؟.. الآن وأنا في عز الشباب، يخيل إليَّ أن العالمَ أصبح يواجهني بشراسةٍ غيرِ مسبوقة” ( نفسه، ص 197 ـــ 198). وهكذا، يجد بدرٌ نفسَه أمام سؤال النسب والانتساب، داخل محيطٍ مضطربٍ عنيفٍ يشككه في هُــويته: ” وبدأ بدرٌ يحسّ أن سلوكَ زملائه في العمل اتجه إلى نوع من الحذر والتحفظ على رُغم أنهم يعرفون أن أمَّــه فرنسيةٌ وأنه لا يحرص على إعلان انتمائه إلى أي دين.”( نفسه، ص157). وسؤالُ الانتساب سيدفعه إلى زيارة المغرب، وإلى إعادة تركيب موروثه المزدوج وإعادةِ تقييمه.
• موتٌ مختلفٌ يفهمه هذا الوريثُ الإشكاليُّ( منير بالأساس) بأنه تحولٌ في الهُـوية، أو الأصحُّ أنه يعني هويةً في تحولٍ متواصل، فالهُـويةُ لا ينبغي لها أن تكون جامدة، منغلقة على ذاتها: ” .. نيتشه يهمس بأن ذلك يقضي أن نترك للكينونة أن تكون؛ …؛ والجوهرُ ليس ثابتا، مكتملا، وليس معطى دفعة واحدة، بل هو مشدودٌ إلى الصيرورة والتحول..”( نفسه، ص 236). وذلك لأن الهُــويةَ لا يمكن أن تتحول، مع الزمن، إلا إلى طبقاتٍ من الأنوات: ” … تراكمُ الأنوات داخلي: فأنا هو منيرٌ الطفلُ ثم المراهقُ الحالمُ بأوربا، وأيضا أنا هو منيرٌ الذي أمضى أكثرَ من أربعين سنة في مجتمع له تاريخٌ مختلف، وامتلأ ذهنُه بأفكارِ الأزمنة الحديثة، وعاين التحولات المتسارعة واهتزازَ القيم على أرض الواقع، وذاق مرارةَ الخيبة وهي تستوطن، على غفلةٍ، مناطقَ من نفسه..”( ص ص 24 ــــ 25). ومعنى ذلك أن المحكيَّ الهُوَوِيَّ هنا يقدم تصورًا عن الإنسان باعتباره “طبقاتٍ من الهُـويات المتتابعة”( 10 )، فالهُــويةُ تتميز بالتعدد والتراكبِ، وتتأسس في شكل طبقاتٍ من الحيوات السابقة، بما يجعلنا أمام هُــويةٍ فرديةٍ، منفتحةٍ ومتحولةٍ، متعددةٍ ومركَّــبَــةٍ: ” كان هذا طموحي أيضا: أن أنعتقَ من سياج هُــويةٍ موروثةٍ منغلقةٍ، لأرتادَ رحابَ هُــويةٍ مشرعةٍ على قاراتِ الدنيا..”( نفسه، ص 201).
• ومع ذلك، وعلى الرُّغم من هذا الإيمان بأن الهُــويةَ هي دوما في تحولٍ وصيرورة، فإن الواقعَ أن هناك شيئا محددًا ثابتا، ظلت الذاتُ تدافع عنه، وتبرر أسبابَ الانتساب إليه، من أجل أن تجدَ مَـخرجا للأزمة التي كان موروثُـها الإشكاليُّ من أسبابِها الأساس، ومن هنا فضلنا صيغةَ الصفةِ المشبهة( الوريث)، التي تدلُّ على الثبوت، فضلناها على صيغة اسم الفاعل( الوارث): ففي شبابه، اختار منيرٌ أن ينتسبَ إلى بلد الأنوار، وأن يستقرَّ به، وأن ينسى أو يتناسى بلدَه الأصليَّ؛ وبعد تقاعده وتقدم السن به، سيقرر في النهاية أن يختبرَ فكرَ الأنوار في وطنه الأصليِّ من دون أن يتخلى تماما عن بلد الأنوار.. ما يعني أن موروثا معينا( فكر الأنوار) يظل الشيءَ الثابتَ الذي من خلاله تحدد الذاتُ هُــويتَــها ونسبَها، والاسمُ الشخصيُّ للوريثِ الإشكاليِّ، في صورتيه: منير / بدر، يدلُّ على هذا الشيءِ الثابتِ في الهُــويةِ الشخصية: الانتسابُ إلى فكر الأنوار: ” هناك إذن جوهرٌ يحددني، وعليَّ أن أستجليه وأغذُّ السيرَ لأصلَ إليه وأعانقَـه لتكتملَ الذاتُ وتصبحَ على بينةٍ من رغباتها وأهدافها في الحياة… اهتديتُ بما سطره نيتشه في كتاباته.. وجدتُ عنده ذلك الحبَّ المطلقَ للحياة التي يعتبرها مَعينا للإحساس ورفضِ وطأةِ الموروثاتِ المحنطة. أتساءل مع نفسي: ألا يعود شغفي بعصر الأنوار إلى ذلك السياق الحرياتيِّ الذي واكب ولادتَـه وألهمَ فلاسفتَه وكُــتَّــابَه إلى رصد الحياة وإبراز صيرورة القيم..؟ “( نفسه، ص 236).
3ــ خـصــائــص ” روايــة الأنا “:
وختامـــًا، يمكن أن نختزلَ أهمَّ خصائصِ رواية الأنا عند محمد برادة في ما يأتي:
• روايةُ الأنا تعني أن نكتبَ عن تلك المحطاتِ المأزومةِ من حياتنا، تلك المحطاتِ التي تستدعي موتا مختلفا، ولادةً ثانية: روايةُ الأنا هي أن نعرفَ، على حدِّ تعبير الرواية، ” كيف نكتبُ ونحن نستحضرُ الموتَ أفقــــًا لنا ونتحدثُ عن حبوطٍ وفشلٍ ومأساة؟..”.
• روايةُ الأنا تعني أن نكتبَ عن وعيٍ بأن العصرَ الراهنَ لم يعد متأكدًا جدًا من هذا التقدم ” نحو الأمام “، فالأسسُ التي يستند إليها خطابُ التقدم قد أصابها الإفلاسُ والانهيار؛ ومن هنا صار من الأنسبِ أن يُـسمَّى بعصر القلق والشك؛ ومن هنا أيضا صارت روايةُ الأنا مكرَّسةً للأب وللرمزية الأبوية: فالأبُ يُــمـثِّــلُ السلطةَ، والمعرفةَ التاريخيةَ والاجتماعية، والأبُ هو الذي يُــمـثِّــلُ الخطابَ، ويبدو كأن الخطابَ لم يعد قائما ولا مسموعا بسبب فشلِ القيم والمُـثُــلِ والاعتقادات، أو ربما بسبب وجود ما يسميه دومينيك فيار بـــتلك ” القطعةِ المفقودة “( 11 ) في خطابِ الأب: فالأبُ منيرٌ لم يكن يُحدِّث ابنَــه وزوجتَــه عن أصوله، ولم يبادر إلى دعوتهما لزيارة بلده الأصليِّ إلى أن قام كلُّ واحدٍ منهما بذلك بمبادرةٍ شخصيةٍ..؛ هناك شيءٌ مغيَّبٌ ومفقودٌ؛ هناك صمتٌ( 12 ) في خطاب الأبِ يؤدي إلى انقطاع الخيطِ الرابطِ بين الأبناء والآباء، ويستدعي ذلك سوءَ الفهم والقلق والشك..؛ في خطابِ الأب، يبدو كأن هناك، في كل مرةٍ، تجربةً كبيرةً في الانفصالِ وفكِّ الارتباط( الانفصال عن دبدو في مرحلة الشباب بعد اختيار باريس؛ الانفصال عن دبدو في مرحلة الشيخوخة بعد اختيار الدار البيضاء / باريس).
• ومع ذلك، فأن تكون روايةُ الأنا مكرَّسةً للوجوه العائلية، والأبوية بالأساس، وأن تعود إلى طرح مسألةِ الهُــويةِ والأصلِ والانتساب، فإن ذلك لا يعني تراجعا أو ارتدادًا عن الاختيارات السابقة: ” أنا الآن، أكثر من أي وقت مضى، مستعدٌّ لمحاربة الدعوة إلى الارتداد إلى ما هو مظلم في الماضي. وإذا كنت أفكر باستمرارٍ في مسقط رأسي بعد تقاعدي وأتطلع إلى العودة، فلأنني أبحث عن بصيص أمل.. أقاوم اليأسَ كي لا أغدو حيا / ميتا في ظل هذا الكابوس المقيم..”( نفسه، ص204 ـــ 205). وبهذا المعنى، فإذا كانت الوجوهُ العائليةُ الأبويةُ تستحوذ على روايةِ الأنا، فذلك لأن الكتابةَ في العمق هي نوعٌ من التغريب( 13 ) Défamiliarisation، أي أنها هي هذا العبورُ النقديُّ لكل الخطاباتِ والمعتقداتِ والموروثاتِ الفرديةِ والجماعيةِ المشتركة، هي هذا الإنصاتُ إلى ذلك الشيءِ غيرِ المسموع، إلى تلك القطعةِ المفقودةِ أو المغَــيَّــبةِ، إلى تلك الغرابةِ المقلقةِ التي تحدَّثَ عنها فرويد: أن نكتبَ يعني أن ننفصلَ عن العائليِّ والمألوفِ من أجل أن نُــولَــدَ من جديدٍ، من أجل أن ننطلقَ من جديدٍ، ذلك لأن الكتابةَ، في أقصى عنفها التحليليِّ، تريد أن تواجهَ الموتَ وأن تكونَ قُــوةً للفرح والحياة.
الــهــوامــش:
7 ــ في البداية، قدَّم فرويد هذا النص القصير الشهير “الرواية العائلية عند العصابيين” إلى أوتو رانك من أجل إدراجه في كتابه: أسطورة ميلاد البطل، وهو كتاب صدر سنة 1909، وظهر في طبعة منقحة سنة 1913، ثم في طبعة موسعة بتقديم من إليوت كلاين سنة 1922، ونشر بعد ذلك في كتاب فرويد:
S.Freud, « Le roman familial des névrosés (1909) », in : Névrose, psychose et perversion.
Paris, Presses Universitaires de France ,1973, pp 157-160.
8 – Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Grasset, 1972,
rééd. Gallimard, coll. Tel, 1977.
بالنسبة إلى الترجمة العربية: مارت روبير: رواية الأصول وأصول الرواية، ترجمة: وجيه أسعد، منشورات اتحاد كتاب
العرب، سوريا، ط1 ، 1987.
9 – D. Viart, « L’archéologie de soi dans la littérature française », Op cit, p116 – 120.
10 – Laurent demanze, , Encres orphelins, Pierre Bergougnioux, Gérard Macé, Pierre
Michon ; Paris, Editions José Corti, 2008, p 59, p59.
11 – Dominique Viart : « Le silence des pères au principe du récit de filiation », Etudes
françaises, Vol. 45, N3, 2009, p103.
12 – Ibid., p103.
13 – Mathilde Barraband : « Héritage et exemplarité dans : Demain je meurs : L’œuvre de
dé- familiarisation de Christian Prigent », Etudes françaises, Vol.45, N3, 2009, p58.