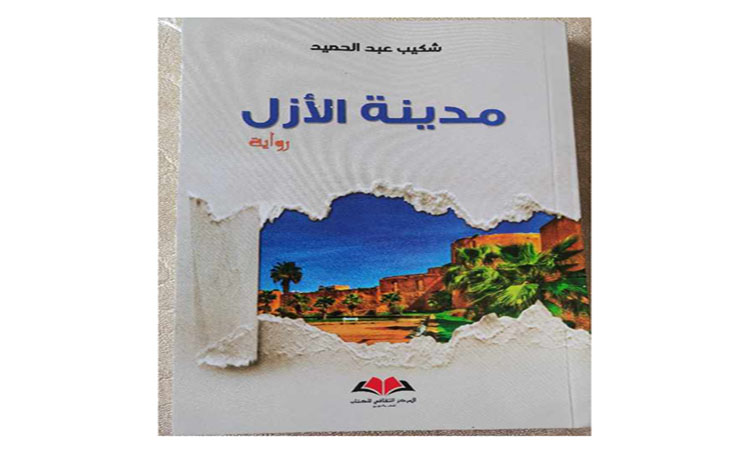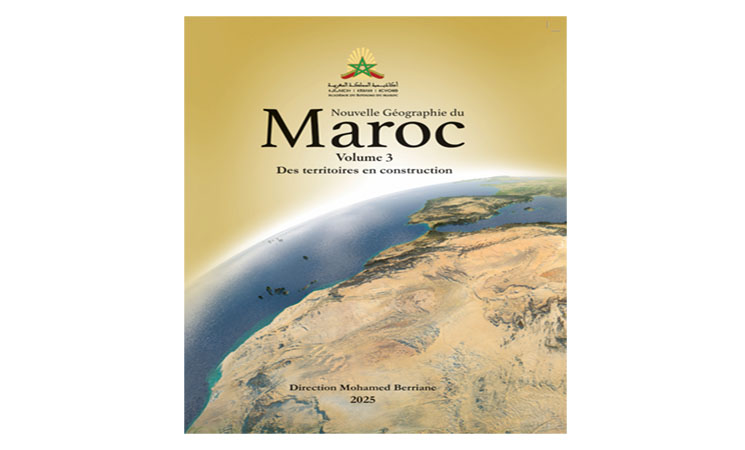إلى أصدقائي أساتذة ومناضلين، وتلميذات وتلاميذ الذين حقق جلهم
ما يدعوني إلى الافتخار بهن وبهم. وإلى ساكنة البلدة طُرّاً
لعلك استرحت الآن نسبيا، وانشرحت، وأنت ترى ما رُمْتَه وما رغبت فيه، يتحقق، وناضلت من أجله يتَكْونَنُ، ويصبح محسوسا ملموسا لبلدة أريد لها الإهمال والتهميش، والحرمان من كل ما هو تنموي بما يعود على الساكنة بالخير العميم، والعيش الكريم.
فقد آلمك، عندما حططت الرحال بأهرمومو في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، أن تجد البلدة صلعاء جرداءَ، تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات ذات الأولوية، والبنيات التحتية من طرق معبدة، ومحَالٍّ تجارية متراصة، وفنادق ومطاعم ومقاهٍ لائقة.
كانت بلدةً تحتضن حزنها وصمتها، وبردها، وتندب حظها وسوء طالعها. الحياة هناك، والموت هنا. يا للمسكينة اا، يا لقاطنيها أطفالا ونساء ورجالا؛ ماذا فعلوا حتى يساموا العذاب والجحود والنكران؟. أليس لديهم أبناء أشاوس في ساحة الوغى، يدافعون عن سيادة وحدود الوطن، بكل تفان وأريحية، ويحرسون صحراءه حتى لا يدوسها المعتدي الباغي، ويسحبها إلى ثراه؟. أبناء بعدد الحصى، جنود مجندون في خدمة الثوابت الوطنية، وخدمة الوطن. فكيف لا يرفع عن أسرهم وعوائلهم وأبنائهم الحصار الجائر؟
هكذا، كنت أحدث نفسي وأنا أمسح بعيني الخريطة الحية، وأُبَحْلِق كالساهم في الفراغ.
صَبَبْتُ لعناتي وشتائمي، وحنقي على من كان سببا في ما جرى، وقفلت راجعا إلى فاس لأعود إلى أهرمومو بعد أيام، عودة سيكتب لها أن تدوم عشرين سنة.
فهل تذكر ـ أيها الجوّال الأفَّاقُ المُرَحَّلُ من رقعة إلى رقعة ـ بداياتِك الأولى، انشدَاهَك واندهاشَك، غربتَك، بحثَك عن منزل أو شقة أو نَزْل ـ في الأقل ـ تقيم فيه ليلتين أو ثلاثاً، وأنت تفتش عن مكان يأويك طيلة إقامتك وعملك أستاذا بها، بلا فائدة؟. وتفتش، عبثا، عن مطعم يسد جوعتك، ومقهى جميلا تَقْتَهي فيه وأنت سادر سارح تنظر شاردا إلى لاشيء. تتعقب مِزَقاً من أشعة الشمس مسفوحة مبعثرة تراوغ أرجل الطاولات النائمة، وحوافر الكراسي المتثائبة، ِمزَقاً صفراء ممتقعة ترتسم على سحنات واجمة، وتنْشَبِح على كؤوس ساهمة، وبقايا طوار متصدع، وإفريز مبقور، بينما الظلال الباردة تنسكب في إثرها متموجات، مطويات كأثواب البزّاز، بين الممرات والحوائط المتقابلة، ثم تستدير، فجأة، مثل حيات متأهبة، او دوائر ماء متقافزة.
هل تذكر ذلك، وكنتَ وحيدا إذ أن زوجتك لم تلتحق إلا بعد شهرين. لقد عُينَتْ بفاس، وتركتَها تُدَرِّس بثانوية ابن خلدون، ريثما ترتب أشياءك، وتَحِنُّ عليكما إدارة تربوية بالرباط مكلفة بقضايا وملفات التعيين والتنقيل، والنعاس يصرعها، وغلظة موظفيها يُنَفِّرُ منها، والمساطر التي تمطرق بها رأسك أعقدُ وأبلد مما تظنون. فكأنك تزور بناية النَّاسا الفضائية حيث مصيرُ الكون والبشرية مسطور مخبوء في أدراجها وأقراصها الإلكترونية، وبنوكها الرقمية.
وها أنتما معاً تشرعان في مباشرة الاتصال والتواصل بالتلاميذ، مدركين أي واجب ينتظركما، وأي عمل مضاعف، وصبر أيوبي يلزمكما لتشركا جمعا بريئا من التلميذات والتلاميذ لا امتداد تكوينيا وثقافيا وتسلويا لهم، وهم خارج الفصول الدراسية.
ويشهد الله أنا بذلنا ما في وسعنا، وما احتزناه من معارف، وكسبناه من تجارب وخبرات في التدريس والتكوين والتثقيف، لِنولمَ به فراخا زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر ( أقصد: لا ماء الأدب والنشاط الثقافي، ولا ثمر البيداغوجيا والديدكتيك ).
ويشهد أهل البلدة ـ نساء ورجالا ـ أنّا لم نأْلُ جهدا من أجل إسعاد أبنائهم وبناتهم، وفتح باب الحوار على مصراعيه دوما معهم، ليكونوا على بيّنة من سيرة فلذات أكبادهم السلوكية والتربوية والتثقيفية.
وعلى مستوى آخر، بات من اللَّازم اللاَّزب، من الآن فصاعدا، أن أقاوم مقاومتين: دفع البرد القارس ما أمكن، وصد الصقيع المخترق، بكل ما أوتيت من لباس وأكل وشراب، والتصدي لأولئك الذين وضعوا العربة أمام الحصان، والعصي في العجلات حتى لا تنعم البلدة، ولو يسيرا بشآبيب التنمية.
لذلك سَرّها ـ سَرَّ البلدة َقاطبة ـ ما علمتْ من خلقي، وتضحيتي، وصدقيتي، وانخراطي السعيد في خدمتها تربويا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وليس غرورا ولا عُنجهية، ولا جاهلية، بل عينٌ وقلبٌ يشهد بهما المُقَرَّبون والصلحاءُ الخُلَّصُ المتقون، ويشهد بهما أبناؤنا وبناتنا الذين أصبحوا ما أصبحوا، والذين أفاخر بهم المدن المغربية ذات الملاعق الذهبية، والسنما، ودور الثقافة والشباب. سَرَّها ذلك، فاحتفت بي، وأوسعت لي ولزوجتي، ولوالديَّ، مكانا اثيرا وثيرا بين أبنائها وقاطنيها. كما احتفت بغيري من أساتذة وموظفين حلوا ونزلوا بها. ولم أكن بطلا، ولا سوبرْمانا، ولا فريد عصره، ووحيد قرنه، كما أسلفت، ولكنها خبرتني طيلة مكوثي بها حيث شمرت عن ساعدي، ورأيت أن من أوجب واجباتي، مع ثلة من أصدقائي الفضلاء المناضلين، رفعَ الضيم عنها، وزرع الفرح في سُوحِها وربوعها، وديارها، وفي كل شبر من ترابها، وإعادة الاعتبار إليها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن ثَمَّ، بادلتني حبا بحب، وثقة بثقة، وتقديرا بتقدير، ووضعتْ زوادة مشاكلها القديمة والجديدة العرمرم في جرابي ـ جرابنا، وحملناه غير مُتأففين ولا مُتَبرّمين ولا ضَجِرين. نُؤْنا بها، وتحتها بفعل ثقلها، ورحنا نحطها رُزَماً.. رُزَماً على المكاتب، والمناضد، والمنابر، والموائد، واللقاءات حيثما حللنا، لعلها تجد آذانا صاغية، وحلولا قلَّت، أو كثرت؛ المهم أن يُفَكَّ أَسْرُ ما أزْمَنَ حتى تَعَفَّنَ. وقد نجحنا ـ في ظني ـ نجاحا معتبرا، لم يكن يلبي كل انتظاراتنا، وانتظارات السكان، ولكنه لبَّى بعضها، الشائكَ منها والقابلَ للحل والتصريف.
سَرَّها ما علمتْ من تفانينا في خدمتها، وكفاحنا ، وتكثيف اتصالاتنا ـ مفيدين من موقعنا كأعضاء مجلس بلدي، كممثلي الساكنة. ومن موقعنا كنقابيين وسياسيين، لنرفع النير عنها، والقيد الظالم الذي شلَّها.
سَرَّها ذلك وغيرَه، فتَغَنْدَرتْ، وتَجَمَّلتْ شجراً باسقا، وشجيرات مُشذبة، وأرزا أخضر زاهياً، وحوانيتَ ومتاجر مرصوفة، وسوقا دائريا، ومربعا يحتل وسطها مثلما قرط لُجَيْني لامع في أذنها، يضفي رونقا على محياها، وملامحها. وسوقا أسبوعيا على مبعدة كيلو واحد، والذي أصبح خاليا من الحيات والصخور الناتئة الجارحة، والأتربة والأوحال، ونبات الدّوم، والسّدر المنفوش المفروش هنا وهناك كالقروح والبثور على جسد مريض.
تحولتْ بفعل ملحاحيتنا وصبرنا، وعدم تراخينا، إلى بلدة أطلسية بهية تَضِجُّ جديدا، وتَعْرِضُ قشيبا من مؤسسات تربوية، وإدارية، ودار شباب، وقاعة رياضية. كما ازدانت بعقد ألماسي ولا أغلى: بمركب ثقافي ( كان لي الفضل بعد الله، ودعم الناخبين الكبار بالمجلس الجهوي لفاس / بولمان، في إحداثه. وسأعود إلى ذلك بعد حين.
ولعل انغماسي الكلي في تدريس تلميذاتي وتلاميذي، وارتمائي المبدئي الواعي في معمعة الحراك التربوي والاجتماعي والنقابي، والسياسي ـ فيما بعد ـ كانا وراء انقطاعي، مرحليا، عن كتابة الشعر إلا فيما ندر. ووراء تأسيس أول مكتب نقابي تابع للنقابة الوطنية للتعليم، وأول مكتب سياسي يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان في الأوج. ووراء استبسالي في تأطير التلاميذ مسرحيا وشعريا في المناسبات الوطنية. ووراء زُهْدي في النشر، والإحجام عن الهرولة لاحتلال الصفوف الأولى، والإفادة من « سفريات « ثقافية، علما أنني عضو في اتحاد كتاب المغرب منذ 1976. كما كانا وراء إقامتي الطويلة المديدة بأهرمومو التي استغرقتْ عقدين كاملين من الزمان، أنا الذي خطط لمبارحتها بعد عامين على الأكثر، فإذا بي / بنا نبقى، ونصبح آباء لأبناء ثلاثة بَرَرة، وهم: إيهاب، ولميس، ومازن.
ودليلي على الابتعاد عن « التمدن «، واللهاث، كوني لم أنشر مجموعتي الشعرية ( جراح دلمون ) بدار البوكيلي بالقنيطرة، إلا في العام 1997، أيْ بعد مرور عشرين سنة على أول نص شعري كتبته.
خُضْتُ الانتخابات الجماعية، ففزت فيها بمقعد. كما خضت الانتخابات الجهوية في العام 1997 بنجاح باسم الاتحاد الاشتراكي حيث رَأَسْتُ في المجلس، لجنة الثقافة والتعليم والتكوين المهني. ست سنوات بالجماعة والمجلس علَّمْنَني الكثير، صاحبتُ فيها مناضلين من مختلف المشارب السياسية والحزبية والنقابية، وصاحبتُ فيها نواب الأمة، ونواب التعليم، ورؤساء الجمعيات الثقافية والتربوية والاجتماعية والبيئية. بل سعدت أيما سعادة بإحداث مركب ثقافي بالبلدة، ما يزال يعمل كنحلة إلى اليوم. وهو مكسب حرقت من أجله أعصابي، ووظفت من أجل حيازته، ذكائي، وطاقتي، وعلاقاتي. ومن باب الاعتراف، ورد الخير إلى أهله، فإن الأستاذ محند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، بوصفه رئيس المجلس الجهوي آنذاك، دعمني، طبعا مع مناضلي حزبي، عند التصويت على مشروع إقامة مركب ثقافي برباط الخير. كما دعم المشروع ـ بطبيعة الحال ـ وزير الثقافة أيامئذ، الصديق الشاعر محمد الأشعري الذي كنت على اتصال به طيلة معركتي الثقافية والاجتماعية النبيلة بهدف إحلال الثقافة الجادة، والتسلية الهادفة، المكانةَ المطلوبة، والمكان المرغوب بين السكان الشُّمِّ، على أرض أهرمومو.
فنشاطي الاجتماعي والثقافي والتربوي الدؤوب، دفع أصدقائي الأساتذة بالطور الابتدائي والثانوي، إلى تشريفي بتسيير فرع النقابة الوطنية للتعليم. ثم انتخبت عضوا باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل غِبَّ المؤتمر الوطني المنعقد بالمحمدية أيام 2 ـ 3 ـ 4 ـ و5 يوليوز 1995.
وليس من شك في أن الفرع النقابي أقلق راحة السادة النواب الذين تعاقبوا على إدارة التعليم بإقليم صفرو. وأبلى البلاء الحسن في خدمة نساء ورجال التعليم والمديرين أيضا. ولهم أن يشهدوا بذلك إن كان هذا كلاما طائرا، أو كلاما راسخا.
ثم رأَسْتُ فرع حزب الاتحاد الاشتراكي قَبْلاً. ومن بوابته، خُضْتُ كما أسلفت معركة الانتخابات محليا وجهويا. ولولا ثقة السكان فيَّ، لما فزت بعضويتي فيهما. فلقد كنت الوحيدَ الذي لا ينتمي إلى قبيلة إغزرانْ، وسط أبناء البلدة الثلاثةَ عشرَ.
موقعي النضالي هذا ـ نقابيا وحزبيا، وترابيا، سهل عليَّ، وعلى زملائي وأصدقائي، الاتصال بعامل الإقليم، وباشا بلدية المَنْزلْ، وقائد رباط الخير، وبالنواب البرلمانيين. ولم يكن الاتصال ليَحيدَ عن طلبات وانتظارات السكان، ووضع المسؤولين الإقليميين والوطنيين في صورة التأخر الذي تعانيه رباط الخير على كافة الصُّعُد: تجهيزا، وبنىً تحتية، ومدارس، ومجموعات، وفرعيات.
كما أنني لم أبخل بقلمي عن طرح جوانب من تلك المعاناة، وعرض المشاكل التي تتخبط فيها البلدة، على صفحات جريدة الاتحاد، توضيحا وتكملة لمواقفي الكلامية والمطلبية مع المسؤولين.
هل أفلحت؟، هل أفلحنا؟ ليس تماما. فما زالت أهرمومو: رباط الخير في حاجة ماسة إلى تنمية شاملة يعم خيرها السكان، ويطم نعيمها الشباب والنساء والأطفال.
كان يوم مغادرتي لرباط الخير، يوما لا كالأيام، يوما تَوَشَّح حزنا وأسىً، غلب الصمت فيه الكلام، وانغرس نصل الألم في الحشا. ودَّعَني فيه الأصدقاء والجيران، بل حتى رجال وأعوان السلطة، بالعناق والدموع. لقد شق عليهم أن اغادرهم إلى غير رجعة، وقد صرت واحدا منهم، وزوجتي وابنائي أختا وإخوانا لهم. وشَقَّ علينا ـ بالمِثْل ـ أن نهجر أرضا أعطتنا كل شيء، رغم قلة الزاد، وضيق اليد. أعطتنا المحبة، والحماية، والحضن الدافيء، والكرم اللامحدود. أعطتنا الثلج والأولاد والأصدقاء.
فكيف أنسى عقدين من الزمان فيها؟، وكيف أنسى تلاميذي وتلميذاتي وساكنيها؟
أما الجامعة فقد عدت إليها طالبا حُرّا، أهييء دروسي من بعيد بعد أن خسرت أكثر من عشر سنوات. ولم أكن نادما على الخسران المبين هذا. عدت إليه لابسا جبة الأدب العربي الذي تَحَصَّلْتُ فيه على الإجازة حول الشاعر الكبير سعدي يوسف: ( القيم الفكرية والجمالية في تجربة سعدي يوسف الشعرية ). وتحصلت على دبلوم الدراسات العليا الذي دار على الشعر المغربي السبعيني المعاصر. وعلى الدكتوراه ( شعر عز الدين المناصرة: بنياته، إبدالاته، وبعده الرعوي ) عز الدين الصديق الفلسطيني الكبير الذي أخذته كورونا على حين غرة قبل أشهر، رحمه الله.
ولم تكن عودتي وليدة رغبتي، وإنما كانت تلبية لرغبة أصدقائي الخُلَّص، وأساتذتي الذي لم ييأسوا من ثَنْيي عن قراري، وإعادتي إلى صوابي. وهم زوجتي، والمرحوم الدكتور محمد الدناي، والدكتور حسن الغرفي، والدكتور العربي الحمداوي، والدكتور عبد الرحمان طنكول، والشاعر عبد السلام المساوي، والشاعر صلاح بوسريف، وغيرهم كثير. فتحية إكبار لهم.
انتهى