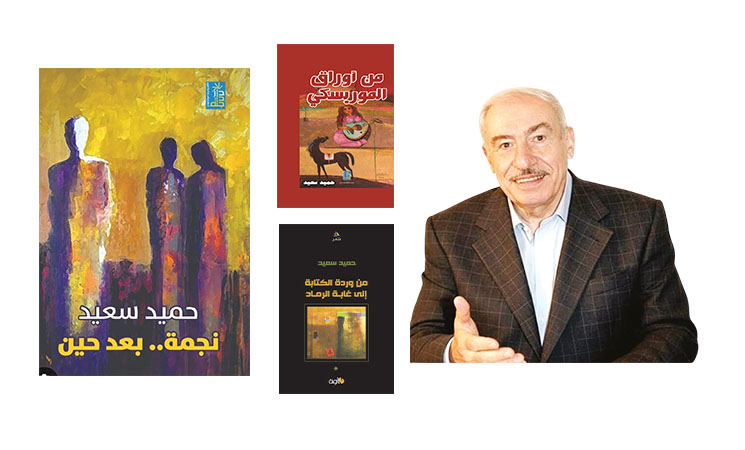في الشعر، نلتقي بأحلام وحركات وأفكار واستيهامات، في صيرورة اشتباك تؤدي، في كل الأحوال، إلى اقتناص الصور وترويض الإيقاعات وإبطال الإبهام. لكن في الشعر، أيضا، نشتبك مع يقظة الوهم، كما نواجه النار التي يقدحها الاحتكاك بين المرئي والمخفي. ومن يقدح الشرارة، إذن، غيرُ الحب؛ «هذا الفوضوي والمُشَوِّش»، بتعبير باتريك زوسكيند؟
الحب في هذا الديوان هو «ما نحتاج إليه» لأنه متصل بديمومة الوجود، وهو شيء في غاية الوضوح، يتجدد باستمرار، ويعمل ضمن سلسلة هائلة من مضادات الموت، ما دامت استعارة «الفراشة» (التي تقوم عليها هذه المختارات الشعرية) تكشف لنا، على الفور، أن التحول المؤلم والضروري هو ما يفسر الحب!
تُختزل عادة الفراشة في الجناحين أو في «غبطة الشمس والفصول». غير أن رمزيتها تتركنا نخوض في المياه السرية لسرديات ميثولوجية عديدة (الإغريق، الرومان، الفراعنة، الكونفشيوسيون، الأفارقة، الهنود الحمر، المتصوفة.. إلخ). فهي «سايكي» أو «بسيشي»، إلهة الروح عند اليونان وزوجة إيروس (إله الحب)، التي أثار جمالها غيرة أفروديتية. كما ارتبطت عند الفراعنة بسياقات جنائزية ضاربة في عمق التاريخ (3000 سنة قبل الميلاد). أما عند المتصوفة فتعني الانصهار في الحق أو «إدراك ما لا يعرف». وترمز الفراشة، هذا المخلوق الأثيري، إلى الانسجام والتوحد مع الطبيعة بكل أشكالها، كما ترمز إلى تجربة التحول، أو الولادة المتجددة، أو الجمال الممتد، أو العناق الانبعاثي، أو «الرؤية الحق أمام الضوء الساطع».
يحق لنا إذن أن نتساءل عن سر هوس الشاعرة ليلى بارع بالفراشات؟ لا يوجد أدنى شك أن «همس الفراشة» امتداد لـ»أرض الفراشات السوداء»، وأن حضور الفراشة حالة وجودية واعية، وسقوط حر في التوهج الذي يتيحه الحب. الفراشة في هذه المختارات لا توبخ الحظ، ما دامت تدرك – أو هي لا تدرك – أن الحقيقة تقيم في أعطاف الضوء (أو النار). الاقتراب هو الانتصار، أما الاحتراق فهو البؤرة التي يسير إليها العارفون. وخلف هذا وذاك تقع الجنة أو الفرح. تقول الشاعرة: «أعيد اكتشاف منحنيات الفرح/ أصعد تلاله بأقدام حافية/ أصطاد فراشاته/ بصبر الدراويش/ وبمهل العارفين» (ص: 25). من يصطاد من؟ هل الفراشة تصطاد الضوء أم الضوء يصطاد الفراشة؟ وأين هو جناح اللاتوقع. ذاك الذي يمنح الشعر القدرة على الطيران العالي نحو السري والمبهم؟
ربما هو ابتسامة المخاطب في قول الشاعرة: «أحدق في عمق ابتسامتك التي كانت/ مصباحا/ أحرق كل الفراشات التي لم تقرأ/ من الكتاب الذي تتغير صفحاته/ كل فجر» (ص: 37-38).
اللاتوقع هنا مضاعف: الفراشات التي لم تقرأ (أو لم تحترق) والكتاب الذي تتغير صفحاته كل فجر (لعله تقريبا كتاب الرمل/ الكتاب البورخيسي/ الكتاب اللانهائي/ اللوح المحفوظ). وإذا كان اللاتوقع لا يخضع للقياس، فإن تلك الابتسامة الحارقة/ الخارقة هي السبب المباشر في وقوع الحب. الحب هو التاريخ الحقيقي للهشاشة. هو القوة الضاربة التي لا تحتاج إلى مظاهرات حاشدة أو مشانق، أو أسلحة. تحتاج فقط إلى كلمات: «وما الذي بيننا/ غير كلمات صغيرة/ كفراشات/ طافت حولنا مترددة/ وفقدت نحو قلبينا/ الطريق» (ص: 46).
الحب هو هذا الزائل الضال الذي قد يستمر في الحدوث. لغة تستمد حياتها من الاحتراق. لا حب دون احتراق. ولا احتراق دون كلمات. الكلمات هي التجربة (الاستيهامات الحاسمة والتخيلات المربكة). الحب هو ما يخلفه الاحتراق، ولا يخلف الاحتراق سوى أثرٍ لا يُرى. ألم يقل محمود درويش «أثر الفراشة لا يرى/ أثر الفراشة لا يزول»؟
لا تُرَوِّج «القصائد المختارة» لحب «من الوريد إلى الوريد»، كما تقول غادة السمان، أو لـ «كلب من الجحيم»، كما يقول شارل بوكوفسكي، أو لذلك الصراع الأزلي بين إيروس وثاناتوس، بل لحب يصنع النسيان ويوثقه بإحكام، دون أي ندم أو تبكيت ضمير. النسيان هو التوازن الكامل حين لا يجدي الكلام.
تقول الشاعرة:
«النسيان سفينتي/ لم أحمل فيها غير روحي» (ص: 21).
«كموجة سابعة، أبطل النسيان سحر الحب، الذي رفرف طويلا بيننا» (ص: 28).
«حتى لا، أنسى حتى لا أختلق حقائق، لم تقع، أعيد تشغيل الشريط، كل ليلة، من جديد» (ص: 30).
«هل من طريقة للنسيان، هل تطوي من أجلي الطريق، والزمن لأوقف الحنين داخلي» (ص: 33).
كل الصور تأتي من مكان بعيد. من النسيان: الشكل المثالي للتحرر. أليس الانتباه الفائق إلى النسيان، في هذه المختارات، هو التماهي الانتهازي مع الاحتراق. فإذا كان النسيان ينتهي بنا إلى الهدوء، كما يقول إميل سيوران، فهل معنى ذلك أن الذاكرة مكان قصي.
تمنحنا القصائد شعورا جنائزيا بالحب. ذلك أن النسيان مجرد حضور لغوي يقطع الأنفاس. صحيح أنه يستحوذ علينا، لكنه لا يعمل إلا بالقدر الذي يجعل الحب أكثر كثافة. ألا يعاد تشغيل الشريط كل ليلة من جديد؟
فهل يعادل التكرار النسيان، كما يقول بول ريكور؟
أليس النسيان «منطقة مفقودة»، خاصة إذا تعلق الأمر بالحب؟
ألا يُبْطَل الحبُّ بالرغبة والتشهي وقتل الممكن والميل إلى الاستهلاك والخضوع لقانون العرض والطلب؟
في الحب، كل شيء يدور حول الألم. لا شيء يتفوق على الألم غير الارتماء في خدعة النور، وما النسيان إلا قناع يسترخي وراءه المعذبون المتشبهون بالفراشات. النسيان هو الصيد الوفير الذي يتيح لكل حب «حياة أخرى». النسيان هو عمق الحب، بل عمق هذه المختارات الشعرية. هو ما يوحد بينها. إنه النزوع الأورفيسيوسي نحو الارتماء في كآبة الصقيع الأبدي، ما وراء الاحتراق أو الضوء أو النار. «لا شيء بالتأكيد بيننا» . هذا هو المختتم أو الصرخة الأخيرة. العبور نحو الهدوء. لا شيء كان بيننا غير الرماد. اختفت الأسماء والأمواج والخدوش والأقنعة. فهل نصدق؟ الأعمى أيضا لن يصدق.
«أيها الأعمى
همست الريح في قلبي
لا تفلت يد الغجرية
حين تعبران نهر النسيان
إنها تمسك في يدها الخضراء
نبوءة المطر
وعينيك» (ص: 7)
لا تتكلم الشاعرة بكل سهولة إلى الآخرين. تناجي. تومئ. تبني قواعد. تطرح السؤال، ولا تنتظر طويلا لترد بالجواب، بل تمد للقارئ حبالا ليساعدها على الخروج بسلام من «الروديو المتوحش الذي يمثله الحب»، بتعبير غواتاري. ولهذا تحضر الصور الرمزية الصائبة أو الصحيحة. إذ ما معنى «نبوءة المطر»؟ ما معنى الإمساك بعيني الأعمى؟
نقول بلغتنا الدارجة «نية الاعمى فعكازو». وللعكازة، في الثقافة العربية، رمزية متعددة تتصل بمعاني الاتكاء والإسناد والحكم والدفاع. إنها فحولة القضيب حين يواجه خصوبة الأرض، وإلا ما معنى «نبوءة المطر»؟ وما معنى الإمساك بعيني الأعمى؟ أليس الحب هو الدليل الذي يقود إلى الحظ. ألا يحتاج الحب إلى تعاقب الفصول، أو إلى القدرة على الانتظار؟
تقول الشاعرة؛
«بإبرة الصبر، تعلمت نسج الفرح، خيطا خيطا» (ص: 25).
نحن هنا أمام المرأة النساجة. بينيلوب التي تنتظر عودة أوليس من رحلته، واثقة من أن الذاكرة تتشكل بنهر لا نهائي من النسيان. أليست بينيلوب، أيضا، ناقضة الغزل؟ أليس الاحتراق هو هذا النقض الممنهج للذاكرة؟
خلاصة القول إن قصائد هذه المختارات تتميز بنزوع تأملي يرمم الذات المحترقة بتباريح الحب وآلامه. كما أنها لا تكتفي بالقول، بل تتفلسف في محاولة شعرية متواصلة للإمساك باللامرئي والهارب وغير المتاح. الحب لا يحتاج إلى تراكيب أو عتاب أو أمل. الحب تحضير طويل للاحتراق في الغياب، ولا سلطة إلا للنسيان، ولا مجد إلا للأثر.