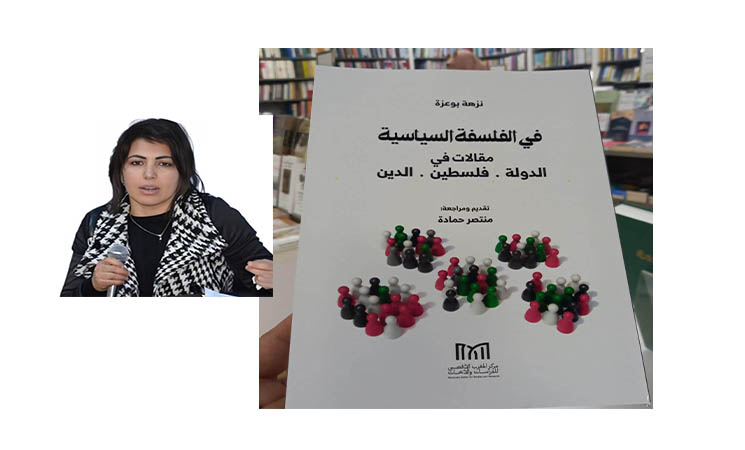يعلن الكاتب علال بنلعربي في بداية منجزه «يجب الدفاع عن المدرسة العمومية» أن قضية التعليم هي القضية أم المعضلات بالمغرب، ولا مناص من الكتابة فيها، فقناعته الفكرية-السياسية تحثه على الإقرار بأنه لا يمكن بلوغ تنمية شاملة، وكما نأملها، دون تغيير النظام التعليمي. لهذا كان الفعل «يجب» حاضرا في عنوان الكتاب لتبيين أن الكتابة في هذا السياق ليست ترفا فكريا؛ بل هي واجب ينبع من صميم الذات، بمعنى إلزامي لا تفرضه القوانين الزجرية، ولكنه تجسيد للاستجابة طوعا لصوت واجب أخلاقي من الداخل.
ثمة دافع موضوعي يحث على ضرورة النبش في ثنايا هذا الكتاب لاستجلاء بعض الأفكار التي قد يفردها فيه الكاتب كحلول أو أجوبة ممكنة عن التساؤلات التي ما تفتأ تطرح حول التعليم بالمغرب. أسئلة متعددة بتعدد الرؤى والمقاربات غير أنها تلتقي حول تشخيص جامع مفاده أننا بصدد أزمة لا بصدد مشكلة أو مشكلات؛ والمقصود في نظر الكاتب هو أزمة التعليم. ويتعلق الأمر بأزمة تطور التعليم الذي يراد به في الأصل حركة المجتمع والسير به نحو التطور والتقدم. معنى هذا أن هنالك بعض العقبات التي تعيق الحركة التاريخية للمجتمع متجذرة في لاحركية التعليم؛ والحال أن الكاتب بنلعربي لمّا يقرن تطور المجتمع بتطور التعليم فيه، فهو في احدى فقرات الكتاب يمضي أبعد من هذا المستوى؛ إذ يعد التعليم هو «العامل المركزي المحدد للمستقبل الوجودي والحضاري للمغرب…»
إنني لا أروم الخوض في استعراض المحاور التي تشكلت منها مضامين الكتاب، أولا، لأن من شأن هذا الصنيع أن يصادر على القارئ حظه من التأويل الممكن، ومن الاستنتاج الذي تتيحه القراءة المباشرة لأي متن. وثانيا، لأن أي عرض مختصر للمضامين سيقفز لا محالة على العلاقات الشرطية والتركيبية التي يتقوم بها مركب القول أيا كان جنسه. لذا أنعطف بمعية قارئ أو قراء محتملين نحو التساؤل التالي: ما الذي لاحظه علال بنلعربي من موقع مسؤوليته كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حينما يؤكد بأن إصراره على تجربة الكتابة في قضية التعليم قد انبثق من تينك المسؤولية؟ وهذا التساؤل كفيل بتبيين بعض الآليات أو الأدوات التي تفضي إلى قراءة ممكنة في هذا المنجز؛ فما لاحظه الكاتب قد شكل في الآن نفسه الدافع الأساس إلى خوض تجربة الكتابة في قضية التعليم، والمنهج المتبع لتجريب الكتابة فعليا. والحال أنه ما من ملاحظة بريئة؛ بل إني أجدني هاهنا أشدد على الاعتبار بأن كل ملاحظة هي تأويل لما التقطته الذات المتأملة من معطيات انوجدت على أرض الواقع سواء في بعدها الميكرو أو الماكرو، في اتصالها أو انفصالها وفي تساوقها أو اطرادها.
لقد لاحظ الكاتب علال بنلعربي أن القرار السياسي يلعب دورا أساسيا ومحددا في سيرورة التطور العلمي الذي يشكل الرافعة الضرورية للنهضة الاجتماعية. ومن خلال تجربته الطويلة في سراديب العمل السياسي والتعليم، أدرك أن مسؤولية تطوير التعليم توجد في قبضة اليد التي تضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق ذلك التطور، وإن يكن في أغلب الأحيان لابد من الرجوع إلى أهل التخصص من المفكرين وعلماء الاجتماع والتربية، علما أن أجرأة ما يتم التوصل إليه من تصويبات وتوصيات على أرض الواقع لا تكون ممكنة ولا تتزمن عمليا إلا بشرعية يمنحها إياها قرار سياسي صرف.ولعله تحت ضوء رؤية مقارنة يتم القول بأن الدول المتقدمة لم تكن لتبلغ هذا التقدم لو لم تبصر ذلك الترابط، ولو لم تدرك أهميته. ومن تم كان حرص الدول المتقدمة على إعطاء الأولوية للتعليم بما هو جسر للعبور نحو تحقيق التقدم المأمول، فسارعت إلى تشييد المدارس والمؤسسات العلمية بقرار سياسي ملزمٍ كنتيجة لِما تجلى أمامها من النتائج الإيجابية الممكن تحققها في المستقبل. وبوعي حقيقي وأصيل بعيد كل البعد عن أي شكل من النظر المغرق في الشوفينية والمصلحة الضيقة لجهة معينة أو لجماعة بعينها سيتم وضع مسؤولية حماية هذا القرار السياسي على عاتق المختصين في العلوم الإنسانية، وهؤلاء هم الذين سيقومون بوضع مقدمات ومنطلقات تصور جديد لتشييد وعي لدى جميع الناس بأهمية العلم والمعرفة، وتنمية الثقة لديهم بأن المدارس والمؤسسات العلمية هي السبيل المضمون لتحقيق النماء والعيش الكريم باعتبارهما الشرطين الأساسيين، جنب شروط أخرى لا تقل أهمية، في التقدم المنشود.
فما الذي يقلق رجلا متمرسا في المجالين معا من هكذا ترابط في ما بين السياسة والمعرفة بشكل عام، وبين القرار السياسي والتعليم وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالإصلاح التعليمي باعتباره موضوع الكتاب؟ ثم ما الذي أثار حفيظة علال بنلعربي وسحبه نحو التصريح بأسئلة حارقة في مقدمة كتابه «يجب الدفاع عن المدرسة العمومية»؟ حيث تتناسل الأسئلة:أي عناصر؟ أي أسباب؟ كيف؟ لماذا؟ وأي طبيعة لتلكم العلاقة ما بين السياسة والتعليم التي على خلفيتها سنجد أنفسنا أمام إقرار جازم من لدن الكاتب بان المسألة تتعلق بأزمة مركبة بنيوية للنظام التعليمي بالمغرب؟
يقدم الكاتب ما يراه الأجوبة المنتظرة في محاور يظهر من خلالها المنهج الذي اعتمده لهذه المقاربة النظرية للأسئلة المرتبطة، بشكل مباشر، بالتعليم كقضية ذات أهمية بالغة في منحى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة؛ فكل جواب يشكل خطوة نحو ما يروم الكاتب بلوغه من وراء تجريب الكتابة حول قضية بهذه الأهمية وبهذا التعقيد الجلي، أي «فهم ما حدث ويحدث في قطاع التربية والتعليم» ؛ غير أنه لا يمكننا إهمال الإشارة إلى عدم قابلية تلك المحاور للتلخيص أو الاختصار لاعتبار أن بعضا من مركبات القول لا تقبل ذلك، لأن بتفاصيلها يتم الفهم وأن عكس هذا الأمر يقود إلى طمس ما يراد توضيحه وتبيينه ليصبح متاحا أمام ملكة الفهم.
أعتقد أن ما يقلق هذا الرجل المتمرس في مجالي التعليم والسياسة ليس هو فكرة أن المحدد المركزي لكل تطور يظل محض قرار سياسي؛ بل إن ما يقلقه لهو ما يتخفى وراء ثمة قرار سياسي بخصوص قضية التعليم التي يعتبرها بنلعربي «قضية وطنية مقدسة لأنها مرتبطة بالمجتمع في أبعاده التربوية والتعليمية والثقافية والتاريخية والإنسانية». وغير بعيد عن هذا الإقرار يلوح في الصفحة الحادية عشرة ما يجعل ما كان متخفيا واضحا. إنها النوايا الثاوية خلف القرار السياسي. بكل تأكيد أن إصلاحا شاملا للتعليم بما يفيد لوضع لبناته الضرورية التي تضمن استفادة جميع المغاربة من خلال مدرسة تفتح أبوابها في وجه مختلف الفئات الاجتماعية لم يكن ممكنا مع تواجد إرادة سياسوية جنب القرار السياسي؛ الثاني يدعي الإصلاح من أجل تعليم عمومي في متناول جميع أبناء الشعب ودونما تكلفة تثقل كاهل أسرهم،والأولى، تحت عناوين وشعارات بطولية من قبيل إنشاء مؤسسات جامعية بمعايير عالمية، مؤسسات تضاهي الجامعات والمعاهد الكبرى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها. إنها مؤسسات تدعي تعميم المعارف العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والقانونية، غير أن النوايا الخفية ترتبط بحسابات أخرى ليست في الحسبان. وهذا بالضبط ما تمت ملاحظته من طرف الكاتب، فكان تصريحه هو الآتي: « والذين من مسؤولياتهم إصلاح النظام التعليمي (…) نجدهم يهملون الإصلاح كمهمة وطنية وفي ذات الوقت يهتمون بالتجارة في التربية والتعليم، والأمر هنا لا يتعلق بالربح المالي المفرط (…) بل هو تعبير عن اختيارات سياسية استراتيجية مؤطرة بمنظومة فكرية واقتصادية للمذهب الجديد لليبرالية الجديدة».
هذا التغلغل والتحكم الخارجي غير المعلن هنا، سيحدث انحرافا عن الهدف الأصيل للتعليم، إذ سيظهر بأن هذه الاستراتيجية إنما هي تجسيد لعلاقات تحكمية جديدة. فالمذهب الاقتصادي الجديد الذي سبقت الإشارة إليه؛ سوف يتموقع بيننا من خلال ثلة من بني جلدتنا، وهي التي ستتحول في ما بعد إلى قوة محركة للحركية الاجتماعية التاريخية للمجتمع المغربي، وخصوصا في قطاع له من الأهمية الشيء الكثير، وهو قطاع التعليم. وبذلك يشد الكاتب انتباهنا إلى مسألة جد خطيرة تتعلق بهذا الصنف من الدسيسة الذي يكون اللجوء إليه لاستعارة بعض النفوذ أو جله حتى يتسنى للفاعلين هاهنا امتلاك سلطة تحكمية قادرة على تزييف الحقيقة البدئية من وراء قرار تعميم التعليم، ثم تبرير اختياراتهم المجحفة في حق أبناء الشعب غير القادرين على دفع رسوم الولوج إلى تلك المؤسسات والمعاهد المتميزة، ويُتركوا لمصير ضبابي يلوح في سماء الجامعات العمومية المشرعة على تعليم، يصفه الكاتب، بكونه محدود الأفق وغير نافع، في أغلب الوقت، في الحياة الإنسانية اليوم. بهذا تظهر الدسيسة بشكل لا يقبل أي لبس في تحول الخطاب الذي يدعو إلى الإصلاح إلى خطاب أيديولوجي. ولا شيء ندلل به على إقرارنا بنفس ما اهتدى إليه بنلعربي، من ذلك المد الجارف من الاختيارات النظرية الرامية إلى تسليع التعليم وبلترة العمل الذهني؛ والذي يُحكِم لجامه خدام الاقتصاد السياسي الذي يؤدي دوره كما ينبغي لاستمرار النظام الليبرالي. وإن هذا ليتوجه أساسا لخدمة مصالح وأغراض الذين أوجدوا تلك المؤسسات الخصوصية.
بهذا التشخيص يتبين الفارق بين وجهتي نظر متضادتين؛ واحدة تعتبر أن رهان إصلاح التعليم ممكن فقط إذا ما تعرفنا على تلك المشكلات التي تتخلل تطبيق برامجه ومضامينه في حجرات المدرسة العمومية، وأخرى تؤكد على أن التعليم يتخبط في أزمة بنيوية لها من التعقيد ما يجعل إصلاحها الحقيقي مستعصيا ما لم يتم الكشف عن أسباب الاختلال المترابطة والآتية من جميع سياقات حركية الزمن الوجودي للمجتمع المغربي؛ أي النظر في الماضي والحاضر لاستشراف تقدم وتنمية مستدامة أصيلين.
ينتصر السياسي رجل التعليم علال بنلعربي للإقرار الجازم بأن التعليم قضية وطنية لا تقبل المزايدات السياسوية ولا التحليلات الفجة؛ فالأمر يتعلق بأزمة بنيوية مركبة ومعقدة، ليسوق بعد ذلك ما يراه أجوبة ممكنة. ودون أن يخفي قلقه إزاء استمرار الوضع على ما هو عليه، أو ربما استفحاله، سيرسم الكاتب ملامح الأمل في غد أفضل، لكن وكأني به، وهو يشرط ذاك الأمل بانبثاق وعي شفيف لدى الجيل الصاعد، يغض الطرف عن معطيات أكثر مرارة مما تم كشفه من خلال هذا المنجز… نعم، لعل الأمر يتعلق بوعي جيل الأغلبية منه قاب قوسين أو أدنى من مغتربين لفظتهم صيغ التعليم من ذواتهم وقذفت بهم في سراديب روح مهجرة خارج الجسد بفعل مخدر ، أو بوعد غير ذي أجل مسمى بمعانقة حلم ثلجي على مرمى حجر وراء المحيط. وأما القلة ممن تسلل بعض نور المعرفة إلى أدمغتهم فسرعان ما يغادروننا بأوراق تبوث لا سرية ولا مزورة صوب نفس الحلم الثلجي هناك.
ترى ما عساه يغدو التشخيص لو انتبهنا؛ نحن نساء ورجال التعليم وكل الذين يدورون في ذات المجال/التعليم، نحن الذين بتنا نضيق ذرعا من استفحال تأزم الوضع التعليمي في بلادنا،إلى أن أكبر عدد من حقائب الأدمغة المهاجرة نحن الذين نعدها بكل إصرار ومع سبق ترصد لأي من الدول تكون لهم فيها الحظوة أكثر.. لا عجب لو أضحى البلد بدون فلذات كبد، لأنه لا كبد له..
نقض الوجوب في كتاب «يجب الدفاع عن المدرسة العمومية»
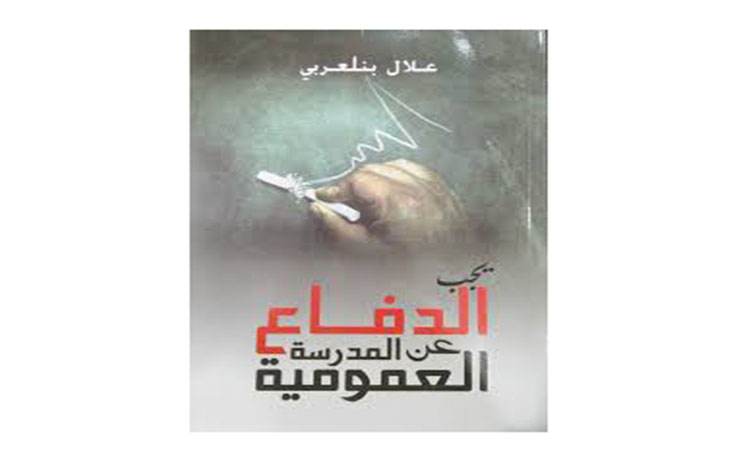
الكاتب : فاطمة حلمي
بتاريخ : 02/05/2025