راكمت الروائية فاتحة مرشيد في سجلها أعمالا روائية هامة. وتعتبر روايتها الأخيرة، «انعتاق رغبة» (المركز الثقافي للكتاب 2019) بمثابة تتويج لمسارها الإبداعي، بالنظر إلى طبيعة الموضوع الذي تناولته . اقتحمت الكاتبة عوالم مغلقة ومحظورة في المخيال الاجتماعي. كسرت أقفال صندوق أسود. يحمل أجسادا «شاذة» و»غريبة» مهزومة نفسيا واجتماعيا، لا تمتلك سلطة الكلام والفعل. لقد حاولت الكاتبة أن تستنطق هذه الكائنات الصامتة، أن تنتشلها من وجودها اللامرئي إلى وجود ملموس. لكن السؤال الذي يجب طرحه، ألم تكن هذه التجربة محفوفة بالمخاطر ونتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات؟
انعتاق رغبة
أم انعتاق ثقافة
تتكون عتبة النص (العنوان) من كلمتين «انعتاق» و»رغبة». لكن، لماذا استخدمت الكاتبة كلمة الانعتاق بدل التحرر؟ كأن نقول مثلا، «تحرر الرغبة». يبدو أن الرغبة أسيرة فضاء. وكل ما هو أسير، فإنه ينشد الحرية. الحرية خلاص الرغبة. رغبة السجين في الحرية مشروطة بإنهاء مدة العقوبة. السجن سلب لحرية المذنب. أما انعتاق (اسم) مصدره انعتق، فإنه يعني الخروج. كأن نقول انعتق العبد من العبودية. فالعبد لم يرتكب جرما أو ذنبا. إنه ضحية بناء ثقافي تم تصميمه بشكل قبلي. العبودية نمط إنتاج، تشكيلة اجتماعية. نقول عتق (فعل) العبد، يعني خرج من العبودية. الخروج من وضعية الإذلال والاحتقار. الخروج من بنية الظلم واللاعدالة. فالرغبة تسعى إلى الخروج من نظام ثقافي، يمتلك سلطة الهيمنة والإقصاء، إلى نظام الاعتراف. الرغبة تسعى إلى الانعتاق من بناء معياري يرسم الحدود، بين ما يُسمح البوح به وما لا يُسمح التعبير عنه.
التصميم القبلي للرواية
مارست الكاتبة مرشيد طقوس الكتابة على مرحلتين: المرحلة الميدانية والمرحلة المخيالية. في البداية، تناولت موضوع الهويات الجنسانية كظاهرة اجتماعية، تتقاطع في دراستها مجموعة من الحقول المعرفية، كعلم النفس وعلم الجراحة وعلم الاجتماع وعلم الحياة… بالموازاة وظفت أدب الرحلة، حيث سافرت إلى عوالم الفئات الجنسانية، وقفت عند مختلف الأنواع، من سحاقيات ومثليين ومتحولي الجنس ومزدوجي الجنس… استمعت إلى حكاياتهم ومعاناتهم، سبرت أغوار وضعياتهم النفسية والاجتماعية، صاحبت كرنفال المثليين بكندا…
انفتحت الكاتبة كذلك على المكون الديني، لتصغي إلى ثنائية الحلال والحرام، «عزيزة أخذت بفتوى أحد العلماء هنا بمونتريال، وهو على علم بمشكلات الأقليات الجنسية، وقد أكد لها اختلاف العلماء حول الحكم الشرعي في الموضوع» (ص 138)…كما وظفت علوم القانون «مازال القانون فيها [إيران] يعاقب المثليين الرجال بالإعدام» (ص،107)..
في هذا السياق يمكن القول، إن الكتابة عند مرشيد مستويات متداخلة من الأحاسيس والعلوم والأجناس. تبدأ بتجربة القلق والمعاناة، ثم تقفز إلى مرحلة الإمساك بالظاهرة ورصد أسبابها ونتائجها. فالظاهرة تتطلب، لفهمها وتفسيرها، عُدة منهجية ومعرفية. ثم، تأتي مرحلة الإبداع، حيث في جوفه يُصهر هذا الجُماع المعرفي والإحساسي في قالب يمكن نعته بجمالية المخيال. إن الرواية، كجنس أدبي، فراشة انعتاق تحط رحالها فوق قلب المتلقي لتهز مشاعره، من أجل بناء فعل تضامني مع أصوات مظلومة ومهزومة تاريخيا. حرصت الكاتبة مرشيد، في هذا العمل، على تجسيد هذا المسار الثلاثي باقتدار كبير. كان غرضها، هو تبليغ رسالة إلى جغرافية المحظور الثقافي، تحمله فيها مسؤولية توريط نمط من التفكير في أوهام معيارية.
الغيرية الجنسية والرغبات الجنسانية
في «انعتاق الرغبة» رسمت الكاتبة / الباحثة مرشيد عالمين: عالم أصلي، وهو عالم الغيرية الجنسية. وعالم النسخة، هو عالم الهويات الجنسانية. (عالم المعقولات وعالم المحسوسات). في العالم الأصلي يسود منطق الإكراه والعقاب، حيث يقع الجسد تحت مراقبة السلطة والخطاب. تقتضي المراقبة تحديد جهة الجنس، هل ينتمي إلى نوع الذكورة أو الأنوثة. يجسد هذا العالم ثقافة سائدة، ثقافة الانضباط والخضوع، باسم الدين والقيم الأخلاقية. ينتمي إلى هذا الفضاء الشخوص مثل: الحاج إبراهيم، مريم، صوفيا ووالديها. أما عالم النسخة، المنفلت من قبضة سلطة المعيار الغيرية الجنسية، فهو عالم متمرد على الضوابط الأخلاقية وعلى الصور النمطية الاجتماعية. ينتمي إلى هذا العالم، كل من عزالدين الذي تحول إلى عزيزة وغسان الصافي وأرونداتي.
يخضع تصميم الرواية، منذ البداية إلى النهاية، إلى هذا التقسيم الثنائي، الذي يعكس صراعا بين عوالم متقابلة. عالم يريد أن يُخضع ميولات الاختلاف إلى إرادة القوة، وعالم يصارع من أجل الاعتراف بالاختلاف. وبين العالمين مظاهر الانتحار الثقافي (ماركس يتحدث عن الانتحار الطبقي) حيث يسقط الأفراد، فهما وتعاطفا، من عالم الإلزام الجنسي إلى عالم التحرر الجنساني. وقد جسد هذا الانتقال، كل من الدكتور فريد السامي وفادية المتخصصة في علم النفس.
نريد أن نسجل أن هذا الانتقال لم يكن وليد معارف علمية، أو دراسات أكاديمية…بل كان نتيجة تجربة ذاتية. فرسالة التغيير التي تراهن عليها الكاتبة مرشيد، لا تتوقف على مواقف سياسية أو إيديولوجية أو فلسفية أو علمية، بل تتوقف على تجربة تأملية في الذات. إن تجربة الخاص، تضع نفسها بمنأى عن المشترك السياسي والثقافي والقناعات المتداخلة. ففي تجربة الذات تعلو النفس نحو مراتب الصفاء الذاتي الخالص، حيث الذات تشبه ذاتها، متصالحة مع روحها. هنا بالضبط تتغير النظرة إلى الحياة، ويصبح العيش في عالم جديد ممكن.
كانت الفضاءات التي وضع فيها فريد نفسه، مناسبة جيدة للتأمل. الفضاء كمحراب للتأمل، اتخذ مظهرين: فضاء مغلق، «عدت إلى البيت أستبق قلقي، أقفلت هاتفي النقال واعتكفت على قراءة الدفتر» (ص، 14). «استأجرت غرفة بأحد الدواوير لا تتوفر على شيء سوى حصير ولحاف، وكان ذلك كافيا لهارب من الدنيا إلى نفسه» (ص،37 ). ثم، فضاء مفتوح «اتجهت نحو مراكش أولا ومنها إلى إقليم أزيلال ثم ذهبت إلى أيت بوكماز التي وجدت بها ضالتي» (ص،37). وهذه الجدلية بين الانفتاح والانغلاق، تعكس إصرار الذات على الإمساك بشيء ما، شيء في حالة مخاض يريد أن يخرج. فالمشي شكل من أشكال الصحة ينصح به الطبيب المرأة الحامل. والمشاؤون الفلاسفة يختارون المشي، لتوليد المعاني والأفكار من مخاض التأمل. على هذا الدرب، حاول فريد أن يكون شخصية متفردة في اختيار نمط حياته وأسلوب تفكيره، حيث استعاض عن اللامعنى بالمشي، «سوف أمشي…أمشي لساعات..بعيدا عن التلفزيون المقتحم لبيوتنا، عن العلاقات «اللا اجتماعية».. سأتواصل مع الطبيعة، مع الحياة الواسعة، ومع نفسي التائهة» (ص،37).
أما شخصية فادية، فإنها انتقلت من عالم الغيرية الجنسية إلى عالم الجنسانية، بسبب العنف والاغتصاب والتعذيب التي مورس عليها في عالم الغيرية. كانت طفلة وديعة تستمتع ببراءتها كباقي الأطفال، وإذا بها تقع بين يدي شخص مجنون (معمر القذافي) مصاب بهستريا عصابية، يجد راحته في فض بكارة العذراوات، رجل يمتلك الحظوة والسلطة ويوظفهما لإشباع رغباته المرضية. هذا هو عالم الغيرية الجنسية، يمارس نزوعا شبقيا مريضا، يتلذذ في ممارسة سادية على أجساد بريئة، فيدمر حياتهم ومشاعرهم وكرامتهم. تتذكر فادية صورا في غاية الرعب، فتحكي قائلة: «في هذه اللحظة بالذات دخل [القذافي] كثور مسعور صارخا.. واغتصبني من جديد وأنا مربوطة الساقين.. بينما تشع من عينيه نظرة وحش مفترس» (ص،150). هذه السادية تطال حتى الرجال من حاشيته «سمعت قصصا كثيرة خلف القضبان والحريم عن اغتصابه لرجال يشغلون مراكز عليا في البلد، لإثبات سلطته عليهم وإهانتهم. ولا يتردد في اغتصاب زوجاتهم أو أبنائهم». (ص،154).
هذه المظاهر من العنف والاغتصاب والاعتداء على كرامة المرأة والرجل على حد سواء، لم تجدها فادية في عالم الجنسانية. بل وجدت قيم التسامح الإنساني، وجدت أحضانا دافئة من المحبة، كما وجدت حكايات ومعاناة مارستها الغيرية على أجسادهم المهزومة. تتذكر فادية الندوب والحسرة التي تحملها ذاكرتهم وأجسادهم. لم تنس فادية الرعاية التي أولتها إليها عزيزة، ولم تنس الأيدي الدافئة التي حضنتها. في عالم الأقليات الجنسانية، اندمجت بسلاسة في مثلهم وقيمهم الإنسانية. عاشت فادية تجربة اكتشاف عالمين: عالم موبوء بالخيانة والغدر، يضفي على نفسه مساحيق التعالي الأخلاقي والنقاء الذاتي. وعالم مرفوض اجتماعيا، بدعوى أنه آثم وفاسد أخلاقيا ويمارس المنكر من الفعل، لكنه لا يحتاج إلى مساحيق النفاق، لأنه فعلا يختزن في ذاته المحبة والسلام وقيم التضامن. «آوتني عزيزة، ورعتني كأم أكرمها الله بابنة كانت تتمناها بقوة». (ص،172).
إن النقطة التي تجمع بين فريد وفادية، هو معاناتهما المشتركة من جراء ممارسات سلطوية لصيقة بطبيعة عالم يطلق على نفسه صفة الاستقامة والاستواء. لكن خلف هذا العالم، تكمن مظاهر العنف المادي والرمزي. في بيت النشأة يتذكر فريد، «أنصاع لإرادة والدتي فأفعل كل ما ترغب فيه على حساب رغبتي» (ص، 118). ثم يضيف « كانت حياتي جادة جدا، قيدتها صرامة والدتي بانضباط عسكري» (ص،180). أما في بيت الزوجية، فقد حولت صوفيا حياته إلى جحيم، «وحين طرق الباب ظننتها زوجتي جاءت باحثة عني لتُشعل نيرانها المتشظية» (ص،10).
بؤس المكان وظلمة الاغتراب
إن جغرافية المكان في رواية «انعتاق الرغبة»، لعبت دورا كبيرا في ولادة إنسان جديد، إنسان يعانق نسائم الحرية، حيث يتصالح جسده مع رغبته. يبحث عزالدين عن مكان يحط فيه ثقله ومعاناته. يتنقل من لبنان إلى كندا مرورا ببلجيكا، يحاول أن يقبض على حلم طالما راوده. حلم يتماهى فيه الجسد مع حقيقته. يعيد فريد ابن عزالدين نفس حلقة الخلاص، يهاجر إلى كندا وقد ترك وراءه كل ما يمكن أن يشد الإنسان إليه، المال (باع أسهم المصحة إلى شريكه) والحب (طلاقه من صوفيا).
لكن السؤال الذي نود أن نطرحه، لماذا لا يحتضن المكان الأصلي ولادة إنسان آخر ؟
لا تمتلك الكاتبة مرشيد أدوات الهدم للإجهاز على ثقافة الإقصاء، بحيث لم ترفع مطالب حقوقية، ولم تقدم مشاريع قوانين، ولم توزع الحقيقة، ولم تلتجئ إلى المجتمع المدني، أو السياسي… لم تسلك مرشيد هذه المسارات، بل لجأت إلى تقنية أخرى، تقنية استخدام الصوت. عندما تحرر سجين أفلاطون من الكهف، واكتشف حقيقة الأشياء، عاد إلى أصدقائه من السجناء، يقرع على أسماعهم صوت الحرية. كان الصوت مثقلا بعطر الحرية. لكن الصوت الذي اختارته مرشيد، صوت الصدمة (traumatisation) لا يحمل حرية، بل يحمل ارتجاجا مدويا. كان الصوت انفجارا، تجاوزت ذبذباته حجم السمع، مخيف وقاس وصادم. إنها صدمة الصوت، اخترق مفعولها آذان الأفراد في مناسبات عديدة: عندما صارح فريد زوجته صوفيا بحقيقة والده الذي تحول إلى امرأة، هذه التقنية التي وظفها فريد كان واعيا بها، إذ كان ينتظر من صوفيا أن “تستوعب الصدمة” (ص،206). أما المناسبة الثانية، حين التقى بشريكه جميل، وحكى له قصة أبيه وعرض عليه بيع أسهمه، هناك “ قبل عرضي دون تردد” (ص،215). لأن “حقيقة والدي تجعل مني شريكا غير مرغوب فيه” (ص،215). وأخيرا، قبل أن يسافر إلى كندا، انتبه إلى ضرورة “إخبار عمتي فاطمة وخديجة بحقيقة أخيهم عزالدين”(ص،219).
وجد فريد في هذه التقنية، حاجة ملحة إلى خلق رجة اجتماعية، صدمة يمكن أن تُفضي إلى طريقة علاجية من أمراض ثقافية. لم يشأ فريد أن يحمل الحقيقة ويسير بها طويلا في واضحة النهار يوزعها بين الناس. لم يشأ أن يكون قسيسا أو راهبا أو صالحا. لم يشأ أن يختزل صور الانبهار والإعجاب في ذاته. فريد يملك شيئا واحدا، صوته. الصوت أداة وخز الضمير، ووسيلة استنهاض الاختلاف، وطريقة جديدة للتفكير. لم يشأ فريد أن يكون وصيا على تفكير الناس.، لأنه يدرك أن الإنسان الجديد يتميز بقدرته على التفكير وبقدرته على بناء استقلالية شخصه. فالحقيقة هي حقيقة الذات لحظة الغوص في أغوارها الباطنية.
جمالية المكان
ونور الحب
هاجر فريد إلى مكان آخر، لأنه لم يعد له موقع في جغرافية البؤس الثقافي. فالأمكنة المسيجة بمعايير الإذلال والإكراه وهستريا القمع، لا يمكن أن تحضن إنسان مارس التطهير الذاتي. إن قرار السفر إلى كندا جاء في سياق العزم على الاندماج في بنية الاختلاف. اندماج في بنية ثقافية تتسع للجميع، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللسان..لكن ما يستهويه في هذه الرحلة الجميلة، هو الحب. عندما يصبح الحب قوة داخلية، يتحول المكان إلى عشق صوفي. لم تكن فادية سوى هذا العشق الذي تماهى مع المكان، حيث انقشعت ظلمة المشاعر بنور الحب. بات الحب نمط حياة جديدة، يسكن المكان والأحاسيس. «إنها المرة الأولى التي أتحدث فيها نفس اللغة مع امرأة. لغة تواطؤ الفكر والانفعالات. لغة تعتمد الصمت أساسا» (ص،199).
لعبة النهاية
إن السؤال الذي يؤرق عادة كُتاب الرواية، هو كيف يختارون نهاية تليق بعملهم الإبداعي. والكاتبة مرشيد تحرص حرصا شديدا على ختم أعمالها بنهاية تفتح أفقا جديدا للتفكير، كما تفتح نهم القارئ نحو ممارسة تأويلية للعلامات مع افتراض وقائع جديدة.
في «انعتاق رغبة» تختار مرشيد علامة، تشكل رمزا مليئا بالدلالات، يتعلق الأمر بالطائرة وهي تسبح في الأعالي، تماما كما تسبح الأفكار في المخيلة. في الطائرة يجري فريد حوارا ذاتيا، حوار وضع فيه حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى. يفكر فريد فقط في المستقبل، «على متن طائرة العودة إلى مونتريال، وأنا مسترخ فوق السحاب، أستعيد حقي في الحلم، انعتقت بذهني رغباتي الآتية على شكل سيناريو شريط رومانسي، يخمن ما سيحدث عند وصولي» (ص،221). في لحظة هذا الاسترخاء والتفكير في المستقبل، يحدث «اهتزاز قوي للطائرة وصوت مضيفة يبعث على الذعر» (ص،223).
نعود إلى مشكلة الصوت، استخدم فريد الصوت كحوار داخلي، ثم كرسالة نابعة من الذات إلى الآخر. ها هو الصوت الآن يصبح منفلتا خارج التحكم الذاتي. إنه نابع من الخارج. يتحول الصوت كسلطة خارجية. تحاول الكاتبة مرشيد، من خلال هذه الصورة النهائية التي تختم بها روايتها، أن تبعث رسالة مشفرة، مفادها أن الحياة ليست خطا متقدما من السعادة أو الشقاء، بل الحياة وضعيات للتفكير. كيف تخرج من مأزق شاءت سيرورة الحياة أن تضعك فيه.
صحيح أن فريد اختار عالما جديدا بمقاييس ذاتية تأملية، إلا أن الحياة لها منطقها الخاص. وأعتقد أن فريد سينتصر على تكاليف الحياة وصعابها، ليس لأنه يمتلك القدرة على مواجهة الصوت الخارجي، بل لأنه مزود بآليات تفكير جديد.

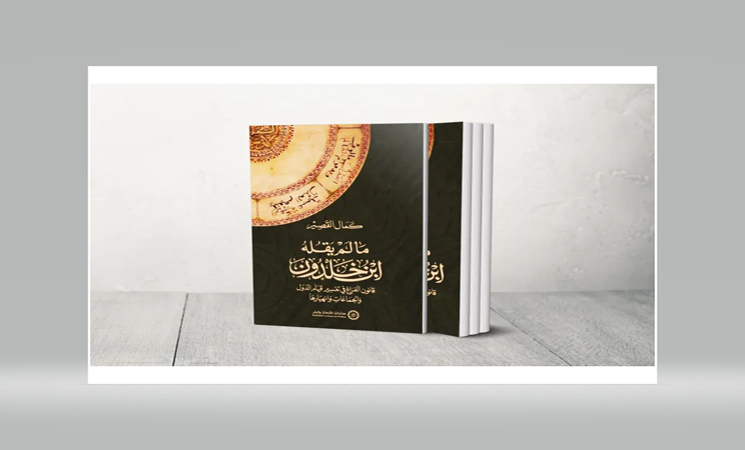





اترك تعليقاً