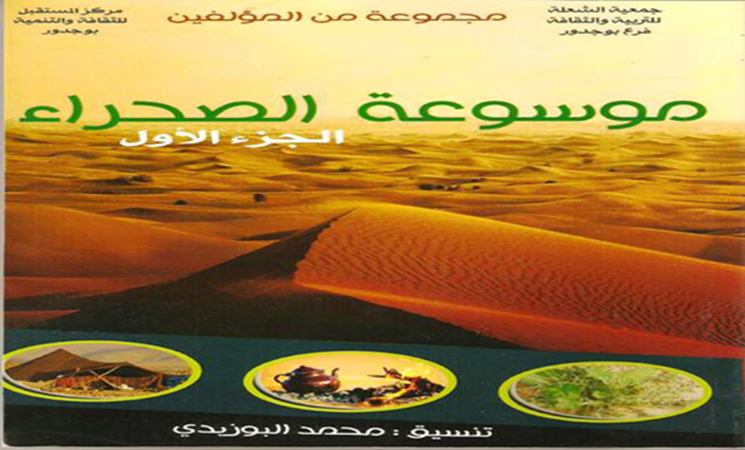التفكير في النص القرآني، وشرحه وتفسيره وحصر معناه، ليس انشغالا عربيا، فقد دأب المستشرقون، ومعهم الدارسون القرآنيون، على محاولة تفكيك الخطاب القرآني وارتياد علومه ومباحثه ولغاته، وتحديد نوازله ومفاتيح فهمه، وذلك في مواجهة التيارات الدينية التي تحاول فرض أساليبها بمنطق استغلاقي واحتكاري وإيماني، لا يستقيم الآن مع تعدد المناهج وطرق البحث العلمية التي تنبني على التشخيص والتحليل والتدقيق والتمحيص واستدعاء القرائن العلمية المادية والتاريخية.
يتضح مما تقدم أنّ المائة الثانية للهجرة تميزت بحركة انفجارية في تدوين العلوم ووضع الأسس المتينة لها واستمرت هذه الحركة التطورية سواء في اقتباس الألفاظ الأعجمية أو الإضافات أونقل الأصطلاحات العلمية كما هي حتى العصور المتأخرة وإلى يومنا هذا.
هذا النهج ليس وليد مرحلة بعينها وإنما تنامى مع نمو الحياة بمختلف مرافقها وسيبقى مستقبلا، وهذا أمر طبيعي لا خوف منه بل هو وسيلة من وسائل النمو اللغوي فما أخذ من اللغات ليس خطرا محدقا بلغتنا لأنه جاء نتيجة طبيعية للتمازج مع اللغات الأخرى دون قصد أو اقحام، إنّما الخطر يكمن حقيقة إذا أبقينا أنفسنا متقوقعين داخل الأطر اللغوية التي تفتقر أحياناً إلى بعض من الألفاظ الأجنبية التي تحمل في طياتها نوعاً من الفائدة، ولا سيّما نحن في وقتنا الحاضر نلحظ تطوراً ملموساً في مناحي حياتنا المختلفة سواء أكانت سياسية أم ثقافية أم تقنية، وهذا التقوقع ربما يؤدي بنا الى الجمود العلمي، وعدم القدرة على مواصلة التقدم السريع الذي يحصل في ميادين العلم، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّنا مستوردون للبرامج العلمية كافة والتي تحمل ألفاظا لا عهد لنا بها، ولم تحتوها معاجمنا اللغوية.
إذن ما العمل؟ أنبقي أنفسنا بعيدين عن مواكبة التطور العلمي ولا نستعمل الكلمات الأعجمية المخصصة لهذا العلم أو ذاك وننتظر إلى أن تجتمع مجامعنا العلمية، وتقرر اللفظة العربية البديلة عن الكلمة الأعجمية بدلالتها العلمية، أم نقول للطب تريث في استخدام هذه اللفظة حتى يقررها المجمع العلمي الفلاني، وحتى لو فعلنا هذا، فإنّنا نجد أنّ اللفظة الأعجمية قد سبقتنا إلى ألسن الناس وشاع استعمالها وأصبحت مألوفة في نطقها وتداولها والسبب يعود الى كثرة المصطلحات وحاجة القياس إليها أو لنقل إلى التباطىء أحيانا في متابعة ما يحصل من تطور في المجالات كافة لتعريب واخضاع الألفاظ الأعجمية سواء العلمية منها أو الإنسانية وتأطيرها بالإطار اللغوي العربي. وعلام هذا كله؟ ألم يستخدم العرب الأوائل ألفاظاً أجنبية؟ ألم يكن بإمكانهم ترجمة هذه الكلمات الأعجمية أو وضع كلمات عربية لها بالاشتقاق أو النحت أو غير ذلك، ولكنّا نجدهم قد استعملوها كما هي، وحسناً فعلوا، تسهيلاً لنقل العلوم، واشتراك العلماء، وتوافق الألفاظ والمصطلحات بين الشعوب والدول. أمن الضروري أو الحكمة أن نحاول تعريب اللفظة الأعجمية على الرغم من سهولتها كتابة ونطقاً واستعمالاً، كما في كلمة (مكروب) و(استبرق)، مثلا، ونحن نعلم وندرك أن دلالتها في لفظها المقتبس أجمل وأوضح عند استعمالها.
الانغلاق إذن في هذا المنحى، لا مبرر له، لأنّ العلم في تقدم مطرد، هذا إذا كنا فعلاً حريصين على تنمية حقول لغتنا المعرفية لنا ولأجيالنا. وعلينا ألا نقيد أنفسنا ونجعلها محصورة ونصرخ أنّ هذه اللفظة أو تلك أعجمية دخلت في طيات كتبنا وأماتت لغتنا.
ألم يسمع هؤلاء قول لله عز وجل: ” إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون”، أم أنّهم تناسوا أنّ لله سبحانه قال: ” إنّا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا “.
ولما كان العلم مشاعاً في ميوله، إنسانياً في منهجه، غير مقتصر على فئة معينة دون أخرى، فمن الضروري والواجب أن نوحد جهودنا مع جهود الآخرين من أجل التوصل الى ألفاظ ومصطلحات علمية أو انسانية، مشتركة ومعروفة، تحمل دلالات واضحة لدى الجميع، وبهذا العمل نكون قد قدمنا خدمة عظيمة لأجيالنا اللاحقة من أجل ايصالهم الى موقع متقدم يفتخرون به أمام الأمم الأخرى ليحصلوا على مبتغاهم دون جهد وبوقت قليل، لكن على الرغم من هذا اليسر نجد ونلحظ محاولات هنا وهناك على مستوى الخارطة الأقليمية للوطن العربي في تعريب المصطلحات العلمية إلا أنّ هذه المحاولات لم تحرز تقدما وظلت محصورة في إطار ذلك الاقليم لا لعجز القائمين بالتعريب عن إمكانية ايجاد الكلمات البديلة، ولكن لعدم امكانية ظهور هذه المصطلحات العلمية المعرّبة الى حيّز العمل قبل شيوع اللفظة الأعجمية. لذا فانّ الوقوف ضد اقتباس اللفظة الأعجمية النافعة والهادفة الى لغتنا دليل انغلاق على العصر ومنجزاته ومضيعة للجهد، لكن هذه الدعوة الخالصة، يجب ألا تجعلنا نتمادى في اقتباس الألفاظ الأجنبية غير الضرورية، وألا نطلق القول بالاستعارة من اللغات الأخرى وفتح الأبواب على مصاريعها لتدخل الألفاظ الأجنبية كيفما ومتى شاءت، ولكن لابدّ أن يراعى في ذلك شرط الحاجة الماسة والملحة، فالحاجة اذاً الشرط الأساسي للاقتباس، أمّا إدخال ألفاظ للتشدق بمعرفة لغة أجنبية فهذا أمر لاشكّ بأنّه يضعف اللغة ويؤدي الى ظاهرة مرضية مما يؤدي بالتالي الى سيطرة الألفاظ الأعجمية على اللغة الأصلية وقد يودي بها.