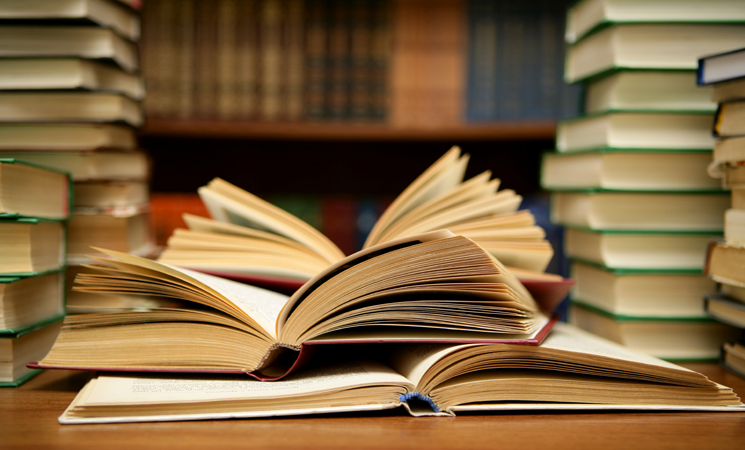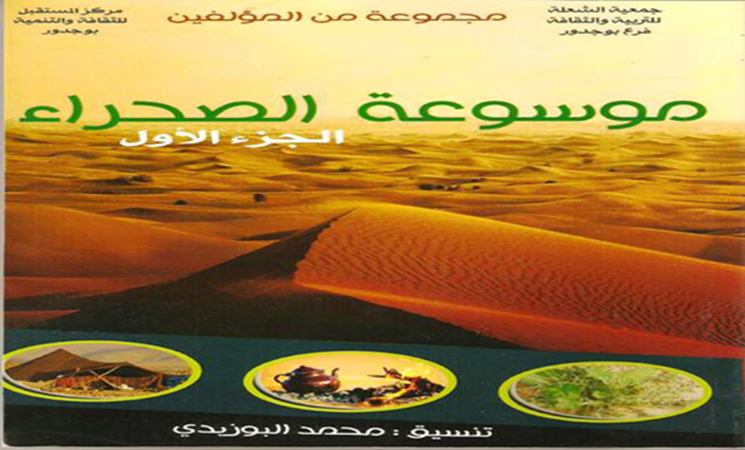ليس هذا الكتاب (الصحوة: النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية) مجرد سيرة ذاتية ساحرة لشخص مثير للجدل جداً، بل هو كتاب يتجرأ على مواجهة أكثر القضايا تحدياً في العصر الحديث بأمانة فائقة.
ليس كتاب ديفيد ديوك (الصحوة) لضعاف القلوب، أو لأولئك المعتدّين بنظم معتقداتهم، بل لأولئك الذين لا يخشون من أن تحفزهم الحقائق والأفكار التي ربما تضع المعتقدات الراسخة موضع تساؤل. إنه كتاب ثوري تطوري ربما (يهز الحضارة من الأعماق) كما يقول غليد ويتني (Glade Whitney) العالم البارز في علم الوراثة السلوكي. يكرس ديفيد ديوك معظم كتابه لوجهة نظره في الأعراق وتضميناتها المجتمعية والتطورية، ولكنه حكاية مثيرة لرجل عرف بوصفه صورة كاريكاتورية رسمتها له وسائل الإعلام المعادية.
وفي كشفه لمرجعية الأصوليين المعاصرين ، فإنّ أ.خليل يرى أنه «إذا كان سيد قطب هو المرجع القريب للإسلاميين (كتبها الإسلامويين) الأصوليين ، فإنّ شيخ الإسلام ابن تيمية هو المصدر الأصيل والأثير لديهم)) فابن تيمية يرى أنّ «النكاح (أى الزواج) فيه الجمع مُلكًا وحُكمًا والجمع فعلا بالحس والحبس وكلاهما موجبه وهما متلازمان)) وكان تعليق أ. خليل «إذن ابن تيمية من رأيه أنّ موجبات عقد الزواج أنه يُعطي الزوج حق المُلك والحبس على زوجته وأنهما مجموعان في يده بمقتضاه)) بل إنّ ابن تيمية يخطو خطوة أوسع : «فيُقارن بين الزوجة والعبد المملوك ، فيرى أنهما سواء لافرق بينهما ، فعندما يتحدث عن النفقة بالنسبة للزوجة ، يُقارن بينها وبين نفقة المملوك ) العبد) ثم ينتهي إلى أنه «ففي الزوجة والمملوك أمره واحد».
وفي نبش الأصوليين في تراث التخلف ، فإنهم يعثرون على أصولي آخرهو ابن القيم الجوزية الذي هو كما كتب أ. خليل «واحد من المرجعيات التي تجد قبولا بالغًا لدى الأصوليين)) وقدّم . خليل بعض النماذج من كتابات ابن القيم الجوزية التي تحط من مكانة المرأة والتركيزعلى أنها موضوع للفراش ، وكأنما المرأة خُلقتْ لإمتاع الرجل ، سواء في الدنيا أوالآخرة ، إذْ أنه (ابن تيمية) بعد أنْ يُقدّم وصفًا تفصيليًا لكل الأبعاد الحسية لنساء الجنة ، يكتب عن الأوصاف المعنوية لهن «فهنّ المُتحببات إلى أزواجهنَ والمطيعات لهم والحسنات التبعل ، وفسرها أبو عبيده : حُسن مواقعتهن وملاطفتهن لأزواجهن عند الجماع مع شدة عشقهن لهم . وفي تفسير آخر: أنهن العواشق ، المتحببات ، الغنجات ، الشكلات ، المتعشقات ، المغنوجات».
وامتلك أ. خليل شجاعة الكتابة بأنّ «خطاب الأصوليين في خصوصية مكان المرأة ووظيفتها مستمد من (النصوص) وبغض النظرعما يُقال عن تفسيرها وتأويلها)) ومن ثم فإنّ الإلمام بظروف المجتمع والبيئة التى انبثقتْ عنهما تلك (النصوص) أمرعلى درجة كبيرة من الأهمية ، بل هو مفتاح فهمها وتعليل ما ورد بها من أحكام وأوامر ونواه ومُحرّمات».
ورغم أنّ أ. خليل متخصصٌ في التراث العربي/الإسلامي إلاّ أنه عندما يكتب يكون بصره وتكون بصيرته دائمًا على مصر. وعلى سبيل المثال فإنه في كتابه )العرب والمرأة) وبعد أنْ أثبتَ الوضع المزري والمتدني للمرأة في التراث العربي ، عقد مقارنة بينها وبين المرأة في تراث الحضارة المصرية ، ولأنه عالم يحترم لغة العلم ، فقد اعتمد على مجموعة من المراجع المتخصصة فى علم المصريات ، ومنها التي تناولتْ وضع المرأة في مصرالقديمة . أما عن السبب الذي فرّق وميّز بين الوضع الإنساني للمرأة المصرية ، والوضع اللاإنساني للمرأة العربية فهو»بكل بساطة الفرق بين الحضارة ، بل أعرق حضارة عرفها التاريخ وبين البداوة».
وإذا كانت الديموقراطية (إحدى آليات الليبرالية) تعني تداول السلطة من خلال حق الشعوب في الانتخاب الحر المباشر، وإذا كان الأصوليون يُعادون هذه الآلية الليبرالية، وبالتالي يُعادون قيم الحداثة التي انتزعتها الشعوب عبْر آلاف السنين، وعبْر آلاف التضحيات، فإنّ أ. خليل له موقف واضح وصريح بالنسبة لموضوع الديموقراطية، فكتب عنه كثيرًا، في كتابه المهم (الجذورالتاريخية للشريعة الإسلامية) وفي مقالاته العديدة في مجلتي (أدب ونقد)، (اليسار) وفي كتابه (الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية) الذي نص فيه على «ليس صحيحًا ما يدّعيه بعضهم أنّ الشورى هي (الطبعة العربية أو الإسلامية) للديموقراطية، ذلك أنّ الاختلاف الجذري بين كنه وطبيعة النظاميْن يؤكد لنا أنه إدعاء فاسد . وكذلك القول أنّ الديموقراطية هي الوسيلة العصرية للشورى ، فهذا خلط للأوراق وتمييع للمفاهيم وهدم لحدود التعريفات».
وفي تفصيل غاية في الوضوح شرح أ. خليل الفرق الجوهري بين الشورى والديموقراطية . فالشورى نظام يقتصرعلى أخذ رأي (الملأ) أي النخبة. أما (القبيل) أي الجماهير فلا حساب لها عنده ولا قيمة ، في حين أنّ الديموقراطية نظام «يرتكزعلى رأي القاعدة الشعبية العريضة ، لا على (الايليت) أو النخبة أو الصفوة أو الملأ أو مجلس الشورى ، فالديموقراطية تعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب . أما نظام الشورى العربي فهو شيء مختلف ، يتأسس بالدرجة الأولى على استبعاد رأي الجماهير الشعبية ، سواء في اختيار نظام الحكم أو في اختيار من يتولون الحكم.. «وليس مصادفة أننا لم نقرأ في كتب التاريخ الإسلامي أنّ (خليفة) أو (واليًا) تم تنصيبه عن طريق الانتخاب الحر المباشر الذي شاركتْ فيه جماهير المسلمين (السواد أو العامة أو الرعية) فهؤلاء (الضعفاء أو المستضعفون) لم نقرأ أنّ خليفة راشدًا أو غير راشد استشارهم أو حتى التفتَ إليهم أو شعر بوجودهم» وبالتالي فإنّ (البيعة) ليستْ «انتخابًا بأى صورة من الصور» أما الديموقراطية فإنها تقوم على ركيزتيْن: 1 – الاعتماد على رأي الشعب ، لا النخبة أو الملأ أو مجلس الشورى أو أهل الحل والعقد 2- الزام الحاكم بما ينتهي إليه رأي الجماهير أو الشعب».
وفي قراءته للواقع المعاصر فإنه كتب عن سبب «أخير يُدعّم دعوتنا إلى (إقالة الشورى) واحلال الديموقراطية محلها : وهوالطغيان السياسي من قِبَلْ غالبية حكام العرب والمسلمين وبطاناتهم المتعددة الأشكال» وأنّ التمسك ب»الشورى يُساعد على تجذيرالطغيان السياسي وتكريسه واستشرائه واضفاء سند شرعي عليه» ولذا «فليس من باب المصادفة أنّ عددًا من الأنظمة الحاكمة حكمًا استبداديًا تُشجّع على عودة (الشورى) وشن الحملات الضارية على الديموقراطية ونعتها بأبشع الأوصاف ، وهذا ما تفعله وبذات الحماس والهمة الجماعات الفاشستية التي ترفع شعارات دينية لإخفاء أهدافها السياسية الدنيوية».
وإذا كان الأصوليون يُروّجون لمقولات تؤدي إلى المزيد من التخلف مثل الزعم بأنّ (النصوص المقدسة) سبقتْ وتنبّأتْ بكل ما جاءت به العلوم الطبيعية ، فإنّ أ. خليل كان يمتلك شجاعة الرد على هؤلاء الأصوليين فكتب «لم يحدث- ولومرة وحيدة- أنْ خرجوا علينا ب (نظرية علمية) إنسانية أو طبيعية استقوها من (النصوص) وهذا أمر بديهي لعدة أسباب منها ، أنّ هذه النصوص ليس من وظيفتها إفراز نظريات علمية . كما أنّ البيئة التي ظهرتْ فيها لم تكن مُهيّأة لظهور نظريات علمية في زمانها ، فما بالك بعد مضى نيف وعشرة قرون ، وأخيرًا فإنّ النظريات العلمية إنما تجيىء نتجة للتجريب والملاحظة ولاتُمطرها السماء عن طريق النصوص».
وفي ذات السياق تصدى للأصوليين الذين «ما إنْ سمعوا بمسألة حقوق الإنسان حتى بادروا إلى الزعم بأنّ (النصوص المقدسة) نادتْ بها قبل أنْ يُعلنها )الفرنجة) بأكثرمن عشرة قرون ، وعلى ذلك فقد طلعوا علينا بما أطلقوا عليه (الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان) عام 1981ب (هيئة اليونسكو) نتيجة إلحاح وإلحاف من (المجلس الإسلامي) وارتكز هذا الإعلان المهيب على آيات من القرآن وأحاديث نبوية».
وبموضوعية العالم فإنّ أ. خليل يرى أنّ (الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان) يفتقر إلى بُعديْن أساسييْن : الأول هو البُعد البشرى ، حيث أنّ )حقوق الإنسان) انتزعها البشر بنضالاتهم انتزاعًا وبتضحياتهم ودمائهم وأنها ليست منحة إلهية أو عطية نبوية أو هبة خليفية . وأنّ تلك الحقوق لو جاءتْ من أي سلطة فوقية ، فإنه من اليسير انتزاعها ، لأنّ من وهب شيئًا يستطيع أنْ يرجع في هبته.. إلخ والثانى هو البُعد التاريخي ، وهذا البُعد بدوره ينضوي على عنصريْن : الأول هو التراكمات التاريخية ، أي خبرة الشعوب في صراعها ضد الطواغيت الحاكمة وتراكم هذه الخبرة طوال التاريخ البشري . والثاني هوالاختلاف في المضمون من حقبة إلى أخرى. وأنّ (حقوق الإنسان) لوكانت مرجعيتها (النصوص المقدسة) فإنها بهذه الحالة «تتسم بالاستاتيكية والثبات وعدم التغيير، لأنّ هذه المرجعية لايجوز تخطيها أو مجاوزتها لقداستها المطلقة ، في حين أنّ الطبيعة البشرية لتلك الحقوق تُعطيها ديناميكية وقدرة على الحركـة ، حيث أنّ التاريخ البشري أثبت «أنّ حقوق الإنسان منذ قرنيْن – ولانقول من عشرة قرون أو أكثر- تختلف عن حقوقه في الوقت الحاضر، وهي بالقطع سوف تختلف عن حقوقه بعد قرون».
وفي سبيل تدعيم وجهة نظره فإنّ أ. خليل وهو يُقدّم قراءة نقدية لتوجهات الأصوليين الذين «فى غمرة حماستهم الفجة للإسلام ومحاولة إظهاره في كل ميدان، أذاعوا (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وأرجعوه إلى (النصوص المقدسة) ولو أنهم أرجعوه إلى نضالات المسلمين والعرب التي خاضوها خلال الثورات التي رفعتْ لواءها الفرق المتباينة : الخوارج ، الشيعة ، المعتزلة ، القرامطة ، الزنج والثورات الشعبية في مصر ومنها الثورة العارمة التى انفجرتْ فى عهد المأمون العباسى (ثورة البشموريين) والذي حضر من بغداد عاصمة خلافته ونجح في إخمادها بوحشية دموية.. لو فعلوا ذلك لكان لإعلانهم ذاك مصداقية أكبر».
في عام 1997روّج الأصوليون لفكرة إقامة احتفال بمناسبة مرور14قرنًا على (الغزو/ الفتح) العربي لمصر. وردّدتْ الثقافة السائدة البائسة هذه الدعوة ورحّبتْ بها ، إلاّ أنّ أ. خليل كان له رأي مغاير تمامًا ، فكتب مقالا وضع له العنوان التالى (نعم للاحتفال بدخول الإسلام مصر.. ولا للاحتفال بالغزو العربي» في هذا المقال فرّق بين الإسلام كديانة وبين الغزو الاستيطاني الاستنزافي الذي قام به العرب ، حيث أنّ الدعوة للدين لاتستدعي «تجييش الجيوش وتجنيد الجنود وتعبئة الصفوف)) وأنّ الفتوحات التى تمتْ «لم تستهدفْ نشر الإسلام أبدًا . لقد كان الهم الأكبر والأوحد لأصحابها هو قضم ثروات البلاد الموطوءة وهبشها ونقلها إلى موطنه الشّرق ، وأسر رجالها ليصيروا عبيدًا وخولا لهم وسبي نسائها الوضيئات وشاباتها الحسناوات ليُمتّعوا بهن أنفسهم ، وفرض الضرائب المتنوعة على أهلها ليعيشوا هم سادة مُنعّمين على حساب عرق العلوج . والعلوج هو الاسم الذى كانوا يُسمون به أهالي البلاد المفتوحة)) وإذا كان هناك من يتشكك فى هذه الوقائع التاريخية ، فإنّ أ. خليل يسد عليهم باب الشك قائلا إنه اعتمد على «أمهات كتب التاريخ العربي / الإسلامي التى تلقتها أمة لا إله إلاّ الله بالتجلة والقبول وفي مقدمتها مؤلفات : الطبري ، اليعقوبي ، ابن كثير، البلاذري ، المسعودي ، الواقدي ، ابن قتيبه الدينوري ، أبو حنيفة الدينوري ، المقريزي ، الكلاعي وغيرهم وغيرهم» وبعد أنْ وجّه النقد إلى المؤرخين المحدثين وإلى الأكاديميين من حملة الدكتوراه ، لافتقارهم للأمانة العلمية ، اختتم مقاله قائلا «نخلص من ذلك إلى أننا نقول بملء أفواهنا : نعم للاحتفال باعتناق أهل مصر للإسلام ، ولكن كلا ومليون كلا للاحتفال بالغزو العربي الاستيطاني الاستنزافي» إنّ ما ذكره أ. خليل عن الغزو العربى فى المقال المنوه عنه ، كتبه بتفاصيل أكثر فى كل كتبه ، فمثلا ذكر حديثًا لعمربن الخطاب قال فيه إنْ عاش لقابل (أي العام المقبل) فسوف يُرسل للراعي نصيبه في العطاء وهو قابع في باديته. وكان تعليق أ. خليل «ف (العلج) المصري (وفق التعبيرالعربي) يشقى طوال العام وولاة (أي عمال) عمر يضعون يدهم على حصيلة كده ويُرسلونه إلى عمر الذى يُوزّعها على صحبه حسب مراتبهم وما يفيض يبعث به إلى راعي الغنم وهومستلقِ على قفاه فى باديته» وفى كتاب آخر كتب عن صعيد مصر «الذى دهستْ أراضيه قبائل كثيرة مع الغزو العربي الاستيطاني بقيادة عمرو بن العاص الذى فعل الأفاعيل هو وجنوده في مصرالمحروسة عكس ما يزعمه حملة المباخر من المؤرخين المحدثين « وهكذا في كل كتبه لم يُخالف ضميره العلمي . وكانت الحقيقة قبلته والعقل الحر مرجعيته ، فلم يُهادن أو يُغازل الأصوليين ، الذين يستهدفون جر مصر إلى عصور الظلم والظلمات ، مثلما فعل كثيرون من مدّعي الليبرالية .