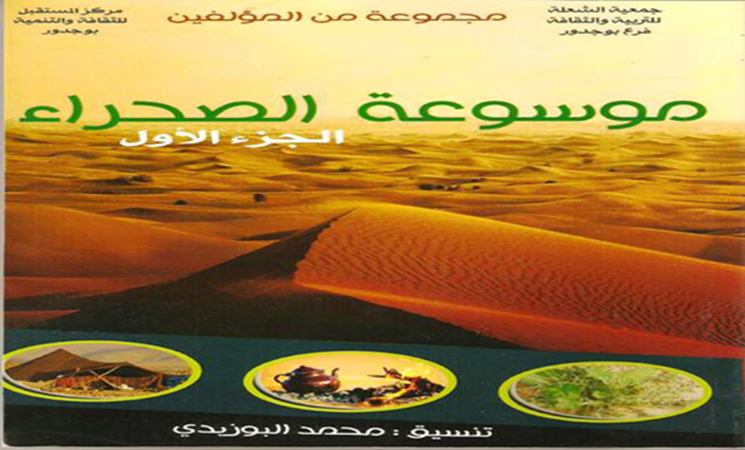ظهرت إبّان مرحلة الاستشراق الإسرائيلي -وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل المدرسة اليهودية في الاستشراق (اليهودية، الصهيونية، الإسرائيلية)- عدّة كتابات حول قصص القرآن الكريم؛ ولم يكن ذلك غريبًا إذ إن المدرسة اليهودية في الاستشراق بجميع مراحلها واتجاهاتها مثَّلت امتدادًا للمدارس الغربية في الاستشراق، وكرّرت ما طرحته هذه المدارس الغربية من فرضيات حول القرآن الكريم، وبالتالي فقد (كرّرت) الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية هي الأخرى نفس فرضيات اقتباس القرآن الكريم لهذه القصص من العهدَيْن القديم والجديد، خاصّة لقصص ما يُعرف في الديانة اليهودية بــ(الآباء أو البطاركة) مثل: آدم، وإبراهيم، ويوسف، ويعقوب، وهي الشخصيات المؤسِّسة أو الكبرى في الفكر الديني اليهودي؛ إذ أطلقت الكتابات الاستشراقية الإسرائيلية عليهم لفظ «الأنبياء المشتركون»، أي: المشتركون بين اليهودية والإسلام.
يحاول هذا المقال اكتشاف الملامح الرئيسة لتأويلية الباكستاني فضل الرحمن مالك، حيث يبحث منطلقاتها والمرتكزات الرئيسة لها، ويلقي الضوء على الأدوات المنهجية التي استخدمتها، والرهانات الرئيسة لها، كما يحاول التداخل النقدي مع أهم ركائز هذه التأويلية.
في المقال الأول حول القراءات الحداثية للقرآن، مقال (المداخل العامة)، كنا قد أشرنا لإشكالَيْن رئيسَيْن من الممكن اعتبارهما من أهم السياقات المعرفية المُنشِئَة لـ(القراءات الحداثية للقرآن)؛ الإشكال الأول هو تأزُّم الخطاب الإصلاحي والنهضوي العربي والإسلامي، والذي تجسّد معرفيًّا في سيطرة التلفيق و(التجاور) والتساكن بين المنظومات الفكرية المختلفة على بنية هذا الخطاب، والإشكال الثاني هو الفراغ المنهجي الذي سببته واقعة اهتزاز التقليد خصوصًا في مساحة تفسير القرآن؛ وهما إشكالان متداخلان بالطبع دفَعَا الخطاب نحو تأسيسه الثاني على ما أوضحنا هناك، ونحن حين نتناول خطاب فضل الرحمن مالك المفكر الباكستاني (1919- 1988م) فإننا نجده يؤسِّس ذاته في قلب هذه الإشكالات المُتداخِلة ويُقدِّم تأويليته للقرآن كمحاولة لتجاوزها.
فنحن نجد في هذا الخطاب إلحاحًا واضحًا على إشكال (التجاور)؛ وهذا لأن فضل الرحمن قد قارب القرآن بالأساس من خلال مشروع واقعي وأكاديمي لدراسة واقع النظام التربوي والتعليمي الإسلامي، وهو الاشتغال الذي كشف له عن سيطرة (التجاور الميكانيكي) -كما يسميه- على هذا النظام في كلّ البلاد الإسلامية؛ سواء الهند أو تركيا أو مصر، بين نظام تعليمي وتربوي إسلامي خالٍ من الحداثة، أيْ من القدرة على «تحقيق إنتاجية ثقافية أخلاقية إسلامية في كافة حقول الجهد العقلي»، ونظام تعليمي غربي حديث لا ينطلق من (مبادئ العقلانية الإسلامية) ولا يتأسَّس عليها، بالإضافة لمحاولات غير مُجدِية لأسلمة هذا النظام التعليمي والتربوي عبر أسلمة العلوم التي تنتظم داخله طبيعية كانت أو إنسانية.
ويعتبر فضل أن الحل لتجاوز هذا التجاور -والذي هو مجرد مثال للتجاور الذي يشمل كلّ مساحات المؤسسات والأفكار في واقع البلدان الإسلامية- هو العودة «للقرآن في انطلاقته الأولى مع محمد» ، واكتشاف العقلانية الإسلامية والممكنات الكامنة في هذا القول القرآني المؤسِّس للجهد العقلي الإسلامي في كلّ المساحات.
وهذا الحل الذي يقترحه فضل الرحمن هو ما يدفعه للتأكيد على هذا الجانب الآخر من الإشكالات المؤسِّسة لنشأة الدرس الحداثي للقرآن؛ أيْ غياب وجود منهجية واضحة لقراءة القرآن بعد واقعة اهتزاز التقليد، ففي مواجهة تلك الاستشكالات التي قد ترد على حَلِّه الذي يفترضه، من قبيل أن تلك الدعوة -دعوة العودة للقرآن في انبثاقته الأولى- هي نفسها دعوة الجميع ربما من إحيائيين وحداثيين، مما يجعل حديث فضل الرحمن مُكرَّرًا يَعِدُ بنفس الآمال المحدودة، عن رؤية ربما هي التي تسببت في نشأة هذا التجاور على مستوى الفكر والواقع من الأساس، يجيب فضل بأن يميز اشتغاله عن هذه الاشتغالات بكونه بالأساس لا يركّز على إنتاج تأويلات جديدة بل على بلورة منهجية تأويلية متماسكة تُمَكِّنُنَا من استخراج ممكنات القول القرآني ومن ربطها بالحياة المعاصرة للمسلمين، في صورة بعيدة عن أيّ تجاور أو تبرير.
ومحاولة بلورة هذه المنهجية التأويلية هو ما لا يقوم به الحداثيون ولا الإسلاميون في رأي فضل مما يبرر طرحه؛ فالتحديثي الكلاسيكي -وفقًا له- لا يمتلك أيّ منهج يستحق هذا الاسم، بل يقتصر نشاطه على التعاطي الإجمالي مع مشكلات تبدو له وكأنها تتطلب حلًّا يفيد المجتمع الإسلامي، لكنها في حقيقتها مُستلهَمة من تجربة الغرب. أما الإسلاميون الأصوليون فإنهم «يتحدثون عن الأصل دون بلورة أيّ فكر أصيل من حوله، ولا يملك الإحيائي الجديد سوى أن يكون ردّ فعل على ما يأتي به الحداثي الكلاسيكي حول بعض القضايا الاجتماعية، دون أن يُتعب نفسه في البحث عن منهجية للتفسير القرآني تكون أمينة وموثوقة دراسيًّا وعقليًّا»[iv]؛ لذا فرغم الاشتغال الطويل على القرآن وعلى الحداثة وعلى الإشكالات التي يطرحها لقاؤهما أو صدامهما، إلا أن قضية المنهج تظلّ غائبة عن العقل الإسلامي -وفقًا لفضل- وفي هذا الغياب، ومن أجل ملء هذا الفراغ بمنهج متماسك يتجاوز التجاور الفكري والواقعي يؤسس فضل تأويليته للقرآن.
يطرح فضل تأويلية للقرآن يؤسسها نظريًّا في كتاب (الإسلام والحداثة، 1978م) أو الإسلام وضرورة التحديث كما هي الترجمة العربية، فيُحدِّد منطلقاته ويُبلوِر منهجيته في التعامل مع القرآن، ويثير الأسئلة التي قد تُثار على تأويليته في منطلقاتها وأدواتها، ويحاول الإجابة على هذه الأسئلة بالدخول في نقاش مع هذه الاعتراضات المُتوقعَة، ثم في كتابه الأهم ربما (المسائل الكبرى في القرآن، 1980م) يقوم فضل بتقديم تطبيق لهذه التأويلية بتحديد المسائل والموضوعات الكبرى للقرآن التي تُشكِّل مركز تأويليته مزدوجة الحركة كما سنوضح.