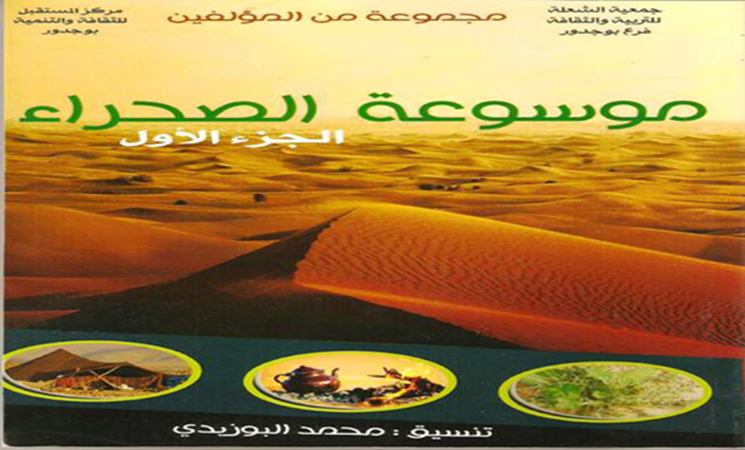لا يغيّر في شيء قول علماء الإعجاز بنفي شبهة الشّعر عن القرآن، وسعيهم إلى اصطناع مصطلحات له، تنأى به عن مصطلحات القصيدة. فقد سمّى الفرّاء نهايات الآيات “رؤوس الآيات” ( أثر القرآن في تطوّر النّقد العربي ص.240) وهي تسمية لا تبعد كثيرا عن مصطلح القافية. جاء في الحديث ” على قافية أحدكم ثلاث عقد”، أراد بالقافية ” القفا ” ( مؤخّر العنق) كتاب القوافي الأربلي ص.91. ويفهم من كلام أبي هلال على عمل الشّعر وما يقتضيه من وضع القوافي، أنّ القافية هي رأس البيت. قال : ”ولأن تعلو الكلام فتأخذه من فوق فيجيء سلسا سهلا ذا طلاوة ورونق خير من أن يعلوك…”كتاب الصّناعتين ص.139 ؛ بل أنّ الفرّاء استشعر لمح الصّلة بين قوافي الشّعر ورؤوس الآيات وحاول أن يقارن بينهما. وهو ما عابه عليه ابن قتيبة كتاب القرطين ص.149 , نقلا عن أثرالقرآن ص.240 . وسمّى أبو الحسن الأشعري نهايات الآيات ”فواصل” حتّى لاتلتبس بالسّجع والقافية. ولعلـّه أوّل من قال بنظام الفاصلة في القرآن، وقصرها على نظمه.
إن تشكيل مناحي وفضاءات الفكر العقلاني النقدي، إنما يقتضي منا مجاوزة مواقف التبجيل والتمجيد والعصر النسّاء لذاكرته، وفتح مساحات طالما أغلقت في ثقافتنا، نحن هنا أمام أمر عظيم فلا يتعارض الضّمير الإنساني الحرّ مع العزّة الإلهية، بل لقد كان دائما هدى في عالم يعاد بناؤه.
لقد طرح السلف من الأسئلة المهمة الكثير ولكنهم ما لبثوا أن أعرضوا عن الخوض فيها، لحظة أتيحت فرصة بسط الخطاب أمام الأبصار وتخلل الذهن الوهم، إنه تدرب مضن على تحمل الإنفراد بالتعامل مع المجاز ذلك العصيّ على الفهم المباشر، وهو ما به اختص القرآن : النص ربّاني الدقة، فالقرآن هو الله في تجليه، إشارات وتعابير بديعة وإيحاءات: إنه ضرب من ضروب حلول الله في الكون. فكيف كانت تتم عملية نقل القرآن من حالة الوحي إلى قلوب الذين كان يقرأ عليهم؟ متى بدأ جمعه، ووفق أيّ معيار تم ترتيبه في مصحف؟
عديدة هي الأسئلة التي وصلت إلى فرط من الإضاءة ، جعلها تختفي منذ زمان طويل في مطاوي الإيمان أو في مظانّ الوضوح البريء.
ولكنّ سؤالا عنيدا ومرعبا يأبى أن يستكين: هل يطال النقد النص القرآني أم يقتصر على الشروحات والتفاسير؟ فينفتح توق إلى التفكير والإنصات إلى قراءات ممكنة تقدمها مساحة المصحف المفتوحة، وهو ما من شأنه أن يضعنا أمام رهبة المقدس.
في تدبر النّص القرآني:
حقيق بنا أن نشير إلى أن عمق النظر يوضح أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال الاكتفاء بالبعد الغيبي التعّبدي وقطع نشأة الإسلام بالتاريخ وتناسي أبعاده الدنيوية التي انفتح في مستواها النص القرآني على التراث اليوناني، وهو ما أفقد السور والآيات تدفّقها الذي كانت عليه لما استحالت “مجرد حكم أو وصية”. وإذا نحن دققنا النظر فيما أومأ إليه “الصدّيق” يتوضح أنه إنما يريدنا أن نعتقد أن هذا الطريقة في التعاطي حرمت النص من تعددية معان لا يمكن اختزالها، بل أن “الصدّيق” يعمد في محاججاته المرهفة إلى تأكيد مفاده أن مثل هذا الترتيب قد يكون المتسبب الأول في قتل البعد الكوني في القرآن.
من أجل ذلك يصبح مطلوبا منا أن نصرف جهدا غير يسير لإعادة تركيب المشهد، فثمة تساوق وتواشج عميق بين العجز عن أن نصير ما نريد، وافتقاد الرغبة في الانتماء إلى زمن العالم، وقد قطع “يوسف الصدّيق” [2]عمرا ليس بالقصير ينظر في هذا التقليد الذي ليس بالقليل، فهذا المفكر الذي نوّد محاورته في هذا العمل والوقوف على أبعاد أطروحته التي توطد في مستواها عزمه على إعادة النظر في مرتكزات “استقرّ فيها التفسير على أرض التلاوة والترتيل لا على مفهوم القراءة الحقّ بمعناها الأوفى” يفكر في هذا الذي ذهبوا إليه وكأنه مشكل يقع خارج أفقنا، لا يعني نفسنا العميقة والقديمة في شيء. ذلك أن القراءة (قراءة العالم والوجود) ما عادت مما يشغل به هؤلاء أنفسهم من جهة ما هو القدرة على إبداع المفاهيم وابتكارها في سياقات العصر وبأدواته، إلا أن الأسلاف أدركوا ذلك فساهموا في تأثيث مناخات حداثة ممكنة – فالحداثة سؤال يطرح لما تتكلس آليات التحول- ونسج سردية تصر على أن تكون نحوا من الحضور الموجب، غير خجول، على صعوبته وتعسّره، إنه جهد مضني يروم معرفة الذات، في علاقة مع الآخر باعثة على أسئلة جذرية يونانية – فالذاكرة ليست نساءه – وإبراهيمية – فنحن أنسباء نبيء.
ولأن “يوسف الصدّيق” يدرك أن النقد والتسامي والمجاوزة إنما يقتضيان عدة معرفية عميقة ومنهجية صارمة ورهافة إنصات للنصوص ينتبه إلى أن القرآن يحض على القراءة والتفكير والنظر والتأمل والتبصر والتدبّر إنه نسيج نصيّ عظيم إلا أن ما يلفت الانتباه : هذا التعاطي القائم على تناقض رهيب في مستوى فهم المتعالي الإلهي وعلاقته بالناسوتي البشري: فمن ذا الذي جعل من المصحف أحكاما مغلقة ومطلقة؟ ولمَ نسأل الكتب السماوية عمّا لم تقله؟
والقول الذي هو أولى بالصواب عند “الصدّيق” هو أن ـ”القراءة” إنما تعني التفكيك والتركيب المتجدّد للوحدات المعنويّة ثم وصلها مع غيرها من المعاني في ذات النصّ ،وباستنتاج يمتلك من الثراء الفتّان ما يمتلك يؤشر إلى أن “القراءة” في كبرى النصوص تشترط قدرات أقوى وتحمّل العبء الأعسر في استحضار المعنى وبسطه. وإمعانا في التحديد والضبط يذهب إلى أن القراءة : تفكيك وتأليف وتنسيب في الأحكام وانفتاح على التاريخ ، من جهة ما هي قراءة نقدية حرة مبدعة تقطع مع كتب التفاسير.
وبما أن الأمر كذلك فإن “الصدّيق” يعين القراءة بوصفها امتثالا يكشف عن الحرف المكتوب من الإله.
وبحكم أن النبي قد توفّي وانقطع الوحي فإن القراءة الوحيدة المتبقية هي القراءة العقلانية.