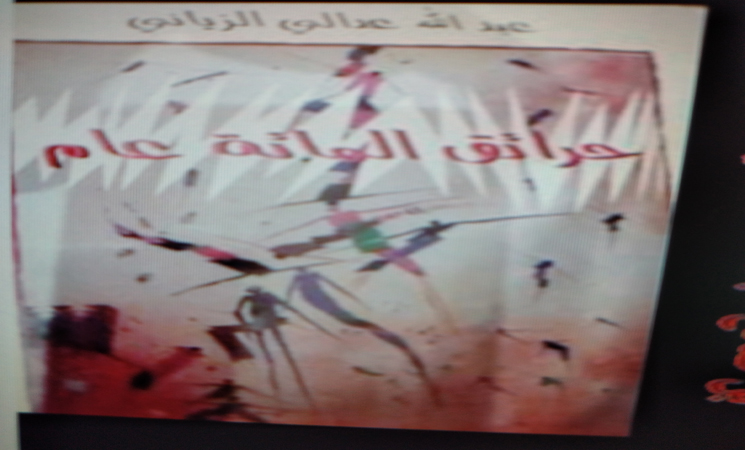“حرائق المائة عام ” رواية استهلالية وباكورة لمسار سردي غرس بذرته الأولى الروائي “عبد الله عدالي الزياني” ، الكاتب العصامي الذي تشرب الثقافة الأمريكية. تقع الرواية في 280 صفحة من الحجم الكبير الصادرة عن مطبعة ديماكروف بالدار البيضاء سنة 2011 .
الكاتب عبد الله عدالي الزياني يتحدر من ضواحي مدينة الفقيه بن صالح. عاش عبد الله لأكثر من عشرين سنة تقريبا بالديار الأمريكية، صنع فيها نفسه وبنى شخوص المتخيل السردي وملامح وأوصاف الأمكنة، متخذا من الرواية قاطرة لتنمية الاقتصاد السردي وتأهيل بنيته التحتية الإبداعية .
الرواية التفاتة إلى الوراء استحضرت زمن الطفولة المغتصبة التي عاشها الكاتب بحمولتها الغرائبية، وذلك ضمن كرونولوجيا تاريخية حافلة بأشد أشكال العذابات والفواجع والإكراهات الحتمية الاجتماعية، وأيضا استحضار الزمن القاسي من تاريخ المغرب زمن الأمراض والأوبئة ممزوجة بمرارة الفقر والجوع و الجهل والسيبة …
ما يشغل حالنا في هذا المنجز السردي هو عامل الموروث الثقافي الشعبي بكل تمظهراته الخفية والجلية ، فإذا كان “وليام أوجبرن” يفرق بين الثقافة المادية والمتكيفة. فالأولى مجموع الأشياء وأدوات العمل، والثانية الجانب الاجتماعي كالعقائد والعادات والتقاليد والأفكار و اللغة … فإن هذا الجانب الاجتماعي هو الذي يعكس سلوك الأفراد شخصيات هذه الرواية، هذا ما يميز العمل الفني للكاتب الماتع أي حضور المرجعية التاريخية ذاتيا وموضوعيا بقوة ، تنهل وقائعه من واقع تلونت حرائقه الموجعة والموغلة في أعماق الجسد والروح .
هو واقع اختفى تقريبا ولكنه حاضر في ذاكرة الكاتب / السارد و يأبى النسيان. واعتبار المؤلف سيرة ذاتية يختصر مرحلة زمنية من عمر الإنسان المغربي مادة وموضوعا بكل تناقضاته وآماله و طموحاته المجهضة .
والمتدبر في رواية “حرائق المائة عام ” يجد نفسه قسرا إزاء موروث ثقافي شعبي شفوي، أسس لثقافة خاطئة، كانت سائدة في ذلك الوقت ولا تزال وهي ذات خلفية اجتماعية ودينية، تحكمت فيها لغة الهدم من خلال استحضار وعي مغلوط صادم عشش في ذهن الأسلاف والآباء هو عامل الجهل والأمية، حيث تأفل الحقيقة وتتمظهر مقابلها الغيبيات وعوالم اللامحسوسات كالجن والعفاريت والسحر والشعوذة والتمائم… وتصير الروحانيات ذات شأن عظيم في واقع تبخرت فيه العلوم واختفى فيه الفقه والتحليل وتحكيم سلطة العقل والمنطق.
السارد إذ يستحضر هذا الزمن السالب لحرية الفكر، فإنه يعزو ذلك إلى معياري الجهل والأمية يقول السارد:”اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون” ص 15 . إنه تاريخ حيث “بلارج” كان وليا من أولياء الله بدون ضريح، وحيث الشجرة تعلق عليها التمائم لتخليص المرضى والمصابين بالجن والبرص والفقر واليأس …
كل هذا الانفلات نابع من ثيمتي الجهل والأمية الجهل بالثقافة السليمة والفكر السوي للعقيدة أولا والتحليل العلمي ثانيا. هذا الجهل بالموروث الثقافي العقدي حاضر على لسان أم السارد عندما تقول :”هي أ وليدي صلاة العصر بالسر ولى بالجهر ؟ … و تبدأ القراءة : الله أكبر . صلى الله على سيدنا محمد . أنحمد الله رب العالمين الرحمن رحيم ملك الدين …” ص 96. لكن هذا النقص الحاصل في المكون الشرعي لدى شخصيات وبعضها في المتن السردي راجع إلى ثقافة وراثية اتخذت من مقاربة النوع معيارا غير منصف، سعى إلى التقليص من تدخل المرأة وحصر لغتها ووجودها بشكل عام بين أربعة جدران، فساد اللحن لعدم ثبوت مؤشرات المقارنة بين الإكساب والاكتساب . وقد يتعدى الموروث الثقافي الشعبي لغة الجسد إلى معجم الروح والتعذيب النفسي السادي خاصة أثناء البكاء على الميت أو النواح وهو عادة جاهلية وجدت في واقع هش تربة خصبة فأينعت كما هو الحال عندما يقول السارد في وفاة أمه:
“أ مي يا مي واجا ما يوصلني ليك
واش من دموع تكفيني فيك
أ مي يا مي واش يبرد القلب المجروح
من غير نبكي و نوح ” ص 132
لقد توارثت شخصيات الرواية، ومن ضمنها السارد، لغة النواح جيلا عن جيل ، حتى صار ذلك عادة. جاء على لسان السارد : لقد ورثت نواح أمي التي كانت خنساء القبائل” ص 132.
وفي هذا المضمار يجيب “ابن باز” حول سؤال النواح أو النياحة أنه الواجب على المسلمين الصبر والاحتساب وعدم النياحة . يقول النبي (ص) :” النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرات ودرع جرب” رواه مسلم في الصحيح . بل الأصح في ذلك يقال كما قال الرسول (ص) في موت ابنه إبراهيم :” إن العين تدمع، والقلب يحزن ، و لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون” صحيح البخاري 2/82
إنه موروث ضارب في أطناب الجهل متوغل في الأمية، وعدم الوعي بلغة ومحتوى الفكر العقلي النقدي. ولعل الحرص الشديد أو الخوف من تحكيم سلطان العقل، أو الاستسلام إلى الغيبيات وميتافيزيقيا الظواهر الخفية والمستعصية التي يصعب تفسيرها، يجعل الموروث الثقافي المنفلت والخاطئ يستحوذ على العقل والفكر معا ، فيصير الإنسان أمام خسارة الجهل وما يترتب عنه، يتخذ فيه الإنسان من أخيه الإنسان ضحية وقربانا ، نظرا لجهله بالشريعة وقوانين العقل بدل ذلك تسود تيمات السطو والاتجار باسم الدين كما وقع ليلة نفوق البقرة، يقول السارد :” لم يدر الرجل ما يفعل، يتمتم بكلمات لم يسمعها أحد وعيناه ممدودتان إلى السماء مع بقية الجالسين . همدت البقرة وأسلمت الروح جيفة ! قام الشريف وصاح : شي واحد معانا هنا ما فيه إيمان … الشريف استدعى أحد الفلاحين والمريدين وقال له : إلى جبتي لي شي خروف عمرو ستة أشهر أنا ضامن ليك الجنة ” ص 173
وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول :”ليس العلم ما حفظ بل العلم ما نفع “، فإن حفظ الموروث الثقافي في ثلاجة الصدور الشفوية لا يصلح إلا لتغليط الرأي العام، بل من الواجب وحري بذلك إخضاعه إلى مقاييس المنطق وثوابت العقل كما قال “ديكارت”، جاعلين من الفكر آلية للاشتغال ، “أنا أفكر إذن أنا موجود” لغة مقابلة لقول السارد :” أنت ما كتعرف الليف من الزرواطة وباغي تحرث و درس خاصك تتعلم بعدا”ص 167_168
ومن نافلة القول أن “رواية حرائق المائة عام ” لعبد الله عدالي الزياني سطرت في حدود “الكائن والممكن” قضايا مصيرية، تندرج ضمن الموروث الثقافي الشعبي غير السليم ، مع استحضار حقبة عصية من تاريخ المغرب اختلط فيها الفقر بالجهل والأمراض، مستثمرة معجما بسيطا وعاميا ، ليؤسس بالمقابل وعيا جديدا، يعتبر مرجعية فكرية حل محل الخرافة والجهل والأسطورة، بحمولته التاريخية مع تحيين الوقائع والأحداث بما يناسب العقل، عبر صفعة تشكيكية هي فرصة للأجيال القادمة .