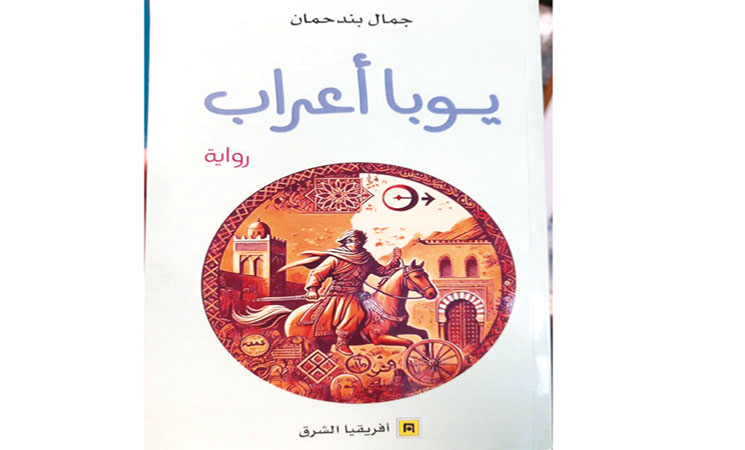وفيها، ومنها نبغْتُ، فأضحيت راوياً وراويةً بالمشافهة التي أثثت وزخرفتْ «استراحاتنا الحائطية»، وعطلنا المدرسية في غياب السفر إلى مكان ما، إلى مدينة ما، وإلى البحر، مثلاً، الذي لم يره الطفل إلا على كِبَرِهِ. كان السفر مستحيلا أو يكاد؛ ومن ثَمَّ، عوضه الطفل/ الشيطان بالمداومة على حضور الحلقة، وإدمان الإنصات النابه إلى الحَكَّاءِ الذي لا يمل من الحكي، ولا ينسى فقرة البارحة المروية التي وقف عندها، ونحن عالقون بفمه، بحكيه، متوسلين أن لا يقطع حبل الكلام، ويقطع معه شوقنا إلى معرفة أين وصل البطل، هل تحقق مراده، ونال بغيته، وكُوفيءَ بلقاء الجميلة الحسناء المحروسة والمحوطة بألف ثعبان وتنّين، وعَرَمْرَم من تلال نار وحفر تفيض بماء يَحْمومٍ؟، أم أنه أخفق ورُدَّ على عقبيه من قِبَل الحَرَس المدجج، والضواري والحيات المتربصة؟. فالحكواتي بارع ـ وذلك بحكم التجربة والخبرة والمراس ـ في إنهاء حكيه عند النقطة الساخنة المشوقة المتحكمة في مسار القص والحكي، والتي تقف عندها الأنفاس، وتخفق القلوب، ويغلي الدم في العروق، وينشف الريق في الأفواه.
ولسائل أن يسأل: ماذا كان يحكي؟، وكيف لحكيه أن يشد الأنفاس، ويعمل في الأبدان والقلوب والعقول، ما يعمله الخدر اللذيذ، والنوم الهنيء، والعسل المُصَفَّى، والطعام الشهي، والشراب العذب، وعيون الحسناوات النجلاوات؟، وكيف أمكن أن يحفظ عن ظهر غيب، مسروداتٍ تاريخيةً أو أسطوريةً هي من الطول، والبنينة المركبة، والتحولات المفصلية، والاكتناز الشخوصي ضمن المتون المحكية المروية بحذق ومهارة، وتقمص عجيب، لا نملك حياله إلا الإشادةَ والتصفيق، والثناءَ على « علم « الرجل، ونباهته، وعدم إخلاله بخيط المحكي، أو تمزيق نسيج المروي الذي يُنْتَسَجُ ويلتئم لُحْمَةً وسَداةً بعد سداةٍ، وخيطاً عقب خيطٍ حتى يتشكلَ النص، ويتجسْدَنَ مسروداً متناسقاً منسجماً، غايةً في البناء والإتقان، والإجادةِ؟
لقد عَلَّمَنا « المعلم» غير الرسمي، المعلم الحر، الفنان الفطري الشعبي، أن للتاريخ ـ بما هو لبناتٌ وطبقاتٌ، وعمائرُ، وحوادثٌ، ووقائعُ ـ ارتباطا بالصيرورة الزمنية، وعلاقةً بالتطور الإنساني والعمراني. وأن الماضي السحيق كان، في جله، تليداً، مُمَجَّدا ـ والعهدة عليه ـ إذ ظهر فيه أبطال دونهم أبطال اليوم، و» سَحَرة « مثيرون دونهم سحرة اليوم، وعماليقُ يُزْرُونَ بأقزام اليوم. فعليهم، وبفضلهم، أصبحنا ما أصبحنا، وصرنا ما صرنا. فهم من أوصلوا الزمن إلى ما هو عليه، ورسموا للواقع صورةَ ما هو فيه. إنهم خرافيون أسطوريون من حيث بطولاتُهُم الخارقة، وفروسياتُهم الهائلة، لكنهم، في اعتبار الحكواتي، وفي اعتبارنا، تَبْعاً له، تاريخيون عاشوا أزمنتهم، ونَمْنَموها ونَقَّعوها، بجبروتهم وعظمتهم، في الدم والصراع، وفي بَلْسَمِ الحب والحياة أيضا. فلم يكن الملك « سيف بن ذي يزن «، والأمير « حمزة البهلوان «، والخليفة « علي بن أبي طالب « مع رأس الغول، والأميرة « ذات الهمة «، والشاعر الفارس « عنترة بن شداد «، والشاطر المحتال « عمر العيار «، وغيرهم، أشخاصا خرافيين ورقيين، بل كانوا تاريخيين من لحم ودم، وأبعاد وجودية، قَصُرَتْ عنها أبعاد أحفادهم، وأحفاد أحفادهم.ا.ا
مِنْ هؤلاء، من تاريخيتهم العجيبة المدهشة، وزمنيتهم الخارقة التي تنوس ـ حكائيا وروائيا ـ بين الحقيقة والخيال، والخرافة والواقع، والتاريخ والأسطورة، شَكَّلَ الطفل ـ مع زمرة من أترابه ـ « ثقافة « أخرى، موازية، مكملة لِ « الثقافة « الرسمية: ثقافة الكُتّابِ، والمناهج والبرامج المدرسية الثقيلة والمُمِلَّة. ومنهم قَبَسَ الذَّلاَقةَ والطلاقةَ عند أجوبة معلميه وأساتذته، وانبرى « زعيما « محدِّثاً، وراويا مؤثثاً فراغاته، وفراغات زملائه، مضيفا ـ متى ما أسعفه الخيال ـ إلى ما سمعه بالحلقة، وتشَرَّبَه باللهفة ـ أكاذيبَ مزوقة، يفترض أن الحكواتي تفاداها أو نَسيَها، أو سقطت منه سهواً في أثناء الحكي. ولربما كان لتلك القصص التاريخية، والمرويات الأسطورية التي مصدرها الحلقة، يدٌ في ما أصبح عليه الطفل وهو « ينضج « رُوَيْداً.. رويدا، حيث ظهرت « ثقافته « التي لا يجادل فيها اثنان، فبات، من دون أن يخطط لذلك أو يسعى إليه، مثقف الحي الذي لا يشق له غبار. فكان قارئ الرسائل البريدية لنساء الحي « الأميات «، اللواتي اخترنه، ولا يعرف لماذا اخترنه هو بالذات، مع اكتظاظ الحي بالأقران والأتراب، بل وبمن كان يفوقه سنا ودراسة وشطارة وتجربة ومكراً. كما كان الطفل الشقي / الجذلان والشيطان، يقرأ ويطالع لهن « بختهن»، حظهن، ما يعني مستقبلهن من خلال ما يقرأ في كتاب: ( دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار)، و (قرعة الأنبياء )، و ( قرعة النساء )، و(كتاب الرحمة في الطب والحكمة )، و (تفسير الأحلام لابن سيرين )، وكتب أخرى صغيرة الحجم لم يعد يذكر عناوينها، كانت مادته المرجعية يجلبها أبوه ولا يدري الطفل من أين، ومِمَّنْ؟
كُنَّ ينْفَحْنَه فرنكات، وأحيانا دريهمات لقاءَ ما أخبرهن به من أنباء لا يأتي بها الهدهد نفسه، وما كشف لهن من أسرار و» حميميات»، تجد صدىً لديهن، فيصدقنها مستغربات، فاغرات الأفواه،، ضاربات صدورهن تعبيراً عن خوفهن ورجائهن أن يحدث ما يتوقعنه، ويقع ما ينتظرنه، وما أنْبأتُهُنَّ به، وكان كله ـ بطبيعة الحال ـ كذبا في كذب ـ واحتيالا في احتيال، ومكراً بهن، واستِغلْاَلاً لسذاجتهن لاستقراء ردود أفعالهن، وشبوب عواطفهن، أو برودة أبدانهن، ومثلوجية أطرافهن إذا لم يجدن في النبإ ما يُسَرّي ويخففُ عنهن ما يجثم على قلوبهن، ويملؤهن أملا ورجاء، وتشوّفاً.
كل ذلك يجري بمنزلنا حول مدفأة متوقدة ملتهبة، مسعورة « الشَّرْبونْ «، محمرة الوُجْنات، والجذع والأطراف والحواشي. يجري بعيدا عن عيون ومعرفة أزواجهن الذين كانوا ـ زمنئذٍ ـ يرتابون في اختلاء المرأة بالرجل ولو كان طفلا غِرّاً؛ وفي زيارة المتسولين أو المشعوذين لمنازلهم مخافة حلول الشيطان ضيفا عليهم، ومخافة « النفاثات في العقد»، وقارئي وقارئات أوراق الكوتشينة، والفنجان، وضاربات وضاربي الرمل والطحين.
لكن دور « المثقف» الذي َاسْتَمْرَأْتُهُ واسْتَطَبْتُه، وواظبتُ عليه سنةً أو أكثر، واللعبة التي استعذبتها واستحليتها إذ كانت تُفيءُ وتُغدِقُ عليَّ « رزقا»، يُسْعفني في ابتياع بعض متطلباتي الصغيرة كعلب السردين، و» صُوصيطْ بَّ عْمْرْ، واكتراء دراجة هوائية للطواف بها حول منازل البنات، لم يدوما، فما لبث أن فطن أبي لفعلتي، وتنبَّهَ لخطورة ما يقوم به ابنه من سحر وشعوذة، وجَمْعِ دزينة من النساء كل عشية في منزله، وقد كان يظن أنهن يزرن زوجه لتبادل الكلام، وتزجية أوقات الفراغ، فأمر بوقف « المهزلة «، متوعدا إياي بأشد العقاب إذا ما فاجأني أحمل « الكتاب « ذاك بين يدي، ومهددا أمي بالويل والثبور إن هي أصرت على استدعاء الجارات إلى بيتنا. بل تجرَّأَ ذات ليلة وقد طار صوابه، واستبد به الغضب، فمزق تلك الكتب تمزيقاً، وألقى بها في فم التنور، في أحشاء المدفأة.
أما سبب تَفَطُّنِهِ للأمر، فهو تأخري في الصف الدراسي، وتَحَصُّلِي على علامات ضعيفة، وشكوى معلمي له مما أصبحت عليه من تأخر في المواكبة والتحصيل، وعدم إنجاز لتماريني، وحفظي لدروسي. وقد فعلوا خيراً إذْ أنقذوني من بئر كنت أنزل إلى قرارتها يوما بعد يوم، وَحرَّروني من كذب أصبحت مولاه: أتقنه، وأتفنن في صياغته صوغ القاهر المتحكم. وأبعدوني عن طريق كانت ستؤدي بي إلى امتهان حرفة ساحر كَهّانْ متخصص في إحضار الموتى، وترقيص الجَّانْ.. !!
فهل يكون ذاك الكذب الجميل الذي وراءه خيال الخيال، هو ما زيَّنَ لي دنيا الكتابة، وعالم الحبر والمحبرة، وأدخلني مدخل صدق أو كذب في محرابه، وجنته وجحيمه؟، ألم يقل المَثَلُ الأدبيُّ: أعذب الشعر أكذبه؟
فها أنا أكذبُ، وسأستمر في الكذبِ !! .
نبضات : الحلْقة: مدرستي الموازيةُ

الكاتب : محمد بودويك
بتاريخ : 01/01/2021