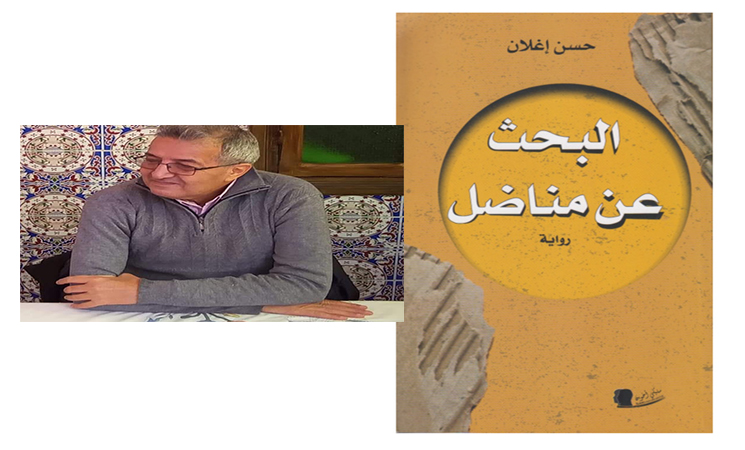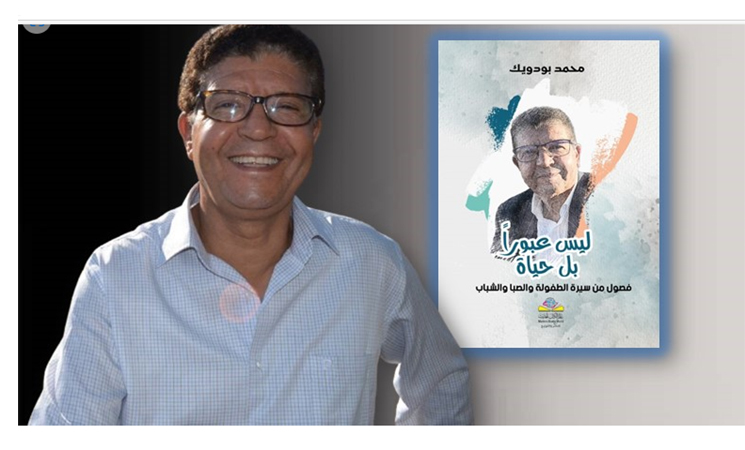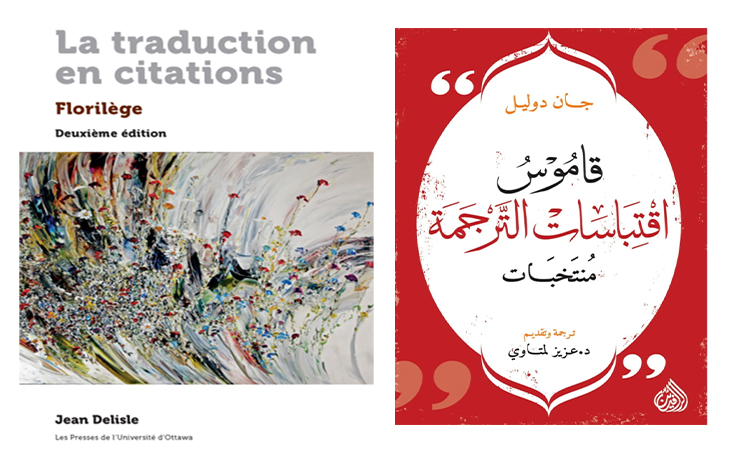في هذه القولةِ، يقصد الكاتبُ الفنزويلي ميغيل بونفوي دولَ أمريكا اللاتينية جميعَها، وليستْ فنزويلا فقط، وبـ(الأساطير) سيكتبون تاريخَهُمْ، وليس بـ (الحقائق والوقائع)!..ومن لا تاريخ له، عليه أن يصنعَ تاريخَهُ، كي يتفادى أسئلةَ الناشئةِ، فيلجأ، مثلا، إلى ابتكار مناسباتٍ وذكرياتٍ من تغذية الخيال، ومواسمَ وهميةٍ، كما سنرى، ليشعرَ جيلُها بانتمائِهِ وهويتِهِ، وخصائصَ شخصيتِهِ الوطنيةِ، التي يتميز بها عن سائرِ الأمَمِ !
وهنا نتذكر الروائي الكولومبي غابرييل غارثيا ماركيز الذي أبرز، جليا، هذا النَّهجَ في السَّردِ بروايته الرائعة: ((مائة عام من العزلة))!.. والحقيقةُ أنَّ قارئَ ((رحلة أوكتافيو)) يمكنه أنْ يُدْخِلَها في خانة (الواقعية السحرية) وإنْ كان البعضُ يراها تتجاوزُ ذلك. فالفلاحُ الذي اكتشف نفسَهُ أُمِّــيًّا بين سكان قريةٍ متعلمين، سوف لا يتحمَّل الوجودَ بينهم، أو يطيق النظرَ إلى وُجوهِهِمْ، ولن تحلو له الحياةَ في القريةِ، إنما سيرحل في ظروفٍ قاسيةٍ ليحقِّـقَ لقاءً تاريخيا بين الفنزويلي ووطنه، بين المرأةِ والرجـلِ، بين الأُمِّي والكـتابة، بين الكـائـن والأسطورة، بين المواطن الفنزويلي وتاريخِهِ…!
لم يكن أوكــتــافــيــو يعرف وطنَهُ، رغــم أنه فــتح عــيــنــيْهِ عليهِ، وعاش فيهِ طفولتَهُ وشبابَهُ . ولم يكن يعرف شعـبَهُ، رغم أنه يحيا بين أهلِهِ، وليس له سِواهُمْ . ولم يعرفِ القراءةَ والكتابةَ بَتَاتًا، يكفي أنْ يطلبَ من الطبيبِ كتابةَ وصفتِهِ الطبيةِ بخطٍّ عريضٍ على خشبةٍ أو طاولةٍ (ربَّما لنقصٍ في الورق) ثم يضعها على ظهره، ويسير مُقَــوَّسا إلى الصيدليةِ في حَـيِّـهِ الفقيرِ ليشتري الدواءَ !
هكذا يعيشُ فلاحٌ أمِّيٌّ، يسمى (أوكتافيو) ومن هنا ستنطلق رحلتُهُ، كي يعرفَ وطنَهُ وشَعْــبَهُ، ويُجيدَ القراءةَ والكتابةَ، و(الأهَـمُّ من كلِّ ذلك) أنْ يتعلمَ كيفَ يُحِبُّ ويعشَقُ !
لكنْ، قبل أنْ يستعرضَ الكاتبُ رحلةَ أوكتافيو، يضع مقدمةً شاملةً لَها، بمثابةِ لبنةٍ تأسيسيةٍ لوطنِ الرَّحَّالةِ. ففي عام 1908 أُصيبتْ فنزويلا بوباءِ الطاعون، وبقي يَــفْــتِــكُ بسُكانِها خمسين عامًا بالتَّمامِ والكمالِ . في هذه الحقبةِ، قرر أهلُ قريةِ (سان بول دو ليمون) بضاحيةِ العاصمةِ (كراكاس) أنْ ينظموا موكبا دينيا، من الرجال والنساء والأطفال، يُعَبِّرون في أجْوائِهِ الروحانيةِ عن إيمانِهِمْ القوي، وحُبِّهِمْ للسماءِ، علَّها ترحمُهُمْ وترأفُ بِهِمْ، فـتشفيهِمْ من هذا الداءِ الخطيرِ، فكانوا يطوفون بين الدروبِ والأزقَّةِ بخطى بطيئةٍ وثابتةٍ، وجِباهُهُمْ تتعرَّقُ، يتقدمُهُمْ تمثالٌ خشبي ضخمٌ للقديس بولس، يرتدي معطفًا بنفسجيًّا مطرزًا بالذهب، وتزيِّن رأسَهُ الزهورُ، والتاجُ الْمُشَوَّكُ، والأجراسُ النحاسيةُ، التي لها دلالاتٌ وأبعادٌ ترميزيةٌ، وتــتبعه فرقةٌ موسيقيةٌ، تصدحُ طبولُها وأبواقُها بالــتـرانـيـم !
وكان الموكبُ ينتقل من حي إلى آخر، لكنه عندما بلغ دارَ العجوز (كَرْيولْ) تطلُّ من حديقتِها (شجرةُ ليمونٍ) هاجمَهُمْ ببندقيةٍ صاعقةٍ، وتحت إبْطِهِ حُزْمةٌ من الخَراطيش، صائحا بصوتٍ عالٍ، وعينين تقدَحانِ شررا : تنحَّوْا، سأقتل أولَ من يعبر السِّياجَ !
فتراجعوا إلى الوراءِ خائفين منه، ومن سُخْط الشجرةِ وغضبِها، تاركين التمثالَ الخشبي معلقا بأغصانِها!..ولَشَدَّ ما تعجَّبوا، عندما رأوْها تُمَدِّدُ غصونَها وترسِلُها طويلا كأنَّها شُعورُ امرأةٍ مُسْدَلةٌ، ثم تبسُطُها كلَّ البَسْطِ على الْفِناء والسِّياج، لتسقط منها مئاتُ الحباتِ من اللــيــمون، مثلَ وابلٍ من البرَدِ ! وسيزدادُ تعجُّبُهُمْ أكثرَ، عندما يتناولونها بقشورها، فــيُشْـفَــوْن، حينًا، من داء الطاعون، وهي في نظرِهِمْ إشارةٌ من السماءِ على قوَّتِها العلاجيةِ، بدلَ الدواء البشري، الذي لم يُــفِــــدْهُمْ طيلةَ خمسةِ عُقودٍ . وما كان من سلطاتِ القريةِ، إلا أنْ تُحطِّمَ دارَ الشيخ العجوزِ، وتبني معبدًا بَدَلَها، بين أشجار السَّرْو، وتُبْقي على الشجرةِ المباركة (بالمناسبة، نتذكر الشجرةَ المقدسةَ للروائي المغربي الراحل محمد زفزاف بالرباط)!.. وحولها توافد الناسُ، يبنون الدورَ والأسواقَ والمؤسساتِ ويُنشئون الحدائقَ حتى أصبحتْ مدينةً قائمةً بذاتِها، وقابلةً للحياةِ . أما شجرةُ زفزاف (فقد كانتْ زائراتُها يعلِّقْن بأغصانِها قطعا ملونةً من الثوب، ويلمسْنَ لِحاءَها بأنامِلِهِنَّ مع قُبُلاتِهِنَّ تبرُّكا بها، قبلَ قطْعِها)!
ولمَّا اختفى الطاعونُ، ومرَّتِ السِّنونَ، نسي السكانُ القصةَ، وأصبحتِ الحياةُ عاديةً، إلى أنْ سُرِقَ التمثالُ، وحَلَّقتِ الشجرةُ في السماء، وهُجِرَ المعبدُ، ولم يَعُدْ لليمون ظهورٌ ولا حضور بين الفواكه، إلا رائحة أوراقِهِ التي تُداعِبُ الأنوفَ، بين الحين والآخر، واسمُها الذي يتردد على الألسنةِ!..وغدتِ الأرضُ خاليةً من أهلِها الأصليين، بلا أولادٍ ولا أحفادٍ ولا أجدادٍ، ولا أحد يــتــذكر تاريخَها !
بهذه التوطئةِ، يقود ميغيل بونفوي قارئَهُ على خطى أناس لا يعرفون تاريخَهُمْ، ويُهْمِلون تُراثَهُمْ وتقاليدَهُمْ وأعرافَهُمْ!..وهي مُسْتوحاةٌ من نصٍّ شعــري لـ(أنــدريــــس إيــلــوي بلانكـــو) موسومٍ بـ(شجــرة اللــيــمــون المباركة) يقول في مقطع منه : ((كانتْ للعجوز دار وخسرها . وكان للدار فِــناء وجدار، وشجرةُ ليمونٍ وبوابة . ويْلٌ للضربةِ التي تقطع شجرةَ الليمون . لقد سقطتْ حباتُها كالمطر، الواحدةُ تِلْوَ الأخرى لتشفي المرضى)) !
تبدأ معاناةُ أوكْـتافْيو، عندما يكتشفُ أنَّهُ فلاحٌ أُمِّي، لا يعرفُ القراءةَ والكتابةَ، كسائر الجيلِ الجديدِ في وطنِهِ . إنه في الطبيعةِ، يقرأ بعينه، بأذنه، بكل حَواسِّهِ، يعرف كيف يقرأها، يعرف كيف يشرحها، لكنه لا يعرف كيف يتواصل مع الآخر، وكمثال، يعجز عن قراءة وفهم الوصفة الطبية . إنه يشعر بالخجلِ الشديدِ، ويُمارسُ سلوكاتٍ غريبةً، تدلُّ على اضطرابِهِ وارتباكِهِ النفسي، كأنْ يُحْدِثَ جُرْحا عميقا في ذِراعِهِ، ثم يلفُّها بخِرقةٍ، كي يُغَطي عن جَهْـلِهِ، فيجلُبَ له عطْفَ الكثيرِ من الناسِ . ويواظبُ على هذه الحالِ، إلى أنْ يلتقي في مقهى بامرأةٍ فاتنةٍ، مثقفة وممثلةٍ، ومهتمة بتاريخ بلدِها، تُسمى (فنزويلا) فتُشْفـقُ عليه، وترى فيه من مزايا جسمانية ونفسانية وعقلانية ما يجذبها إليه، رغم إعاقـتِهِ (المصطنعة) فــ((فتحتْ قلبَها لوضوحه البارد)) وبذلك، تغيرت حياته ((فكَّتْ إلى جانبه أبجديةً لم تكنْ تعرفها، بالنسبة لها، وبسببها سيكتشف أوكتافيو قوةَ الكلماتِ وسِحْرَها، وفي تلك اللحظة، تغلبتْ عليه الرغبةُ العنيفة في إعادة تسمية العالم منذ بداياتِهِ))..ستحتضنه هذه المرأة بكل حنانِها وحدبِها، فيُلْــفي نفسه غارقا في حبِّها!
وكان على هذه المرأة الجميلةِ والذكيةِ أنْ تفهم عيوبَ عشيقِها، فتلقـنه دروسا، وتمكِّنُهُ من العلم والمعرفةِ، دونَ أنْ يُحِسَّ بأدنى سخرية منها، أو يشعر بمضايقةٍ أو تبرُّمٍ من طرفِها وعلى يدِها، سيقرأ تاريخَ وطنِهِ، ونِضالَ شعبِهِ، في الوجودِ والبقاءِ !
كان هناك شيءٌ آخرُ يُنازِعُهُ، ولا يقدر على دَحْضِهِ؛ إنَّها صداقـتُهُ القديمةُ مع تلك العِصابة التي يقودُها (روتيليو ألبرتو غيرا) تسطو على الأحجار والتُّحَفِ الثَّمينةِ، وتُخْفيها في المعبد، وإنْ كان لا يُشاركُها في عملياتِ السَّطْو والسرقة التي تُنَظِّمُها . وسيتفاجَأ، حين تقتحم العصابةُ بيتَ حبيبتِهِ فنزويلا، فتستولي على كلِّ أحجارِها الكريمةِ، وتُحَفِها النفيسةِ، ولا يدري ماذا يفعل؟!..لم يجدْ سبيلا غيرَ الرحيلِ عن حبيبته فنزويلا (المرأة والوطن) ويسير في الأرض بعيدًا، فيخطو عبر الغابات الكثيفة، والجبال الشاهقة، والسيول المتدفقة، والطبيعة البرية والكهوف الغامضة، لمقابلة الأطفال والرجال والغرباء . إنه العملاق (هكذا يشعر في نفسِهِ) الذي يعرف كـنـزَ معرفة القراءة والكتابة، يتحول إلى قارئ!..وفي رحلتِهِ، سيحيا وحيدًا، وخلالَها سيكتشفُ التاريخَ الحقيقي لوطنِهِ، كأنه يريد أنْ يولَدَ من جديد . فيرى شعوبا كيف تفكر وتعمل وترتقي، وأخرى كيف تتعلم وتُخَطِّط وتتطور، وثالثة كيف تحمي وطنَها وتفيد شعبَها…وتشاءُ الصدفةُ أنْ يهطل المطر الغزير، وهو يعبر الجبالَ، فيختبئ في كهْفٍ، وهناك يجد أحجارا قديمةً، منقوشةً بالهيرغـليفية المحليةِ، التي تشهد على ماضٍ أعمقَ في التاريخ الفنزويلي، وأكثرَ قيمةً من شجرة الليمون نفسِها، التي يُجِلُّها أهْلُ القريةِ، فيتأمَّلُها أوكتافيو، ليستكملَ معرفتَهُ بتاريخ وطنِهِ . وعندما يُشعل النارَ حولَها، يُصابُ بالذُّهول، فـ((وهج ألسنة اللهب المرتعشة، ترتفع أمامه من جميع الجهات، مثل وحش مخمور، صخرة أرجوانية ضخمة، ترتفع بأربعة أو خمسة أمتار، مقسمة إلى ثلاثةِ أشكال، تزينها رسوماتٌ تعود إلى مليون سنة)) . ثم يحاول فكَّ رموز هذا الحجر، الذي يتحدث كلَّ اللغات، ويذكره بالحجر المسروق من فنزويلا، الذي يُبْدي بقايا حضارةٍ ضاربةٍ في القِدَمِ، ما زالتْ على سطحِها بصماتٌ متبقيةٌ من المشهد الطبيعي للحضارة القديمة، والتي أصبح من الضروري الكشف عنها لفهم مكانها على الأرض))..يكتشف أوكتافيو هذه الأبجدية على الصخر، التي لم ترسم بأيدٍ بشرية، بل بواسطةِ نباتاتٍ، تحركها إرادة خاصة بها، تدل على الوحي الباروكي!.. فالذين يسرقون هذا الصخرَ، يحاولون أنْ ينفردوا بمعرفةِ تاريخ بلادهم، ويحرموا الآخرين من هذه المعرفةِ الحقيقيةِ، ولهذا تكونتْ عصابةٌ من (اللصوص النبلاء) الذين سيُظْهِرون رَدَّ الفعل على هذه السرقات . كما سيكتشف أوكتافيو أنَّ ذلك الصخرَ ما هو إلا كتابٌ، يؤرخُ لـ((ولادةِ الأدب الفنزويلي في نقْش كامبا نيرو الصخري، الذي صمد أمام امتحان الزمن الطويل)) !
هذه الرحلةُ التي دامت سنتين، ستغير العديدَ من الأفكار والأحاسيس والرؤى لدى أوكْـتافْيو، وسيقتنع بـ(بداية جديدة) بداية متعلم ومتخلِّقٍ، لا جاهل ولا سافلٍ ولا أمي، لنقل ونشر تاريخ حقيقي لوطنه . سيعود إلى قريتِهِ (سانت بول دو ليمون) حاملا فكرا جديدا، ورؤيةً مغايرةً للحياةِ، وإرادةً للتغيـير . وبعودتِهِ، سيصبح التمثالُ رمزا للثقافة، وشجرةُ الليمون رمزا لعطاءِ الأرضِ الخصيبةِ، وسيزول عنهما ذلك الفهمُ الغيبي الخاطئُ . كما أنَّه سيبحث عن كلِّ التحفِ النفيسةِ المسروقةِ، ويُعيدُها إلى أماكِنِها وأصحابِها، ليُقْنِعَنا بأنَّ السَّرقةَ، أحيانا، ليستْ جريمةً، إذا كانتِ الغايةُ منها، هي حمايتُها من طَمَع وجَشَع الأثرياء الأنانـــيـــيـــن، الذين يحـــتـــفــظون بها لأنفسِهِمْ فقط، بينما هي لعامَّةِ أفراد الشعب، لأنَّها تبلور إبداعاتِهِمُ الفنيةَ والفكريةَ والثقافيةَ !
كــيــف تــأتَّــى للكاتــب ميغيل بونــفــوي أنْ يــنــسُجَ أحــداثَ هــذه الروايةِ، وهو الذي ولد في باريس ونشأ فيها، وتعلم اللغة الفرنسيةَ، وألَّف بها؟!..لقد كانتْ والدتُهُ دبلوماسيةً، تشتغلُ ملحقةً ثقافيةً، فتستقبل الكتابَ والشعراءَ والصِّحافيين، وكان والدُهُ قاصا، يُقيم في بيتِهِ ندواتٍ ومناظراتٍ أدبيةً . فكانتْ هذه الأنشطةُ، كافيةً لتجعلَ الكاتبَ عاشقًا للأدب، منذ طفولته الأولى . لكنْ، كيف خصص أدبَهُ لوطنه الأصلي فنزويلا، وهو لم يولدْ أو يترعرعْ في حِضْنِهِ، فينشأ ذلك الحبُّ بينهما؟!..هل رضعَهُ من والديه؟!
كانتْ هناك ثلاثةُ عواملَ أساسيةٍ، تُحَدِّدُ هذا التوجُّهَ : الأول، أنَّ فرنسا تُرَكِّز تعليمَها على الأدب الفرنسي، ما جعلَ كاتـبَنا يتساءلُ مُتَعجِّبا : أليس في العالم أدبٌ آخرُ غيرَ الفرنسي؟!..والعاملُ الثاني، أنَّ فــنــزويلا تُــدَرِّس جــيــلَها الــتــاريخَ الفرنسي والإسباني، فتـنـبَّهُ إلى هذا الاستلابُ والاغترابُ الأدبيـين والمعرفيــين، اللذين أيقظا فيهِ حَــمِــيَّــتَــهُ، وحرَّكا هُــوِّيــتَــهُ ليفعلَ شيئًا ما، وبالضبط، ليُحْيي أدبَ أمريكا اللاتينية . وثالثا، تركتْ فيه قراءتُهُ لروايةِ ((مائة عام من العزلة)) أثَرا بليغا، فأسَرَّ في نفسِهِ : ((كيف يمكنني كتابةُ عملٍ أدبي جميل جدًّا؟!)) .
إذا تمكنتِ الشخصياتُ من التحليق، أو التَّواري عن الأنظارِ في روايةِ ماركيز، فلماذا لا يحوِّل شخصيةً ما إلى (تمثالٍ خشبي) و(الليمون إلى دواء فعَّال)؟!..وكما تأثر ميغيل بماركيز، تأثر الأخيرُ بروايةِ ((التحول)) لفرانتس كافكا، وفيها ستـتحول الشخصية المحورية إلى (حشرة عملاقة) وهذه الروايةُ الرائعةُ (ترجمها إلى العربيةِ الكاتبُ المغربي مبارك وساط 2015) كذلك ميغيل، سيجعل من فلاح أمي بسيط (عملاقا) يحقق المستحيلَ !
و(الواقعية السحرية) هي نَهْجٌ في أدبِ ما بعـد الحداثةِ، يُدْمِجُ عناصرَ (الخيال) في سردٍ (واقعي) أي نسرد أحداثا وشخصياتٍ (أسطوريةً) في بيئةٍ (واقعيةٍ) نستطيعُ من خلالِه أنْ نتعرَّفَها بيُسرٍ، ونستطيع، أيضا، أنْ نجمع بين حقيقـتين متوازيتين .
وتبقى هذه الرواية نموذجا آخرَ للإنسان الذي تصحو ذاكرتُهُ في لحظةٍ من اللحظاتِ الْحَرِجة، ليستعيدَ أرضَهُ وتاريخَهُ، فيحقق تلك القناعةَ الذاتيةَ بالهويةِ والانتماءِ، وإنْ كان هذا الشعورُ ليس عامًّا، لأن هناك عوامل شتى، تتضافر لتشكيلِهِ !
وهكذا نرى الكاتب ميغيل، عبر بطلِهِ الورقي أوكتوفيو، ينقل حُبَّهُ لهذا البلد، الذي تزدهر أرضُهُ بالأساطيرِ، في حكايةٍ تقرِنُ الحلمي بالواقعي، وتتجاوز ما كان يصطلح عليه في بداية القرن العشرين (الواقعية السحرية) !