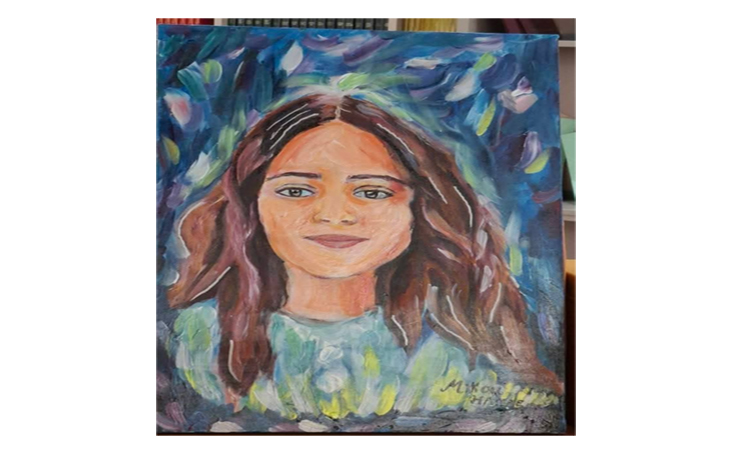أكد الكاتب أحمد المديني في تصديره لمجموعته القصصية الأولى «العنف في الدماغ» التي أصدرها سنة 1971 ما يلي: «لن أزعم بأنني سأقدم عملا يمتلك كل سمات التجديد والأصالة لكني أحس إحساسا عميقا يتجاوز قناعتي الشخصية بومضات الجدة والأصالة في ما كتبت. أومن أساسا بضرورة الخلق، تجاوز حصار العقم والتقليد. لقد مضى زمن طويل على إنتاجنا وهو يقتات من تجارب مكرورة، ويعيد نسج أساليب ومضامين كتاب آخرين «موضيين»، وذلك بشكل ممسوخ يفرغها من كل قيمة فنية». بهذه الكلمات الحاسمة التي صيغت على شكل بيان أدبي، دعا المديني إلى ضرورة اجتراح طرائق جديدة في الكتابة، وتجاوز القوالب الجامدة، وتمزيق كل أكفان العقم والتقليد.
ومن المعروف أن من رحم هذا النص المؤسِّس خرجت تجارب نوعية وتجريبية في المغرب فتحت مسارب جديدة أمام الأدب المغربي بغية تحريره من الطرائق المعتادة والمألوفة في الصياغة والإبداع.
ومنذ إصداره لهذه المجموعة القصصية المتميزة، لم يتوقف المديني عن الكتابة في أجناس أدبية مختلفة كالرواية والقصة والرحلة والشعر والنقد والترجمة. كما ظل وفيا لروح التجريب والتجديد، سواء على مستوى الشكل أو المضمون.
«رجال الدار البيضاء- مرس السلطان» (المركز الثقافي للكتاب، 2021) هي الرواية الأخيرة للكاتب، تتميز أولا بتنوعها وغناها سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف؛ رواية تميزت بقدرة مؤلفها على التقاط التفاصيل وسبر الأعماق والانتقال السلس بين مستويات إبداعية مختلفة، منها التخييلي، ومنها ما يشِط ّفي الخيال واللعب والتجريب إلى درجة الإرباك أحيانا.
ورغم أن العديد من المؤشرات الواردة في هذه الرواية خاصة، تؤكد أنها رواية عن المكان، وبالضبط عن الدار البيضاء- مرس السلطان، إلا أن التوغل في أحداثها ووقائعها سيظهر أنها بقدر ما احتفت بالمكان، شأن عديد من روايات المديني، احتفت أيضا بالزمن خاصة سبعينيات القرن العشرين، وما شهدته من أحداث جسام مرتبطة بالصراع بين المعارضة والحكم في مرحلة أصبحت تنعت بسنوات الجمر والرصاص. لم يعمل الكاتب على تقديم أحداث هذه المرحلة من زاوية نظر واحدة تجنبا للابتسار والأحادية، بل عمد إلى تقديمها من زوايا نظر مختلفة عن طريق فسح المجال أمام رواة متبايني النظرة والحساسية مثل: زهوان، عبد الهادي، المصطفاوي، قاسم، وآخرين.
يعتبر (زهوان) الشخصية الرئيسية في هذه الرواية وسارد أغلب فصولها. وهو أستاذ بإحدى ثانويات الدار البيضاء تمت المناداة عليه للاشتغال آنذاك متعاونا في صحيفة «المحرر» التي كانت تشكل لسان حال المعارضة الاتحادية. ومنذ التحاقه بالجريدة أصبح يعيش حياته بإيقاعين مختلفتين: حياة النهار بالجريدة رفقة مناضلين وصحافيين من أصناف مختلفة، منهم الصادق المستقل ومنهم الانتهازي الموالي، وحياة الليل بمرس السلطان، بحاناتها ومقاهيها وأضوائها وصخبها. لم يكن زهوان صحافيا أورثوذكسيا جامدا على غرار عديد من المناضلين والصحافيين الذين عاشرهم بمقر الجريدة وتجنب الاشتباه بهم أو التماهي معهم: «…لا قاسم المحتال، البكّاي، لا المصطفاوي ولا الجابري الملقحان ضد الابتسام كأنه وباء أو يؤدّى عنه رسوم. نعم أنا، أريد أن أبقى حـرا، وأنت وأصحابك تقرعون الرؤوس صباح مساء: «خصنا نكونوا جادين ومسؤولين يا الإخوان…، خاصنا حوار جاد مسؤول..»! لم أسمعكم يوما تقولون خصنا نعيشوا مزيان. خصنا نتمتعوا في هاد الدنيا خصنا الحب – البهجة» (الرواية ص 260).
كما حافط زهوان على مسافة اتجاه الأجواء المعتملة في قلب العمل بالجريدة مثل الصراع الناشب بين أجنحة الحزب «جماعة الرباط/ جماعة الدار البيضاء» وظل نائيا بنفسه عن الحسابات والمناورات والولاءات التي كانت تؤثر على عمل الصحفيين. فكان مرتابا متحفظا لا يطمئن إلى المظاهر الخادعة. وظلت العديد من ملاحظاته ومواقفه تطفح بالسخرية من صحفيين متجهّمين أو انتهازيين أو موالين. ولم يسلم من غمزه حتى زعيم الحزب الذي كان يحظى من طرف الآخرين بالتبجيل والتعظيم، لم يسمه واكتفى بتلقيبه»اسم الزعيم» « مقابل ذلك، حظي الزعيم الاتحادي عمر بن جلون بمكانة استثنائية في الرواية، باعتباره نموذجا مختلفا للزعامة الحزبية. فقد كان يتميز بالكثير من الحيوية والبشاشة والتفاني في خدمة القضية التي كرس لها حياته. ورغم أنه تعرض لكل أصناف التعذيب، فإنه ظل معينا لا ينضب بالعطاء والتضحية إلى أن تم اغتياله ببشاعة.
استأثرت شخصية عمر بن جلون بفصول هامة من الرواية الشيء الذي يدفعنا إلى القول أن رواية «رجال الدار البيضاء» هي الرواية الثانية التي احتفت بمكانة وقيمة هذا المناضل الاستثنائي إلى جانب رواية «الجنازة» التي جعلت منه واحداً من شخصياتها الرئيس. والفرق بين الروايتين، أن «الجنازة» استعادته في قالب أقرب إلى الخيال والفانطستيك والتجريب، فيما استعادته «رجال الدار البيضاء» من خلال كتابة أقرب إلى التسجيلية والواقعية والاستقصاء الدقيق لحدث اغتياله.
من المعروف أن الكاتب أحمد المديني سبق له أن احتفى بمدينة الدار البيضاء في بعض رواياته السابقة مثل رواية «الجنازة» ورواية «براقـش». غير أن حضورها في هذه الرواية كان أبرز وأقوى، وذلك لكون السارد تمكّن من النفاذ إلى أدق تفاصيلها، واصفاً إياها بالكثير من الأناة والدقة، متوغلا في جنباتها وأزقتها ودروبها، مستحضراً شخصيات وتجارب ظلت لصيقة بها مثل الشاعر أحمد المجاطي، والشاعر مصطفى النيسابوري، والكاتب محمد زفزاف، والشاعر الجوماري، ومجموعة ناس الغيوان، والسينمائي محمد الركاب…. وغيرها من الأسماء التي التحمت بالمدينة وكانت صدى يرجع توق أهلها إلى واقع أفضل. وقد شكلت ساحة (مرس السلطان) منطلق الحكي وموئله. ففي إحدى مقاهيها كان يجلس السارد ويفسح المجال لذاكرته في استحضار الأحداث والشخوص والأمكنة والصور إلى درجة أنه في بعض الأحيان كان يدخل في حالات من الهذيان، فيقوم بحركات تثير فضول وريبة باقي الزبناء: «(…) وقفت لأدقق، وحولي وقف الفضوليون بدورهم ينظرون في اتجاهي، ولما عيِيَ بصرُهم عادوا يتهامسون ألم نقل لكم إنه مسكين يحلّق في الأعالي طار له الفرخ…» (الرواية ص 447). ولم تكن حالات الشرود التي ظلت تنتاب السارد بين الحين والآخر إلا نتيجة الإجهاد الذي اعترى الذاكرة المنشغلة بأحداث الماضي الكثيرة والمتشابكة والحارقة، أحيانا. ولعل المحكي الرئيس في هذه الذاكرة هو محكي جريدة «المحـرر» ونضال جيل برُمّته ضد كل أشكال الإذلال. ورغم مختلف أشكال القمع التي كانت تمارس على المناضلين في مخافر وأقبية عديدة كدرب مولاي الشريف، الكوربيس، غبيّلة… إلا أنهم كانوا يجابهون ذلك بصمود خرافي كان يدهش جلاديهم أنفسهم. فالرواية طافحة بأحداث ووقائع الاعتقال والتعذيب ،الشيء الذي جعل منها شهادة صادقة عن مرحلة حرجة من تاريخ المغرب، مرحلة جيل كان مُترعاً بالآمال والأحلام لولا أن شراسة القمع أجهضت هذه الآمال: «كذلك أصبحوا شتاتا ولم يصمد منهم إلا قليل، غادروا إلى المنافي، الجزائر خاصة، قسم منهم أشباح ومرضى وموسوَسون وحتى ممسوسون، ممن يمشون في الطريق اعوجّت أعناقهم يمشون بها من كثرة ما يلتفتون إلى الوراء ويحسبون ظلهم شبحا يلاحقهم» (الرواية ص 153).
ورغم أن أغلب محكيات الاعتقال والتعذيب كانت تنضح بالمرارة، إلا بعضها لم يخل من هزل ودعابة وسخرية كما هو الشأن بالنسبة لمحكي زوجة أحد المعتقلين السياسيين التي كان يتحرش بها أحد رجال الأمن، وحين يئست من صدّه أوهمته باستعدادها للاستجابة لنزواته، فضربت له موعدا بمنزلها. وحين دخل تحايلت عليه وجرّدته من ملابسه وخبأتها وبدأت تصرخ إلى أن حضر رجال الأمن، وأخرجوه مكبلا ذليلا أمام ضحكات وشماتة الجيران الذين أكبروا فيها جرأتها وشجاعتها. وهنا لابد من التنبيه إلى أن هذه الرواية لم تعن برجال الدار البيضاء فقط، بل اعتنت ببعض النساء أيضا مثل شخصية «نفيسة» التي كانت تشتغل سكرتيرة بالجريدة إلا أنها كانت تتعرض للتحرش من مناضلين وصحفيين بمن فيهم أحد كبارهم!! وبعد أن رفضت الاستجابة لنزوات هذا الأخير، تم فصلها بطريقة مهينة الشيء الذي أظهر أن العقلية الذكورية المتخلفة متحكمة حتى في من يدّعي أنه يحمل أفكارا متنورة وحداثية، طبعا كله مسرود على صعيد التخييل !. وإلى جانب شخصية نفيسة، هناك حضور لافت لامرأة، وإن بطريقة مبهمة، ظلت تلقي بظلالها على ذاكرة السارد فكان يستحضرها من حين لآخر، إلى درجة أنه كان يتخيل طيفها يجالسه بالمقهى، وهو الأمر الذي كان يثير ريبة النادل والزبناء في صحته العقلية. ويبدو أن السارد كانت تربطه علاقة حب بها إلاّ أن حرصه على حريته أفضى بهذه العلاقة إلى الفشل. إن انحياز السارد إلى حريته حصّنه دائما من التماهي مع الأوضاع والتجارب التي عاشها سواء في الحب أو النضال أو الحياة بشكل عام.
ظلت الرواية تعرض مختلف هذه المحكيات بأسلوب يتراوح بين الجد والهزل، الوضوح والالتباس، التلميح والتصريح. ورغم أن بعضها كان يَرْشَح بالمرارة والألم، إلاّ أن السارد كان يبث فيها جرعات من الدعابة والضحك تخفف من وطأتها وقساوتها. كما أن علاقته بفترة السبعينيات كانت مشوبة بالكثير من الحنين والضعف، وهو لم يكن يخجل من الاعتراف بهذا الشعور: «الحنين، الشعور الوحيد الذي لا أخجل ولا أخشى من فداحة رومانسيته المفترضة، يتقدمني ليمسح عن البلاد غبار الأيام ويجعلني أنطق بلسان سفيان بن عيينة:
جسمي معي غير أن الروح عندكم
فالجسم في غربة والروح في الوطن» (ص 580)
تقوى ارتباط السارد بمرحلة السبعينيات حين بدأ يلاحظ حجم التحولات التي طرأت على المجتمع المغربي في المراحل التي أعقبتها كتفشِّي الانتهازية والأنانية والتنكّر للمبادئ وغيرها من القيم النبيلة التي ضحّت من أجلها الأجيال السابقة. فأصبحت تظهر عليه بين الحين والآخـر أعراض «باتولوجية» تبين عجزه عن التعايش مع هذه التحولات السلبية. لذلك تجده يسأل عن جريدة «المحـرر» عند بائع الصحف رغم أن هذه الجريدة توقفت عن الصدور منذ سنين وحلت محلها جريدة أخـرى. كما أصبح يخلط بين التواريخ والوجوه والأشياء الشيء الذي يبين أنه لم يستطع أن يتعايش مع التحولات فأصبح «غريب الوجه واليد .. واللسان» على حد تعبير المتنبي. يقول السارد: « لا تهمني تواريخ محددة، فلم يبق لها من معنى، وإنما بعض الأحداث أتشبث بها، باسترجاعها، فيها علامات من حياتي، وبها أقيس بتذكرها كم بيني وبين اللحد بعد.» (ص 361).
تعتبر تيمة الحنين من التيمات المركزية في هذه الرواية غير أنها لم تسقطها في مزالق الغنائية، بل ظلت شعورا ثاويا خلف استعادة روائية واقعية لأحداث ووجوه وعلامات لها عميق الارتباط بذاكرة السارد دون تقديس أو توثين لهذا الماضي:» لست ممن يقدسون الماضي، من الطبيعي أن لا أقبل عبادة الهياكل والأوثان، حقيقة ومجازا، بدعوى وجودها المتحكم في الحاضر. كما أحرص على حماية الكتابة من الابتذال مُفرداً لها في الكون المنتشر عزلتها العالية، كذلك أحتاج أن أرى أثر وشم اليد لأعترف أنها يدُ أحد.» (الرواية ص 581).
ونظرا للكم الهائل من الأحداث والوقائع التي كانت تثقل على ذاكرة السارد إلى درجة أنه أصبح يخلط بين الواقع والخيال، الحقيقة والوهم، الماضي بالحاضر الشيء الذي دفع به إلى مطالبة المحكمة التي اعتقلته بسبب تغطيته لأحداث 20 يونيو1981بضرورة إحضار الكاتب أحمد المديني لأنه هو الذي ورطه في كل هذه «المشاكل». وهنا تنتقل الرواية، بفضل هذا التدبير الفني الناجع، إلى مستوى متميز في اللعب بين المحافل السردية، والخلط بين الأوراق والخيوط التي تتطلب من القارئ بعض النباهة والذكاء للتمييز بين مستوياتها. وتجدر الإشارة إلى أن من دأب على قراءة أحمد المديني سيلاحظ أن تقنية اللعب هذه الموظفة في الرواية، هي واحدة من التقنيات البنائية الأساسية التي يعتمدها قصد تجديد أساليبه في الكتابة وتطويرها.
وختاما فإن هذه القراءة المقتضبة لا تدعي أنها لامست كل مفاصل ومكونات هذه الرواية الغنية لأن هناك، حتما، الكثير من العناصر والظلال التي تحتاج إلى قراءات أخرى قصد إضاءتها والكشف عن دلالاتها وأبعادها. كما يمكن القول إن هذه الرواية تعد تتويجا لمسار كاتب راكم الكثير من الإصدارات المتميزة والنوعية في أجناس أدبية مختلفة، كما أنه ضمّنها الكثير من الإمكانات الجمالية التي كانت تهجس بها نصوصه السابقة، الشيء الذي بوأها مكانة فارقة في المشهد الروائي المغربي والعربي على حد سواء.
*باحث وناقد أدبي