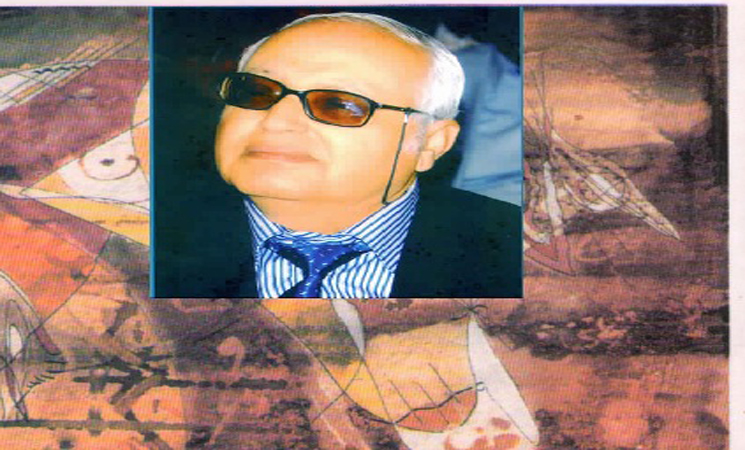عالم الاجتماع مصطفى محسن:لهذه الأسباب تم التضييق على الفلسفة والسوسيولوجيا
مصطفى محسن: عالم اجتماع، كاتب ومفكر عربي بارز من المغرب، خبير في قضايا التربية والثقافة والتنمية… في المغرب والوطن العربي بشكل عام…
تقلد، منذ تخرجه سنة 1972، عدة مهام تربوية وتكوينية وتدبيرية في حقل التربية والتعليم وتكوين الأطر…
اشتغل أستاذا باحثا «في سوسيولوجيا التربية والشغل والتنمية» بمركز التوجيه والتخطيط التربوي/الرباط، وأيضا أستاذا متعاونا مع بعض الكليات ومؤسسات تكوين الأطر التربوية العليا….
عضو مؤسس، أو مشارك في أنشطة عدة هيئات ومؤتمرات ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية، مثل: الجمعية المغربية لعلم الاجتماع /المؤتمر التأسيسي للفضاء المغاربي/ المؤتمر القومي العربي…الخ.
له العديد من الدراسات والمقالات والحوارات والأبحاث والمؤلفات الفردية أو المشتركة. وهي أعمال ينطلق فيها كلها من هدف جعلها تأسيسية متميزة. وذلك حين يحاول إقامتها على ما يسميه بـ »منظور النقد المتعدد الأبعاد« بما هو مرجعية فكرية ومنهجية مؤطرة وموجهة لمشروع الباحث برمته، وبما هو أيضا نقد إبستمولوجي وسوسيولوجي وحضاري حواري وتكاملي منفتح للذات (النحن)، وللآخر (الغربي المغاير)، وللسياق الحضاري باعتباره لحظة تاريخية لتبادلهما وتفاعلهما على كافة الصعد والمستويات. غير أنه، إذ يؤكد على نوعية واستقلالية مشروعه الفكري هذا، فإنه يلح، في نفس الآن، على ضرورة النظر إليه في شرطيته السوسيوتاريخية الشمولية، أي على أنه جزء من كل، أي كأحد روافد حركة نقد عربي فكري وثقافي وحضاري معاصر أوسع وأكثر تمايزا في الأهداف والرهانات والخلفيات والرؤى والنماذج الإرشادية الموجهة… إلا أنها تسعى كلها إلى المساهمة الفاعلة المنتجة في التأسيس الجماعي لفكر عربي حداثي ديمقراطي حواري مؤصل، وإلى تشكيل وعي وثقافة جديدين، وإلى بناء إنسان جديد ومجتمع جدارة جديد…
في هذا الحوار تفاعل السوسيولوجي مصطفى محسن مع كل الأسئلة المطروحة-رغم ظروفه الصحية الصعبة- عن مساره في الفلسفة والتربية والسوسيولوجيا دراسة وتدريسا، وعن التضييق الذي طال شعبة السوسيولوجيا والفلسفة بعدها وتداعيات ذلك على مسار السوسيولوجيين المغاربة أنفسهم. وبوصفه مربيا وفاعلا مدنيا، تطرقنا معه إلى أدوار المجتمع المدني في إشاعة قيم المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية المغربية، وكيف يتصور بناء «مدرسة المستقبل» في تشكيل المواطن/الفرد. وإذا كانت هوية مصطفى محسن سوسيولوجية فإن له إنتاجا محترما في المسألتين التربوية والفلسفية. وما يؤطر خطابه، في كل هذا، هو مشروعه النقدي الحواري المنفتح المتعدد الأبعاد.
p حدثنا عن علاقتك بالسوسيولوجيا؟
nn بالنسبة لعلاقتي بالسوسيولوجيا فقد كانت في صلب اهتمامي بالفلسفة في مدلولها العام. ذلك ان المراجع والمصنفات المشار إليها فيما سبق قد شكلت المصادر الأولى لتعرفي على بعض الرواد المؤسسين لعلم الاجتماع: (سان سيمون، أوجست كونت‘ إميل دوركايم…).إلا أن التحاقي بالجامعة في أواخر الستينيات المنصرمة قد عمق هذه العلاقة، خاصة وأنه كان من بين مدرسي علم الاجتماع آنذاك أسماء متألقة الحضور مثل: محمد جسوس، ورشدي فكار، وعبد الكبير الخطيبي, وغيرهم ممن لم تكن أعمالهم واهتماماتهم بعيدة عن العلوم الاجتماعية والإنسانية عامة، كمحمد عابد الجابري، وعبد الله العروي، وبول باسكون، ومحمد عزيز الحبابي، ورولان بارث…ومن جايلهم من أعلام تلك المرحلة المذكورة.
ولما انخرطت في حقل التدريس في مطلع السبعينيات، وانتقلت، بالتدريج، من حب المهنة إلى طور التفكير في أهدافها المعرفية والسياسية والاجتماعية، وفي الآليات المركبة لاشتغالها نظريات وممارسات… أدركت أن السوسيولوجيا بما هي نقطة تقاطع عدة علوم اجتماعية، بإمكان منظورها الشمولي للظواهر المبحوثة أن يوفر للباحث والمهتم مقاربة تكاملية لتلك الأبعاد والمقومات التربوية الآنفة، هكذا تواصل اهتمامي بهذا الحقل التخصصي على مستوى استكمال التكوين الذاتي، كما على مستوى البحث والاهتمام…
أما فيما يتعلق بما ورد في سؤالكم عن طبيعة تساكن التربية والفلسفة والسوسيولوجيا في مفاصل تكويني وأعمالي-ويمكن أن أضيف إلى ذلك ثقافتي الفقهية، وذائقتي اللغوية والأدبية والتي مارست عبرها كتاباتي الإبداعية (الشعرية خاصة) منذ أوائل الستينيات الفائتة- فإني، وبكل أمانة وصدق، قليلا ما أتفطن إلى هذه الحيثية المعرفية التي أعتقد أنها أمست أحد مكونات شخصيتي الثقافية. ولم أكن أفكر فيها إلا عندما يذكرني بها بعض قراء أعمالي أو طلبتي أو زملائي… ولا سيما على مستوى أسلوب وجمالية الكتابة والتعبير…وقد كان أبرز هؤلاء جميعا أستاذي المرحوم محمد جسوس، الذي كان له الدور الأكبر في توثيق تعلقي بعلم الاجتماع…مما أدرجته في كتاباتي عن فكر ومسار هذا العالم المعلم المبدع الأصيل.
وفي تقديري، فإن هذا التساكن أو التواشج أوالتفاعل العفوي المتهادن لتلك المحتديات المعرفية المشار إليها في وعيي وتكويني ومنجزي المتواضع يعود، من بين ما يعودإليه، إلى ما أكدت عليه سابقا من تفاعل جدلي للعديد من العوامل الذاتية الخاصة، والموضوعية العامة في مسيرتي التربوية والثقافية بشكل عام. كما يرجع ذلك أيضا إلى طبيعة ما تلقاه جيلي، في الخمسيميات والستينيات تحديدا، من تكوين ذي طبيعة “موسوعية” لم تكن تتمثل فقط في تقييم متوازن لأهمية مواد الدراسة، بل حتى في مدرسينا أنفسهم من مغاربة ومشارقة، والذين كانوا حينذاك- ولظروف متعددة- يتنقلون بسلاسة ملحوظة بين مختلف ما يلقنونه من مقررات تعليمية أدبية أو علمية متنوعة. وقد عزز هذا المنحى الشمولي في ميادين التعليم والتعلم عدم تبلور ما أصبح يدعى الآن ب”ظاهرة التخصص الوظيفي” في مجال دراسي أو مهني محدد. كما أن حقل “التوجيه التربوي المدرسي والمهني والجامعي…” لم يكن قد تبلور وتطور وقتذاك إلى ممارسة بيداغوجية وتربوية متكاملة ممأسسة، مندرجة في إطار سياسة أو مخطط او”مشروع تربوي” واضح التوجهات والمعالم… ولست أدري ما إذا كان من حسن حظي أم لا أنني قد كنت من”مخرجات أو منتوجات” هذا النمط من التعليم الشمولي المتعدد، الذي لا يمكن إنكار مزاياه، كما بعض مواطن ضعفه أو قصوره…
p أشكرك، ذ. مصطفى محسن، على هذه الأضواء الكاشفة المفيدة التي ألقيتها على أهم محطات مسارك الفكري التكويني. ولكن اسمح لي أن أسألك: هل يعتبر اهتمامك الكبير بالسوسيولوجيا بمثابة لجوء إلى الابتعاد عن الفلسفة التي لك في مقاربتها أعمال مؤسسة رائدة، لكنها لا تقاس بما راكمته من “منجز” وفير في مجالات البحث السوسيولوجي والتربوي؟
nn لقد كان لجوئي إلى السوسيولوجيا كحقل اهتمام واشتغال اختيارا وجهني إليه ما أسلفت الحديث عنه من ظروف تكوين وتحولات مسار، غير أنه لم يكن ابتعادا قصديا عن الفلسفة. فهي حاضرة دوما، بقدر ما وحسب مقتضيات الدراسة والبحث، في كل أعمالي، حتى الإبداعية منها. فالفلسفة، كما يرى مفكرون وعلماء وفلاسفة كثر، تظل، في مواضعات عديدة، “خلفية مضمرة”، كامنة في ثنايا كل علم وكل معرفة وكل تقنية، بل وفي كل ممارسة فكرية وعملية واجتماعية شاملة. غير أن أهم ما أود التذكير به هو أن مجمل أعمالي تظل، مهما تنوعت محاور تركيزها، ذات “هوية سوسيولوجية” بالأساس. وحتى الكتابين الأساسيين اللذين خصصتهما لمقاربة الخطاب الفلسفي، والمدرسي منه بالتحديد، وهما: “المعرفة والمؤسسة…” و”نحن والتنوير…” يعدان، في التحليل النهائي وعلى مستوى النظرية والمنهج والتصنيف، منجزين سوسيولوجيين لا ينفي أبدا، وفق الملاحظة الآنفة، أن ” نفحة أو نكهة فلسفية ما” تبقى كامنة في جل ما أنجزت، ولا سيما فيما انتهجته من أساليب في الكتابة والتعبير والتفكير، وفيما أعتمده في ذلك من أدوات وطرائق للتحليل والتفسير والتأويل والحجاج والبرهنة والاستدلال والاستنتاج… وهومعطى ينسجم، كما أزعم، مع “النموذج الإرشادي: البراديغم” الذي أستأنس به، والذي أجتهد أن أجعله “نقديا حواريا منفتحا على تكاملية العلوم والتخصصات والمعارف”. ولكن في إطار “جدلية تفاعلية وتبادلية دينامية مرنة” بين أجهزتها النظرية والمفاهيمية، وأنماط أطرها ونماذجا المرجعية والمنهجية الموجهة لسيرورات البحث وإنتاج المعرفة ضمن حدودها النسبية المتواضع عليها في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية…
p حينما نتحدث عن محاولات التضييق والإقصاء التي تعرض لها الفكر الفلسفي بالمغرب، وحصاره من طرف السلطات السياسية القائمة، فإننا ننسى أن السوسيولوجيا كانت هي الضحية الأولى لهذا التضييق والإقصاء، وذلك بعد إغلاق “معهد السوسيولوجيا” سنة 1970، وإدماجها إدماجا رديئا ضمن شعبة الفلسفة. فهل تم ذلك نظرا لخطورة الفكر الفلسفي والسوسيولوجي إلى هذه الدرجة؟ ولماذا كان اختيارك للسوسيولوجيا رغم هشاشة شروط وإمكانات البحث العلمي ببلادنا؟ وكيف تفسر هجرة بعض السوسيولوجيين إلى الأنتروبولوجيا أو إلى الكتابة مثل حالة عبد الكبير الخطيبي؟
nn يعود التضييق على الفكر الفلسفي والسوسيولوجي بالمغرب، ولا سيما منذ مستهل سبعينيات القرن الماضي، ومن بين ما يعود إليه من عوامل، إلى تحفظ أو تخوف بعض القوى المتنفذة في دواليب تدبير الشأن العام من المضمون النقدي لهذا الفكر، بل ومن “فكر وثقافة الحداثة” بشكل عام، ذلك أنه، وعلى عكس بعض فصائل اليسار والنخب السياسية وشرائح الأنتيليجانسيا، كان لهذه القوى السائدة منظور آخر مختلف لتنمية وتحديث المجتمع، ممهور في مضمونه ومنحاه ب “تقليدانية محافظة” تروم الإبقاء على شروط الأوضاع القائمة وتطويرها، متوجسة في ذلك من كل فكر مغاير جديد. ولعل مما يفسر هذا التوجس هو أن الفلسفة والسوسيولوجيا معا، تقومان على أسس السؤال والحفر والنقد النظري والمنهجي الذي يعمل على التحليل والتفكيك والخلخلة المتواترة للبنى والهياكل والأجهزة والمؤسسات والأنساق… عاملا بذلك على تعرية وكشف آليات اشتغالها في مساق مجتمعي محدد في الزمان والمكان. وهذا النقد بالذات هو ما ترى فيه تلك القوى الاجتماعية المتنفذة تهديدا ضمنيا ومعلنا لمصالحها القائمة، ولما تملكه من سلط مادية ورمزية، ومواقع وأدوار، وأدوات هيمنة ونفوذ، وتحكم في جل مقدرات ومجالات المجتمع المعني.
في سياق هذا المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي ببلادنا، والذي اتسم، منذ أواسط ستينيات القرن المنصرم على الأقل، بالكثير من أنماط التوتر والصراع والتجاذبات والاستقطابات السوسيوسياسية الحادة المعقدة، ثم التضييق على الفلسفة في الجامعة وتحوير “مناهجها ومقرراتها الدراسية” في التعليم الثانوي، كما هو معروف، وكما عالجت ذلك في بعض أعمالي السوسيولوجية والتربوية. وفي هذا السياق ذاته حدث إغلاق “معهد السوسيولوجيا” اتقاء لمخاطر فكرها النقدي “المزعج” حسب تعبير عالم الاجتماع بيير بورديو. لتبقى بعد ذلك مجرد “مادة” تدرس في شعبة الفلسفة، التي تطورت ثم تشعبت فيما بعد، ليغدو علم الاجتماع الآن “شعبة أو مسلكا” في كليات الآداب ذات الاستقطاب المفتوح، الذي شجع على اجتذاب دراسة علم الاجتماع لأعداد هائلة من الطلاب. وهي وضعية تحتاج في نظري إلى مقاربات علمية تربوية وسوسيولوجية معمقة متنوعة الأهداف والمناهج… وقد حاولت الإسهام في هذا بجهد فكري متواضع عبر دروس وحاضرات ألقيتها ببعض الجامعات المغربية القديمة والحديثة، في محاولة للتعرف على بعض شروط ومكونات الوضعية الراهنة لعلم الاجتماع في الحقل الأكاديمي والثقافي والسوسيو اقتصادي في مجتمعنا المغربي، بل وحتى العربي المعاصر.
وفي إحدى مجالساتي المخصوصة للأستاذ محمد جسوس -رحمه الله- قدم لي تفسيره الشخصي لبعض بواعث القلق أو الانزعاج لدى بعض المسؤولين في علم الاجتماع. فربما كان الأمر يرتبط حينذاك بالتباس حصل لهؤلاء بين مصطلحي: «Sociologie ” و ” Socialisme”، أي بخلط ما بين علم الاجتماع وبين الشيوعية أو الاشتراكية، وبما يرتبط بهما من خلفيات نظرية وعملانية ممارسية تتناقض وطبيعة النظام السوسيو سياسي المتبنى في المغرب، والذي يتواءم مع الرأسمالية والليبرالية والتعددية السياسية أكثر من تناغمه مع أسس الفكر الاشتراكي العام. وعلى أي فإن ما يحصل الآن في مجتمعنا، وطنيا وقوميا، هو نوع من العودة إلى “التطبيع المتحفظ” مع الفلسفة والسوسيولوجيا. وهذا في حد ذاته مكسب مهم، ولكنه ينبغي أن يظل باستمرار مفتوحا على جهود وآفاق الإثراء والتطوير…